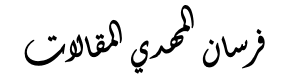مآلات الخطاب المدني

الإسلاميون ضد الحضارة؟
يتردد كثيراً في أدبيات غلاة المدنية أن الحركات الإسلامية حركات عدمية ضد الحضارة والمدنية والتحديث, وأنها مجرد حركات هوية لا حركات نهضوية, وأنه ليس لديها إلا آلية الممانعة ومقاومة التغيير, وأنها حركات انفصالية عزلوية تدعو للتقوقع والانكفاء على الذات, وأنها ضد الاستفادة من المنجزات المدنية الحديثة, ونحو هذا الكلام الذي –بصراحة شديدة- صار مستهلكاً هذه الأيام ويعاني نوعاً من السماجة.
وهذه الدردشة الصحفية المبتذلة لا تخلو إما أن يكون صاحبها لم يقرأ للاتجاه الإسلامي جيداً وإنما هي ألفاظ أعجبه حسن حداثتها فتلقفها ورددها, مع أنها بالمناسبة شعارات قديمة رددها الفكر العربي منذ عدة عقود وإنما استوردها الداخل المحلي مؤخراً.
وإما أن يكون هذا الكلام مدفوعاً باستراتيجية سجالية بأن يحاول الكاتب التدليس على الموقف الإسلامي وتصعيده وتصويره بشكل سلبي بهدف تيسير إسقاطه والرد عليه, فيكون هذا الكاتب يصارع أشباحاً لاحقيقة لها وإنما هي صورة خلقها ليرد عليها كطواحين الهواء.
وفي كثير من الأحيان حين تفتش في دوافع هذا الكلام تكتشف أن الكاتب إنما يحاول تضميد جرح غرزه موقف شخصي لا صلة له بالاعتبارات الموضوعية للقضية أصلاً, وانما الظاهرة الاسلامية في هذه الحالة غرض للنكاية لاأكثر.
على أية حال.. الخطوط العامة لموقف الإسلاميين من الحضارة والمثاقفة عموماً والحضارة الغربية على وجه الخصوص واضحة ليست بالأغاليط, صحيح أن ثمة اجتهادات متفاوتة في بعض التفاصيل, لكن الكليات المنهجية لجماهير الإسلاميين المعاصرين مشتركة لا تكاد تخطئها العين المنصفة, ويتلخص هذا الموقف في ثلاث ركائز هي في حقيقتها “تمييزات منهجية” لمستويات التعاطي والقراءة, ومن استوعب هذه التمييزات المنهجية الثلاث استوعب جيداً الموقف الإسلامي المعاصر من الحضارة والمثاقفة عموماً والحضارة الغربية خصوصاً, وهذه التمييزات المنهجية كالتالي:
-الركيزة الأولى: التمييز بين الحضارة كغاية والحضارة كوسيلة:
فالحضارة عند غلاة المدنية مطلب مطلق يريدون منها أن تهب رياحها وتبحر في كل اتجاه بلا شروط تفرض من الخارج في ظل الحرية الشخصية إلى درجة غياب المعنى وغموض الغاية, أما الحضارة في التصور الشرعي فهي حضارة موجهة بهدف “تحقيق العبودية” بما تتضمنه من إظهار الدين والقيام بالشعائر والشرائع, فالحضارة المنشودة هي الحضارة المنضبطة بقيود الشريعة والهادفة لنصر الإسلام وتحقيق قيمه ومضامينه, وتأخذ قضايا وجزئيات الحضارة قيمتها التفصيلية بحسب مؤداها إلى هذه الغاية.
ولذلك فإن الشارع لم يوظف مفهوم الحضارة ولا المدنية وإنما وظف مفهوم “القوة” و”العلو” كقوله تعالى {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} وقوله صلى الله عليه وسلم (ألا إن القوة الرمي) وقوله تعالى {وأنتم الأعلون} وقوله صلى الله عليه وسلم (اليد العليا خير من اليد السفلى). ومن المعلوم أن الطاقة التخييلية التي تتضمنها ايحاءات مفهوم الحضارة والمدنية ليست كالدلالات التي يضخها مفهوم القوة, فالقوة مفهوم خادم للمبدأ ومرتبط به, أما الحضارة فمفهوم موحي بالمتعة والرفاه.
والمراد من ذلك أن الحضارة والتمدن عند الإسلاميين “مطلب” لكنها ليست هي المطلب الرئيس ولا المطلب الجوهري لهذه الحياة, بل هي مجرد وسيلة لتحقيق الغاية الحقيقية التي هي العبودية.
-الركيزة الثانية: التمييز بين الوجه العلمي والفلسفي والسياسي:
غلاة المدنية يدعون إلى الإقبال الشغوف واحتضان المنجز الغربي بكامل صوره وكأنه معطى مصمت لا يتفاوت, ويتضايقون من الصرامة في الفحص والاختبار ويعدونها لوناً من التعنت والعدمية ورفض المثاقفة, ولذلك يدعون عملياً إلى التسامح والتغاضي عن الثغرات, أو يلتمسون لها المعاذير والتسويغات وينبشون لها الآراء الشاذة لتتكئ عليها, أما الإسلاميون فيفرقون بشكل واضح بين الوجوه الثلاثة الرئيسية للحضارة الغربية, فيتفاوت تقييمهم وصرامتهم وتدقيقهم في الاختبار والفحص بحسبها.
فأما الوجه الأول فهو “الوجه العلمي” المحض بما يدخل فيه من منتجات تجريبية وعلوم طبيعية وتصنيع وتكنولوجيا ونظم اتصال وحوسبة ونحوها من المنتجات التي يغلب عليها أن تكون “أدوات” أو “وسائل” محضة بحيث تستطيع كل ثقافة أن توجهها بحسب قيمها, فهذه حكمة مشتركة, وصواب الفكر الغربي فيها أكثر من ضلاله.
بل إن المجتمع الغربي اليوم لم ينفرد بها فهناك أمم أخرى تشارك في هذا الانتاج التقني ان لم تكن أكثر تفوقاً, وعلى وجه الخصوص اليابان والصين والهند, وتعتبر ظاهرة التلزيم (outsourcing) من أهم الظواهر التي كشفت تحولات التركز في الخبرة التقنية العالمية, بحيث صارت تعهدات التصنيع الخارجي في مناطق العمالة الرخيصة تخلق أقطاب خبرة تكنولوجية جديدة ليست في العواصم الغربية.
ووجه أغلبية الصواب في هذا الباب أن هذه المنتجات مستمدة من القوانين الكونية المحضة التي أودعها الله الطبيعة, فهي حظ مشترك لاتتفاوت كثيراً بسبب الخلفية الدينية.
والواقع أن الإسلاميين بجميع أطيافهم سبقوا غيرهم من الطبقات الثقافية إلى الانتفاع بها, بل وكتب كثير من السلفيين أن حقائق العلوم الطبيعية حقائق شرعية, بل لايوجد علم من العلوم المعاصرة على وجه العالم اليوم خدمه أصحابه برمجياً مثل العلوم الشرعية, وصورة الشاب المتدين في كليات الطب والهندسة والحاسوب ونحوها ليست صورة طبيعية فقط بل هي صورة نمطية راسخة في الوعي الشعبي, حتى أن الفرانكفوني المتطرف محمد أركون أشار إلى ذلك في غير موضع من دراساته, إضافة الى ظاهرة الاقبال الاسلامي على الدورات التدريبية في ادارة الذات وعلم النجاح والبرمجة اللغوية وغيرها, فلا أدري ما وجه المزايدة على الإسلاميين والقول بأنهم ضد المثاقفة والاستفادة من المنجزات؟
وأما الوجه الثاني فهو “الوجه الفلسفي” للحضارة الغربية بما يتضمنه من تصورات عن الأسئلة الأنطولوجية والإكسيولوجية والإبستمولوجية وما بعدها من حقول الفلسفة الكبرى, كحقيقة الحياة, ومفهوم السعادة, ووظيفة الدنيا, وكنه الإنسان, ومستقبل البشرية بعد فنائها, والعالم العلوي, ومرجعية الأخلاق, وإطلاقيتها ونسبيتها, ومصادر المعرفة والتي هي البنية التحتية للفلسفة, ونحوها.
فهذا الوجه ضلال الفكر الغربي فيه أكثر من صوابه, خصوصاً في الأسئلة الكبرى, أما التفاصيل والجزئيات فقد يكون بعضها مشتركاً وبعضها متناقضاً مع الوحي.
بل إن القارئ المسلم لايكاد يجد فيها نتائج مبرهنة يسعد بها ويحملها كرسالة اجتماعية, بل كل فيلسوف ينقض ما قاله سابقه, وغاية القارئ في هذه الأبواب ليس أن يبني تصوراته وعقيدته بشكل صحيح فتكون له إضافة في ذاته, بل غايته أن يحصل له مران ذهني ودربة على السجال والجدل والرد والتفنيد, في مقابل أن يخسر فضيلة الحسم واليقين والتي هي من أهم أسباب الإمامة في الدين كما قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ}.
فيمتلئ القارئ بالارتياب والحيرة واللاحسم في كل شئ, حتى يصل إلى مرحلة عدمية لا يستطيع فيها أن يجزم بشئ من معطيات الشريعة, وهذه ظاهرة مشاهدة, والارتياب والحيرة والتردد في الأصول الكبرى من شعب النفاق والعياذ بالله, كما قال تعالى: {وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ}.
ولذلك تجد عامة غلاة المدنية الذين اقتربوا من هذه الدراسات الفلسفية يرددون “الأهم هو طرح الأسئلة وليس الإجابات” أو قولهم “إلى المزيد من طرح الأسئلة” ونحو هذه العبارات التي هي كالمخدر يسلون به أنفسهم عن عدم الوصول لنتيجة, حتى أصبح شائعاً لدى المؤرخين للفلسفة قولهم “الفلسفة تقدم الأسئلة بما يفوق تقديم الإجابات”.
وسبب ذلك أن المضامين الرئيسية المكتوبة في هذه الحقول إما لائكية محضة وهو الأكثر, وإما كتابية محرفة وهو الأقل, بل هو النادر, على أن من ورث فيهم شيئاً من الكتابية المحرفة خير ممن بقي على اللائكية الخالصة, فإن بركة بقايا النبوات وما فيها من النور خير من العمى التام, فالمتمسك بالمسيحية المحرفة أشرف وأرفع في ميزان الله من الكافر المحض, فنصوص الوحي متضافرة على تفضيل الكتابيين على الدهرية الملاحدة, وهذا من بركة بقايا النبوات التي بأيديهم, فالكتابي خير من المجوسي, والمجوسي خير من الملحد, لأن المجوسي معه شبهة كتاب والملحد لا كتاب له, ولذلك قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (أضل أهل الملل مثل جهال النصارى وسامرة اليهود: أعلم من الفلاسفة, وأهدى وأحكم, وأتبع للحق).
وقال الإمام ابن تيمية أيضاً: (ومن المعلوم أن المشرك إذا تمجَّس, والمجوسي إذا تهوَّد, حسنت حاله بالنسبة إلى ما كان فيه قبل ذلك).
ومما يجدر الإشارة إليه أن هذا الوجه الفلسفي ليس هو الوجه المتقدم في الحضارة الغربية أصلاً, بل هو الوجه الظلامي المتخلف المنحط, برغم محاولات كثير من غلاة المدنية الزعم بأن التطور الغربي انعكاس لفلسفته, وهذا مجرد أمنية تاريخية.
والواقع أن التفوق المدني الغربي اليوم عائد للثورة الصناعية في المرحلة السابقة, ثم الثورة التكنولوجية ونظم الاتصال والمعلوماتية حالياً, وهذه كلها نتاج عرق المعامل والتمويلات السياسية الضخمة لمراكز البحوث, وغاية الفلسفة أن تكون تفسيراً استرجاعياً لما حدث, فهي دوماً تفسير لاحق للأحداث تحاول اعطاءها المعنى بعد أن تقع, فأفضل حالاتها أن تكون “حكيم بعد الحادث”, وهذا سبب تراجع أهميتها المعرفية.
بل إن من أسباب تراجع أهميتها المعرفية عدم قدرتها على خلق “قوانين مطردة” تحقق لها العلمية، ولذلك فهي تعاني من عقدة نقص تاريخية قديمة أمام العلوم الطبيعية التي تفرض احترامها المعرفي بسبب ما تحمله من القوانين العلمية المنظمة, ولذلك كثرت الصيحات الغربية في الفترة الأخيرة بإعلان موت الفلسفة, وانجفلت التطلعات الثقافية إلى العلوم الإنسانية، ولا سيما بعد أن قدمت لها البنيوية شبه اطراد عبر استعارة النموذج الألسني كما أشار إلى ذلك تحديداً كلود ليفي شتراوس وغيره.
وسبب هذا الوهم حول عظمة الفلسفة أن كثيراً من مثقفي غلاة المدنية تأثروا بالكتابات التعليمية عن “قصة الفلسفة” والتي صورت التاريخ البشري كنتاج مباشر لأفكار بضعة عشر فيلسوفاً على مر التاريخ, وكأن التاريخ الإنساني عموماً والتاريخ الأوروبي خصوصاً مركبة يتربع في كابينتها طائفة من الفلاسفة يخلف بعضهم بعضاً يشيرون للمجتمعات أن تذهب يمنة أو يسرة!
والواقع أن الكتب الفلسفية ذات الطابع التعليمي عبثت بتفكير غلاة المدنية كثيراً, فهذه الصورة المرتسمة في أذهانهم وهْم طريف يغيِّب دور العوامل التاريخية الجوهرية في صناعة الماضي والحاضر, كدور القيادات السياسية والخبراء والأعمال الأدبية الكبرى والعواطف الشعبية, فضلاً عن دور الإعلام الحديث ونظم الاتصال وتوازنات القوى والشركات المتعددة الجنسيات ومتغيرات الموارد ونحوها.
بل هذه الرؤية المدرسية الساذجة غيب دور النبوات في تشكيل التاريخ, ولذلك تنبه المؤرخ الشهير توينبي إلى دور النبوات كعامل رئيس في صناعة التاريخ فقال (التحول الديني كان حقيقة مبدأ كل شيء في التاريخ الانكليزي).
وقبل توينبي نبه على هذه العامل الحاسم ابن خلدون في مواضع كثيرة من المقدمة ومنها قوله:
(الدول العامة الاستيلاء، العظيمة الملك, أصلها الدين, إما من نبوة أو دعوة حق).
وقال الإمام ابن تيمية في الصارم المسلول:
(ليس في الأرض مملكة قائمة إلا بنبوة أو آثار نبوة, وإن كل خير في الأرض فمن آثار النبوات, ولا يستريبن العاقل في الأقوام الذين درست النبوة فيهم كالبراهمة والمجوس).
وهذا التفاوت بين الإبداع العلمي والانحطاط الفلسفي هو الغالب على الأمم التي اعتنت بالمدنية وأعرضت عن النبوات, فهو شأن تاريخي متكرر أصلاً, ولذلك لما كانت الحضارة الاغريقية مفلسة من مضامين الوحي غنية بالعلوم المدنية تشكلت فيها ذات الصورة, ويلخص الإمام ابن تيمية هذا المشهد بقوله:
(فإن القوم-أي الفلاسفة- لا يعرفون الله, بل هم أبعد عن معرفته من كفار اليهود والنصارى بكثير, لكن لهم معرفة جيدة بالأمور الطبيعية, وهذا بحر علمهم وله تفرغوا, وفيه ضيعوا زمانهم, وأما معرفة الله تعالى فحظهم منها مبخوس جداً, وأما ملائكته وأنبياؤه وكتبه ورسله والمعاد فلا يعرفون ذلك ألبتة)
وقال الإمام ابن تيمية أيضاً عن رمز الفلسفة اليونانية:
(وأرسطو المعلم الأول من أجهل الناس برب العالمين إلى الغاية)
والحديث عن هذه الإشكاليات الفلسفية يطول ومن الأفضل أن نرجئه إلى الجزء الثاني الذي هو عن علاقة الخطاب المدني بالفكر الحديث لكونه أكثر مناسبة.
والمهم هاهنا أن نشير إلى أن هذا الباب الفلسفي تجد عموم الإسلاميين فيه حذرين أشد الحذر, لأنهم ولله الحمد موقنون أن مضامين وتصورات الوحي أهدى وأحكم.
بل إن كثيراً من حقائق الوحي في هذا الباب الفلسفي لا تعرفها الفلسفة الغربية المعاصرة أصلاً, أو لديها حوله معلومات مشوهة, كباب الإلهيات, وما يتضمنه من معرفة الله وما ينبغي له معرفة صحيحة, والعوالم الغيبية وتقدير كل شئ في اللوح المحفوظ, وجريان السنن الطبيعية بغايات إلهية, وأثر العبادة في النواميس الكونية, وحركة القلب بالتزكية كالتوكل والافتقار والضراعة, ونحو هذه المعاني التي هي التنوير الحقيقي, كما قال تعالى في هذه المقارنة بين تنوير الوحي وظلامية ما يعارضه:
{أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا}[الأنعام:122]
و قد أشار الامام ابن تيمية الى هذا التنوير المستمد من الوحي فقال:
(وعند المسلمين من “العلوم الإلهية” الموروثة عن خاتم المرسلين ماملأ العالم نورا وهدى)الفتاوى 2/84
وأما الوجه الثالث فهو “الوجه السياسي” للحضارة الغربية وهو الوجه الكالح بكل معنى الكلمة, فالمؤسسة السياسية الغربية مؤسسة إمبريالية استعمارية تمتص ثروات الأمم الأخرى, وليس لديها أية حواجز أخلاقية أمام مصالحها, فهي ديمقراطية شفافة في السياسة الداخلية, ديكتاتورية معتمة في السياسة الخارجية.
والمؤسسة السياسية الغربية هي التي خلقت أبشع النماذج الدموية في التاريخ, وهي المسؤولة عن تطوير أدوات الابادة البشرية الشاملة, والمعتقلات اللاإنسانية, وقصف المدن الكاملة بما فيها من المدنيين, كيف تبرأ تلك الحضارة من عقدة الذنب وهي تتذكر عصر العنصريات والقوميات والنازية وهيروشيما ونجازاكي واستعمار الدول العربية وغوانتنامو وأبو غريب, والأسلحة النووية والغازات السامة, وإيقاف تحقيقات الفساد لأجل مصالح قومية عليا, بل وسن تشريعات حرمان المسلمة من حجابها, ورعاية مؤسسات صحفية تسخر بنبي يؤمن به شطر العالم.
على أية حال.. هذه الوجوه الرئيسية الثلاثة للحضارة الغربية إنما هي نماذج فقط, وتبقى هناك حقول أخرى لا يتسع هذا الجزء لتفصيلها كالعلوم الإنسانية والفنون ونحوها, وهذه النماذج كافية في الدلالة على المقصود بأن الإسلاميين لديهم موقف تفصيلي يميز المفيد من الضار وليس كما يتصوره غلاة المدنية.
-الركيزة الثالثة:التمييز بين الانتفاع والانبهار:
غلاة المدنية يتوهمون أن هناك تلازم بين الانتفاع والانبهار, وأنه لكي نستفيد من الحضارة الغربية يجب أن تمتلئ أشداقنا بتأوهات التعجب, وأن نفغر أفواهنا ونحن نسوق فلسفتهم, وأن نحوط أسماءهم وأعلامهم بهالة التعبيرات الخارقة, ولذلك يطلق بعضهم عبارة “المعجزة الغربية” أو “معجزة الحداثة” ونحوها.
وتفريعاً على ذلك ينظرون إلى أي ذم أو انتقاص لواقع الحضارة الغربية على أنه رفض للانتفاع بما لديها من صواب! ويتبرمون بأي تعبير ديني في توصيف الحضارة الغربية كوصفها بالضلال والفجور والفواحش والكفر وأمثالها من التعبيرات الشرعية, ذلك أن هذه المفاهيم وأمثالها مشبعة بحمولة دينية وهم يريدون التعامل بلغة مدنية تستبعد المحتوى الديني من التقييم.
والواقع أن عدم فهم غلاة المدنية للموقف الشرعي إزاء الحضارات هو سبب عدم فهمهم للموقف الإسلامي المعاصر من الحضارة الغربية, فليس في الشريعة تلازم مطلق بين الانتفاع من الآخر والانبهار به, بل الموقف الشرعي بخلاف ذلك أصلاً.
فالنبي صلى الله عليه وسلم استفاد من الحضارة المعاصرة له في الخندق ومشروعية الغيلة والتبادل التجاري وافتدى الأسير الكافر بتعليم المسلمين وراسلهم واتخذ خاتماً لمراسلته كما هي عادتهم وقبل هداياهم كما قبل هدية ملك أيلة والقبط وأكل من طعامهم ولبس من منسوجاتهم وشارك يهود خيبر في نخيلهم وغير ذلك من أوجه التواصل الشرعي لكنه مع ذلك كله بين ضلالهم وانحطاطهم وظلاميتهم بسبب إعراضهم عن نور الوحي, كما قال صلى الله عليه وسلم عن الفترة التي سبقت بعثته: (إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من أهل الكتاب) رواه مسلم.
وقال تعالى:
{كِتَابٌ أَنزلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ}
وقال سبحانه وتعالى:
{هُوَ الَّذِي يُنزلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ}
فبين سبحانه أن هذه الأمم التي عاصرته كلهم في ظلمات, وأنهم هم الظلاميون الذي يحتاجون التنوير الحقيقي الذي هو نور الوحي.
هذه التمييزات المنهجية الثلاثة وهي: التمييز بين الحضارة كغاية والحضارة كوسيلة, والتمييز بين الوجه العلمي والفلسفي والسياسي للحضارة المعاصرة, والتمييز بين الانتفاع والانبهار, هي المفتاح الرئيس لفهم موقف الإسلاميين المعاصرين من الحضارة المعاصرة, ومن استوعبها علم قطعاً جهل من يقول ان الإسلاميين ضد الحضارة والمثاقفة والتحديث, واستبان له أن لدى الإسلاميين موقفاً تفصيلياً منظماً مستمداً من خلاصة توازنات نصوص الشريعة.
أما كثرة تذمر غلاة المدنية وشكواهم من الارتياب الاجتماعي ضد الثقافة الغربية وضعف الثقة بدعاتها وتشنج بعض الناس ضد المنتج الغربي فالمسؤول الحقيقي عنه ليس الإسلاميين وانما النزق التغريبي الذي تبناه بعض غلاة المدنية حتى قال الأول: يجب أن نأخذ ما لدى الغربيين بحلوه ومره وخيره وشره, وحتى قال الآخر: الحضارة الغربية كقصر فخم يجب أن لاننشغل بسلة مهملاته الصغيرة, فمثل هذه الطيش وانعدام التماسك أمام المنجز الغربي هو الذي أقلق الهوية الإسلامية واستفز توربينات الممانعة الشعبية, إذ لو رأى الناس في تلك النخب الثقافية موقفاً عقلانياً رزيناً إزاء منتجات الفكر الغربي يبدي غيرته على قيم الإيمان والفضيلة لما احتاجوا أن يعبروا عن رفضهم بهذه الصورة التي ينتقدها غلاة المدنية.
ماوراء أنسنة التراث:
المعركة اليوم معركة “تفسير” بالدرجة الأولى, تدور حول السؤالين التاليين: كيف نفهم النص؟ وكيف نفهم حملة النص؟
فتفسير النص, وتفسير التاريخ, كادا أن يكونا محور الجدل الثقافي المعاصر, وكاد أن يكون السجال الفكري يدور حول “النماذج التفسيرية” وتقنيات التأويل.
وفي المرحلة الفكرية السابقة –كماسبقت الإشارة لذلك- كانت النخبة الثقافية المأزومة مع الإسلام ودعاته تطرح نقداً وتهجماً على مضامين الرؤية الإسلامية ذاتها, فهناك سيل كبير من المقالات والكتب التي انتقدت التصورات الإسلامية صراحة كتحكيم الشريعة والحجاب والجهاد وغيرها من المفاهيم والقيم القرآنية وكانت المفاجأة أن الاتجاه الإسلامي يزداد صلابة, ويتأكد لقواعده الشبابية جدية عداء هذه النخب الثقافية المأزومة للإسلام والوحي والتعاليم النبوية.
لقد شعرت هذه النخب الثقافية المأزومة بكل وضوح بافلاس رصيدها الشعبي, بل ومعاناتها من حالة نبذ اجتماعي حاولت ان تتغلب عليه من خلال انخراطها في مشروعات السلطة, والتضحية بأية مضامين تدفع باتجاه الاستقلالية السياسية, بل وفي بعض الأحيان يصل الأمر –ولشديد الأسف- الى اعتبار هذا الاستقواء غير النزيه نوعاً من الحذاقة في ادارة الاختلاف الفكري.
ونتيجة لهذا النبذ الاجتماعي فقد تحولت النخب الثقافية المأزومة إلى خيار ثقافي آخر, حيث هجرت إعادة مضغ النقد الممجوج حول الحاكمية والحجاب والجهاد والتعدد وأحكام الذميين ونحوها إلى محاولة تهتيك الوشائج بين القواعد الشبابية الإسلامية وبين نماذجها الملهمة التراثية والمعاصرة وذلك من خلال خطاب الأنسنة.
والأنسنة في الخطاب العربي اليوم توظف في سياقين, فأما السياق الأول فهو “أنسنة العلاقات” بمعنى أن تكون علاقاتنا ونظرتنا إلى العالم اليوم هي علاقات مدنية مبنية على القيم الإنسانية المشتركة, لا على أساس الهوية الدينية, وهذه سنعرض لها في الفقرة اللاحقة.
أما السياق الآخر فهو “أنسنة التراث” بمعنى إعادة تفسير التراث وولادة مفاهيمه الجوهرية وحراكها الداخلي تفسيراً تستبعد فيه أية دوافع أخلاقية أو دينية أو قناعات ذاتية, ويبحث فيه عن الدوافع المادية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم عرقية أم غيرها, عبر التوسل بالجهاز المفاهيمي الأنثروبولوجي تحت شعار التسلح بأدوات العلوم الانسانية المعاصرة, وبعض الفرانكفونيين العرب حين يتحدث عن توظيف أدوات العلوم الانسانية المعاصرة يضيف الى ذلك فاصلاً تاريخياً وهو قوله “العلوم الإنسانية ما بعد العام 1950م” ولا أدري لماذا هذا التاريخ التوقيفي, لكن هذه هي الدعوى على اية حال.
بمعنى أن تفسر تشكلات التراث على أنها مدفوعة بصراع سلطة أو مزاحمة سيادة أو احتفاظ بالجمهور أو أهداف بزنسية أو صفقات تسويقية, فمن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب مروراً بالشافعي وانتهاء بالدعاة المعاصرين تفسر كافة تمظهرات الخطاب على أنها مجرد موازنات سياسية وحسابات اجتماعية محضة.
وهكذا تنطلق صافرة الأنسنة في لحظة إطلاق رصاصة الموت في دماغ التفسير الأخلاقي والديني, فحين تجمع الوقائع بطريقة موجهة وتربط بدوافع سياسية وخلفيات اجتماعية تذوي منزلة رموز الإسلام, وتسقط الثقة بمايقولون, ويزدرى ما يحملون, وينظر لمواقفهم البطولية على أنها مجرد استماته في حظوظ النفس, وهكذا ينقطع عن المنابع وُرَّادها, وتموت وظيفتها في القيام بدورها في شحن الشاب وتزويده بالمضامين الإسلامية.
الأنسنة في الخطاب العربي المعاصر لم تستوعب مفهوم الأنسنة فعلاً كما هو في ذاته, صحيح أن هناك في المقابل مبالغات ساذجة في تصوير التاريخ ترنسندنتالياً باعتباره مجرد معطيات متعالية لا صلة له بالتركيب البشري, لكن هذا لا يعني الانقلاب للجهة الأخرى.
العلمانيون العرب يتبرمون كثيراً من إمكانية اعتبار الدين والأخلاق والإيمان محركاً للتاريخ, بل يعتبرون التاريخ محكوم دوماً بدوافع غريزية محضة, إما مادية أو سيادية أو غيرها, أما الخطاب الديني والأخلاقي فهما مجرد بنية فوقية معلنة تخفي الدوافع التحتية الحقيقية.
لقد بلغت الأنسنة العربية مراحل مزرية تستدعي الرثاء, فحرب أبي بكر للمرتدين هي محاولة مادية لتمويل الخزينة, وعثمان وعلي مجرد طامحين للسلطة, والفتوح الإسلامية كلها حركات إمبراطورية توسعية, والشافعي مهجوس بشكل مضمر بعرقلة نفوذ السلطة السياسية لسلطته العلمية, ومحمد بن عبدالوهاب مسعور بالمزيد من الجغرافيا, وآباء الحركة الإسلامية الروّاد يسعون بشكل مكشوف للوصول للسلطة, والدعاة المعاصرون كلهم يبحثون عن بريق الإعلام والقنوات الفضائية.
حالة الافلاس في الخطاب العربي المعاصر تستدعي النظر بعين الرحمة والإشفاق والشكر لله على تجاوز هذه النظرة المرضية الهوسية للآخرين, أتساءل أحياناً لماذا لايفكر العلمانيون العرب بأن هؤلاء الرموز قد يكونون مدفوعين بدوافع روحية وأخلاقية؟ خصوصاً أن كثيراً منهم ضحى بحريته أو روحه التي بين جنبيه, لكن ربما أن من لم يتذوق الدافع الأخلاقي في نفسه فلا يمكن أن يقرأه في تصرفات الآخرين.
فضلاً عن أن هذا التفسير لدى العلمانيين العرب ينم عن جهل مطبق بمفهوم الأنسنة ذاته, فمقتضى الأنسنة هو النظر إلى الإنسان بما هو إنسان, ولاشك أن من أقوى مكونات الإنسان المكون الديني والأخلاقي والروحاني, فاستحضار بقية مكونات الإنسان وتغييب بعضها الآخر هل يستحق أن يسمى أنسنة أم يسمى اختزالاً للإنسان؟
وباختصار شديد تحولت تقنيات الأنسنة إلى خطاب “سوء ظن” منهجي منظم, بدلاً من أن يكون مجرد زلة سلوكية, ويسمى في النهاية -وبكل بجاحة- خطاباً تفسيرياً علمياً! ولذلك فمن المشاهد اليوم أن من انهمك في مشروعات إعادة قراءة التراث المهجوسة بافتراض الدوافع السياسية في كل حدث فإنه يمتلئ قلبه بالغل على القرون المفضلة, وقد قال تعالى:
{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإيمان وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}
ولو جئنا نختبر ذلك العصاب في التفسير المادي لواقع الحركة الإسلامية فإنه حتماً سيفلس في تقديم إجابة دقيقة على الكثير من الظواهر.
خذ مثلاً: مالذي يدفع الإسلاميين المعاصرين إلى ترك الفرص الاستثمارية في المؤسسات الربوية وتحمل كلفة المصرفية الإسلامية؟ مالذي يدفع الشابة المؤمنة الرقيقة إلى ارتداء الحجاب وتحمل نظرات الاستخفاف في الأماكن العامة؟ مالذي يدفع شاباً في زهرة العمر إلى التضحية بمجتمع الرفاه الذي يتقاطر اليه الوافدون والمقيمون ويتوجه لجبال شعثاء ينشد غناء الموت؟ مالذي يدفع رجالاً تشابكت مسؤولياتهم الاجتماعية والأسرية إلى التنازل في الظل عن جزء من رواتبهم المحدودة لطباعة تفسير أو توزيع شريط قرآن؟ مالذي يدفع فتى في غمرة سني اللهو واللعب إلى أن يدع مغاني أقرانه ويمد اليك مع ابتسامته الغضة تمرة تفطير عند إشارة مرور؟
وهكذا دواليك, مشاهد كثيرة تمردت على نظريات الأنسنة العلمانية, وأفلست محاولاتها التفسيرية البائسة في قراءة هذه الظواهر, لا زالت هذه المدرسة غير قادرة على استيعاب أثر الإيمان في النفوس بما يجعل الدين محركاً للتاريخ, فلم يصلوا إلى ما وصل إليه هرقل بحكمته الرومية حين أدرك ماذا تصنع “بشاشة الإيمان” إذا تسللت إلى القلوب, وذلك فيما روى البخاري أن هرقل قال لأبي سفيان:
{وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لا, وَكَذَلِكَ الإيمان حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ}
ويمكن للقارئ أن يضع المدارس التفسيرية في اطار تاريخي أو هيكل عام يمكننا من تصور اتجاهاتها العامة, حيث يمكن القول -بشئ من التجوز- أن المدارس التفسيرية مرت بثلاث مراحل “مرحلة المؤلف” و “مرحلة النص” و “مرحلة القارئ” , فمرحلة المؤلف كان التركيز فيها على خلفيات منتج النص وسياقه الذي يتحرك فيه, واندرج فيها المدارس النفسية والاجتماعية ونحوها.
والمرحلة الثانية كانت مرحلة النص وكان التركيز فيها على بنية النص ذاته بغض النظر عن السياق التاريخي, وقد أثر في الدفع بهذه المرحلة إلى الوجود بحوث العالم الألسني دي سوسير الذي توفي مطلع القرن الماضي وذلك في كتابه عن علم اللغة العام والذي جمع من محاضراته بعد وفاته وركز فيها على التفريق بين المحور السنكروني والدياكروني, فكان هذا التمييز المنهجي بين المحورين الآني والتطوري هو النافذة التي انبثق منها التفكير البنيوي, معززاً بإنتاجات المدرسة الشكلانية الروسية, وسرعان ما انتشر هذا النموذج الألسني إلى بقية العلوم الإنسانية وخصوصاً على يد أنثروبولوجيا شتراوس وكتاباته حول الأشكال الأولية للقرابة, ثم جاك لاكان في التحليل النفسي وألتوسير في تأويل الماركسية, ووصل هذا النموذج البحثي إلى ذروة جاذبيته حين قاربه مؤرخ الأفكار الشهير ميشال فوكو في آركيولوجياته حول التطورات الإبستيمية للتاريخ الأوروبي وذلك في كتابه ذائع الصيت الكلمات والأشياء.
صحيح أن فوكو كان يتملص من بنيويته بعد خبوها لاحقاً, لكن الباحثين والمؤرخين جرت عادتهم على اعتبار هذا الرباعي وهم شتراوس ولاكان وألتوسير وفوكو أبرز تطبيقات البنيوية, كما نجد ذلك عند روجيه جارودي في كتابه “البنيوية فلسفة موت الانسان”, وعند كريزويل في “عصر البنيوية”, بل حتى عند المؤرخين النقاد العرب كصلاح فضل وغيرهم, وأهم دارسي فوكو في كتابهما “ميشال فوكو مسيرة فلسفية” مالوا الى تبني هذه البنيوية المرحلية في خطاب فوكو.
وربما كانت ثورة الطلاب في فرنسا نهاية الستينات –بحسب مؤرخة البنيوية كريزويل- هي الإعلان الرسمي لنهاية البنيوية والتي هي رمز عصر النص وبداية عصر جديد تحول فيه الاهتمام إلى “القارئ” بمعنى البحث في دلالات الخطاب, لا على أساس المؤلف ولا على أساس النص, بل طبقا لوعي القارئ, فشاعت -بدرجة أقل- تفكيكية جاك دريدا ومفاهيم الغراماتولوجيا, وانتعشت جماليات الاستقبال ونظرية التلقي على يد هولب, وبلغ هذا المنهج ذروته التفتيتية في شعار “النص رياضياً يساوي عدد القراء”.
وفي بحر السبعينات, وعلى مائدة مستديرة في الكوليج دي فرانس, تمتم مؤرخ الأفكار المعروف “ميشال فوكو” في توطئة محاضرته عن النظريات التفسيرية عند الثلاثي (نيتشة, فرويد, ماركس) بحلم حالت المنية دون تحقيقه, وذلك حين قال:
(الحقيقة أن هاته الأفكار التي أعرضها عليكم تخفي من ورائها حلماً: وهو أن نتمكن ذات يوم من وضع نوع من الموسوعة التي تضم جميع “تقنيات التأويل” التي أمكننا معرفتها ابتداء من النحاة الإغريق إلى أيامنا هاته, وإني أظن أن هاته المدونة الضخمة التي تضم جميع تقنيات التأويل, لم يكتب منها حتى الآن إلا فصول قليلة).
والحقيقة أن من يتأمل في كثير من التقنيات التفسيرية الحديثة التي سلطت على التراث يلاحظ دورانها كثيراً حول مفهوم “السلطة” سواء كانت سلطة السيادة أو إرادة السلطة كما في الاتجاهات النيتشوية, أو سلطة المال أو البعد الاقتصادي أو البنية التحتية المتعلقة بأنماط الإنتاج كما في التفسير الماركسي, أو سلطة الليبيدو الفرويدي أم غيرها.
ويلاحظ القارئ “الهادئ” أن هذه التقنيات التفسيرية الباحثة عن دور السلطة في تشكيل النص لم يكن وهجها بسبب “عبقريتها” وإنما كان وهجها بسبب “تطرفها”, فدور السلطة والمال والجنس وغيرها من الدوافع في تشكيل النص والتاريخ هي معطيات معروفة مسبقاً وليست جديدة, وإنما الذي صنع لها هذا الدوي والزخم إنما هو التطرف في جعلها العامل الحاسم.
فالوحي الإلهي ومن بعده علماء التراث كشفوا عن هذه السلطات وغيرها بشكل مبكر ولكنهم “أعطوها حجمها” ولم يبالغوا في تتبع تشكلات التاريخ بناء عليها, وهذا انعكاس لبنية الاعتدال الشرعي, وبنية الغلو الغربي.
ففي الحديث الشهير الذي رواه الترمذي وغيره وصححه غير واحد من الحفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«مَا ذئبان جَائِعَانِ أُرسِلاَ في زريبة غَنَمٍ بأفسَدَ لها مِنْ حِرصِ المرء على المال والشَّرَف لدينهِ»
فبين النبي صلى الله عليه وسلم سلطة الشرف وسلطة المال في تشكيل شخصية الفرد, وقبل هذا الحديث فقد أشار القرآن إلى دور هاتين السلطتين فقد حكى الله عن أصحاب الشمال قولهم:
{مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ, هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ}
وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلك في موضع آخر إلى سلطة المال وسلطة الغريزة الجنسية, فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن عمر:
« ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصِيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إِليه ».
وتكلم علماء السلوك الإسلامي كثيراً حول “قوادح التجرد” وأسهبوا في ذكر هذه السلطات التي تؤثر على المعرفة وتخلق التحيزات الداخلية, كسلطة الآباء وسلطة مشاكلة الأصحاب وسلطة الجاه وغيرها كثير, ومن ذلك ماذكره بشكل تفصيلي منظم الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة.
بل إن الناقد السعودي المعروف عبدالله الغذامي في كتابه الخطيئة والتكفير حين شرح أسس السيميولوجيا نقل نقلاً عن الإمام أبي حامد الغزالي وقارنه بما وصلت إليه السيميولوجيا الحديثة ثم ذكر أنه يبدو أن السيميولوجيا الحديثة لم تكد تتقدم شيئاً بعد الغزالي!
وما نقله الغذامي عن الغزالي مبثوث عند غيره من علماء التراث, وأحياناً بشكل أكثر تفصيلاً.
والمقصود هاهنا ذكر أن أكثر هذه التقنيات التفسيرية الحديثة لم تأخذ دويها الاعلامي بسبب جدتها بقدر ما هو مغالاتها في تحويل الدافع الطبيعي إلى عامل حاسم ومطلق يجيب على كل الظواهر.
وقد سبقت الاشارة الى أن الأداتين المفضلتين في خطاب أنسنة التراث هما أداتي التسييس والمديونية, بل كادا أن يكونا محور تلك الأطروحات التفسيرية كلها, بحيث تؤول اليهما كل تلك النتائج.
والجدير بالذكر أن الأصول الرئيسية لتلك التأويلات هي أصلاً اطروحات استشراقية مبكرة رددها كبار المستشرقين أمثال شاخت ونللينو وجولدزيهر وغيرهم, وإنما كان الدور الجوهري الذي لعبه الفرانكفونيون العرب هو دور “الشراح” الذين أعادوا صياغة وترتيب تلك النتائج, وأكثروا من التنويع عليها, وغالب الاضافة لدى الشراح العرب إنما هي استلهام النماذج الاستشراقية في تطبيقات جديدة, أو اكتشاف شواهد جديدة لتلك النظريات التفسيرية, أما التخلص من طوق تلك الآليات الاستشراقية واستكشاف دور “النص” في تشكيل الحياة العامة للتاريخ الاسلامي فهو نادر فيهم.
والواقع أن أداة “المديونية” بمعنى تتبع حضور الآخر في الذات, أي استكشاف أثر الثقافات السابقة على الثقافة اللاحقة هي في أصلها جزء من منظومة الأدوات العلمية لتحليل الخطاب, وقد وظفها المبدعون في التراث الاسلامي بشكل رائع ولكن دون مغالاة ولاتعسف ولاتكلف, بل باعتبارها عامل ضمن شبكة عوامل مركبة, لا باعتبارها العامل الحاسم, ولابتكلف رد كل شئ اليها.
فالدراسات الاستشراقية –وتبعاً لذلك شراحها من الفرانكفونيين العرب- تحاول رد كل مفاهيم التراث الاسلامي التشريعية والسلوكية الى الثقافات السابقة للاسلام وتصوير التراث كحالة اقتراض ثقافي, ويستبعدون الوحي من أن يكون منبعاً لتلك التصورات.
بينما لم يكن علماء التراث الاسلامي بهذه المغالاة والتطرف, بل تحدثوا كثيراً عن ماكان الأئمة يسمونه “علوم الأوائل” وانتقدوا استمداد بعض مفاهيم علم الكلام وأصول الفقه والتصوف منها, ولكنهم لم يشطبوا الوحي والنص من دوره الجوهري في تشكيل التراث, وهذا يؤكد ماسبقت الاشارة اليه من الفارق بين بنية الاعتدال الاسلامي وبنية الغلو المعرفي الغربي.
وهذه المقارنة تكشف بجلاء أن مالدى هذه التفسيرات الاستشراقية وشراحها العرب من الحق فقد قرره علماء التراث الاسلامي, وماأضافوا الى ذلك فأغلبه فروض واحتمالات باطلة, تستند في غالبها الى التشابه الفيلولوجي لا إلى المستند التاريخي.
ومن أكثر أسباب هذا الضلال الاستشراقي غياب الوعي بمعطيين أساسيين, أولهما: دور النبوات وبقايا الكتب السماوية في تشكيل ثقافات الأمم السابقة للاسلام, وثانيهما: حجم المفاهيم المشتركة بين الكتب السماوية كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد).
وتبعاً لهذين المعطيين فإن جزءاً كبيراً من ظاهرة التشابه المفاهيمي بين ثقافات الأمم المتأثرة بالنبوات ليس نتيجة اقتراض ثقافي بينها, بقدر ماهو انعكاس لمصدر متقارب المفاهيم, بل يصل أحياناً لحد التطابق.
وأما أداة “التسييس” وهي التنقير عن الخلفيات السياسية للخطاب التراثي فأكثرها افتراضات وتهويلات وسوء ظن, وحين نتأمل في ظاهرة التفسير المادي/السياسي للتراث فاننا نشعر بالألم من حالة “التناقض التفسيري” الذي يقع فيه غلاة المدنية.
ففي قراءة التراث يميلون الى تقديم قراءة تاريخانية تحيل الافكار الى خلفيات السياق الاجتماعي والسياسي, فيفسر علم الفقه بصراعات القوى, وعلم العقيدة بمعارك المذاهب, وعلم الحديث بطلب السوق, وعلم التفسير بالموروث الثقافي, وهكذا.
بينما في قراءة الفكر الغربي لاتتم قراءته بمنظور تاريخاني يكشف البعد الذاتي, بل تتم قراءته بنيوياً باعتباره مجرد نسق ثقافي نقي متعالٍ, ومعزول عن الخلفيات والدوافع البشرية والسياسية والعنصرية, فيصور باعتباره مجرد فلسفة تستهدف الاستنارة والسلام الانساني وسعادة البشرية.
ومقارنة هذين المشهدين تشي بالتناقض المذهل في نظرية التفسير, فلايمكن تصور أن تكون حضارة كاملة تقرأ تاريخانياً, وحضارة أخرى تقرأ بنيوياً, فتفاوت التقنية التأويلية بهذا التناقض الحاد يكشف عن انحيازات نفسية عميقة أكثر من كون الخطاب رؤية معرفية.
والمتأمل في خطاب غلاة المدنية واللغة التي يعبرون بها عن منجزات الفلسفة الغربية والهالة التي يحيطون بها الأعلام الأوروبية ينكشف له هذا الانحياز النفسي بشكل واضح, فالتصور المطروح عن الفكر الغربي ليس “تصور علمي” معني بقراءة وتفسير الحالة الغربية كنسيج اجتماعي أو شبكة معقدة تمتزج فيها السياسة والمصالح والافكار والاخلاق والتيارات, بل تقدم صورة الفكر الغربي بلغة مناقبية وعبارات وجدانية هي أقرب الى الهيام منها الى القراءة المعرفية, فخطاب غلاة المدنية عن الغرب هو خطاب تبشيري وليس كما يزعمون من أنه خطاب تحليلي.
بل ويصل التطرف في تطويب الغرب -بمعنى تحويله الى طوبى- عند بعض غلاة المدنية الى مستويات أكثر من ذلك, فبعض غلاة المدنية اذا أخذ يتحدث عن المجتمع الغربي كأنه يصف “مدينة فاضلة” تتحقق على الأرض, فتأخذك التساؤلات أين هذا المجتمع المثالي الرومانسي الخالي من النزوات البشرية الذي يتحدث عنه هذا الكاتب؟
لتكتشف بعد ذلك أن هذا الكاتب حين يتحدث عن المجتمع الغربي فإن ذهنه يمر بثلاث مراحل: ففي البداية يركِّب “الصورة المثالية” الحالمة في ذهنه, ثم ينسبها لهذا “المجتمع الغربي”, ثم يحاكم المجتمعات الأخرى عن عدم وصولها لهذا المستوى الغربي المتقدم؟!
فالمجتمع الغربي يطابق المثال الذهني الطوباوي المفترض, وليس هو الواقع الغربي الذي نعرفه جغرافياً وفكرياً, بمعنى أنه تحول الغرب الى “مقولة مرجعية” تستحضر لأغراض التقييم والقياس ومحاكمة التجارب البشرية الأخرى, أكثر من كونها للدلالة على حضارة معينة معروفة جغرافياً وفكرياً ولها سياقاتها الخاصة.
وهذه السيرورة الذهنية تشابه الى حد كبير بعض متفقهة المدنية الذين إذا لم يستحسنوا بذوقهم المحض شيئاً قالو: هذا لاينسجم مع الشريعة. فنسبوا ذوقهم للشريعة, ثم حاكمو الوقائع على أساس مخالفتها لهذه الشريعة التي زعموها.
وحتى لايكون الكلام تجريدياً أذكر أن أحد كتاب الغلو المدني أفرد عدة مقالات يتحدث فيها عن ظاهرة “القبيلة” في المجتمع العربي والمحلي خصوصاً, وخلع عليها كل ألقاب الذم التي حملها قاموسه, ثم أخذ يتحسر بسبب أن ثقافتنا تحمل جذور العنصرية بخلاف الثقافة الغربية الخالية من هذه العنصريات.
فلاأدري عن أي غرب يتحدث هذا الكاتب؟ فالصراعات الكبرى في الثقافة الأوروبية كانت تدور حول تمايزات الأعراق الغربية, وقد أشعلت على أساسها حروب كبرى, وقامت على اساسها مشروعات دول, والولايات المتحدة التي ينظر اليها غلاة المدنية باعتبارها نموذج المساواة لم يصل الى سدة الحكم فيها طوال عمرها الرئاسي لارجل أسود ولا أنثى حتى هذه الساعة, ومع ذلك كله فإن هذا الكاتب يحاكمنا الى هذه الثقافة زاعماً نقاءها الاثني, فهذا مما يدل على أنه ركب صورة ذهنية مثالية ثم نسبها للمجتمع الغربي ثم أخذ يحاكم المواقف اليها.
بمعنى أن الغرب تحول عند بعض غلاة المدنية الى صورة متخيلة غير موجودة هي أشبه بالمطلق والمتعالي منها بالواقعي والانساني, وعليه فيبدوا أن غلاة المدنية هم الذين بحاجة الى أنسنة تصوراتهم عن الغرب, بمعنى كشف البعد الانساني والذاتي في مضامين الفكرة الغربية, لاقراءتها باعتبارها فكرة سماوية مجردة عن السياق التاريخي.
والحقيقة أن هذا الانبهار المرضي فضلاً عن كونه متصادم مع الوحي والواقع, فانه مضر أيضاً بالنفسية المسلمة, فان الاعتماد على جاهزية المنتج الغربي يسبب تسلل الشلل الى امكانيات الانتاج, ولذلك فان تجارب النهوض الآسيوية كلها كانت تؤكد أهمية عنصر “الثقة بالذات” في نجاح التنمية.
وبعض غلاة المدنية قد أغلق الباب بينه وبين نقاد الثقافة الغربية, عن طريق مسلمة مسبقة وهي أن “نقد الثقافة الغربية ناشئ عن الجهل بها” فكلما رأى ناقداً للثقافة الغربية افترض أنه ينقدها بسبب أنه لايعرفها.
وهذا تصور غير صحيح بتاتاً, بل إن رموز نقد الفكر الغربي هم أكثر اطلاعاً من كثير من المبشرين بالفكر الغربي, وسأضرب مثلاً هنا بأربعة مشروعات ضخمة: وهي مشروع فيلسوف المغرب “د.طه عبدالرحمن” لاعادة تقويم التراث وحق الاختلاف الفكري والفلسفي وتأصيل الفلسفة واستكشاف العلاقات الدقيقة بين الألسنية والمنطق, ومشروع “د.ابويعرب المرزوقي” لربط جذر المشكلة الفلسفية والفكرية بالفلسفة الاسمية في صورتها التيمية/الخلدونية, ومشروع “د.عبدالوهاب المسيري” لدراسة ظاهرة العلمانية الشاملة -أو مايمكن تسميتها بظاهرة المادية- في التصور الغربي, ومشروع “د.ادوارد سعيد” لتتبع تجليات “ارادة الهيمنة” في البنية التحتية للمنتج الثقافي الغربي كظاهرة الاستشراق والسرديات الكبرى في التاريخ الغربي.
فهؤلاء الرموز الأربعة لنقد الفكر الغربي ليسوا جهالاً به, بل هم أخبر به من كثير من المبشرين بالغرب من غلاة المدنية, ومع ذلك فهؤلاء الرموز الأربعة لديهم موقف صارم غير ودي تجاه الثقافة الغربية, وهذا مما يكشف أن نقد الثقافة الغربية ليس انعكاساً للجهل بها.
وبعض غلاة المدنية يستنكر هذا النقد الاسلامي للثقافة الغربية, وينعى على الاسلاميين غياب انبهارهم بمعجزة الحداثة الغربية, ويردد أن المجتمع الغربي ليس فيه مما يخالف الاخلاق الا المشكلة الجنسية فقط, بينما يتمتع المجتمع الغربي بأخلاقيات العمل كالصدق والأمانة ونحوها, وأن المجتمع الغربي استطاع أن يمؤسس العدل والأخلاق, فالاسلاميون كمن دخل قصراً فخماً فاشتغل بالنظر الى سلة المهملات وترك جمال القصر وابداعه, وهذه الفكرة منتشرة كثيراً عند غلاة المدنية.
والحقيقة أن هذا المثل المضروب مثل مضلل خادع, وإنما المجتمع الغربي كقصر فخم المظاهر لكن أساساته مهددة بالانهيار, فهل من العقلانية أن نستغرق في جمال مظاهره ونستنفر الناس لدخوله, أم أن نحذر الناس من انهياره الوشيك؟
ومما يكشف ذلك أن الثقافة الغربية تعاني من اضطراب حاد على صعيد الالهيات, فغالب الناس في ذلك المجتمع يعاني من تشوش عميق في هذا الأساس الجوهري, أما أغلب النخب المثقفة فهي إما لائكية أو أن قضية الدين عندها قضية مؤجلة غير محسومة, فالعالم الغربي نتيجة عدم تشرفه بالايمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لايزال محروماً من التصورات الصحيحة الدقيقة عن الله والمعاد والنبوات والعالم العلوي والمستقبل بعد الموت ونحوها من المطالب العالية.
فهذا السؤال الجوهري وهو: ماذا خسر الغرب حين كفر بنبوة محمد؟ لايزال غائباً عن كثير من المثقفين المسلمين وللأسف.
فالمجتمع الغربي حين كفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم خسر تحقيق مستقبل جيد بعد فناء البشرية وأصبح مهدداً بمخاطر كارثة جهنم, وخسر التعرف على محتوى الوحي, وهي تلك المعلومات الثمينة التي حملها آخر رسول أرسله خالق الكون الينا.
ولذا لم يستوعب كثير من مثقفي وفلاسفة الغرب مادلت عليه العلوم الالهية من أن هرم الأولويات هو عمارة النفوس بالله, بتألهه والتعلق به, وتجريد الذات لمراده ومحبوباته.
كما أن المجتمع الغربي لم يهتد لكثير من أصول وتفاصيل العدل التي كشفها الوحي, فلم يهتد الى كارثية الربا والميسر والمسكرات والفواحش, ولم تتطور عقليته التشريعية الى معرفة كثير من تفاصيل نظام الاثبات والقضاء الشرعي والحدود الجنائية وقواعد العلاقات الأسرية التي دل عليها الوحي, بل لم يهتد الى كثير من سنن الفطرة في الطهارة وازالة الأدران والتي نبهنا اليها الوحي .
بل إن المجتمع الغربي يعاني من “ظاهرة الوثنية” التي هي أحط مستويات التخلف, وكثير من غلاة المدنية لايتنبه لظاهرة الوثنية في المجتمع الغربي نتيجة كونه يعتقد أن الوثنية هي السجود لصنم فقط, بينما مفهوم الوثنية في القرآن أوسع من ذلك نتيجة سعة مفهوم العبودية, فإن الانصياع التام للهوى الشخصي واللذة الخاصة عبادة للهوى, ولذلك قال تعالى:
{أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} (23) سورة الجاثية
وقال سبحانه:
(أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلا}
وتبعاً لتأليه الهوى فان الانسان الخاضع لمتطلبات المادة خضوعاً تاماً جعله النبي صلى الله عليه وسلم عبداً للمال, فقال كما في الصحيح (تعس عبدالدينار, تعس عبدالدرهم).
فهذه النصوص تبين وجهاً من وجوه الوثنية وهو تأليه الهوى وعبودية المادة.
فكم هو مؤلم أن يغيب عن مفكر مسلم حجم انتهاكات الشريعة في الحضارة الغربية, ويرى أنه ليس في المجتمع الغربي الا مشكلة “الجنس” فقط, والواقع أن التدقيق في مثل هذه المقالات يكشف أن كثيراً من ذلك ناتج عن المغالاة في قيمة الحضارة المادية, والزهد في قيمة العلوم الالهية الموروثة عن الرسل, وهذا مما يؤكد أن الغلو المدني ينبوع الانحراف الثقافي.
ومع ذلك فلو سلمنا لغلاة المدنية بأنه ليس في المجتمع الغربي من تقصير الا الفوضى الجنسية, كاتخاذ الأخدان والسفاح وسن تشريعات زواج المثليين, فان ذلك كافٍ في كشف انحطاط وظلامية وتخلف هذا المجتمع, وحاجته الماسة والسريعة للتنوير بالعلوم الالهية, فظاهرة المثلية والشذوذ ليست مجرد سلة مهملات صغيرة بل هي أحد موجبات الغضب الالهي العام, ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى عاقب قرية سدوم باهلاكها هلاكاً عاماً لما انتشرت فيها ظاهرة المثليين, كما قال تعالى:
{ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ, مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ}
وقال سبحانه عنهم أيضاً:
{ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ, فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ, إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ, وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ, إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ}
فاذا كانت ظاهرة المثلية تستوجب هذا الغضب الالهي العارم فكيف يجوز تهوين الأمر وعرضه باعتباره مشكلة محدودة مع أن المجتمع الغربي بلغ بالمثلية تنظيمها تشريعياً وحفظ حقوق منحرفيها, ولم يناهض ظاهرة المثلية في المجتمع الغربي الا المؤسسة الكنسية نتيجة ماتبقى لديها من نور النبوات, ومع ذلك فان بعض الكنائس أطفأت ماتبقى من هذا النور الطفيف واعلنت احترامها لهذه الظاهرة المنحرفة.
أما القول بأن المجتمع الغربي استطاع أن يمؤسس العدل والأخلاق, فانه كما استطاع أن يمؤسس بعض هذه, فإنه أيضاً استطاع وبكفاءة أن يمؤسس كثيراً من تطبيقات الرذيلة والجريمة والظلم, ويوفر لها أرقى الامكانيات التكنولوجية.
أما مايشيعه غلاة المدنية من تشبع المجتمع الغربي بأخلاقيات الصدق والأمانة في العمل التجاري, فان بعض ذلك موجود حقيقة كما هو موجود في غيرهم من الأمم, ولكن كثيراً منه ليس صدقاً وأمانة يبتغى بها وجه الله وليس نابعاً من الاخلاص لخالق الكون سبحانه, بقدر ماإنها “مصداقية تسويقية” مدفوعة بحسابات الربح والخسارة المادية ومهارات “الماركيتنج”.
ويكشف ذلك احصائيات حجم الاختلاسات والسطو المنظم وفنون الجريمة في المجتمع الغربي, والذي تعرضه دوماً الدراسات الاجتماعية باسهاب, وتقتبس منه الصحافة أحياناً بعض النماذج, وهذا مما يؤكد أيضاً حاجة الغرب الى العلوم الالهية لتصحيح الدوافع.
ومن أوجه التناقض التفسيري الذي سبقت الاشارة اليه عند غلاة المدنية أنهم يرون أن التفسير السياسي لمفاهيم التراث وافتراض أن ثمة صفقات خفية بين رموز التراث والسلطة هو خطاب علمي متنور مستوعب للأدوات الانثروبولوجية, أما نقد الكتاب المعاصرين فهو دخول في النيات وتنقيب عما في القلوب وشق عما في الصدور, فاتهام نيات أئمة القرون المفضلة يعتبر خطاباً علمياً, أما اتهام الكتاب التجديفيين والروائيين العبثيين فهو دخول في النيات, فأي تناقض أبشع من ذلك.
وخلاصة الأمر من هذه الفقرة أن أضخم المخاطر من أنسنة التراث –بمعنى تفسيره مادياً- هو إساءة الظن به واسقاط قيمته, وبالتالي انفصال الشاب المسلم عن “النماذج الملهمة” والتي تغذيه بالإيمان والقيم, فيعرض عن التفاعل مع أخبار القرون المفضلة في عبوديتهم وعلمهم وزهدهم وجهادهم, حتى يذبل إيمانه وتذوي حيويته الدعوية, فانبتات الجذور استسلام للعاصفة.
أنسنة العلاقات:
من أهم المقولات عند غلاة المدنية قولهم (يجب أن نعمل للإنسان بما هو إنسان, بغض النظر عن هويته وعقيدته ودينه) ويرددون كثيرا لفظ “الإنسان” بصيغة مطلقة بدون إضافات تقيد أو تخصص, ويحمل بعضهم شعار “الأخوة الإنسانية” او “الآدمية المشتركة” أو “المذهب الإنساني” ونحوها من اللافتات التي تدور حول هذا المعنى.
والواقع أن هذه الدعوة -وإن كان البعض يرددها بحسن نية- إلا أنها تضمر سلخ الأوصاف القرآنية القطعية التي ميز الله على أساسها بين الناس وفاوت في العلاقات طبقاً للتفاوت فيها, كوصف المؤمن والمسلم والفاسق والكافر والمشرك والمنافق, ووضع هؤلاء جميعاً في مرتبة واحدة بناء على اشتراكهم في الإنسانية, ليصبح المسلم واليهودي والوثني على حد سواء لا فرق بينهم طالما أنهم يعملون لسعادة الإنسانية والسلام البشري!
يا ترى كم من الآيات يجب أن ننزعها من المصحف ليمكن للمرء تقبل هذه الدعوة؟ إن مجرد التأمل في هذه الدعوة وتصور مآلاتها ومؤداها كافٍ لردع المسلم -الذي يقدر الله حق قدره- عنها والتبرؤ منها.
لقد بين كتاب الله بشكل جلي واضح أن الإنسان إذا أعرض عن الإسلام والوحي فقد تكريمه الفطري الكوني الذي ذكره تعالى في قوله {ولقد كرمنا بني آدم} وأصبح مهاناً منحطاً في نظر الله ونظر أهل الإيمان, ولذلك لم تأت الشريعة بالمدح والتعظيم المطلق لـ”الإنسان” كما يتوهم بعض غلاة المدنية, بل إن القرآن بين في مواضع كثيرة ذم “الإنسان” إذا فقد شرف الإيمان ومن ذلك قوله تعالى:
{قُتِلَ الإنسان مَا أَكْفَرَهُ}[عبس:17]
وقوله تعالى:
{وَكَانَ الإنسان كَفُورًا} [الإسراء:67]
وقوله تعالى:
{إِنَّ الإنسان لَكَفُورٌ مُبِينٌ} [الزخرف:15]
وقوله تعالى:
{إِنَّ الإنسان لِرَبِّهِ لَكَنُود}
وقوله تعالى:
{كَلا إِنَّ الإنسان لَيَطْغَى}
ومن تدبر المواضع القرآنية التي ورد فيها مفهوم “الإنسان” وجد أن الله سبحانه وتعالى يذم جنس الإنسان بمذام متنوعة ثم يستثني من عموم هذا الذم أهل الإيمان.
ومن ذلك أن الله تعالى تعالى أقسم بالزمان على أن الإنسان في خسارة تامة كما قال تعالى:
{وَالْعَصْرِ, إِنَّ الإنسان لَفِي خُسْرٍ}
ثم أتبعها باستثناء أهل الإيمان من هذه الخسارة فقال:
{إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ}
وذم الله جنس الإنسان بصفة الهلع والجزع والشح ثم استثنى أهل الإيمان كما قال تعالى:
{إِنَّ الإنسان خُلِقَ هَلُوعًا, إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا, وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, إِلا الْمُصَلِّينَ} [المعارج:19-22].
وذم الله جنس الإنسان بصفة القنوط والجحود والبطر ثم استثنى أهل الإيمان كما قال تعالى:
{ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإنسان مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نزعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ, وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ, إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ}
وذم الله جنس الانسان بصفة الظلم والجهل, ثم أعقب ذلك بالتمييز التفصيلي في جنس هذا الانسان الظلوم الجهول على أساس الموقف الديني فقال تعالى:
(وَحَمَلَهَا الإنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا, لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}
وهذا المعنى المتضمن ذم جنس “الانسان” ثم استثناء أهل الايمان له نظائر كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, بل إن الله هدد الإنسان تهديداً مدوياً بقوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الإنسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ}
ولذلك لما سمع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رجلاً يقرأ هذه الآية قال: (غره والله جهله) والذي يبدوا أن عمر استنبط هذا المعنى من الآيات التي وصفت “الانسان” بالجهل كما سبقت الاشارة لبعض تلك الآيات.
فكيف يقال بعد ذلك أن الله كرم “الإنسان” وفضل “الإنسان” بغض النظر عن هويته الدينية, وأن الأديان لا تؤثر في كرامة الإنسان إيجاباً ولا سلباً, وأننا يجب أن نعمل لمفهوم “الإنسان” بغض النظر عن عقيدته, أو قول بعضهم لا تجعلوا الرأي الشخصي يفرق بين أبناء آدم, أليس في ذلك مشاقة لكلام الله سبحانه وتعالى الصريح؟
ومن الإنصاف أن نقول أن بعض الكتاب الذين يرددون هذه المقولة لم يتنبهوا لمضامينها المصادمة للميزان الإلهي, ولم تخطر ببالهم الآيات القرآنية في ذم الإنسان إذا فقد الإيمان.
وأتذكر أحد الكتاب المأخوذين بقضية الحضارة كان يردد في فترة سابقة: أن الإسلام السياسي همش “الإنسان” بينما القرآن كرمه وأعلى قدره, فكان يحاول أن يزاحم في قضية التأصيل ذاتها, ثم لما اصطدم بسيل الآيات القرآنية في منزلة غير المؤمن, تحولت نغمته السابقة وأصبح يردد: للأسف أن الإنسان في نصوصنا الدينية منزوٍ مهمش لا قيمة له, فتحول من إدانة الإسلاميين المعاصرين إلى إدانة نصوص الكتاب والسنة.
هذه الإلماحة السابقة إنما هي إشارة مختصرة لصلة هذا المذهب الإنساني بأصول الوحي, أما صلته بالواقع فالمذهب الإنساني في الحقيقة رؤية رومانسية حالمة, إذ لا يوجد أصلاً دولة من الدول اليوم شرقيها وغربيها تعمل للإنسان المطلق, بل تجدها تميز في الجنس الإنساني إما على أساس وطني أو قومي أو عرقي أو غير ذلك من المقاييس, فكيف نتقبل تمييز هذه الأمم بين المواطن وغير المواطن, ولا نقبل تمييز الله بين المسلم والكافر؟!
ومن أهم الآثار السلبية لهذه الدعوة أنها تضيع الثواب والأجر عند الله للعامل, فبدلاً من أن يعمل الإنسان لنفع المسلمين مبتغياً الثواب عند الله, يصبح يعمل لنفع الناس مسلمهم وكافرهم بهدف إنساني محض لا بهدف التقرب لله.
ومن قدر له أن يعايش بعض الغربيين ولو لفترة محدودة, ويحاورهم حول تصوراتهم عن غاية الحياة, ومعنى السعادة, ووظيفة المال, وقيمة الإيمان, وتفاصيل نظامهم الاجتماعي, فستتأكد له الصورة التي رسمها القرآن عن شخصية الكافر.
من رأى أولئك الكفار لاهثين في لجام الملاذ, منكبّين على الموائد, لايبالون مأتاها ومخرجها, ولا يرفعون رأساً بطيباتها من خبائثها, ويتضاحكون عالياً في ليلة غاب عنها القمر, ولم يستعدوا للقاء الله طرفة عين, فسيفريه العجب فرياً وهو ينظر إليهم ويتذكر قوله وتعالى في سورة محمد:
{وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ}
فعلاً والله.. ألا ماأعظم هذا التشبيه الإلهي, أرأيت كيف تغيب رؤوس الأنعام في قلال العشب لا ترفع أعناقها إلا لتعود مرة أخرى, ليست مهمومة بلقاء الله, ولاتفكر في خالق ولا نبي ولا وحي ولا عبادة ولا بعث ولا حساب ولا عذاب ولا مستقبل أخروي حتى يفجؤها يومٌ يقتص فيه للشاة الجلحاء من الشاة القرناء, فتلك حياة الكافر.
وانظر إلى كتاب الله كيف يعيد سبحانه هذا التصوير والتشبيه بالأنعام مرة أخرى, مشيراً إلى علة ذلك وهي استغراق هؤلاء المساكين عقولهم وحواسهم في تدبير معاشهم الحاضر والإعراض عن الاستدلال بها على الله والاستعداد للقائه في الحياة المستقبلية القريبة, بل جعلهم هذه المرة في مرتبة أحط من مرتبة الأنعام كما قال سبحانه في سورة الأعراف:
{لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا, وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا, وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا, أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ, بَلْ هُمْ أَضَلُّ, أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ}
ويأتي سبحانه مرة ثالثة بذات التشبيه, وذات التعليل, وذات المرتبة, فيقول سبحانه في سورة الفرقان:
{أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ, إِنْ هُمْ إِلا كَالأَنْعَامِ, بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلا}
بل زاد سبحانه وتعالى في بيان دناءة وخسة مرتبتهم فجعلهم سبحانه في مرتبة أسوأ الدواب فقال في سورة الأنفال:
{إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ}
وقال في موضع آخر من الأنفال:
{إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ}
وفي موضع آخر من كتاب الله شبه الله سبحانه وتعالى نوعاً من الكفار بأرذل من ذلك فقال سبحانه في سورة الجمعة:
{مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ}
وضرب الله سبحانه مثلاً آخر أشد بشاعة لنوع آخر من الكفار وهم الذين بلغوا مرتبة من العلوم ولكنها لم تقدهم إلى الإيمان بالله, فشبههم بما هو أقبح من كل ماسبق, فقال سبحانه في سورة الأعراف:
{فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا}
فكل من أعرض عن هذا الإسلام ونور الوحي فهو في هذه المرتبة المنحطة, ولذلك وصفهم الله بالرجس لما تبرمت صدورهم عن قبول الإسلام, كما قال سبحانه في سورة الأنعام:
{فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام , وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء, كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ}
وذكر الله عنهم هذا الرجس أيضاً في سورة يونس أيضاً فقال سبحانه:
{وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ, وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ}
فيالله العجب, كيف صار كثير من الأذكياء في مرتبة الأنعام والدواب في المعيار الإلهي؟! بل جعل بعض هذه أحياناً أشرف منهم! آيات قرآنية كأنها ضرب من الخيال في عصر الأنثربولوجيا الفرانكفونية, لكنها حقائق الوحي..
هذا بعض من صورة “الكافر” في كتاب الله, وهذه مرتبة الكافر في المعايير الإلهية, وهي فقط نماذج أوردتها للمقارنة بفكرة المذهب الإنساني الذي لا يفرق في جنس الإنسان على أساس الإيمان والكفر, ليتبين حجم التناقض والهوة التي ارتكبها هذا المذهب البائس.
فكم هو شعور عاصف بالألم حين يكتشف الإنسان أن معاييره غير تابعة للمعيار الإلهي, فيتفاجأ بمشاعره وأحاسيسه الداخلية تعظِّم من قد حطَّ الله منزلته, وتستهين بمن رفع الله شأنه!
فكيف نكرم من قد أهانه الله, والله تعالى يقول:
{وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء}.
يتيبس الذهول في نظرات المرء حين يرتطم بكارثة معاييره وموازينه الشخصية وهي تتعارض مع معايير وموازين جبار السموات والأرض.
وإن كانت تلك المعايير والموازين الشخصية في كثير من الأحيان معايير مضمرة غير معلنة, لكنها حقيقة غامضة تتنكر في زي التمدن, وتمتح من نبع الهوى, وتظهر آثارها في خلجات الترحيب واستبشار الوجوه.
هذه حقائق الوحي, وهذا حكم الله وقراره, وهذا قضاء جبار السموات والأرض, إن كنا فعلاً نؤمن بالله, ونفخر بمضامين كلامه سبحانه, ونلتزم بمقرراته, ونقدره حق قدره.
أما التحرج من حقائق الوحي, والتدسس عنها مجاملةً لوسائل الاعلام, وتربيتاً على أكتاف الذوق الجماهيري الحديث, فلن تغير من حقائق الوحي شيئاً إلا إن استطعت أن تحجب الشمس بكف أرعشها الخجل.
أفيكون ربنا سبحانه أهون الناظرين إلينا فنجاملهم على حساب وحيه وحكمه وقضائه سبحانه, كيف ونحن نقرأ معيار صريح الإيمان (ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت)؟!
ومما انبنى على هذا “الميزان الإنساني” أن بعض غلاة المدنية إذا تعرض لبعض الشخصيات غير المسلمة ذات الوزن التاريخي إما بسبب منجز معرفي أو بسبب نزعة سلمية فإن بعضهم يتجرأ ويجزم بأنه في “الجنة” وأنه لا يمكن أن يدخل “النار” حتى لو كفر بالإسلام.
ومن الإنصاف أن أذكر أن ثمة فئة من غير المسلمين صادقة في أحاسيسها ومشاعرها, ومخلصة في بذلها لا تطلب مصلحة, ولا حمية لقومها, ولا رياء وظهوراً, ولا حباً في الذكر الحسن, ولا جاهاً عند الناس, ولا طلبا لاحترام الآخرين, وإنما هي نزعة إنسانية رؤوفة محضة من بقايا الفطرة الربانية فيهم, وهذه الفئة المتجردة من حظوظ النفس -وان كانت محدودة عزيزة الوجود بطبيعة الحال- إلا أنه ماذا ستنفعها كل أخلاق الدنيا طالما أنها كافرة بـ “نبوة محمد” صلى الله عليه وسلم؟! ماذا تنفع الإنسان كل أعمال الدنيا إذا كانت نفسه لم تعمرها الضراعة والإخبات ولم تتزك بالعلم بالله ومعاملته سبحانه وتعالى؟!
هذا “أبوطالب” لم يؤذِ مسلماً واحداً, بل كان أذاه للكفار, فقد كان سنداً لرسول الله صلى الله وسلم في دعوته فنصره وحامى عنه, وتلطف له وأحبه, بل لقد كان في نفسه يعلم صدق خبر محمد عن نبوته, وبذل جاهه وشيئاً من سمعته في سبيل الذود عنه, بل وأوذي فيه, وما تطاول الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات ابوطالب, ومع ذلك هو في ضحضاح من نار, بل لقد نهى الله ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي انتفع بحمايته من أن يدعوا له, ولم يجعل ذلك أبسط الوفاء له! وماذاك إلا لأنه أعرض عن الانصياع التام لحكم الوحي.
وهذا عبدالله بن جُدعان ملأ الجزيرة العربية بالأعمال الإنسانية المحضة من إغاثة الملهوفين وإيواء الضعفة ومع ذلك لم ينفعه ذلك لأنه لم ينكسر يوماً بين يدي الله كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين, فهل ذاك نافعه؟ فقال صلى الله عليه وسلم:
(لا ينفعه, إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين)
وهذا حاتم الطائي كان يتعشق الإحسان للناس في جزيرة قاحلة, ويبذل من ماله الخاص ليطعم الجائع ويكسو العاري, ومع ذلك لم ينفعه ذلك في ميزان الله لا لشيء إلا لأنه لم يؤمن بالوحي, فقد روى أصحاب السير أنه لما وصلت “سبايا طيء” وقفت ابنة حاتم الطائي وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أبي كان يحمي الذمار, ويفك العاني, ويشبع الجائع, ويكسو العاري, ولم يرد طالب حاجة قط, أنا ابنة حاتم طيء, فقال رسول الله :
(يا جارية هذه صفة المؤمنين حقاً, ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه..)
فليس لأعماله وزن في ميزان الله لأن “قبول هذه الأعمال معذوق بالإيمان” كما يعبر ابن كثير رحمه الله ..
لن يغني هؤلاء الإنسانيين -على قلتهم- أنهم مؤمنون بالله, أو أنهم لم يشركوا بالله في عبادته, أو أنهم قدموا نفعاً للبشرية -كما يقوله بعض المفكرين- طالما أنهم لم يؤمنوا بـ”نبوة محمد” صلى الله عليه وسلم .. ولذلك قال مفسر المعتزلة العلامة جارالله الزمخشري:
(من لم يجمع بين الإيمانين: الإيمان بالله وبرسوله فهو كافر)
وقد دل على ذلك قوله تعالى في سورة الفتح:
{وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا}
فمن لم يجمع الإيمانين فهو كافر.
وقد علل الله سبحانه حبوط كثير من الأعمال بالكفر بـ”نبوة محمد” صلى الله عليه وسلم وقرنها بالكفر به سبحانه كما قال تعالى:
{وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ}
وقال تعالى أيضاً:
{فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ}
فلو فرضنا عملاً إنسانياً محضاً لايريد به صاحبه مالاً ولا منصباً ولا جاهاً ولا ظهوراً ولا شهرةً ولا تصدراً ولا رياسةً ولا طلباً للذكر الحسن عند الناس ولا أي مصلحة مادية أو معنوية فان ذلك كله –على فرض وجوده- لاينفع صاحبه طالما أنه كافر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم, فأعمال الكفار كلها حابطة في ميزان الله بمجرد أن يعرضوا عن شيء من مضامين الوحي كما قال تعالى في سورة محمد:
{وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ}
وقد شبه الله حبوط أعمال الكفار تشبيهات ذات دلالة بليغة فشبهها سبحانه تارة بالهباء كما قال سبحانه في سورة الفرقان:
{وَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا}
وكشفت هذه الآية أن هذه الأعمال التي جاء بها الكفار يوم القيامة هي “أعمال محمودة” في ذاتها وحسنة في أصلها, لكن الله لم يقبلها منهم ولم تنفعهم, ولو لم تكن محمودة في ذاتها لم يجعلها هباءً, بل لجعلها وبالاً, فإن الآثام تحتسب على الكافر ولا تذهب هباء, وإنما الذي يذهب هباء هو العمل المحمود في أصله لكنه لم يقبل لفوات شرط القبول.
وفي موضع آخر جعل الله أعمال الكفار كالرماد المتطاير كما قال في سورة ابراهيم:
{مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ}
وجعلها في موضع آخر كالسراب الزائف كما قال في سورة النور:
{وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا}
ومما هو لصيق الصلة بهذه الرؤية أنك تجد غلاة المدنية يتحدثون عن خيرية العالم المعاصر, وجمال الإنسانية المعاصرة, ونحو ذلك, ويعتبرون الحديث عن حجم الضلال “نظرة سوداوية” منعكسة عن رؤية همجية ونحو ذلك.
والواقع أن الحديث عن غلبة الفساد والضلال على العالم هي رؤية قرآنية تضافرت آيات القرآن على تأكيدها, ومن ذلك قوله تعالى:
{وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} [يوسف: 103]
وقوله سبحانه:
{وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [الأنعام:116]
وقال سبحانه وتعالى:
{وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [سبأ: 20]
وجاءت كثير من آيات القرآن بنسبة أوصاف من الذم إلى أكثر الناس, فقال تعالى:
{وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} وقال سبحانه {فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلا كُفُورًا} وقال سبحانه {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ} وقال سبحانه {وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الأوَّلِينَ}
بل إن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه لو آخذ الناس بكل ذنوبهم لما بقي أحد كما قال تعالى:
{وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ}
وقال سبحانه في موضع آخر:
{وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ} [ فاطر:41-45]
ونحو هذه الآيات الكثيرة التي تكشف غلبة الضلال والفساد في جنس الإنسان بما يتناقض مع الرؤية الحالمة التي يروجها بعض غلاة المدنية.
وخلاصة الأمر أن مفهوم الأنسنة في هذا السياق ينطوي على استبعاد المضمون الديني من صياغة علاقاتنا بالآخرين, وهذا انحراف عن الوحي يؤول بصاحبه إلى مآلات خطيرة, نسأل الله أن يعفو عنا جميعاً.
خصوم الدعوات كمعطى تاريخي:
كثير من غلاة المدنية يميلون إلى تصوير الواقع الثقافي اليوم باعتباره مجرد “اختلاف فكري” ويحاولون دوماً تغييب “الدافع الديني” كعامل فاعل في رسم المسافات بين الفرقاء, صحيح أن هناك مساحة واسعة من الاختلاف الفكري هي “اختلاف اجتهادي” لايجوز شرعاً تصعيده إلى معاقد الولاء والمفاصلة, وصحيح أيضاً أن ثمة نزراً من المتسرعين المنتسبين للإسلاميين تحت أقنعة إلكترونية مستعارة يفسقون ويضللون على أساس مسائل اجتهادية, هذا ما لا يجوز إنكاره.
ولكن عين الباطل سحب هذه التصور على كافة هذا الاختلاف بأريحية صالون ثقافي أو عرض أكاديمي, وتصور أن كافة الاختلاف الفكري اليوم إنما هو مجرد “اجتهادات ثقافية”.
ومما بنوا على ذلك أنه يجب أن ننظر للكتاب المنتسبين للإسلام اليوم نظرة واحدة, ولايقبل التمييز والتفاوت بينهم على أسس دينية, فكل من انتسب للإسلام وجبت موالاته سواء كان معروفاً بالتقوى والفقه في الدين ونصر الإسلام أم كان معروفاً بالإعراض عن الوحي والقدح في قطعيات الشريعة, فكلهم مسلمون ومايطرحونه مجرد اجتهادات فكرية, ولذلك يتضايق غلاة المدنية من استحضار المفاهيم الشرعية كمفهوم الإفساد في الأرض ومفهوم النفاق ونحوها من المفاهيم أثناء بحث الشأن الثقافي.
والواقع أن هذه الرؤية تتضمن تغييب الكثير من معطيات الوحي, وسنشير إلى بعض ذلك:
فأولاً وقبل كل شئ يجب أن نقر أن ثمة قانون تاريخي وهو أنه لا يخلو زمان من وجود ظاهرة “خصوم الدين” ممن يجاهرون بمشاقة الله ورسوله, وقد كشف القرآن الكريم عن هذا القانون التاريخي كما قال تعالى:
{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِين}
وبين سبحانه نوعي الأعداء بقوله سبحانه:
{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإنْسِ وَالْجِنِّ }
وهؤلاء الخصوم المحادين للدعوات الإلهية لا تكاد تخلوا منهم بقعة من الأرض كما قال تعالى:
{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا}
فهذه ظاهرة دل عليها الوحي وأكدها التاريخ, فلا يجوز اعتبار القضية كلها قضية فكرية لا صلة لها بالموقف من الدين والوحي.
ولكن مع يقيننا بهذه الظاهرة التاريخية الشرعية فإنه لا يجوز ربط التصنيفات الفكرية المحدثة بهذا الوصف الشرعي مطلقاً, فثمة في الساحة اليوم تصنيفات فكرية متعددة بعضها مستقى من مذاهب غربية وبعضها الآخر مستوحى من تجارب تراثية, وهناك جدل في إلحاق التكفير أو التفسيق أو عداوة الإسلام بمثل هذه الألقاب, والواقع أن هذه التصنيفات الفكرية هي ألقاب محدثة أصلاً لا يعلق عليها مدح ولا ذم شرعي مطلق, وإنما المدح والذم الشرعي المطلق يكون بالأوصاف الشرعية التي علق الله ورسوله عليها الأحكام, في تفاصيل منظمة في باب الأسماء والأحكام من علم أصول الدين.
فالمدح والذم المطلق إنما يعلق باسم المحسن والمؤمن والمسلم والفاسق ومن في قلبه مرض والفاجر والمشرك والكافر والمنافق ونحوها, وتعيينها في الشخص المعين يكون باستفراغ الوسع في سبر تحقق الشروط وانتفاء الموانع.
ولا يقال طبعاً إنه لا يمكن الجزم بمعرفة الإيمان مثلاً ونحوه من الأعمال القلبية, وأننا لم نؤمر بالتنقيب عن قلوب الناس, فإن الإيمان ونحوه من الأعمال القلبية له نوعان من الأحكام: أحكام أخروية كالجزم بمصير المعين في جنة أونار, فهذا إلى الله.
وأحكام دنيوية كالموالاة والشهادة له بالخير فهذا يعرف في الدنيا وتعلق عليه أحكامه بالنظر إلى آثاره والتوسم في أماراته وآياته في الشخص المعين, ولذلك قال تعالى:
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إلى الْكُفَّارِ}
فدل على إمكانية معرفة ظاهر الإيمان في الشخص المعين بالتوسم في أماراته, لا بالتنقيب عما استتر من مكنوناته.
ومما ينبغي التنبه له أن الولاء في الشريعة ليس على درجة واحدة كما يتوهمه غلاة المدنية, بمعنى ليس درجة واحدة يستوي فيها كل مسلم, بل الولاء للمسلمين درجات, فيتفاوت بحسب مافي المسلم من الإيمان والعمل الصالح وموالاة الوحي والقرون المفضلة, وهو نظير كون البراء والمعاداة تتفاوت بحسب ما في الكافر من مسالمة ومحادة ونحوها.
وهذا المعنى ظاهر في آيات القرآن وتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وفقهاء أصحابه, وقد دلت على ذلك آيات “عامة” يدخل فيها المسلم وغيره, وليست مختصة بالكافر, فقد ذكر الله سبحانه أن المؤمن والفاسق وإن كانا يشملهما اسم الإيمان لكنهما لايكونان في منزلة واحدة كما قال تعالى:
{أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ}
وقال تعالى في سورة الجاثية:
{أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}
وقال تعالى في سورة ص:
{أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأرْضِ}
ثم قال بعدها:
{أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ}
ومن المعلوم أن مطلق الفسق واجتراح السيئات والإفساد في الأرض والفجور كلها لا تخرج المسلم بمطلقها من الإسلام، فيبقى صاحبها مشمولاً بهذا التمييز في المنزلة والمكانة عند الله, وميزان المسلم تبع لميزان الله تعالى.
وتفاوت الولاء فرع عن تفاوت المنزلة الدينية الظاهرة, ولذلك فإن الله تعالى فاوت الولاء بحسب منزلة المؤمن فقال سبحانه:
{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا}
فانظر كيف جعل صيغة العلاقات تتفاوت بحسب التفاوت في درجة الإيمان والمجاهدة, فمن آمن وهاجر كانت له الموالاة التامة, ومن آمن ولم يهاجر نقصت ولايته بقدره, فكيف بمن اشتغل بإثارة المشتبهات وتزيين الفنون الغربية وتسويغ ما تضمنته من الفواحش والقيم المنحطة.
وهكذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في التعامل مع المسلمين في عصره فإنه يزيد في موالاة المسلم بحسب قيامه بشعائر الدين الظاهرة, وينقص في موالاته للمسلم بقدر نقصه في أمر الله.
ولذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه خمسين ليلة -كما في البخاري ومسلم- حتى قال الطبري: (قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي).
ولما قالت زينب للنبي صلى الله عليه وسلم: “أنا أعطي تلك اليهودية” تعيب بذلك صفية, هجرها النبي زهاء شهرين فقد روى الامام ابوداود عن عائشة قالت:
(اعتل بعير لصفية بنت حيي, وعند زينب فضل ظهر, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب: أعطيها بعيرا, فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية؟! فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر)
والحقيقة أن التطبيقات الخاطئة في فهم تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكياته في سيرته, خصوصاً في مثل هذه القضايا, يجب أن لا تدعونا للانقلاب على هذا الأصل كله, فقد كان هذا منهج أئمة القرون المفضلة فقد استفاض عنهم تفاوت الولاء بحسب قيام المسلم بالكتاب والسنة, ونقص موالاته بحسب ابتعاده عنها, وقد لخص الغزالي القدر المشترك في هذه الأخبار المستفيضة فقال في عبارته الجميلة:
(طرق السلف اختلفت في إظهار البغض مع أهل المعاصي، وكلهم اتفقوا على إظهار البغض للظَّلَمة والمبتدعة، وكل من عصى معصية متعدية إلى غيره).
ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن الصحابي الجليل عبدالله بن عمر لما أخبره يحيى بن يعمر عن قوم أنكروا القدر قال ابن عمر: (إذا رجعت إليهم فقل لهم: ابن عمر يقول لكم: إنه منكم بريء، وأنتم منه براء).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
(وأما إذا أظهر الرجل المنكرات: وجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره ، فلا يسلم عليه، ولا يرد عليه السلام، إذا كان الفاعل لذلك متمكناً من ذلك من غير مفسدة راجحة, وينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتاً كما هجروه حياً، إذا كان في ذلك كف لأمثاله من المجرمين, فيتركون تشييع جنازته، كما ترك النبى – صلى الله عليه وسلم – على غير واحد من أهل الجرائم ، وكما قيل لسمرة ابن جندب : إن ابنك مات البارحة، فقال : لو مات لم أصل عليه ، يعني لأنه أعان على قتل نفسه فيكون كقاتل نفسه، وقد ترك النبي الصلاة على قاتل نفسه, وكذلك هجر الصحابة الثلاثة الذين ظهر ذنبهم في ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليهم ، فإذا أظهر التوبة أظهر له الخير).
فسائر ما روي من جنس هذه المواقف التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم وفقهاء أصحابه وأئمة القرون المفضلة إنما هو نوع من “البراء الأصغر” الذي يدور مع علته وجوداً وعدماً, وهو مرتبط أيضاً بالمصلحة الشرعية فإذا عارضته مفسدة راجحة لم يكن محموداً.
وانعكاساً لتفاوت الولاء بحسب تفاوت المنزلة, فإن العقوبة على التعرض للمؤمنين تتفاوت بحسب تفاوت منازلهم أيضاً, فهو مطرد منعكس, فمن عادى ولياً لله ليس كمن عادى مسلماً فاجراً, ولذلك قال تعالى في الحديث القدسي (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب).
على أية حال .. فإن تفاوت الموالاة وتفاوت المعاداة هما فرع عن الأصل العظيم الذي ينتظم الشريعة كلها, وهو أصل العدل والقسط, فالشريعة لا تسوي بين المختلفين كما أنها لا تفرق بين متماثلين, وهو معنى الميزان الذي ذكره الله سبحانه في عدة موضع من القرآن, كقوله تعالى:
{لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ}
وقوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي أَنزلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ}
وقوله تعالى: {وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ}
وهذه النصوص الشرعية تكشف سقوط دعوى غلاة المدنية حين قالوا أن البراء لايكون إلا من الكافر أو من الكافر المحارب, أو أن الولاء للمسلمين لا يتفاوت.
على أنه لو لم ترد تلك النصوص الخاصة في البراء الأصغر, فإن الاستدلال بالنصوص الواردة في البراء الأكبر على البراء الأصغر كافٍ في بيان الحق, وهو من ضرب الأمثال التي أشار القرآن إلى كونها تبيانا لكل شئ, فهو استدلال ببعض المعنى لا أنه قياس شمول ولا قياس أولى, فيؤخذ من جزء الحكم بقدر ما تحقق من جزء العلة إذا لم يوجد ما يعارضها.
وهذا النوع من الاستدلال كان من منهج النبي صلى الله عليه وسلم وفقهاء أصحابه وعموم أئمة القرون المفضلة, فكانوا يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الأصغر, ويستدلون بما نزل في عقوبات الكفار بأوصاف معينة على من شاركهم من المسلمين في عين ذلك الوصف.
ففي سنن الترمذي عن أبى واقد الليثى أن النبي وأصحابه لما مروا بالكفار وهم يتبركون بشجرة ذات أنواط طلب بعض الصحابة أن يكون لهم شجرة يتبركون بها, فهذا التبرك الذي طلبوه كان شركاً أصغر, ومع ذلك فقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم واستدل بآية نزلت في الشرك الأكبر فقال صلى الله عليه:
(قلتم و الذى نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم ءالهة قال أنكم تجهلون)
ولما رأى الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رجلاً من المسلمين في يده خيط يستعمله كتميمة, قطعه وتلا قوله تعالى (ومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) فاستدل بما نزل في الأكبر على الأصغر بجامع بعض المعنى.
ولما سئل ترجمان القرآن عبدالله ابن عباس عن قوله تعالى في سورة البقرة (فلاتجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) قال : هو كقول الرجل “لولا الله وأنت” ففسرها بقادح أصغر, برغم كونها في القادح الأكبر, لاشتراكهما في أصل التفات القلب لغير الله.
وعندما مر علي بن أبي طالب بقوم يلعبون الشطرنج على وجه محرم يفضي لترك الواجب الشرعي نهاهم وتلا قوله تعالى (ماهذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون) فاستدل بآية في الشرك على المعصية بجامع شدة التعلق المفضي لانتقاص قدر الله جل وعلا.
وفي قوله تعالى (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) قال غير واحد من السلف كعلي بن أبي طالب والضحاك وغيرهم هم “الحرورية”, برغم كون الآية نزلت قبل أن يخلق الحرورية أصلاً, وذلك منه رضي الله عنه استدلال بمانزل في الأكبر على الأصغر, بجامع بعض المعنى.
وهذا الوجه من الاستدلال بما نزل في الأكبر على الأصغر بجامع اشتراكهما في أصل المعنى شائع مستفيض في فقه القرون المفضلة, ومن طالع التفاسير الأثرية المعنية بنقل تأويل النبي وأصحابه والتابعين رأى كثرة ما فيها من هذا الضرب من الاستدلال.
وكثير من الكتاب اليوم يظنون أن “النفاق” الذي تحدث الله عنه في القرآن وأسهب في تصويره إنما هو النفاق المحض الذي هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام, وتبعاً لذلك يستبعدون وجوده ويستعظمون استحضار هذا المصطلح الشرعي, ويهولون على من ينبس به.
والواقع أن النفاق ليس محصوراً في النفاق المحض, فإن النفاق المحض الخالص قليل في المسلمين اليوم ولله الحمد, حتى أن حذيفة -وهو أعلم الصحابة بأسرار النفاق- قال كما روى البخاري في الصحيح عنه: (إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان).
ولكن هناك ما هو غير النفاق المحض وهو أن يقع الإنسان في “شعبة” من شعب النفاق –نسأل الله السلامة والعافية- فربما تجارت بالإنسان فأهلكته وربما أدركه لطف الله جل وعلا.
ولذلك روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شعب النفاق العملي (أربع من كن فيه كان منافقا خالصا, ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه “شعبة من النفاق” حتى يدعها..الحديث)
وشعب النفاق تكون في الوقوع في عمل من أعمال المنافقين, كما قال صلى الله عليه وسلم: (من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على “شعبة من نفاق” )
ولذلك فرق الله في القرآن كثيراً بين اسم “المنافق المطلق” وبين المسلم الذي “في قلبه مرض” أي شعبة من النفاق, وعطفهم على بعضهم في كثير من المواضع مبيناً اشتراكهم في بعض شعب النفاق, كما قال تعالى:
{إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاءِ دِينُهُمْ}
وقال تعالى أيضا:
{لئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ..الآية}
وقد علق الإمام ابن كثير على الآية الأولى وهي قول المنافقين ومن فيهم شعبة نفاق حين ادلهمت الأزمة الأمنية: “ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا” تعليقاً مشبعاً بالبلاغة حيث قال:
(أما المنافق فنجم نفاقه، والذي في قلبه شبهة أو حسِيْكَة ضَعُف حاله فتنفس بما يجده من الوسواس في نفسه؛ لضعف إيمانه وشدة ما هو فيه من ضيق الحال).
وشعب النفاق كما هي شعب الإيمان كلاهما يعرف بالتوسم في الأمارات والأحوال والآيات والعلامات كما قال تعالى في سورة محمد:
{وَلَوْ نَشَاءُ لأرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ}
وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أمارات شعب النفاق وشعب الإيمان في صحيح البخاري فقال: (آية الإيمان حب الأنصار, وآية النفاق بغض الأنصار)
وهذه العلامات والآيات تورث التهمة, فتقوى وتضعف بحسبها, وقد كان الصحابة –خلا حذيفة- لايعلمون أسماء المنافقين تعييناً, بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لايعرف بعضهم كما قال تعالى (لاتعلمهم نحن نعلمهم), وإنما كان الصحابة يعلمون كثيراً منهم بحسب هذه الأمارات فيكون فيهم متهماً بذلك, ولذلك فإن كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن الغزاة في قصته الشهيرة ذكر أنه لم يجد في المدينة إلا من كان متهما ومغموزاً بالنفاق, كما روى البخاري عن كعب أنه قال:
(فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق)
أي مطعونا عليه في دينه ومتهما بالنفاق, كما ذكر غير واحد من شراح الصحيح.
ومن تدبر شعب النفاق التي ذكرها الله في مواضع متفرقة من القرآن خصوصاً مطلع البقرة والتوبة والأنفال ونحوها من السور المدنية علم سر قلق الصحابة من النفاق, فالصحابة لم تكن خشيتهم الأساسية أن يبطنوا الكفر ويظهروا الإسلام, فهذا أمر ظاهر, وإنما كانوا يخشون أن يقع أحدهم في شعبة من شعب النفاق الدقيقة, ولذلك وصف التابعي الجليل ابن أبي مليكة حالهم فقال كما في صحيح البخاري:
(أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه)
ومما يبين ويوضح أن قلقهم الأساسي لم يكن من النفاق الخالص وإنما كان من شعب النفاق تتمة هذا الأثر حيث يقول ابن أبي مليكة:
(ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل)
فتبين أنهم عنوا نقص الإيمان الكامل بما يعارضه من شعب النفاق, وإنما كانت خشيتهم من شعب النفاق لأن شعب النفاق قد تتجارى بالإنسان حتى تهلكه, فيزداد وارد هذه الشعب حتى يضعف المحل عن احتمالها فيخرج منه نور الإيمان والعياذ بالله, كما قال تعالى:
{فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا}
وجاء نظير هذا المعنى في التوبة فقال تعالى:
{وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلى رِجْسِهِمْ}
ثم إن شعب النفاق إذا نقلت المرء إلى اسم النفاق المطلق فإن هذا النفاق التام يتفاوت أيضاً بحسب شدة صاحبه في مناهضة وبغض أمر الله ورسوله, فهناك المنافق وهناك من مرد على النفاق, كما يقال شيطان وشيطان مريد, كما قال تعالى:
{وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ}
ومن أعظم شعب النفاق التبرم بمرجعية الوحي, وازدراء القرون المفضلة, واللهج بذكر الكفار وامتلاء القلب بتعظيمهم, هذه كلها من شعب النفاق, والتي يقاربها كثير من الكتاب اليوم فمستقل ومستكثر.
وحتى لا يكون الكلام تجريدياً نذكر بعض الأمثلة, فحين يكتب أحد رموز الفرانكفونية المشهورين عدة دراسات يقول فيها أن “القرآن أسطوري البنية” ويحاول في دراسات كثيرة أن يربط القرآن بالثقافات السابقة للإسلام ويتكلم عن حجم الاقتراض الثقافي, أو حين يكتب باحث شهير آخر في رسالته الجامعية بأن القصص الفني في القرآن هي مجرد “أساطير” لا حقيقة لها وأنه يجوز نقدها تاريخياً, أو حين يقول رائد التغريب المطلق بأن “حديث الكتب السماوية عن إبراهيم وموسى لا تعني مصداقية الوجود التاريخي”, أو حين يكتب باحث آخر بأن “القرآن منتج ثقافي” كحصيلة التفاعل مع البيئة العربية, مع محاولاتهم المستمرة لربط القرآن بالموروث الديني عند ورقة بن نوفل أو بحيرى الراهب أو غيره, ونحو ذلك.
فهل يشك باحث صادق امتلأ قلبه بتعظيم الله وقدره حق قدره أن هذا كله من شعب النفاق؟! هل يشك إنسان يعظم الله أكثر من تعظيم الذوق الحديث بأن هذه المقالات من “الإفساد في الأرض” ومن “الفجور” الذي قال الله عنه:
{أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأرْضِ, أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ}
فمالفرق بين هذا النمط من الباحثين الذين يربطون القرآن بالأساطير السابقة للإسلام وبين قول كفار قريش:
{وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا, فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلا}
وهي ذات نظرية كفار قريش حين زعموا أن القرآن مأخوذ من غلام مسيحي اسمه “جبر” كان يبيع عند الصفا وهو عبد لابن الحضرمي, كما ذكر ذلك ابن اسحاق في السيرة, ونص الله على مقالتهم تلك وأشار بوجه دقيق إلى بطلانها نتيجة استحالة التواصل اللغوي, فقال سبحانه:
{وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ, لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ}
وقريب من هذه الأقول الشنيعة قول أحد الباحثين “أن الشريعة والسلف اعتقلانا, فيجب أن ننطلق من البرهان أي العقل المطلق” فهذا معنى مخيف, لا يتسامح تجاهه إلا من ضعف قدر الله في قلبه.
وكثير من هؤلاء المثقفين المأزومين تجاه “النص المؤسس” كما يسميه بعضهم يغمغمون في العبارة ويراوغون ويرسلون كلاماً مشتبها حول مقدسات الوحي وَجَلاً من حميَّة الناس لدينهم, ولا يوجلون من الله وهم ينتهكون حرمته, ولو كان لدى القارئ المسلم فسحة أكثر من ذلك لرأيت تصريحاً أكثر بجاحة وأشنع, وهذه أيضاً من شعب النفاق فقد أخبرنا الله سبحانه أن الخوف من الجمهور أكثر من الخوف الله من شعب النفاق كما قال سبحانه:
{لأنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ}
وجاء نظير هذا المعنى في سورة النساء فقال سبحانه:
{إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً}
وقد أمرنا الله أن نعرض عن هذا الضرب ولا نواليه, كما قال تعالى :
{وإذَا رَأَيْتَ الَذِينَ يَخُوضُونَ في آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرِهِ}
بل إن دعوتهم إلى تجاوز فهم القرون المفضلة الذي اعتقلنا –كما يزعمون- هو مما أيقظنا الشارع إلى حدوثه وحذرنا من أهله فقد روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
«سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم».
وأمارة هذا الضرب من الناس اتباع المتشابهات وترك المحكمات والشغف بالتفسير الغريب على طبيعة الوحي وسيرة النبي وأصحابه, كما قال تعالى:
{هُوَ الَذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ وأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ}
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذه الأمارة التي ذكرتها الآية فقال صلى الله عليه وسلم:
(فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)
وذكر ذلك النبي صلى الله عليه في سياق آخر كما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
« ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب ، يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف: يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون مالا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل »
والمقصود من هذا كله أن الباحث العاقل المنصف المتجرد إذا تأمل نصوص الوحي الإلهي ورأى أن الشارع اعتبر خيانة الأمانة وفجور الخصومة وترك تحديث النفس بالجهاد وبغض الأنصار والارتياب في وعد الله ونحوها كلها من “شعب النفاق” فإنه لايشك طرفة عين أن التبرم بمرجعية الوحي, والإزراء بفهم القرون المفضلة, واللهج بتعظيم الكفار, وربط القرآن بالأساطير السابقة للإسلام, واعتبار الشريعة والسلف قد اعتقلانا, أنها كلها شعب من النفاق أشد وأبشع, ولا موقع للمجاملة في مثل هذه القضايا.
وبعض الناس يرى أن هذا فيه شيء من المبالغة, والحقيقة أن ما سبق من الآيات يكشف أن ما ذكرنا دون ما جاءت به الآيات أصلاً, ومع ذلك سأضرب لذلك مثلاً أتمنى أن يوضح الصورة أكثر: إذا كان مجرد “الجهر بالصوت” عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصادم مع توقيره بما يصل إلى “حبوط العمل” كله كما قال تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَاتشعرون}
فكيف سيكون شأن من ينقر ويقمش ويجمع ساقط المرويات ليهز ثقة القارئ في القرآن والسنة؟