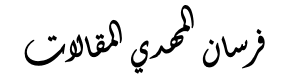مآلات الخطاب المدني

شتيمة الدوغمائية:
يلاحظ المتابع لخطاب غلاة المدنية ولعهم المبالغ فيه بذكر “النسبية” واتهام المخالفين لهم بمصطلحات الوثوقية والدوغمائية واليقينية ونحوها.
والنسبية في المسائل الاجتهادية حق لا مرية فيه أقره الشارع في حديث “لايصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة”, ولكن المؤلم في خطاب غلاة المدنية أن بعضهم يتحدث نظرياً عن النسبية فيما دون القطعيات, ولكنك تكتشف أن هذه النسبية لا تتوقف أصلاً, بل تمتد وتمتد يوماً بعد يوم, فكل من خالف في قطعي من قطعيات الوحي سواء كان متقدماً أم معاصراً تجد من يبرر له ذلك بشعار النسبية.
ومن واقع تجربة مرة فإن أكثر من قرأت له من غلاة المدنية عن النسبية وجدته في بادئ الأمر يتحدث عن النسبية في الاجتهاديات، وهذا مستوى محمود لا شك فيه, إلا أنه بعد فترة يقفز إلى تطبيق النسبية في كل شئ, فكثير من غلاة المدنية يجعلون كل شئ “نظراً شخصيا محضاً”, ولا يجعلون لمعطى من المعطيات الشرعية -مهما كان قطعيته وحسمه وصراحته ووضوحه- شأنا يستحق الجزم واليقين المطلق.
ومما بنوا على أصل النسبية أنهم يسمون الغيرة على الشريعة والفضيلة “توتراً” ويطلقون على الداعية الذي يغضب ويتمعر وجهه إذا انتهكت الأصول الشرعية “متوتراً” أو يسمونه “نزقاً” ونحو هذه الأوصاف والعيوب.
ومما بنوا على أصل النسبية أيضاً التبرم بالحديث عن “شرف هذه الأمة” وفضلها على سائر الأمم, وينزعجون كثيراً من الحديث عن اجتباء هذه الأمة واصطفائها وحب الله لها, ويرونه لوناً من الوهم والتضليل والوثوقية.
ومما بنوا على أصل النسبية أيضاً أنهم يسمون إنكار المنكرات الشرعية ونهي المقصر “إقصاءً”, ولذلك يتباهى كثير من غلاة المدنية ببرودهم أمام مظاهر التقصير الديني باعتبارها “حرية شخصية”, ويجعلون سجية “التواصي” التي شرفها الله “وصاية” ويكثرون من تنقصها.
فإذا تأمل القارئ هذه الظاهرة اعتصره الألم وهو يرى محامد الوحي تتحول إلى مذامّ بألاعيب الألفاظ وتزويق المفردات.
والحقيقة أن من راقب مآلات النسبية رأى أنها الطريق الذي يقود المرء خطوة خطوة إلى “العدمية” المحضة التي لا تكاد تثبت شيئاً, وتجعلك غير قادر على الحماس لأي معطى شرعي, وتسلب المرء فضيلة اليقين وتقحمه في كهوف الارتياب والحيرة والتردد.
ولذلك فإن جبريل حين جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله في ذلك المجلس الذي قررت فيه أصول الدين الثلاث الإحسان والإيمان والإسلام, جعل أشرف هذه المراتب هي “الاحسان” وعرف الإحسان باليقين الحاسم الذي ليس دونه أدنى تردد, بحيث لا يوجد في قلب المرء إلا هذه الحقيقة, فقال “الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه”, فجعل الإحسان هو امتلاء القلب بحقيقة الألوهية بحيث كأنه يشاهد الله عياناً, والواقع أن من لهث خلف سراب النسبية فقد أغلق الباب بينه وبين هذه المنزلة التي هي أشرف منازل الدين, فبدل أن يجاهد نفسه لتستيقن أصبح يجاهد نفسه لترتاب.
والحقيقة أن التأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يكشف لنا بكل وضوح أن الحماس والغيرة على الشريعة والغضب لله ورسوله من المقامات المحمودة وليس توتراً ولا نزقاً ولا وصاية ولا إقصاء.
فمن ذلك ماروى البخاري في صحيحه من حديث عائشة أن النبي لما رأى قرام التصاوير يستعملونه ستراً تلون وجهه من الغضب.
وروى البخاري أيضاً من حديث ابن مسعود في حديث الذي يتأخر عن صلاة الغداة (لطول الصلاة) قال ابن مسعود: فما رأيت النبي أشد غضباً في موعظة منه.
وروى البخاري أيضاً من حديث زيد بن خالد الجهني في الذي سأله عن ضالة الإبل قال “فغضب رسول الله حتى احمرت وجنتاه, أو احمر وجهه” ثم قال: (ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها).
وروى البخاري أيضاً من حديث ابن عمر أن النبي لما رأى القذاة في المسجد “تغيظ”.
وغيرها كثير وإنما أردنا المثال لا الاستيعاب, حيث تبين هذه الأحاديث غيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه لله في مسائل من الأصول ومسائل من الفروع, فغضب من تطويل الصلاة ومن تعليق الصور ومن التقاط ضالة الإبل ومن القذاة في المسجد وغيرها.
ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في شؤون الإسلام ببرود معرفي كما يتصور غلاة المدنية, بل كانت تظهر عليه آثار الغضب والغيره, ففي صحيح مسلم من حديث جابر قال:
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه, وعلا صوته, واشتد غضبه, حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم, ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى)
فكيف يقال بعد ذلك إن الغيرة على محكمات الإيمان والشريعة والفضيلة والغضب لله ورسوله من التوتر والنزق الوصاية والإقصاء ونحوها من الشتائم؟
فالغضب لله ورسوله ليس انتقاماً شخصياً, وشهوة تسلط على الناس, بل هو من أسمى مقامات الإيمان التي تعكس عمق تشرب القلب لحب الله ورسوله.
أما التباهي والافتخار بالبرود واللامبالاة والسلبية أمام مظاهر التقصير الديني باعتبارها “حرية شخصية” فهذا مرض ينبغي على الإنسان معالجته لا قيمة راقية يدعى إليها, فقد كان من أسباب لعن بني إسرائيل هو برودهم وسلبيتهم إزاء مظاهر التقصير الديني, كما قال تعالى:
{لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ* كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ} [المائدة:78-79]
ومن أهم وسائل سلامة المجتمع من كوارث الغضب الإلهي وجود نخبة تغار على الحرمات الشرعية, كما قال تعالى:
{فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلا قَلِيلا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ}
وأما اجتباء هذه الأمة واصطفاؤها وخيريتها وتشريفها بالشهادة على الناس فهو من محكمات الوحي, كما قال تعالى:
{ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ } [ الحج : 78]
وقال سبحانه وتعالى أيضاً:
{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [البقرة: 143]
وهذه النصوص مجرد شواهد فقط, وإلا فالكتاب والسنة مليئة بنظائر ذلك, بحيث أن من تأملها وتدبرها علم قطعية القدر المشترك بينها وبطلان ما يعارضها من مفاهيم الغلو المدني.
تعظيم الذهنيات:
غلاة المدنية يعظمون “المعاني الذهنية” القائمة على النظر والفكر والرأي والتجريد وعويص المعاني ودقائق المفاهيم وإمكانيات الخطاب وثروة المفردات, ويفتحون لها الصوالين الفكرية والاستضافات الثقافية, ويتحدثون كثيراً عن “لذة المعرفة” ويتلذذون بها لذة حقيقية لا مصطنعة, ويملكهم العجب من المتمكنين في هذه الحقول المعرفية, ويجعلونها معيار التقييم في النظر إلى الناس والأفراد, وينزلون الناس منازلهم بحسب براعتهم في هذا الباب وحدة نظرهم.
أما “المعاني السلوكية” القائمة على تزكية النفوس, وتطهير إراداتها, ونهيها عن الهوى, وكفها عن الشهوات, وردعها عن غرائزها, ودقائق معاملة الله سبحانه وتعالى, وما يليق به سبحانه وما لا يليق به, والطريق إلى عبوديته, والإخبات بين يديه, والتضرع له سبحانه, وطول القنوت في محراب الافتقار, وسائر الشعائر ومقامات الإيمان ومدارج التعبد, فينظرون إليها باعتبارها قيمة شخصية لا يطربهم الحديث عنها والتنافس فيها, ولا يعجبهم إقحامها في المجالس.
وما ذاك إلا لأن القوم أصحاب نظر لا أصحاب عمل, وأصحاب ذهنيات لا أصحاب إرادات, فمنزلة العقل –الذي هو مَلِك الفهم- عندهم مقدمة على منزلة القلب –الذي هو ملك الجوارح- بل لا منزلة للقلب بجانب العقل أصلاً.
ولذلك فإن المعظم وصاحب الجاه عندهم ومن ينصاعون لسلطته وينحنون لرياسته ويتفانون في إكرامه وتوقيره وتبجيله والتباهي بلقائه إنما هو صاحب الباع في المعارف النظرية والذهنية والعقلية, ومن يملك القدرات الفكرية والإمكانيات الفلسفية.
أما ذلك الشخص التقي الذي حباه الله بالعلم به سبحانه وتعالى, وقوة الإرادة بالانكباب على عبوديته والاستعلاء على داعي الهوى والغريزة, والإقبال على كتابه, وإفناء الساعات في مناجاته, لكن ليس له باع في الذهنيات والمعارف العقلية فينظرون إليه كشخص بسيط ساذج, ويسمونه في كثير من الأحيان “درويشاً” استخفافاً به وزهداً في حاله, وفي أحيان كثيرة ينظرون إلى ربانيته واستغراقه في معاني العلم بالله سبحانه كتعبيرٍ عن فشله في المعارف الفكرية ودقائق النظر وأبواب العقليات.
وأصل هذه الحالة تعود إلى إشكالية فلسفية طرحت منذ أيام الفلسفة اليونانية ولا زالت حية كفلسفة ضمنية وإن كانت غير معلنة في شكل نظري منظم, وهذه الإشكالية الفلسفية يلخصها التساؤل التالي: (بماذا يكون كمال النفس الإنسانية؟)
والواقع أن الفلسفة اليونانية القديمة قدمت إجابة مبكرة على هذه الإشكالية لخصتها في عبارتها الدارجة وهي أن (كمال النفس الإنسانية يكون بالعلم بالمجهولات والإحاطة بالمعقولات).
والفلاسفة المتقدمون يتكلمون كثيراً عن أقسام اللذات وحقيقتها, وقد انتقل ذلك إلى علماء الكلام الإسلامي, وقد صنف عمدة متأخري الأشاعرة الإمام فخر الدين الرازي -صاحب مفاتيح الغيب والمحصول والمباحث المشرقية ونحوها مما أصبح مرجع كثير من المتأخرين- كتاباً تكلم فيه عن أقسام اللذات وجعلها ثلاثة أقسام, وذكر منها “اللذة العقلية” وشرح شيئاً من حقيقتها وأسبابها.
وهذه العبارة الفلسفية وهي كون (كمال النفس الإنسانية يكون بالعلم بالمجهولات والإحاطة بالمعقولات) تلقاها فلاسفة الإسلام المتقدمين كالفارابي وابن سينا ومن بعدهم عن الفلسفة اليونانية, وكثر تناقلهم وتداولهم لها بنصها كمسلمة فلسفية يبنى عليها ما بعدها.
ولا يزال جماهير المفكرين والمشتغلين بالشأن الفلسفي إلى اليوم يعظمون المعرفة المحضة والمعاني العقلية والعلمية المجردة ويرونها أعلى الكمالات, وينزلون صاحبها بحسب منزلته فيها وتضلعه منها, سواء كان هذا التصرف معلناً, أم تتم ممارسته بشكل منهجي منظم وإن كان غير مصرح به, فقيمة الإنسان داخل هذه النخب بحسب معرفته العقلية والمدنية.
وقد ناقش المحققون من علماء الشريعة هذه الفلسفة على ضوء أصول الوحي الإلهي, وكشفوا تعارض هذه الفلسفة مع المنظور القرآني لكمال النفس الإنسانية, حيث بنيت هذه الرؤية على أساسين, أولهما أن الكمال بمجرد العلم والمعرفة, وثانيهما أن أكمل العلوم هي المعارف العقلية والمدنية.
وهذان الأساسان كلاهما أساسان باطلان مصادمان لأصول الوحي, فأما الأساس الأول فإن الكمال في القرآن ليس بمجرد العلم ولكن بالعمل بالعلم, وأما الأساس الثاني فإن أكمل العلوم ليس المعارف العقلية والمدنية وإنما العلوم الإلهية بما تتضمنه من العلم بالله وكتبه والمعاد ونحوها من المعاني والمضامين الراقية السامية.
ويتلخص الرد على هذه الفلسفة كلها بآية واحدة من كتاب الله وهي قوله تعالى: