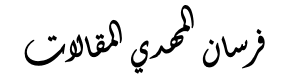مآلات الخطاب المدني

(فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ)
فهذه الآية تضمنت جملتين أولهما بينت أشرف العلوم وهو العلم بالألوهية, وثانيهما بينت أشرف الأعمال وهو العبودية, ودلالة هذه الآية بطريقة ضرب الأمثال التي هي منهج القرآن في الدلالة والبيان.
وهذه الفكرة الفلسفية كان لها آثار ضخمة في بنية الفلسفة القديمة والحديثة, بل تكاد أن تجدها كالنواة الإبستيمية المضمرة في كثير من الأطروحات الفكرية المعاصرة, ولذلك قال الإمام ابن تيمية في درء التعارض:
(ونفس المقدمة الهائلة التي جعلوها غاية مطلوبهم وهو أن “كمال النفس في مجرد العلم بالمعقولات” مقدمة باطلة)
وقدم الإمام ابن تيمية ضمن مناقشته لهذه الفلسفة تحليلاً للأساسات الداخلية لهذه الفكرة, حيث يقول في درء التعارض:
(وضلالهم من وجوه: منها ظنهم أن الكمال في مجرد العلم, والثاني:ظنهم أن ما حصل لهم علم, والثالث:ظنهم أن ذلك العلم هو الذي يكمل النفس, وكل من هذه المقدمات كاذبة)
ثم أخذ في تفاصيل ذلك, والذي يعنينا الاشارة اليه هنا أنه نتيجةً لهذه الرؤية الضمنية في بنية خطاب غلاة المدنية فقد تراجعت قيمة العبودية وسلوكيات الفضيلة والعفة, ويشير الإمام ابن تيمية لذلك في الصفدية بقوله:
(فنفس عبادة الله وحده ومحبته وتعظيمه هو من أعظم كمال النفس وسعادتها, لا أن سعادتها في مجرد العلم الخالي عن حب وعبادة وتأله)
وعلى أية حال فإن منزلتي “النظر والعمل” كلاهما مطلبان شرعيان نبهت عليهما فاتحة الكتاب, ولم تأت الشريعة بذم أصلهما, ولكنها جاءت بتهذيبهما وتكميلهما, وتبيين مراتبهما, وإنما يقدم النظر مطلقاً جمهور الفلاسفة, ويقدم العمل مطلقاً جمهور الصوفية, وكلاهما لون من الانحراف, ولذلك قال الإمام ابن تيمية:
(وكل واحد من طريقي النظر والتجرد: طريق فيه منفعة عظيمة وفائدة جسيمة, بل كل منهما واجب لا بد منه, ولا تتم السعادة إلا به, والقرآن كله يدعو إلى النظر والاعتبار والتفكر, وإلى التزكية والزهد والعبادة, وقد ذكر القرآن صلاح القوة النظرية العلمية, والقوة الإرادية العملية, في غير موضع, كقوله تعالى{هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله} فالهدى كمال العلم, ودين الحق كمال العمل, وكقوله سبحانه أيضاً {أولي الأيدي والأبصار}) الفتاوى2/59
وهاهنا ملحظ طريف جداً من دقائق الحكمة الشرعية المتعاضدة مع الحكمة الكونية, ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى كل طائفة من عباده من جنس غريزتها وهواها المركوز فيها, فاختبرها الله شرعاً بما يوافق واقعها كوناً, فمن حباه الله بالقدرات العقلية الباذخة ابتلاه سبحانه وامتحنه بالاستسلام والانقياد والخضوع للوحي والعمل بما فيه إذ العمل شاق على أمثال هذه النفوس.
ومن آتاه الله قوة الإرادة اختبره الله سبحانه وتعالى باتباع البرهان والحجة وعدم المغالاة في الرهبنة تحقيقاً للذة روحية غريزية, إذ حبس النفس عن الاسترسال في الروحانيات فوق ما أمر الله شاق على أمثال هذه النفوس.
فابتلى الله الأذكياء وأصحاب العقول بحمل النفس إلى العبودية, وابتلى الله الروحانيين وأصحاب العبادة بحبس التعبد على هدي محمد صلى الله عليه وسلم واقتصاده وسنته, وقد نبهت على ذلك خاتمة الفاتحة بمثالي “المغضوب عليهم” و “الضالين” ودلت عليهما أبلغ دلالة على طريق ضرب المثل.
ومن تأمل هذه الإشكالية الفلسفية, واتجاهات الناس فيها نظرياً وعملياً, انكشف له سر ذلك الزهد العميق لدى غلاة المدنية في قيمة “التفقه في الوحي”, في مقابل الشغف والتفاني في الاطلاع على “العلوم المدنية” وتعظيم صاحبها, بل جعل فقه الشريعة أدنى المراتب باعتباره لا يدرس أموراً معقولة ولا مدنية, وإنما قصاراه أن يدرس تفاصيل الأمور العملية, كما قال الإمام ابن تيمية في الصفدية:
(وأما العلم النظري فجعلوه هو الغاية, بناء على أن كمال النفس في العلم, فرأوا “الفقه” هو العلم العملي, فجعلوه أدنى المراتب)
وقد كشف لنا القرآن عن هذه النزوة البشرية, ونبهنا إلى أن ننظر إلى العلوم الإلهية باعتبارها أعظم من كل ما على الأرض من العلوم والمظاهر المدنية, بل ونبه ربنا على مقام “الفرح والاغتباط بالقرآن” كما في قوله تعالى في سورة يونس:
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ, وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ, وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ, هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ}
فجعل هذا “القرآن” من أعظم الممتلكات التي تستدعي الفرحة والسرور, كما قال ربنا تماماً في هذه الآية “فبذلك فليفرحوا”.
وقد لاحظ القارئ الأول “أبي بن كعب” رضي الله هذا المعنى العظيم الذي تضمنته هذه الآية, فحين روى أبي بن كعب للتابعين قصته المعروفة التي جاء فيها أن الله سبحانه أمر نبيه محمداً أن يقرأ على أبي بن كعب سورة بعينها من القرآن, سأله التابعي الجليل عبدالرحمن بن أبزى قائلاً: (يا أبا المنذر، فَفَرحت بذلك؟) فقال أبي بن كعب: (وما يمنعني عن ذلك والله سبحانه يقول:”قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) كما خرجه أحمد في مسنده عنه.
ولذلك ذكر العلامة الراغب الأصفهاني أنه لم يرخّص في الفرح إلاّ في هذه الآية في سورة يونس!
وفي كثير من المواضع في القرآن يقارن تعالى بين قيمة الوحي وقيمة الممتلكات الدنيوية, وينبه المؤمنين بهذا الوحي إلى مضامينه أعظم مما يرونه من المظاهر الدنيوية كقوله تعالى:
(وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, لاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ)
وسننتقل إلى إشكاليتين وثيقتي الصلة بتعظيم الذهنيات وهما التعليل المادي للشريعة والانفعال الوجداني بالوحي, وسنعالجهما في الفقرتين اللاحقتين.
التعليل المادي للشريعة
كثير من غلاة المدنية في محاولتهم لتكريس أهمية الشأن المدني يحاولون ربط الشعائر والشرائع بالحضارة, فتراهم يقولون إن غاية الشعائر هي تهذيب “الأخلاق الاجتماعية” وغاية التشريع هو “سياسة المصالح العامة”.
وقد شاركهم مثل هذا الطرح بعض المنتسبين للاتجاه الإسلامي -بحسن نية- حيث كان مقصودهم تقريب الإسلام إلى النخب الثقافية التغريبية, فتكلموا في مقاصد الشريعة على هذا الأساس, وكان من أكثر الأسباب التي ساعدتهم على هذا الوهم فهمهم غير الدقيق لعبارات بعض متأخري الأصوليين في علم مقاصد الشريعة وعلم السياسة الشرعية حول المصلحة والضروريات الخمس ونحوها.
ومن كتب من المنتسبين للفكر الإسلامي متابعاً لهذه الاتجاهات إنما حمله على ذلك أنه رأى في ظاهر هذه الفكرة تعظيماً للشريعة وحمداً لها, ولم يتنبه لآثارها ومآلاتها ولوازمها.
ومن مقتضيات هذه الرؤية -التي وصل إليها كثير من غلاة المدنية- أنهم لما رأوا بعض المجتمعات غير المسلمة تهتم ببعض الأخلاق الاجتماعية وسياسة المصالح العامة شعروا أن هذه المجتمعات حققت مقصود الإسلام وإن لم تسلك وسائله, والعبرة بالغايات لا بالوسائل, بل إن بعضهم يردد العبارة الدارجة رأيت في الغرب إسلاماً بلا مسلمين, أي أنه رأى مقاصد الإسلام وإن لم يسلم هؤلاء, فتراجعت قيمة المأمورات والمنهيات الإلهية, لما اختزلت مقاصدها في الشأن الاجتماعي والمادي.
بل إنهم كثيراً ما يشيرون إلى أن فقهاء الإسلام المتقدمين والمعاصرين إنما اشتغلوا بتفاصيل المأمورات والمنهيات الواردة في نصوص الوحي, بينما الأمم المتقدمة حققت المقاصد دون هذا الإغراق في هذه التفاصيل, فكان مؤدى هذه الفكرة الزهد العميق في فقه الوحي, والانبهار بالمجتمعات الكافرة.
ومن آثار هذه الرؤية, أن تراجعت قيمة تفاصيل الوحي, ولذلك كتب بعض غلاة المدنية بأن الإنسان المهذب في سلوكه الاجتماعي لكنه لا يعبد الله أفضل من الشخص العابد لكن في سلوكه بعض الفظاظة, لأن الأول حقق المقصد والثاني حقق الوسيلة, والمقصد مقدم على الوسيلة.
بل إن بعض من امتهن التجديف في الشرعيات وصلت أسئلته واستشكالاته الجريئة إلى “الكبائر” فلا زلت أتذكر ماكتبه أحدهم حول دور التطور الحديث في رفع المحظورات وضرب لذلك مثلاً بأن “تحريم الخمر” إنما كان مقصوده الشرعي حفظ صحة البدن وضبط تصرفات العقل, فمع تطور الآليات التشريعية والأجهزة الصحية ومعامل الإنتاج والنظم الجنائية فإنه يمكن ضبط ذلك والسماح بقيود معينة بما يمكن معه تحقيق مصلحة الخمر التي أشارت اليها الآية “ومنافع للناس” مع درء المفسدة التي يتغيا الشارع درءها.
وكتب بعضهم يقول: أن المقصد الشرعي من تحريم المعاشرة خارج مؤسسة الزواج إنما هو حفظ النسب والنسل, فعليه فإنه لما تطورت تقنيات التحليل الطبي الحديثة لكشف النسب وتطورت نظم الرعاية الاجتماعية للطفل, فإن مقتضى ذلك مشروعية العلاقات غير المشروعة بين الجنسين, لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً, ولن تتحقق مفسدة اختلاط النسب وضياع النسل.
وهذه النماذج السابقة وإن كانت نماذج متطرفة ولم يكتب لها الانتشار بسبب بشاعة صورتها النهائية, إلا أنها مما يكشف المآلات الخطرة التي يؤول إليها ربط الشعائر والشرائع بمجرد مقاصد مادية أو اجتماعية أو مدنية ونحوها, والغفلة عن المقاصد الأولية التي نبه إليها الوحي.
وأساس هذه الانحرافات كلها هو الضلال في فهم مقصود الشارع بالشعائر والشرائع, واختزال تلك المقاصد كلها في المصلحة الاجتماعية والمدنية والمادية, حتى إذا تحققت بعض تلك المقاصد الاجتماعية من غير طريق الشريعة لم يعد أولئك يعقلون معنى للعبادات والتشريعات الإلهية, وسنشير إلى جملة من المقاصد بشكل مختصر إذ المقصود المثال وليس الاستيعاب, والمثال كافٍ في التنبيه على جنس هذه النظائر.
فأما العبادات الظاهرة والباطنة –مثال الظاهرة الصلاة ومثال الباطنة التوكل- فإنها أولاً وقبل كل شئ ليست في أصل تشريعها أساساً مجرد “وسائل” لغيرها, بل هي في ذاتها غايات ومقاصد مطلوبة مرغوبة محبوبة لله سبحانه وتعالى, فإن الله يحب أن يرى عبده يسجد ويقنت ويركع ويطوف ويعلي ذكره ويوقن به ويخلص له ويحبه ويرضى بقضائه, فإن الله تعالى تبعاً لألوهيته سبحانه يحب أن يرى العبودية من عبده.
فمقصود الله الأولي من تشريع هذه العبادات الظاهرة والباطنة أنه يحبها جل وعلا ويحب منا أن نقوم بها, ولذلك لما ذكر الله الطهارة قال {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله وتر يحب الوتر).
أما المقصود الأولي للعبد من القيام بهذه الأعمال فهو تحصيل رحمة الله كما قال تعالى {وَهَذَا كِتَابٌ أَنزلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}
أما ما ورد من دور العبادات في تهذيب الأخلاق كقوله تعالى{إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}
فغاية الدلالة في هذه الآية ونظائرها أن الأثر السلوكي إنما هو مجرد أثر يدخل في جملة المقاصد والحكم المحمودة لاأنه علة التشريع الأساسية, وفرق بين العلة والأثر, ثم إن هذه الآية وأمثالها بينت أن الأثر السلوكي لايقتصر على الأخلاق الاجتماعية فقط, بل يدخل في ذلك دخولاً أولياً سلوكيات الايمان كمحاذرة الفواحش والمنكرات.
ولو كانت السلوكيات الاجتماعية هي علة التشريع الجوهرية من هذه العبادات لما كلف الله العباد بهذه الشعائر وتفاصيلها مع أننا نرى الكثير من الناس فيه سلوك اجتماعي حسن من دون هذه الشعائر, حتى أن الله ذكر عن بعض كفار اليهود أمانتهم مع كفرهم كما في قوله تعالى (ومن أهل من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك), بل لكان تكليف الله للخلق بهذه الشعائر لمجرد السلوك الاجتماعي تطويل للطريق وعبث ينزه الله عنه.
ثم يلي كونها أحوال مطلوبة في ذاتها مقاصد أخرى, وأعظم وأهم مقاصد الشعائر الظاهرة “تزكية النفوس” بمقامات الإيمان كالتضرع والخضوع والتذلل والافتقار والمناجاة والتمسكن ومناشدة الله والانطراح بين يديه واللجأ اليه وامتلاء القلب بحمده وشكره.
وهذه الغاية الجليلة وهي تزكية النفوس وعمارة القلوب بالله تشمل الشعائر والتشريعات, فإن أصول المأمورات وأصول المحرمات كلها تثمر للقلب طهارة وزكاة وسلامة هي من أعظم المبتغيات الإلهية, وسنذكر نماذج لذلك.
فمن ذلك أن الله تعالى حين شرع الصيام لم تكن غايته الجوهرية “الحِمية الصحية” كما يقوله غلاة المدنية ممن يجعلون التشريعات مبنية لمقاصد مادية محضة, بل إن هدفه الجوهري ما يورثه للقلب من التقوى كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}
وحين ذكر تشريع الزكاة والصدقة ربطها بالتزكية فقال :
{خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}
وحين ذكر الله تشريع الجهاد بين مايثمره للقلب من تمحيص وتزكية فقال تعالى:
{وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ}
وحين ذكر تشريعات الأسرة قال عن عضل الأولياء مولياتهم:
{فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ}
وحين ذكر أدبيات الاستئذان قال سبحانه:
{وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ}
وحين ذكر أصول الفضيلة كغض البصر وضبط الغريزة ذكر أثرها في التزكية فقال:
{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ}
وقال عن أخلاقيات الحجاب:
{ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}
وحين ذكر تشريعات القضاء والشهادات قال سبحانه:
}وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}
ومن تدبر هذه النصوص -وأمثالها كثير- علم قطعاً أن من أعظم غايات ومقاصد التشريع تزكية النفوس وعمارة القلوب بالله, أما تهذيب الأخلاق الاجتماعية وإقامة المصالح العامة فهي من جملة غاياتها ومقاصدها التي يحبها الله, لكن لايجوز اختزالها فيها وقصرها عليها, فضلاً عن تقديمها على أصل الإيمان والفرائض.
وغلاة المدنية لايكادون يرفعون رأساً بهذا المقصد الحيوي الجليل, بل ويعدون من ينبه عليه مجرد واعظ سطحي لايعقل الإشكاليات الفكرية والفلسفية والمدنية, فكم هو مؤلم أن تكون أعظم المبتغيات الإلهية قيمة هامشية لدى المثقف المسلم, بل إن الله سبحانه بين أنه أرسل الرسل إلى الأمم ثم عاقب عليها ألوان الأزمات كل ذلك بهدف أن تتضرع تلك الأمم إلى الله, ذلك المقام وتلك الكسرة التي يحبها الله من عبده كما قال سبحانه في سورة الأنعام:
{وَلَقَدْ أَرْسَلنَآ إلى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ}
وأكد هذا المقصد الإلهي في الآية التي تليها فقال سبحانه:
{فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ}
بل إن الله سبحانه ما أرسل الأنبياء إلا لهذه الغاية وهي أن يقف الإنسان موقف الضراعة بين يدي الله كما قال سبحانه في سورة الأعراف:
{وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ}
ويرسل الله العقوبات على الأمم ليذكرهم سبحانه بمقصد التضرع إليه كما قال سبحانه في سورة المؤمنون:
{وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ}
ولذلك فإن أول شعور وإحساس يغمر الإنسان حين يؤمن بهذا الوحي هو “الإخبات” له كما قال تعالى في سورة الحج:
{وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ}
وكشف لنا سبحانه أنه لا قيمة للأمم بدون هذا التضرع كما قال سبحانه:
{قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم}
هذه المعاني الجليلة التي يريدها الله من العباد, والتي هي الهدف من خلق الإنسان أصلاً, وهي زبدة مشروع الرسالات منذ بدء الخليقة, لا يجوز تغييبها واختزال الشرائع بغايات مادية محضة.
وحين يتذكر الإنسان مقصود الله سبحانه بالضراعة والإخبات, وحب الله سبحانه وتعالى لهذه الحال الإيمانية, وكيف أرسل الرسل ووالى النعماء والضراء طلباً لها من عباده, فإنه لابد أن يتذكر معها دوماً قصة تضرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشفق عليه أبوبكر من شدة اجتهاده في الضراعة.
حديث عجيب, يهتف فيه محمد بربه, ويشفق عليه ابوبكر, وصادف أن الذي رأى ذلك المشهد ورواه هو عمر بن الخطاب, الرجال الثلاثة في تاريخ الإسلام!
ففي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه قال:
(لما كان يوم بدر نظر رسول الله إلى المشركين وهم ألف, وأصحابه ثلاث مائة وتسعة عشر رجلاً, فاستقبل نبي الله القبلة, ثم مد يديه, فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني, اللهم آت ما وعدتني, اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض, فما زال يهتف بربه, ماداً يديه, مستقبل القبلة, حتى سقط رداؤه عن منكبيه, فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه, فألقاه على منكبيه, ثم التزمه من ورائه, وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك, فإنه سينجز لك ما وعدك, فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين..)
ولذلك لما كانت “تزكية النفوس” هي المدار الذي تدور عليه الأعمال فإن الله جعل المفاضلة بين الناس بحسب ما قام في هذه القلوب من معاني الإيمان, وجعل سبحانه أصل المؤاخذة يتعلق بكسب القلب كما قال تعالى:
{وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة:225]
وانعكاساً لذلك جعل التغيير والإصلاح يبدأ بإصلاح هذه القلوب وعمارتها بمعاني الإيمان, كما قال تعالى:
{إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم}
فإذا انتهت هذه الدنيا وبدأت الحياة المستقبلية المؤبدة فإن الله سبحانه وتعالى إنما يزن هذه القلوب والنفوس وما في الصدور, كما قال تعالى:
{أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ* وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ}
ومن أعظم غايات التشريع التي تغيب عن غلاة المدنية مقصد “ابتلاء التسليم والامتثال” فإن المؤمن يتلقى للتنفيذ, أما من في قلبه مرض فتجده معرضاً عن الأمر أو باحثاً عن التسويغات, ولذلك فإن الله تعالى حين ذكر اختلاف الشرائع بين الأمم بيَّن أن المقصود منها إنما هو “اختبار الانقياد” كما قال تعالى:
{لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم}
وحين حرم الله الصيد على المحرم ابتلى الله أصحاب محمد بصيد قريب من يديهم وقت الحظر ليختبر تسليمهم وانقيادهم كما قال تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ} [المائدة:94]
وقريب من ذلك حين ابتلى الله بني اسرائيل بصيد قريب من يديهم وقت الحظر فقال تعالى:
{إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ}
وعبر تعالى عن مقصد اختبار التسليم والانقياد تعبيراً عاماً شاملاً فقال سبحانه:
{ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون}
وهذه الفكرة التي يرددها غلاة المدنية حول غاية الشعائر والشرائع لها صلة بالأساس الفلسفي الذي أشرنا إليه في فقرة سابقة والمتعلق بجوهر كمال النفس الإنسانية, فكل اتجاه فكري أو فلسفي يربط مقصود الشريعة طبقاً لرؤيته حول كمال النفس الإنسانية, لاطبقاً لدلالات القرآن حول مقاصد الشريعة.
وقد قدم الإمام ابن تيمية مناقشة رائعة لهذه الإشكالية توقف فيها عند مشهدين: المشهد الفلسفي, ومشهد متأخري الأصوليين, وبين ما في هذين من قصور في تحليل غاية التشريع, وبرغم طول النص إلا أننا نحتاجه لأهميته:
(وكثير من الناس يقصر نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب والنفوس ومفاسدها, وما ينفعها من حقائق الإيمان, وما يضرها من الغفلة والشهوة, فتجد كثيراً من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن, وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى “سياسة النفس وتهذيب الأخلاق” بمبلغهم من العلم, كما يذكر مثل ذلك المتفلسفة وأمثالهم؛ فإنهم يتكلمون في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من علم الفلسفة, وما ضموا إليه مما ظنوه من الشريعة, وهم في غاية ما ينتهون إليه دون اليهود والنصارى بكثير, وقوم من الخائضين في “أصول الفقه” وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة, إذا تكلموا في المناسبة وأن ترتيب الشارع للأحكام على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم, ورأوا أن المصلحة “نوعان” أخروية ودنيوية: جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم؛ وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر, وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها: كمحبة الله وخشيته وإخلاص الدين له والتوكل عليه والرجا لرحمته ودعائه وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة, وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود, وصلة الأرحام، وحقوق المماليك والجيران, وحقوق المسلمين بعضهم على بعض, وغير ذلك من أنواع ما أمر به ونهى عنه, حفظا للأحوال السنية وتهذيب الأخلاق, ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح, فهكذا من جعل تحريم الخمر والميسر لمجرد أكل المال بالباطل؛ والنفع الذي كان فيهما بمجرد أخذ المال) مختصراً
على أية حال..فمع يقيننا بأن الشعائر كالصلوات والصيام والنسك والذكر والنحر ونحوها طريق لتزكية النفوس وتهذيب أخلاقها وتنقيتها وتطهيرها من شوائب المادة التي تعلق بالافئدة, ولكن أيضاً ينبغي الوعي بأن الإسراف في تأكيد مقاصدها السلوكية يورث ضعف قيمتها, إذ يحولها إلى وسائل صرفة وأدوات محضة يمكن الاستغناء عنها بغيرها ما دام أن المراد والهدف النهائي هو تزكية النفس وتنقيتها, بمعنى أن الإنسان إذا وصل لـ”صفاء الروح” بأي طريق كان فقد حقق المقصود الالهي, دون أن يتعنى سلوك هذه الشعائر والالتزام بها, وهذه الفكرة الساذجة قد انطلت على بعض المتصوفة وعثر فيها كثير من غلاة المدنية.
وقد لاحظ الإمام ابواسماعيل الهروي(481هـ) ملاحظة مبدعة تستثير الدهشة حول دور الخلل في تعليل الأحكام في إضعاف قيمة الحكم الشرعي بما يترتب عليه انكماش الدافعية, حيث يقول رحمه الله في كتابه المعروف منازل السائرين:
(تعظيم الأمر والنهي: هو أن لا يعارضا بترخص جاف, ولا يعرضا لتشديد غال, ولا يحملا على علة توهن الانقياد) منازل السائرين,81
فربط الشعائر بعلل سلوكية محضة, أو ربط التشريعات بحكم اجتماعية محضة: من أعظم ما يوهن الدافع لها, والسبب في ذلك أن نظر الإنسان دوماً يتشوف للغايات ولا يكترث بالوسائل, وهذه اللفتة أكدتها الظواهر المشاهدة والتجارب الحية, فما إن يستغرق المثقف في علل الشعائر وحكم التشريعات حتى تراه بعد ذلك غير مكترث بها, بل وينعى على من اشتغل بتتبع تفصيلات الوحي, وينظر الى ذلك كنوع من السذاجة في فهم أعماق الشريعة.
وقد حلل الامام ابن القيم هذه اللقطة المبدعة لأبي اسماعيل الهروي وهي “حمل الأمر والنهي على علة توهن الانقياد” حيث يقول في كتابه المدارج:
(وقوله: “ولا يحملا على علة توهن الانقياد” يريد أن لا يتأول في الأمر والنهي علة تعود عليهما بالإبطال, كما تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه معلل بايقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفساد, فإذا أمن من هذا المحذور منه جاز شربه كما قيل:
أدرها فما التحريم فيها لـذاتها * ولكن لأسباب تضمنها السكر
إذا لم يكن سكر يضل عن الهدى* فسيان ماء في الزجاجة أو خمر
وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين جملة, ومن العلل التي توهن الانقياد: أن يعلل الحكم بعلة ضعيفة لم تكن هي الباعثة عليه في نفس الأمر, فيضعف انقياد العبد إذا قام عنده أن هذه هي علة الحكم, ولهذا كانت طريقة القوم عدم التعرض لعلل التكاليف خشية هذا المحذور, وفي بعض الآثار القديمة: يا بني إسرائيل لا تقولوا لم أمر ربنا, ولكن قولوا بم أمر ربنا. وأيضا: فإنه إذا لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علته لم يكن منقادا للأمر, وأقل درجاته أن يضعف انقياده له. وأيضا: فإنه إذا نظر إلى حكم العبادات والتكاليف مثلا, وجعل العلة فيها هي جمعية القلب والإقبال به على الله, فقال أنا أشتغل بالمقصود عن الوسيلة, فاشتغل بجمعيته وخلوته عن أوراد العبادات, فعطلها وترك الانقياد بحمله الأمر على العلة التي أذهبت انقياده, وكل هذا من ترك تعظم الأمر والنهي, وقد دخل من هذا الفساد على كثير من الطوائف ما لا يعلمه إلا الله, فما يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلا الله, فكم عطلت لله من أمر, وأباحت من نهى, وحرمت من مباح, وهي التي اتفقت كلمة السلف على ذمها) مدارج السالكين 2/297
ومما يوضح ذلك ويبينه أن الملك الذي يصدر أمره إلى أحد مؤسسات دولته بتحقيق “هدف” معين عبر “قانون”معين، لا يرضيه أن يصلو إلى ذات الهدف مع مخالفة قانونه الذي فرضه عليهم. فكذلك ملك الملوك من باب أولى –ولله المثل الأعلى- لا يرضيه أن ندع ما شرعه لنا من الشعائر ووسائل التزكية, بل إن الالتزام بهذه الوسائل الإلهية جزء من عملية التزكية ذاتها, فإن من تعبد لله بالغاية التي أرادها والوسيلة التي شرعها جميعاً, خير وأحب إلى الله ممن تعبده بالغاية واستكبر عن وسائله سبحانه.
ومما يدخل في مأزق “التعليل المادي للشريعة” استدلال بعض غلاة المدنية بقوله تعالى: {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط} على أن المراد بها العدل السياسي وتداول السلطة ونحوها, وأن وظيفة الانبياء جاءت أساساً لمقاومة الاستبداد السياسي.
والحقيقة أن العدل السياسي إنما هو جزء من معنى الآية, وهو جزء شريف ولا شك, لكنه ليس هو المعنى الأولوي أصلاً, فضلاً عن أن يكون هو المعنى المطابق.
وهذا يشابه من فسر قوله تعالى (والميزان) بأنه المنطق العقلي, وهذا كله إما تفسير للنص بجزء المعنى الذي ليس هو أشرف معانيه, وإما إقحام معنى في الآية لا تدل عليه.
فإن القسط في القرآن هو العدل وضده الظلم, وذلك ليس مختصاً بالعدل السياسي أو مناهضة الاستبداد, بل هو شامل للعدل العام والخاص, فكل مأمورات الشريعة نوع من العدل, وكل منهيات الشريعة نوع من الظلم, فالشريعة أصلاً كلها أمثال مضروبة للقيام بالقسط, ورأس القسط والعدل في الشريعة هو تجريد القلب من كل ما سوى الله وعدم التفاته لغيره, كما قال تعالى: {قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين}.
والتفات القلب لغير الله قد يكون بصرف عبادة تامة فتكون وثنية كبرى كما قال تعالى: {إن الشرك لظلم عظيم}, وقد يكون التفات القلب إلى طلب الجاه بين الناس فهذا أطلق النبي عليه اصطلاح “الشرك الأصغر” كما قال في الرياء (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء).
فكل التفات للقلب لغير الله سواء كان بعبادة غير الله أو بميل القلب إلى ثناء المخلوقين: فهو ظلم يعارض القسط الذي جاءت به الانبياء.
وليس المقصود –حاشا لله- التزهيد في منزلة الاحتساب السياسي والتصدي للعدل العام, وإنما المقصود بيان منزلته في الإسلام وأنه دون الإيمان والفرائض, وإلا فإن التصدي للقيام بالعدل العام من أشرف معاني هذه الآية ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى بنفسه من أجل العدل العام من “سادة الشهداء” والسيادة في الشهادة أمر زائد على مجرد الشهادة, كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(سيد الشهداء حمزة، و رجل قام إلى إمام جائر فأمره و نهاه فقتله)
ووجه كونه “شهيداً” أن التصدي للعدل العام من أفضل منازل “الجهاد” كما روى أهل السنن وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري، وجابر, وأبي أمامة، وطارق بن شهاب وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر)
وفي رواية (أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لإمام جائر).
وقد كان من أسباب عقوبة أهل “مدين” مظالم الأموال العامة, ولذلك قام فيهم نبيهم شعيب بهذا الأمر, كما قال تعالى:
{وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ}
كما كان من أسباب غضب الله على فرعون استعلاؤه السياسي واستضعافه للناس كما قال تعالى:
{إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ}
وقد لخص الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء منهج القرون المفضلة في ذلك فقال:
(واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض، بل كل من أمر بحروف فإن كان الوالي راضياً فذاك، وإن كان ساخطاً له: فسخطه له منكر يجب الإنكار عليه, فكيف يحتاج إلى إذنه في الإنكار عليه, ويدل على ذلك عادة السلف في الإنكار على الأئمة).
على أنه من الملاحظ في خطاب غلاة المدنية غياب حديثهم عن منكرات المظالم العامة أصلاً, وإنما غالب مادة حديثهم تدور حول: الحريات السلوكية والإبداع الثقافي واتهام التراث وربط المؤسسات الدعوية بالعنف والتصفيق للمنجز الغربي ونحوها من القضايا, وسبب غياب الحديث عن منكرات المظالم العامة ما ينطوي عليه من إحراجات يفضلون تحاشيها.
وفريضة الإنصاف تقتضينا أن نقول أن من تصدى للقيام بالعدل العام -ابتغاء وجه الله- وإن كان لديه غلو في بعض جوانب المدنية إلا أنه أشرف وأنزه وأجلّ من المنهمكين في لمز السنة واتهام التراث وتبجيل الغرب والتأليب ضد العمل الدعوي وتصيُّد زلات المحتسبين والتشنيع على الفتاوى الدينية وتلميع النظم ونحوها من القضايا الصحفية البائسة, فأين هذا من ذاك؟!
والذي يعنينا الإشارة إليه هاهنا أن تبيين منزلة الاحتساب السياسي والتصدي للعدل العام وأنه دون الإيمان والفضيلة والفرائض لا يخدش في قيمته ولايغض من شأنه, وإنما الذي يوهن قيمته وينفر الناس عنه -لو أردنا المصارحة- إنما هو مغالاة بعض المنتسبين له فيه, حتى قادهم ذلك إلى الإزراء بأئمة الهدى والمحققين من أهل العلم والفضل, والحط على بعض القرون المفضلة, واتهام جماهير فقهاء السلف بمداهنة السلطة العباسية, ولمز مصادر التراث الإسلامي وأنها اشتغلت بالهوامش, ونحو ذلك مما كان هدفه حشد الاهتمام بالاحتساب السياسي.
حيث ظن بعض هؤلاء المنتسبين لقضيتي “العدل والشورى” أن تفريغ الاهتمام من قضايا الالهيات وتفاصيل التشريع التي اعتنت بها القرون المفضلة سيقود تلقائياً إلى الانخراط في مشروعات التصدي للعدل العام وتداول السلطة ودسترة النظام السياسي ونحو ذلك من القضايا, والحقيقة أن هذا الأسلوب كثيراً ما يأتي بنقيض المقصود فيجعل الشاب المسلم المعظِّم للسلف يرتاب بمثل هذه الدعوات ويزهد فيها أساساً, وهذه نتيجة طبيعية فإن الغلو كثيراً ما يأتي بنتائج عكسية.
والمغالاة في قضية التصدي للعدل العام حملت بعضهم إلى مآلات كارثية, حتى أن بعض المنتسبين لهذا الاتجاه أصبح يصرح بأن مقصود النبوة إنما هو إقامة العدل الدنيوي ونحو ذلك, وهذا فهم مغلوط له نتائج خطرة, سبق أن أشرنا اليها, وقد أشار لذلك الإمام ابن تيمية في الصفدية:
(ومما يبين فاسد قولهم-أي الفلاسفة- أنهم يزعمون أن المقصود بالرسالة إنما هو إقامة عدل الدنيا)
والغاية من هذه الاشارة المختصرة تأكيد قضيتين متوازيتين لايمكن فصلهما, أولهما: أن التصدي للعدل العام منزلة من أشرف منازل الجهاد, وثانيهما: أن حشد الاهتمام بالاحتساب السياسي لايكون عن طريق الازراء بأئمة القرون المفضلة ولا باختزال الشريعة في هذه القضية.
وأقرب مثل يوضح ذلك أن المجاهد في سبيل الله اذا غالى في “قضية الجهاد” بحيث قدمه على العناية بأصول الايمان أو الفرائض أو استخف بالصحابة أو التابعين أو تابعيهم لأجله بحيث صار يملأ قلوب مستمعيه بالغل للقرون المفضلة فان رايته الجهادية تصبح راية مذمومة ينفر منها الشاب المسلم أكثر من كونها تجذبه.
الانفعال الوجداني بالإيمان:
يلاحظ المتابع أن بعض غلاة المدنية إذا قدر لأحدهم أن يتعاطى مع بعض نصوص الوحي فإنما يميل إلى التعامل معها كخطاب معرفي بحت يتضمن قضايا معرفية محضة, وليس كخطاب إيماني حي يتضمن رسالة, ولذلك ينفرون من مظاهر الانفعال الوجداني أمام القرآن, كالإطراق المخبت واستكانة الجوارح وذرف الدموع واقشعرار أطراف الجسد, وينظر بعضهم إلى هذه الحالات الإيمانية باعتبارها نزعة طهرية مبالغ فيها أقرب إلى سذاجة الوعاظ منها إلى الرزانة المعرفية.
وهذا التصور ناشئ بسبب الجهل بمراد الله من الإنسان حين يقرأ كلامه سبحانه وتعالى, وماهي الحالة الأسمى والأرقى أمام الوحي, إن مجرد استشعار أن الوحي إنما هو “كلام إله” كافٍ لهز المؤمن من أعماقه, وقد حكى الله لنا في صور مشرقة جذابة أحوال أهل الإيمان وكيف كانت انفعالاتهم الوجدانية أمام الوحي, تلك الصور كانت تحمل ثناء ضمنياً على تلك الحال, فلما ذكر الله مسيرة الأنبياء عقب بذكر حالهم إذا سمعوا آيات الوحي حيث يقول تعالى:
{أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا}
فهذه الآية تصور “جنس الأنبياء” لا بعضهم وهم أكمل البشرية وأشرفها, وهم الأرقى بالتنوير الحقيقي, وهم الأسمى عن الظلاميات الحقيقية, فانظر كيف يستقبلون آيات الوحي بالخرور إلى الأرض ساجدين وباكين, فأي انفعال وجداني أعظم من ذلك؟
ويصف تعالى في مشهد آخر صورة الخرور والبكاء فيقول تعالى:
{وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الإسراء:109]
ويصف تعالى مشهداً آخر لأهل الإيمان وهم يستقبلون آيات الوحي فيقول تعالى:
{وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إلى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ} [المائدة:83]
ويعتبر تعالى أن الانفعال الوجداني بالوحي من سلوكيات العلم والمعرفة الحقيقية كما يقول تعالى:
{قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا} [الإسراء:107]
ويصف تعالى مرة أخرى أثر القرآن الجسدي وليس الوجداني فقط فيقول تعالى:
{ اللَّهُ نزلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلى ذِكْرِ اللَّهِ}
بل إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه التأثر النفسي أمام الوحي من مقتضيات وآثار الإيمان التي إن غابت فإنما تدل على ضمور الإيمان, إن لم يكن ذهاب أصله, كما قال تعالى:
{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ}
وكما هي عادة القرآن فإنه اذا ذكر حالا محمودة, فإنه يذكر ضدها ويذمها تتمة للبيان واستكمالاً للدلالة, ولذلك يقول تعالى:
{فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [الزمر: 22]
بل إن الله ضرب لنا مثلاً للتأثر بالوحي من تدبره وتأمله امتلأ خجلاً من حاله وحياء من الله, فإن الله تعالى ذكر أن أشد أنواع الجمادات وهي الجبال والحجارة لو أنزل عليها هذا القرآن لتأثرت وانفعلت به, حيث يقول تعالى:
{لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله}
ويقول تعالى:
{وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ} [البقرة:74]
وقال تعالى:
{وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى} [الرعد:31] .
بل إن الشجر ذاته يتأثر بذكر الله, ففي صحيح البخاري من حديث ابن عمر وجابر كليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى المنبر حَنّ الجذع وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يُسَكَّن, وذلك من شدة فقده للذكر والوحي من رسول الله, حتى أن الحسن البصري لما جلس مرة يروي هذا الحديث لأصحابه بكي ثم قال: (أنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه من جذع شجرة).
بل إن هذا التأثر النفسي والوجداني لا ينحصر فقط في الاستماع للوحي, بل إن المؤمن لا يملك نفسه أمام سائر حقائق الإيمان, فالمؤمن قد يسيطر عليه الحزن والبكاء نتيجة فوات “عمل صالح” يتقرب به إلى الله, وهذا الموضع لا يعقله غلاة المدنية, فلو شاهدوا رجلاً يبكي لفوات عبادة من العبادات لامتلؤوا انتقاصاً له, مع أن الله تعالى يحكي لنا طرفاً من أحوال الصحابة وكيف يتأثرون لفوات عمل صالح فيقول تعالى:
{وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ} [التوبة:92]
فإذا كان ذلك كذلك فكيف يليق بنا أن نستمع للوحي وحقائق الإيمان ببرود معرفي محض؟! وكيف يليق بنا أن نتعامل مع الانفعال الوجداني بالوحي والإيمان باعتباره لوناً من السذاجة الوعظية؟ الواقع أنه لم تفقد هذه الأحوال العظيمة قيمتها إلا بسبب تعظيم المدنية الدنيوية وعلومها المادية, ويكفي للعاقل أن يقرأ هذا العرض الإلهي:
{أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نزلَ مِنَ الْحَقِّ, وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ}