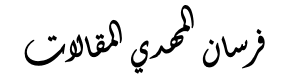بندر الشويقي :فتح سجالاً جديداً حول «مآلات » السكران
فتح سجالاً جديداً حول «مآلات » السكران
بندر الشويقي : المحمود عينة صادقة لظاهرة الانقلاب الفكري
عكاظ 21/2/1429هـ عدد (22447)
منتصف العام المنصرم كتب الباحث البارع إبراهيم السكران ورقته التي عنون لها بـ (مآلات الخطاب المدني)، و دون أيِّة مقدمات أو كتابات دعائية، أخذت تلك الورقة مكاناً متقدِّماً في الساحة الثقافية المحلية، خصوصاً لدى المعنيين بأمر الدعوة والإصلاح. تلك الورقة نُشرت على الشبكة الإلكترونية أولَ الأمر، فلم تنشرها صحيفةٌ شهيرةٌ، ولا طُبعت في كتابٍ، ولا عُقدت لها ندوات التلميع الفضائية. ومع ذلك كله استطاعت أن تخترق الوسط الثقافي بكل يسرٍ وسهولةٍ، نظراً لما حوته من معالجةٍ جادةٍ، وطرحٍ موفَّقٍ.
تلك الورقة تناولت بالوصف والتحليل والتعليل ظاهرة الانقلاب الحاد في الانتماء وفي المفاهيم الكبرى لدى طائفة من الشباب والكُتاب قبيل وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وفي تقديري أنه لم يكتب أحدٌ في معالجة تلك الظاهرة بعمقٍ وهدوءٍ مع أدبٍ وطول نفَسٍ كما فعل السكران في بحث (المآلات) .
وبعد مضي نصف عامٍ، وفي ملحق (الدين والحياة) طُرِحَ سؤالٌ عن تلك الورقة على الأستاذ محمد المحمود الكاتب بجريدة الرياض، فجاءت إجابته ـ مع اختصارها ـ حادةً ومندفعةً حملتْ هجوماً على الكاتب أكثر من النقد الموضوعي للكتابة نفسها. ذكر المحمود أن ما كتبه السكران يعبر عن (بساطةٍ في التفكير) ، و(رؤيةٍ سلفيةٍ منغلقةٍ على ذاتها) ، وقال إن موقفه (لا يختلف عن موقف أيِّ سلفيٍّ تقليديٍّ متعصبٍ) .
ثم شرع المحمود بعد هذا في الازدراء والتعالي، فزعم أن السكران يذكِّره بنفسه حين كان في الرابعة عشرة من عمره، وكان يتصور أن الجغرافيا والتاريخ والطب والفلك والعلاقات الدولية كلها موجودة في أشعار الجاهلية و وقصائد المتنبي والمعري!
لديَّ سببان اثنان جعلاني لا أفاجأ كثيراً بحدة تعليق المحمود ولا بلغة التعالي والترفع الواضحة فيه.
السبب الأول : يرجع لمعرفتي السابقة بمنهجية الكتابة لديه في زاويته بجريدة الرياض منذ سنوات، فتعليقه على بحث السكران جزء من معضلةٍ منهجية أوسع.
السبب الثاني ـ وهو الأهم ـ : أن المحمود نفسه يمثل عينةً صادقةً لظاهرة الانقلاب الحادَّة التي كان السكران يتناولها في بحثه بالعرض والتحليل، مع أن المحمود حاول النأي بنفسه عن أيِّ تحولٍ حاد أو انقلابٍ في توجهاته الفكرية، حين ذكر أن قراءاته في المناهج النقدية الغربية الحديثة كانت قديمة رافقته منذ بدايته قبل عام (1990م) حين كان يقرأ ـ على حدِّ قوله ـ في (المناهج ذات العلوم الإنسانية كالمنهج النفسي والاجتماعي والبنيوية التكوينية، فضلاً عن الدوريات، كمجلة فصول النقدية، وإبداع، وعلامات وملحق الحياة والرياض، وتأثر بالثابت والمتحول لأدونيس…إلخ) !!
هذا الكلام مما يصعب تصديقه وقبوله، لأن المحمود من مواليد (1971م)، وبشهادته على نفسه، فقد بلغ عامه الرابع عشر ـ أي عام (1985م) ـ وهو يعتقد أن الجغرافيا والتاريخ والطب والفلك والعلاقات الدولية كلها موجودة في أشعار الجاهلية و قصائد المتنبي والمعري ! فمع هذا التصور الساذج الغريب عام (85م) ، هل يمكن أن تكون قراءاته في (المنهج النفسي والاجتماعي والبنيوية التكوينية…إلخ) قراءةً عتيقة تمتد إلى ما قبل عام (90م) ؟!
العقل الصحيح يأبى هذا، إلا في حالة وجود طفرة جينية قفزت بالمحمود بين عشيةٍ وضحاها إلى عالم العبقرية، فتحول من فتى ساذجٍ يرى العلوم كلها في الشعر، إلى قارئٍ محكحَكٍ يخوض غمار العلوم الإنسانية الحديثة وينقِّب في تفاصيل البنيوية التكوينية ولم يبلغ العشرين عاماً!
وأيا كان الأمر، فإن كتابات المحمود اليوم تثبت صحة كلِّ حرفٍ خطه السكران في بحث (المآلات) .
فالمحمود بعد سرده أوصاف التطرف والانغلاق وبساطة التفكير، ذكر من عيوب بحث السكران حرصه على شرح المصطلحات الفلسفية التي يستخدمها. وهذا الشرح ـ في رأي المحمود ـ يدل على أنه يخاطب شريحة جاهلة لا تستحق أن تخاطب !!
هذا الانتقاد لا يكشف عيباً في بحث السكران، بقدر ما يشرح إحدى أبرز معضلات الأستاذ محمد المحمود. فالرغبة الشديدة في الترفُّع والتعالي على القارئ سمةٌ ظاهرةٌ في كتاباته يلمسها من يتصفح بضعة مقالاتٍ له. هذه الخصلة لا تظهر فقط في إقحامه اصطلاحات فلسفية بمناسبة ودون مناسبة، بل حتى على مستوى اختيار الألفاظ البعيدة المتكلفة في التعبير عن المعاني الجلية. فالذي يقرأ للمحمود يجد نفسه أمام فكرة سهلة محجوبة بألفاظ : ( الانزياح، والاندياح، والاندغام، والتواشج، والتموضع، والتمظهر، والتأطير، والتبئير، والتشاكل، والماقبلية، والمابعدية، والماوراء، والمابَين …إلخ ) .
ومع أن السكران حرص كلَّ الحرص على عدم ذكر الأسماء في بحثه، إلا أني تخيلته ينظر للمحمود وهو يقول : (بعض الكتاب يميل إلى التحذلق والتقعر في الكتابة وعدم القصد إلى المعاني مباشرة, حيث يشعر أن طرح الفكرة في قالب مباشر يبدد وهجها, وأن وضع الفكرة في طرق ملتوية يبهر القارئ ويجعله يذعن للنتيجة … و أن بعضهم يعجبه أن يتميز عن جمهور الناس بشيء ما, فلذلك تبتهج نفسه بالخطاب المعقَّد حيث يحقق له فرادة شخصية … والحقيقة أنه لا يذعن أمام سلطة الغموض والتعقيد إلا القارئ ضعيف الشخصية, أما القارئ الواثق فإنه يعتبر التعقيد والغموض عيباً في الكاتب لا ضعفاً في القارئ) .
هذه الإشارة الناقدة الصادقة ونظائرها في بحث (المآلات) هي التي تجعلني أقول : إن المحمود يمثِّل عينةً صادقةً تشرح الظاهرة التي كان يتحدث عنها السكران في بحثه. لذا لم تكن ردة فعل المحمود تجاه بحث (المآلات) مستغربةً.
فمن الواضح أن كاتبه وضع يده على الجرح، فهيَّج بعض الآلام. غير أن هذه الآلام لم تكن مقصودةً له، فلغة كتابته كانت لغة الطبيب المداوي، لا العدو الشامت.
عن الثقافة الغربية
ومن الجروح التي لامستها يده قوله : إن بعض الكُتَّاب (أغلق الباب بينه وبين نقاد الثقافة الغربية, عن طريق مسلمة مسبقة وهي أن “نقد الثقافة الغربية ناشئٌ عن الجهل بها” فكلما رأى ناقداً للثقافة الغربية افترض أنه ينقدها بسبب أنه لا يعرفها … وإذا لم نقنع بما يقوله (الغرب) فذلك لعيب في فهمنا نحن لا لعيب فيه هو لا سمح الله ! ) .
هذه الخصلة التي يشرحها السكران ظهرت جليةً في لقاء المحمود ببرنامج إضاءات في قناة العربية، حين سأله مقدم البرنامج عن سبب الانطباع السلبي في المجتمع تجاه الليبرالية. فأجاب المحمود دون تردد : (الجهل فقط .. جهل الناس بماذا تعني الليبرالية) !
فها هو المحمود يثبت لنا صدق رصد السكران لمظاهر الخلل في التفكير لدى الشريحة التي تناولها في بحثه . فالقيم الغربية الليبرالية لا يمكن أن ينقدها ناقدٌ أو يقف منها موقفاً سلبياً، إلا إذا كان جاهلاً بها في رأي المحمود !.
فليس هناك مجالٌ لوجود وجهة نظر تحتمل الإصابة في نقدها. وكأن الليبرالية أصبحت وحياً منزلاً منزهاً عن كل نقيصةٍ وعيبٍ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه! .
ومن المضحك المبكي أن قائل هذا الكلام هو الذي لا يفتأ يندب ضعف القراءة النقدية لدى أهل الإسلام.
فمن الواضح أن النقد المطلوب منا لا يشمل المنتج الغربي الذي يتعين إلغاء ملكة النقد عند التعاطي معه.
التبرم من الأمة
هناك المزيد والمزيد من الشواهد في كلام المحمود التي تؤكد صحة مآخذ السكران على التوجه الأخير لطائفة من الكتاب الشباب المنقلبين على مفاهيمهم الكبرى. فمن ذلك أنه أشار في بحثه إلى ظاهرة (التبرم بالحديث عن “شرف هذه الأمة” وفضلها على سائر الأمم, والانزعاج كثيراً من الحديث عن اجتباء هذه الأمة واصطفائها وحب الله لها, فهم يرونه لوناً من الوهم والتضليل والوثوقية). وقد رأيت المحمود في مقالةٍ له بعنوان (نحن والآخر .. من إشكاليات العلاقة) ، رأيته يقول : (لا يمكن لأمة تمَّ شحنها بخرافة أنها أفضل الأمم أن ترتطم بحقيقة إفلاسها الحضاري واندحارها الأممي وانحطاطها النهضوي) . (كيف كان يمكن أن تواجه الأمة ـ التي تتصور نفسها سيدة الأمم في كل مجالٍ ـ حقيقة أنها هي الأدنى في كل مجال) !
فأمة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ هي الأدنى (في كل مجالٍ) ودون استثناء في عين المحمود. والقول بأفضليتها على الأمم خرافة. حتى مع شهادة العزيز الحكيم بذلك !!
يمضي السكران في استعراض مشاكل خطاب الغلو المدني، فيذكر منها دعوة بعضهم (إلى قراءة “نصوص الوحي” ونصوص “التراث الإسلامي” قراءة مدنية, بمعنى قراءة “موجَّهة” تبحث داخل هذه النصوص عن أية مضامين تدعم “المدنية” ثم تؤَوِّل مايتعارض معها.
وتصبح فرادة الفقيه داخل هذا الاتجاه تابعة لقدرته في توفير الغطاء الشرعي لمنتجات الحضارة وبحسب إمكانياته في تأويل ما يتعارض معها وتخريجه بشتى المخارج, بدل أن تكون الدعوة إلى قراءة الوحي قراءة “صادقة” تتجرد للبحث الدقيق عن المراد الإلهي ! ) .
العصرنة وآليات التحديث
هذا الملحظ الذي يثيره السكران في بحثه لا تخطئه عين القارئ في كتابات الأستاذ محمد المحمود، فتحت زخرف دعاوى الإبداع ونبذ التقليد والقراءة الحديثة، نجد المحمود يلحُّ في كتاباته على إعادة قراءة (نصوص التراث) و عصرنة الفكر الديني، من أجل الانخراط في الفكر المعاصر!! ففي مقالته (التاريخ وأزمة الفكر الإسلامي) يقول المحمود : (إن رفض الآليات المنهجية الحديثة ـ التي تمثل مرحلة متقدمةً من مراحل نضوج الفكر الإنساني ـ يعني بالضرورة أن يقف الفكر الديني خارج العصر … العصرنة اليوم لم تعُد خياراً، وإنما أصبحت شرطاً للحياة (شرطاً نوعياً) إن الحياة يراد لها أن تتمثل الديني وأن تتخلق بوحيه، ولا يتم هذا إلا بعصرنة الفكر الديني ابتداءً، لأنه هو الحاسم فينا … وعصرنة الفكر الديني لا تتم إلا بواسطة الانخراط في منظومة الفكر المعاصر بكل إصرارٍ و إيجابية، لنخرج من رحلة الاجترار التاريخي) .
حديث المحمود هنا عن (العصرنة) ، وعن (آليات منهجية حديثة) ما هو إلا تغليف وزخرفة لما ذكره السكران عن الدعوة إلى القراءة (الموجَّهة)، التي لا تهدف للبحث عن معنى ومقصود النصِّ الإلهي، وإنما تسعى (لتوفير الغطاء الشرعي لمنتجات الحضارة) .
فالفكرة المطلوب الوصول إليها محدَّدة سلفاً. والمطلوب فقط إلصاقها بالنص الشرعي عبر شيء يسميه المحمود (آليات منهجية حديثة) !
فنحن إذا وجدنا نصَّ القرآن يعارض منتجاً غربياً، فيجب علينا إعادة قراءة النص حتى يخضع ويذعن للمنتج الغربي. وبهذه الطريقة نكون قد طورنا فكرنا الديني !!
ولي عودة ووقفات في العدد القادم
اتهمه بإدمان المديح الخطابي للمدنية الغربية
الشويقي : كتابات «المحمود» ارتجالية تخلو من النضج والموضوعية
عكاظ ـ الخميس 28/2/1429هـ العدد (2454).
محمد بن علي المحمود لديه ولعٌ شديدٌ وشغفٌ لا حدَّ له بكيل المدائح الإنشائية للمفاهيم الليبرالية الغربية وما يتفرَّع عنها، كما أن لديه حساسيةً شديدةً تجاه أيِّ نقدٍ يُوجَّه لها، حتى يخيل لقارئ بعض مقالاته أنه أحد مؤسِّسي النهضة الأوروبية المنظِّرين لها، وأحد أعلامها الكبار الذين بذلوا عرقهم لإشادة بنيانها، فهو ـ بالتالي ـ يغار عليها من نسمة الهواء العابرة أن تنال من وجهها المشرق الأبيض النقيِّ.
وقد كان من الممكن قبول بعض دفاعاته لو أنه انتهج الموضوعية والعلمية في كتاباته، غير أنه في سرده لمقالات المديح يصوِّر الغرب وكأنه مجتمع أفلاطوني، يتمثل تعاليم فولتير في جميع حركاته وسكناته.
هذا التصور الساذج لتركيبة المجتمع الغربي لا يختلف عن التصور القديم الذي حكاه المحمود عن نفسه حين كان يظنُّ في يومٍ من الأيام أن علوم الفلك والطب والجغرافيا والعلاقات الدولية موجودة في شعر المتنبي والمعرِّي!
هذا الخلل لدى المحمود ونظرائه لم يفُتْ البارع إبراهيم السكران وهو يبحث (مآلات الخطاب المدني)، حين ذكر أن أصحاب ذاك الخطاب لا يملكون (“تصوراً علمياً” معنياً بقراءة وتفسير الحالة الغربية كنسيجٍ اجتماعيٍّ أو شبكةٍ معقدةٍ تمتزج فيها السياسة والمصالح والأفكار والأخلاق والتيارات.
بل يقدِّمون صورة الفكر الغربي بلغة مناقبية وعبارات وجدانية هي أقرب إلى الهيام منها إلى القراءة المعرفية, فخطاب غلاة المدنية عن الغرب هو خطاب تبشيري وليس كما يزعمون من أنه خطاب تحليلي) اهـ.
فلنرجع لكتابات المحمود وسنجد اللغة الخطابية المناقبية الوجدانية في وصف الفكر الغربي حاضرةً في الصدارة. فمن ذلك ـ على سبيل التمثيل لا الحصر ـ قوله في مقالة عنوانها : (ويبقى الإنسان) : (لقد كانت الفلسفة بأفقها الأرحب، وتسامحها اللامحدود، وقدرتها الفائقة على الاستقبال والإرسال، وبراءتها من اليقينيات المطلقة، هي صاحبة الفضل في قيادة الفكر الأوروبي إلى الإنسان. ذلك أنها ربطت الوجود بالفكر، فارتبط الفكر بالإنسان، وبهذا أصبح الهم الإنساني لا يغيب عن الذات المفكرة).
وفي مقالته (متطرفون في الزمن الليبرالي) يقول المحمود : (القيم الليبرالية – بتقدميتها التي تعانق إنسانية الإنسان – هي مستقبل الإنسان المعاصر … الزمن المعاصر زمن ليبرالي، ولا يستطيع أي أحد أن يزورَّ عن الليبرالية – فضلاً عن أن يحاربها) اهـ.
لغة المديح الخطابية هذه التي أدمنها المحمود لن تفسح أيَّ مجالٍ لعقله كي يفكر ويميِّز الحسن من القبيح في مظاهر وحقائق المدنية الغربية.
وهذا هو الفارق الأميز بين كتاباته الحادة، وبين بحث السكران المتوازن.
فالأخير يكتب لينبه للأشواك المحيطة بوردة الحضارة الغربية، في حين لا يرى المحمود في المنتج الغربي سوى باقة زهور منزوعة الأشواك.
حتميات ماركس
أما حديثه عن كون الليبرالية (هي مستقبل الإنسان المعاصر)، وأنه ما من (أحدٍ يستطيع أن يزوَرَّ عنها فضلاً أن يحاربها) ، فهذا الخطاب يذكرنا بحتميات ماركس التي طواها النسيان بعدما صفَّق لها طويلاً شعراء البلاط الماركسي. واليوم جاء دور شعراء البلاط الليبرالي لينظموا القصائد في الحتمية الليبرالية.
لا أريد أن أقف طويلاً ههنا، لكني فقط أريد أن أرجع مع المحمود للوراء قليلاً، إلى مقالةٍ كتبها بعنوان : (الإرادة الإنسانية… المستقبل يصنعه الإنسان) .
في تلك المقالة شنَّعَ المحمود على من يلغي إرادة الإنسان، ويجعلها رهينةً بالحتميات! وذكر أن من ميزات الإنسان الغربي أنه لا يستسلم للحتميات ! وأعلن أنه لا يمكن أن يحصل انبعاثٌ مادام الوعي أسيراً للحتميات !
بل أعلن أن الاستسلام للحتميات نفي حادٌّ للإنسان ! بل هو انتقال من عالم الإنسان إلى عالم الأشياء !!
فإذا كان الأمر هكذا.. فكيف استباح المحمود نفي إنسانيتنا، وكيفَ أسلمنا للحتميات، ونقلنا ـ ونقل نفسه معنا ـ إلى عالم الأشياء، حين حكم وقضى بأن الليبرالية قدرنا المحتوم الذي لا يستطيع أحدٌ منا أن يزورَّ عنه ، فضلاً عن أن يحاربه؟!
هذه الخطابيات المتناقضة تؤكد قناعةً لديَّ ولدى كثيرين غيري، خلاصتها أن المحمود لا علاقة له بالليبرالية من قريبٍ ولا من بعيدٍ، إلا علاقة المديح الإنشائي. ومن نسبه إلى الليبرالية فقد حمَّله ما لا يطيق.
فالمسألة كلها لا تتعدى رغبةً محمومةً في المشاكسة والمعاكسة لا أكثر. ومثل هذه الرغبة لا يمكن بحالٍ أن ينتج عنها فكرةٌ متزنةٌ أو رؤيةٌ ناضجةٌ.
لذا فإن التوازن والنضج آخر ما يمكن أن تجده في مقالة يكتبها محمد المحمود.
بين المحمود و برتراند رِسْل
كان برتراند رِسْل يقول : “إن الفيلسوف الليبرالي لا يقول : (هذا حق).. بل يقول: (يبدو لي أن هذا الرأي أصحُّ من غيره)”. ولربما لو مُدَّ في عمر رِسْل ، لأعاد النظر في مقولته تلك. فما من أحدٍ يتنفس الهواء هذه الأيام يمكن أن ينافس المحمود في عبارات الجزم والحسم واليقين والتحقير والتجهيل لمخالف رأيه. فلابدَّ أن يكون أحد الاثنين قاصراً في فهمه للفلسفة الليبرالية: إما (برتراند رِسْل)، أو (محمد المحمود)!. ومع قناعتي بأن الرؤية الليبرالية تصبح قيمةً أرضيةً منحطةً إذا ما قورنت بالمفاهيم الاجتماعية والقيم السامية لشريعة الإسلام، إلا أن جميع ما يكتبه المحمود لا يرتقي لمستواها بأيِّ حالٍ، حتى وإن أجهد قلمه وأهلك نفسه في سبيل الالتصاق بها، وتنصيب نفسه محامياً عنها. فمن الواضح أنه كلما أمعن في الدفاع عنها قدَّم المزيد من البراهين على براءتها منه.
أقول هذا وأنا أعلم أن قلم المحمود يطيش حين يسمع من يتحدث ـ مجرَّد حديث ـ عن وجود تعارض بين شريعة الإسلام، وبين الرؤية الليبرالية. فقد رأيته يقول في مقالة له بعنوان (متطرفون في الزمن الليبرالي) : إن (مسألة التضاد بين الليبرالية والإسلام، لم يعُد يتحدث عنها إلا الأغبياء، من سدنة خطاب الجهل) .
حين قرأتُ هذا الكلام تخيَّلت المحمود جالساً بين يدي فولتير يحاول إقناعه بأنه (ليبرالي أصيل) يؤمن أن الدين يجب أن يكون حاكماً لأنظمة الدولة وقوانينها، فضلاً عن العلاقات الاجتماعية داخلها! فلو سمع فولتير هذا الكلام ربما يكون أكثر تهذيباً، فلا يتحدث عن (الغباء وسدانة الجهل) ، لكنه بالتأكيد سوف يضرب كفاً بكفٍّ ، وسيدرك أن (التنوير) الذي جاهد من أجله لم تصل صورته إلى الآن إلى رأس شاعر الليبرالية محمد المحمود.
فمن الواضح أن صاحبنا يدافع عن مبدأ لا يملك الإدراك الكافي لأبعاده الحقيقية، ثم يزيد في تعقيد الأمر حين يمارس التجهيل والتسفيه لمن يحاول شرح هذه الأبعاد الخافية عنه أوتقريبها إليه.
فمما أذكره هنا أن المحمود كتب يوماً مقالةً عنوانها: (المتطرفون وصناعة خطاب الجهل) شنَّ فيها هجوماً (خطابياً) على برنامج عُرض في قناة فضائية عن الفلسفة (الليبرالية).
فكان مما أغضب المحمود قول ضيف البرنامج : إن الفلسفة الليبرالية تتسم بالغموض وعدم الوضوح لدرجة أن أصحابها عاجزون عن تحديد مفهومها بصورة جليةٍ. ومع أن غموض الفكرة الليبرالية مما يقرُّ به منظروها قبل خصومها، إلا أن المحمود فزع ثانيةً لعبارات التجهيل والتسفيه، فكتب مقالةً كرَّر فيها مفردة (الجهل) 45 مرةً !
فضلاً عن عبارات التطرف وما يتفرع عنها. ولمزيد من التفخيم والتضخيم، ذكر المحمود أنه لا يمكن لأحدٍ أن يلمس الليبرالية حتى يقرأ المجلدات العشرة من كتاب (قصة الحضارة) كاملةً!
وحين يتابع القارئ هجوم المحمود ليرى أين تنتهي فكرته يجده في النهاية يعلن بوضوحٍ بأن الفكرة الليبرالية لا يمكن أن تُحَدَّ ، لأنها تتعدَّد بتعدُّد أفرادها!
إذن كان كلام ضيف القناة الفضائية صحيحاً، فلأيِّ معنى كانت غضبة المحمود؟! فهاهو في النهاية يعود ويقرُّ أن الليبرالية فكرة عائمة تتعدد مدلولاتها بهذه الصورة الفوضوية.
غير أن الذي يطول منه العجب أن المحمود مع تقريره لهذا التعدُّد والاتساع لمفهوم الليبرالية، ومع تقريره أنها رؤية تتعدَّد معانيها بتعدُّد أفرادها، فإنه ـ في الوقت نفسه ـ يرى من الغباء والجهل أن يتصوَّر أحدٌ وجودَ تعارض بين الإسلام وبين أيِّ واحدةٍ من هذه (الليبراليات) غير المحدودة!
لأجل هذا الموقف وأمثاله أقول : إن من الصعب أن تجد للنضج والاتزان أدنى أثر في كتابات المحمود الارتجالية. والبحث في إثبات أو نفي التعارض بين شريعة الإسلام وبين القيم الليبرالية يحتاج لأمرين اثنين : رؤية واضحة لأبعاد الفكرة الليبرالية ، مع دراية وفهم لأصول وقواعد وآداب شريعة الإسلام.
والمحمود يعاني فقراً مدقعاً في الجانبين، علاوةً على الحدة والنزق الظاهرين في تناوله للمسائل. فإذا انضمَّ لذلك كله قطيعةٌ كاملةٌ مع النَّص الشرعي، فحينئذٍ يستحكم البلاء ، وتضعف أمام المحمود فرص الخروج من الدائرة التي حاصر نفسه داخلها دون أن يشعر.
والمتصفِّح لمقالات المحمود من الممكن أن يمرَّ على إنتاجه على مدى السَّنة والسنتين من غير أن يجد أثراً لنصٍّ قرآنيٍّ أو سنةٍ نبويةٍ. مع أن جلَّ ما يكتبه يتعلق بأحكامٍ شرعيةٍ كبرى من المفترض أن تستند على النصِّ الشرعيِّ قبل غيره.
بل إني رأيت المحمود في مقالةٍ له عنوانها : (ما بعد الأيديولوجيا .. العقد الاجتماعي) ، رأيته يقول : (ماهية الحوار ـ من حيث هو حوار (!) ـ يفترض فيه أن تغيب النصوص التي ينطلق من خلالها المحاور) !!.
فمثل هذا الكلام من المحمود يوضِّح أن مشكلته ليست مع سلفية، ولا مع صحوة، أو تراث فقهي، بل معضلته الكبرى مع (النصِّ الشرعيِّ) نفسه. لذا تراه مرةً يتحدث عن (آليات حديثه) لإعادة قراءة النَّص من أجل عصرنة الفكر الديني، ومرةً ثانيةً تراه يعلن أن النَّص من المفترض ألا يكون له مكان في الحوار، (من حيث هو حوار!). فالمشكلة التي يعانيها المحمود مع النص الشرعي واضحةٌ مهما حاول سترها.
وبالعودة لبحث (المآلات) الذي تهجم عليه المحمود، نجد كاتبه يرصد هذه الظاهرة ويبرزها حين يقول : (تأمل في نُفرة كثيرٍ من غلاة المدنية من النصوص الدينية وابتهاجهم بذكر الأعلام الغربية وقارنها بقوله تعالى في سورة الزمر : (وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذُكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون). وقوله في سورة الحج : (وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتٍ تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر)). اهـ.
العقلانية والعقل
نرجع ـ ثانيةً ـ لتلك الحلقة الفضائية عن الليبرالية، فنجد ضيفها يذكر من عيوب الليبرالية كونها (فلسفةً عقلانيةً). وعند هذه النقطة انتصب المحمود مغضباً وكتب يقول : (هذه التهمة من عجائب التيار المتطرف الذي لا يعرف حتى كيف يدين خصومه. فكون الليبرالية عقلانية، يعني أنها مع العقل. وتيار التطرف تيار معادٍ للعقل). حين قرأتُ هذا الكلام شككتُ كثيراً إن كان المحمود قرأ بالفعل كتاب (قصة الحضارة) الذي نصحنا به آنفاً.
فلو أنه مرَّ عليه مروراً عابراً لما قال مثل هذا الكلام، ولما فهم كلام ضيف الحلقة هذا الفهم الحرفي العجيب.
حين تعاب نظرية ما بأنها (عقلانية)، فليس معنى ذلك أنها (مع العقل) كما توهم شاعر (الليبرالية). بل المقصود بذلك تصنيفها ضمن أحد مناهج التفكير الفلسفي الغربي الذي لا يؤمن بغير العقل مصدراً للمعرفة. فالدين بالتالي لا يصلح طريقاً أو مصدراً للمعارف، ومن هنا دخل العيب على المناهج العقلانية. ولو تصفَّح المحمود كتابه المفضَّل (قصة الحضارة) فسيجد حديثاً كثيراً مكرَّراً عن كتاب شهيرٍ عنوانه : (نقد العقل الخالص) للألماني عمانوئيل كانت، وهو الكتاب الذي احتفل الألمان قريباً بمرور (220) سنة على تأليفه. وسيجد المحمود ـ أيضاً ـ في (قصة الحضارة) عرضاً واضحاً لموقف (روسو) الناقد لعقلانية حركة التنوير، بعدما توصل إلى أن العقل عاجزٌ عن تعليم الناس الفضائل.
فليرتجل المحمود ـ إذن ـ قصيدة يهجو بها (كانت) و (روسو) ، وليعطهما نصيبهما من الخمسة وأربعين تجهيلاً، حتى يفهموا مناهج الفلسفة الغربية على أصولها في المرات القادمة.
حين أورد مثل هذه الشواهد ، فلست أسعى من خلالها للتشكيك في ليبرالية المحمود، لأن هذه الليبرالية لا وجود لها من الأساس، فلا أجدني بحاجة للتشكيك فيها.
غير أني أريد أن أقول : إن المنتسبين لليبرالية نوعان: فهناك ليبرالي (حقيقي) ، يقابله ليبرالي (مجازي) .
فالأول قانع برأيه ، مدركٌ لأبعاده ، وملتزمٌ لوازمه.
أما الثاني فهو في الغالب شخصية تعيش على مشاكسة الآخرين، وتجد لذةً في الخصومة وافتعال المعارك الكلامية العابثة.
ومتى ألصقت تلك الشخصية نفسها بالليبرالية، فإن وظيفتها غالباً ما تكون محصورة في القيام بدور شاعر البلاط الليبرالي، الذي يمتهن نظم القصائد في مدح (الليبرالية)، وهجاء معارضيها فقط لا غير.
ولو وجد الليبرالي (المجازي) فكرةً غير الليبرالية تساعده على المشاكسة والمعاكسة بصورة أفضل لبادر بالانتساب لها، والالتصاق بها، ونظم القصائد الزائفة في ذكر مناقبها.