أهل السنة و الجماعة اشكالية الشعار و جدلية المضمون

وقال ابن تيمية في النبوات (1/423) (فالبدع نوعان: نوع كان قصد أهلها متابعة النصّ والرَّسول، لكن غلطوا في فهم النصوص، وكذَّبوا بما يخالف ظنَّهم من الحديث ومعاني الآيات؛ كالخوارج، وكذلك الشيعة المسلمون، بخلاف من كان منافقًا زنديقًا يظهر التشيع، وهو في الباطن لا يعتقد الإسلام، وكذلك المرجئة قصدوا اتباع الأمر والنهي، وتصديق الوعيد مع الوعد، ولهذا قال عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط، وغيرهما:إن الثنتين وسبعين فرقة أصولها أربعة: الشيعة، والخوارج، والمرجئة، والقدريَّة . وأمَّا الجهمية النافية للصفات، فلم يكن أصل دينهم اتباع الكتاب والرسول؛ فإنه ليس في الكتاب والسنة نصٌ واحد يدل على قولهم، بل نصوص الكتاب والسنة متظاهرة بخلاف قولهم).
ثم لم يأت القرن الرابع حتى استقر شعار أهل السنة والجماعة وصار ينتظم أهل الحديث والأثر وأهل الفقه والرأي وأهل السلوك والتصوف السني والمتكلمين على أصول أهل السنة، كما قال عبد القاهر البغدادي (ت424) في الفرق بين الفرق (1/7 ) في إطلاق اسم أهل السنة على أهل الحديث وأهل الفقه والرأي (ونحوها من الأبواب التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة من فريقي الرأي والحديث على أصل واحد خالفهم فيها أهل الأهواء).
وقال أيضا في (1/19) (فأما الفرقة الثالثة والسبعون فهي أهل السنة والجماعة من فريقي الرأي والحديث، وفقهاء هذين الفريقين، وقراؤهم، ومحدثوهم، ومتكلمو أهل الحديث منهم، كلهم متفقون على مقالة واحدة في توحيد الصانع وصفاته وعدله وحكمته، وفي أسمائه وصفاته، وفى أبواب النبوة والإمامة، وفى أحكام العقبى، وفى سائر أصول الدين، وإنما يختلفون في الحلال والحرام من فروع الأحكام، وليس بينهم فيما اختلفوا فيه منها تضليل ولا تفسيق، وهم الفرقة الناجية، ويجمعها الإقرار بتوحيد الصانع وقدمه، وقدم صفاته الأزلية، وإجازة رؤيته من غير تشبيه ولا تعطيل، مع الإقرار بكتب الله ورسله، وبتأييد شريعة الإسلام وإباحة ما أباحه القرآن وتحريم ما حرمه القرآن، مع قيود ما صح من سنة رسول الله، واعتقاد الحشر والنشر، وسؤال الملكين في القبر، والإقرار بالحوض والميزان، فمن قال بهذه الجهة التي ذكرناها ولم يخلط إيمانه بها بشيء من بدع الخوارج والروافض والقدرية وسائر أهل الأهواء، فهو من جملة الفرقة الناجية إن ختم الله له بها، وقد دخل في هذه الجملة جمهور الأمة وسوادها الأعظم من أصحاب مالك والشافعي وأبى حنيفة والأوزاعي والثوري وأهل الظاهر).
كما قال ابن حزم في الإحكام 4/579 وهو يرد على التقليد (قلنا أهل السنة فرق فالحنفية جماعة، والمالكية جماعة، والشافعية جماعة، والحنبلية جماعة، وأصحاب الحديث الذين لا يتعدونه جماعة).
وقال أيضا في 6/ 272 (سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وابن القاسم وداود ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وأبي ثور وهؤلاء الفقهاء رحمهم الله هم الذين قلدتهم الطوائف بعدهم ما نعلم الآن على ظهر الأرض أحدا يقلد غيرهم… فإن كان مالكيا أو شافعيا أو حنفيا أو سفيانيا أو أوزاعيا قيل له فقلد أحمد بن حنبل فإنه أتى بعد هؤلاء ورأى علمهم وعلم غيرهم وتعقب على جميعهم، ولا خلاف بين أحد من علماء أهل السنة أصحاب الحديث منهم وأصحاب الرأي في سعة علمه..).
ثم في أواخر القرن السادس بعد شيوع التقليد المذهبي واندثار كثير من المذاهب الفقهية السنية ـ كمذهب الثوري والأوزاعي والليث وأبي ثور وابن جرير وداود الظاهري ـ صار اسم أهل السنة والجماعة ينتظم على وجه الخصوص أتباع المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة المشهورة وهي مذهب أبي حنيفة بالعراق وما خلفه من المشرق الإسلامي، ومالك بالحجاز والمغرب الإسلامي إلى الأندلس، والشافعي بمصر والشام، وأحمد ببغداد ثم بالشام ثم نجد، ولم يبق أحد لا من أهل الحديث ولا من أهل السلوك ولا من أهل الكلام لا يقلد أحد أئمة هذه المذاهب، بل حتى المعتزلة صاروا منذ القرن الثالث لا يخروجون في مذاهبهم الفقهية عن مذهب أبي حنيفة أو الشافعي كالقاضي عبد الجبار والزمخشري!
ثم لم تنته عند ذلك الإشكالية إذ ما زال الغلو والتطرف والانحراف يفعل فعله في بعض أتباع الطوائف السنية حتى تجاوزوا أصول أهل السنة العقائدية الدينية، كما تجاوزوا أصولهم العملية السياسية، وهي الأصول التي قررها الخطاب القرآني، وطمس معالمها في العصور المتأخرة الخطاب السلطاني، الذي فتح الطريق للخطاب العلماني، حتى صار الخيار أمام أهل السنة وعموم الأمة في العصر الحديث إما العلمانية الديمقراطية أو الجبرية والطاغوتية وللحديث بقية!
…
4 – الأصول السياسية والعقيدة الغائبة 1
بقلم د. حاكم المطيري
لا تقتصر أصول أهل السنة والجماعة العقائدية على مسائل الإيمان وإثبات الصفات وإثبات القدر ونحوها من مسائل العقائد وقضايا الغيب ـ كما تحاول بعض الطوائف المعاصرة قصرها عليها وإشغال الأمة بها دون غيرها مشايعة منها لأهواء الملوك والطغاة ـ بل لأهل السنة والجماعة أصولهم العقائدية السياسية التي اشتهروا بالقول بها، وأجمعوا عليها، وثبتت عندهم بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ومن لم يقل بها فليس من أهل السنة والجماعة، وهذه الأصول موافقة لصحيح المنقول وصريح المعقول، وهو ما تقره الفطر السليمة والعقول الحكيمة ومن هذه الأصول :
الأصل الأول : وجوب إقامة الخلافة، ونصب الإمام، وتنفيذ الأحكام، وظهور شرائع الإسلام، وأن الأصل هو اختيار الأمة للإمام بعقد البيعة وبالشورى والاختيار لا بالنص ولا الإجبار، وإثبات خلافة الخلفاء الراشدين، وأنه يجب اتباع سننهم والاقتداء بهديهم في باب سياسة الأمة، وأنه يجب لزوم جماعة المسلمين والمحافظة على وحدتهم، وعدم الخروج على الأمة إذا اجتمعت على خليفة، ويحرم تعدد الأئمة، فصار كل من يثبت الخلافة، وأنها بالشورى والاختيار لا بالنص و الإجبار فهو من أهل السنة والجماعة :
قال الإمام أحمد ـ في رسالة عبدوس بن مالك العطار ـ (أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم … ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين ـ صار إماما تجب طاعته ـ والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء، وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم) انظر أصول السنة للإمام أحمد (ص24).
وقال في رواية إسحاق بن منصور، وقد سئل عن حديث النبي (من مات وليس له إمام، مات ميتة جاهلية) فقال أحمد : تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون، كلهم يقول: هذا إمام؛ فهذا معناه). انظر منهاج السنة لشيخ الإسلام (1/526-229).
وجاء في رواية التميميين كما فهماه من مذهبه (وأن الفيء يقسمه الإمام، فإن تناصف المسلمون وقسموه بينهم فلا بأس به، وأنه إن بطل أمر الإمام لم يبطل الغزو والحج، وأن الإمامة لا تجوز إلا بشروطها: النسب، والإسلام، والحماية، والبيت والمحتد، وحفظ الشريعة، وعلم الأحكام، وصحة التنفيذ، والتقوى وإتيان الطاعة، وضبط أموال المسلمين، فإن شهد له بذلك أهل الحل والعقد من علماء المسلمين وثقاتهم، أو أخذ هو ذلك لنفسه ثم رضيه المسلمون جاز له ذلك، وأنه لا يجوز الخروج على إمام ومن خرج على إمام قتل الثاني) انظر اعتقاد الإمام أحمد (ص 305).
وقد سئل عن خلافة علي فقال (أصحاب رسول الله رضوا به واجتمعوا عليه، وكان بعضهم يحضر وعلي يقيم الحدود فلم ينكر ذاك، وكانوا يسمونه خليفة، ويخطب ويقسم الغنائم فلم ينكروا ذلك، قال حنبل قلت له خلافة علي ثابتة؟ فقال سبحان الله يقيم علي رحمه الله الحدود، ويقطع، ويأخذ الصدقة ويقسمها .. نعم خليفة رضيه أصحاب رسول الله، وصلوا خلفه، وغزوا معه وجاهدوا وحجوا، وكانوا يسمونه أمير المؤمنين راضين بذلك غير منكرين، فنحن تبع لهم ونحن نرجو من الله الثواب باتباعنا لهم إن شاء الله مع ما أمرنا الله به والرسول) السنة للخلال (2/413).
فيستفاد من هذه النصوص عن أحمد ـ عند أصحابه على اختلافهم في بعضها إلا أنها صحيحة عنه من حيث الجملة ـ جملة أصول منها:
1 ـ أن موضوع الخلافة والإمامة من أصول أهل السنة والجماعة ولها أحكامها الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ومن لم يقل بها فليس من أهل السنة.
2 ـ وأن الخلافة والإمامة تثبت في حالتين :
الأولى : حال السعة والاختيار وهي الحال الطبيعية كما كان عليه الصحابة حيث الشوكة للأمة تختار من تشاء، وفي هذه الحال لا يتم عقد الإمامة ولا اختيار السلطة إلا بالبيعة والشورى والرضا من الأمة ابتداء، ويشترط فيها أن يكون الإمام عدلا قادرا على سياسة شئون الأمة كفؤا لها، ويعقدها له أهل الحل والعقد العدول الثقات نيابة عن الأمة.
الثانية : حال الضيق والاضطرار وهي الأوضاع الاستثنائية حين تقع الفتن وتعجز الأمة وتضطرب أحوالها فهنا من تصدى للإمامة واستطاع جمع كلمة الأمة ولم شعثها وتوحيد شملها حتى استقر له الأمر ورضيت به الأمة خليفة عليها حتى صار لا ينازعه أحد فيها فهو إمام تجب له الطاعة، إذا تحقق به الرضا انتهاء.
فاشترط رضا الأمة في الحال الطبيعية ابتداء، وفي الحال الاستثنائية انتهاء.
3 ـ وأنه لا يكون للأمة إلا أمام واحد فمن جاء ينازعه ـ وقد اجتمعت عليه الأمة ورضيت به ـ ليفرق وحدتها ويشق جماعتها فيجب قتاله.
4 ـ وأن مهمة الإمام إظهار الإسلام وتنفيذ الأحكام وحماية البيضة وإقامة الجهاد ودفع العدو وقسم الفيء..الخ.
5 ـ وأنه إن بطل أمر الإمامة وتعطلت الخلافة ـ إما لفتن داخلية بين المسلمين أو موت الخليفة ولم تجتمع الأمة على أحد بعده ـ فإن الجهاد ماض لا يتعطل ولا يفوت وكذا الحج وغيرهما من الأحكام فيقوم بها من استطاع من المسلمين من أهل الشوكة والقدرة، إذ المقصود من نصب الإمام إقامة الأحكام، فإن تعذر نصبه، لم تتعطل إقامتها على من قدر عليها.
وقد عبر شيخ الإسلام ابن تيمية عن ضرورة الإمامة والخلافة لقيام الدين وظهور الإسلام وتنفيذ الأحكام بقوله (يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين؛ بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا باجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولابد لهم عند الاجتماع من رأس… فأوجب ـ الشارع ـ تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم. وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة، فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله؛ فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال بها..وإن انفرد السلطان عن الدين، أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس). انظر مجموع الفتاوى (28/390-394و391).
والمقصود هنا بالإمامة والولاية والإمارة عند أهل السنة والجماعة أي الإمامة والولاية الشرعية، التي هي رئاسة سياسية عامة نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة أحكام الإسلام، إذ الإمام الشرعي الذي طاعته من طاعة الله ورسوله هو الذي ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة الأمة وسياسة شئونها وفق حكم الكتاب والسنة، وليس كل ذي سلطان مهما كان خارجا عن أحكام الشرع كما يتصور الجاهلون!
قال ابن حزم في الفصل (4/87) (اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة والخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد للإمام العادل، يقيم فيهم أحكام الله، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم).
وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي ـ كما في الشرح الكبير 2/51 ـ في اختصاص الخليفة ببعض الأحكام وتعليل ذلك بأنه نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مقامه في أمته (يجوز للخليفة دون بقية الأئمة، فانه قال في رواية المروزي ليس هذا لأحد إلا الخليفة، وذلك لأن رتبة الخلافة تفضل رتبة سائر الأئمة فلا يلحق بها غيرها، وكان ذلك للخليفة، وخليفة النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مقامه).
وكما قال الشوكاني (فهذه الألفاظ تدل على أن المراد الإمامة الإسلامية، وأما أمر الجاهلية فقد انقرض… ومعنى الخلافة معنى الإمامة في عرف الشرع، وهؤلاء الذين نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافتهم هم الخلفاء الأربعة، وليس المراد بالإمامة هنا هو المعنى اللغوي الشامل لكل من يأتم به الناس ويتبعونه على أي صفة كان بل المراد الإمامة الشرعية) (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 1/937).
وهذا الأصل المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة وهو وجوب نصب الخليفة، وأن يتم عقد البيعة له بالشورى والرضا والاختيار بلا إكراه ولا إجبار، وأنه يحرم تفرق الأمة وتعدد الأئمة..الخ كل ذلك قائم على أصل آخر قطعي وهو ثبوت إجماع الصحابة على خلافة الخلفاء الراشدين، وأنها ثبتت لهم بالشورى والاختيار لا بالنص ولا الإجبار، وأنهم حافظوا على الخلافة ووحدة الأمة وإقامة الملة..الخ
قال الإمام الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث (ص24) (ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، باختيار الصحابة إياه، ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه، ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر، ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن بيعة من بايعه من البدريين).
وليس مقصود أهل الحديث بالنص على هذا الاعتقاد إثبات هذه القضايا تاريخيا، بل المقصود إثبات أن هذه هي السنة وما كان عليه سلف الأمة في باب الإمامة، وأن النظام السياسي في الإسلام هو الخلافة لا الملك العضوض ولا الجبرية ولا الإمامة بالنص كما يدعيه الإمامية، وأن الأمر فيها شورى واختيار ورضا وبيعة من الأمة للإمام، وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على من جاء بعدهم الاهتداء بهديهم واتباع سننهم كما قال (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) وقد أجمع الصحابة على قول عمر ـ كما في صحيح البخاري ـ (من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا بيعة له ولا للذي بايعه تغرة أن يقتلا).
وهذه القضية هي أول قضية حدثت في الإسلام كما قال الإمام أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين (1/2) عن اختلاف أهل الإسلام (فصاروا فرقا متباينين، وأحزابا متشتتين، إلا إن الإسلام يجمعهم، ويشتمل عليهم، وأول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم اختلافهم في الإمامة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبضه الله عز وجل ونقله إلى جنته ودار كرامته اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعده بمدينة الرسول وأرادوا عقد الإمامة لسعد بن عبادة وبلغ ذلك أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما فقصدا نحو مجتمع الأنصار في رجال من المهاجرين…ثم بايعوا أبا بكر رضوان الله عليه واجتمعوا على إمامته، واتفقوا على خلافته، وانقادوا لطاعته، فقاتل أهل الردة على ارتدادهم، كما قاتلهم رسول الله على كفرهم، فأظهره الله عز وجل عليهم أجمعين، ونصره على جملة المرتدين، وعاد الناس إلى الإسلام أجمعين، وأوضح الله به الحق المبين، وكان الاختلاف بعد الرسول في الإمامة، ولم يحدث خلاف غيره في حياة أبي بكر رضوان الله عليه وأيام عمر إلى أن ولى عثمان بن عفان رضوان الله عليه).
قال الشهرستاني في كتاب الملل والنحل(1/20) (الخلاف الخامس: في الإمامة، وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان).
وقال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق (1/340) عن قول أهل السنة والجماعة بشأن الخلافة والإمامة (وقالوا في الركن الثاني عشر المضاف إلى الخلافة والإمامة: إن الإمامة فرض واجب على الأمة، لأجل إقامة الإمام ينصب لهم القضاة والأمناء، ويضبط ثغورهم، ويغزى جيوشهم، ويقسم الفيء بينهم، وينتصف لمظلومهم من ظالمهم.
وقالوا ـ أي أهل السنة والجماعة ـ بأن طريق عقد الإمامة للإمام في هذه الأمة الاختيار بالاجتهاد.
وقالوا من شرط الإمام العلم والعدالة والسياسة، وأوجبوا من العلم له مقدار ما يصير به من أهل الاجتهاد في الإحكام الشرعية، وأوجبوا من عدالته أن يكون ممن يجوز حكم الحاكم بشهادته، وذلك بأن يكون عدلا في دينه، مصلحا لماله وحاله، غير مرتكب لكبيرة، ولا مصر على صغيرة، ولا تارك للمروءة في جل أسبابه، وليس من شرطه العصمة من الذنوب كلها خلاف قول من زعم من الإمامية أن الإمام يكون معصوما من الذنوب كلها ..
وقالوا ـ أي أهل السنة والجماعة ـ إن الإمامة تنعقد بمن يعقدها لمن يصلح للإمامة إذا كان العاقد من أهل الاجتهاد والعدالة.
وقالوا لا تصلح الإمامة إلا لواحد في جميع أرض الإسلام، إلا أن يكون بين الصقعين حاجز من بحر أو عدو لا يطاق، ولم يقدر أهل كل واحد من الصقعين على نصرة أهل الصقع الآخر، فحينئذ يجوز لأهل صقع عقد الإمامة لواحد يصلح لها منهم).
وقال عبد القاهر البغدادي أيضا في أصول الدين (ص 274) عن أهل السنة والجماعة أنهم لا يجوزون أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد واجبي الطاعة ثم رد على من جوزها من الكرامية فقال (فيا عجبا من طاعة واجبة على خلاف السنة! ولو جاز إمامان وأكثر لجاز أن ينفرد كل ذي صلاح بالإمامة فيكون كل واحد منهم بولاية محلته وعشيرته وهذا يؤدي إلى سقوط فرض الإمامة من أصلها)!
وقال ابن حزم في كتاب الدرة في الاعتقاد (ص 374) (لا يجوز أن يكون في الناس إمامان ألبتة، ولا يحل أن يكون في شرق الأرض وغربها إلا إمام واحد، وهذا إجماع الأمة وقال تعالى {ولا تنازعوا} وقال {ولا تفرقوا} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما)).
وما حذر منه عبد القاهر هو ما تحقق فعلا على أرض الواقع فلما فرضت الحملة الصليبية على العالم الإسلامي هذا الواقع الجديد، وأقامت دويلات الطوائف على أنقاض الخلافة العثمانية، وتخلى أهل السنة وهم عموم الأمة تحت ضغط الواقع عن إيمانهم بفرض إقامة الخلافة والإمامة الشرعية التي تعبر عن وحدة الأمة، جاز قيام عشرات الدويلات الضعيفة، وصار الطريق مفتوحا لتجزئة كل دويلة وفق هذا القول المبتدع المخترع المصادم لقطعيات القرآن والسنة وإجماع أهل السنة وسلف الأمة!
وصارت الأمم الأخرى على اختلاف أديانها وقومياتها تنزع إلى الوحدة والاتحاد بضرورة المصلحة وحكم العقل بينما صار المسلمون يروجون باسم الإسلام والسنة لدويلات الطوائف الصليبية ويضفون عليها الشرعية باسم الوطنية الإسلامية مع أنها ليست سوى قواعد عسكرية للحملة الاستعمارية منذ سقوط الخلافة العثمانية إلى اليوم!
وهذا الأصل في كون الإمامة والخلافة تثبت بالشورى والاختيار يوافق عليه أهلَ السنة والجماعة كلُ طوائف الإسلام كالمعتزلة والخوارج والشيعة الزيدية ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة الإمامية.
قال الشهرستاني (1/77) (والجبائي وأبو هاشم ـ وهم أئمة المعتزلة ـ قد وافقا أهل السنة في الإمامة وأنها بالاختيار، وأن الصحابة مترتبون في الفضل ترتبهم في الإمامة).
وكذا أصل كون الإمام والخليفة لا يكون إلا واحدا هو قائم على أصل وحدة الأمة وحرمة تفرقها واختلافها كما قال تعالى {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} وقوله {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا} ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على هذا الأصل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال التحليل (3/143) (ومعاوية لم يدع الخلافة; ولم يبايع له بها حين قاتل عليا, ولم يقاتل على أنه خليفة , ولا أنه يستحق الخلافة…بل لما رأى علي رضي الله عنه وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته ومبايعته, إذ لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد, وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب, وهم أهل شوكة رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب, فتحصل الطاعة).
وكل ما سبق ذكره من أصول أهل السنة والجماعة العقائدية السياسية في باب الإمامة قال به المتأخرون ونقلوا عليه الإجماع قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: (وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة) وقال (واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا).
ونقل الإجماع عليه القرطبي وقال (هذه الآية ـ إني جاعل في الأرض خليفة ـ أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة .. فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين) كما أجمعوا على أنها تنعقد بالشورى والاختيار …الخ.
كما أنها أحكام معللة معقول المعنى فليست الإمامة مقصودة لذاتها وإنما لتقوم بما أوجب الله على الأمة القيام به ابتداء كالأمر بالمعروف وإقامة العدل والقسط كما قال الجويني في غياث الأمم (ص22) عن الخلافة بأنها(رياسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة، في مهمات الدين والدنيا، مهمتها حفظ الحوزة، ورعاية الرعية، وإقامة الدعوة بالحجة والسيف، وكف الحيف والخيف، والانتصاف للمظلومين من الظالمين، واستيفاء الحقوق من الممتنعين، وإيفاؤها على المستحقين).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يقرر كلام أهل السنة في باب الإمامة وأنها تثبت ببيعة الجمهور والأكثر ويرد على المتكلمين الذين قالوا بأنها تنعقد ببيعة رجل واحد كما في بيعة عمر لأبي بكر يوم السقيفة فقال (بعض أهل الكلام يقولون: إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة، كما قال بعضهم: تنعقد ببيعة اثنين، وقال بعضهم: تنعقد ببيعة واحد، فليست هذه أقوال أئمة السنة، بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إمامًا …فمتى صار قادرًا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره، فهو ذو سلطان مطاع، إذا أمر بطاعة الله، ولهذا قال أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار: (أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله إلى أن قال: (ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فدفع الصدقات إليه جائز .. وقال في رواية إسحاق بن منصور، وقد سئل عن حديث النبي (: “من مات وليس له إمام، مات ميتة جاهلية”، ما معناه: فقال: تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون، كلهم يقول: هذا إمام؛ فهذا معناه) منهاج السنة (1/526-229).
وقال أيضا عن بيعة أبي بكر وأنها تمت ببيعة الجمهور والأكثر مع وجود أقلية معارضة (ولو قُدِّر أن عمر وطائفة معه بايعوه، وامتنع سائر الصحابة عن البيعة، لم يصر إماماً بذلك، وإنما صار ـ أبو بكر ـ إماماً بمبايعة جمهور الصحابة، والذين هم أهل القدرة والشوكة، ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة، لأن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية، فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح الإمامة، وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك، فمن قال إنه يصبر إمامًا بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة، وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة، فقد غلط؛ كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو الاثنين والعشرة يضر، فقد غلط) منهاج السنة(1/530-531).
وكذا احتج بأن عمر لم يصبح خليفة بمجرد عهد أبي بكر له وترشيحه للخلافة بعده، وإنما صار إماما بعد وفاة أبي بكر ببيعة الصحابة له برضاهم وطوعهم، ولو لم يبايعوه لما صار خليفة عليهم بالعهد حيث قال عن خلافة عمر (وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه، ولو قُدِّر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما).
وكذلك عثمان لم يصبح إماما وخليفة بمجرد ترشيح عمر له في الستة، ولا برضا الخمسة الآخرين به، وإنما صار خليفة للمسلمين بعد أن عقدها الصحابة له في المسجد بالبيعة العامة، حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية (عثمان لم يصر إماما باختيار بعضهم بل بمبايعة الناس له، وجميع المسلمين بايعوا عثمان لم يتخلف عن بيعته أحد).
وبناء على إجماع الصحابة على هذه السنن في باب الإمامة وسياسة الأمة أجمع أهل السنة والجماعة عليها بعدهم، وصارت شعارا لهم، يرون أن هذا هو الإسلام والسنة والحق والدين والواجب في باب الإمامة، فليست القضية عندهم مجرد عقيدة تاريخية لدفع الطعن عن الخلفاء الراشدين لا أثر لها غير ذلك في واقع الأمة السياسي ـ كما يتوهم الجاهلون، وله يروجون ـ وإنما هي عقيدة شرعية سياسية قائمة على أن ما فعله الصحابة في هذا الباب هو الحق والدين والإسلام كما ثبت بالنص والإجماع، وأن الأمر في الإمامة هو الخلافة ـ لا الملك العضوض ولا الملك الجبري ولا ولاية الفقيه ولا الإمام المعصوم ولا المهدي المنتظر الغائب في سردابه ـ وأنها قائمة على الشورى والرضا والاختيار والاجتهاد كما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنه، وأنه لا يسوغ فيها التعدد، ولا التفرق، حيث لم يقبل بذلك أبو بكر حين قاتل المرتدين، ولا علي حين قاتل البغاة والمتأولين لوضوح هذا الأصل وهو وحدة الأمة ووحدة الإمامة والخلافة.
لقد تم تهميش ذلك كله حتى صار أدعياء السنة اليوم لا هم لهم في شأن الصحابة إلا عقد مجالس الثناء والدعاء ـ كمجالس الشيعة في العزاء والبكاء ـ أما إحياء نهجهم وسننهم في باب الإمامة، والاقتداء بهم، ودعوة الأمة إليه، والجهاد في سبيل إحيائه ولو بالكلمة والرأي ـ كما جاء بذلك الأمر النبوي (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور) ـ فكل ذلك صار عندهم نسيا منسيا، بل هم اليوم أشد الناس دفاعا عن المحدثات والملك العضوض والملك الجبري، بل وعبادة الطاغوت والرضا بالتحاكم إليه والدعاء له بالبقاء والرفاء! وهم اليوم دهاقنة هذا الواقع وسماسرة الطغاة، إلا من رحم الله منهم وقليل ما هم!
لقد صارت هذا الأصول العقائدية عند أهل السنة والجماعة بالأمس العقيدة الغائبة والفريضة المهجورة اليوم، وأصبحت تاريخا وقصصا يروى عند أدعياء السنة اليوم، بل تجاوزوا ذلك حتى صار من يتحدث بموضوع الخلافة وإقامتها على أصولها في نظرهم اليوم أحد رجلين إما خارجي وإما حالم!
مع أن الخلافة كنظام سياسي هي التي حكمت العالم الإسلامي وحققت له السيادة على المسرح الدولي مدة ثلاثة عشر قرنا حتى أسقطته الحملة الاستعمارية الصليبية في الحرب العالمية الأولى! ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر بعودتها بقوله (ثم تعود خلافة على منهاج النبوة) كما بشر بفتح روما بعد فتح القسطنطينية!
فلا هؤلاء الأدعياء قاموا بالأمر ولا آمنوا بالخبر ثم لا يترددن أن يرفعوا شعار أهل السنة والجماعة ويدعون عليه الوصاية وهم أول من كفروا بأصول أهل السنة ونقضوها، وردوا النصوص القطعية وعارضوها، فلا تكاد تجد في خطابهم العام حديثا عن الخلافة، ولا عن حق الأمة في الشورى والاختيار، ولا عن العدل بالقضية والقسم بالسوية، ولا عن وجوب الوحدة ورفض القطرية والوطنية، التي فرضها مشروع سايكس بيكو على الأمة، ولا عن وجوب إقامة الجهاد وأنه لا تتعطل بذلك الأحكام حتى لو بطل شأن الإمامة وسقطت الخلافة كما جرى بعد الحرب الاستعمارية الصليبية وللحديث بقية!
5 – الأصول السياسية والعقيدة الغائبة (2)
بقلم د. حاكم المطيري
ثبت كما سبق ذكره من نصوص عن أئمة أهل السنة بأن قضية الخلافة والإمامة مع كونها قضية سياسية هي أيضا من أصول الدين والاعتقاد عندهم، بل هي من أركان الدين الذي لا يقوم دين الإسلام إلا بها كما نص عليه ابن حزم والقرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية، وأن من لم يؤمن بها فليس من أهل السنة والجماعة، وقد خالف أهل السنة في شأن الخلافة وفي بعض فروعها طوائف وفرق أخرى ومن ذلك:
1 ـ القول بالخلافة ـ كنظام سياسي وكرئاسة عامة على الأمة بانتخاب الأمة بالشورى والرضا والاختيار نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ هو قول أهل السنة قاطبة ووافقهم عليه المعتزلة والخوارج والمرجئة والشيعة الزيدية ولم يخالف إلا الشيعة الإمامية الذين قالوا بالنص والعصمة ونفوا أن تكون الإمامة بالشورى والاجتهاد، قال عبد القاهر البغدادي في أصول الدين (ص279) (واختلفوا في طريق ثبوت الإمامة من نص أو اختيار: فقال الجمهور الأعظم من أصحابنا ـ يعني أهل السنة ـ ومن المعتزلة والخوارج أن طريق ثبوتها الاختيار من الأمة باجتهاد أهل الاجتهاد منهم واختيارهم من يصلح لها، وزعمت الإمامية أن طريقها النص من الله على لسان رسوله ثم نص الإمام على الإمام بعده).
2 ـ وقال أئمة أهل السنة والجماعة بأنه لا تنعقد الإمامة إلا بالبيعة من كافة الأمة كما هي بيعة عمر وعثمان بن عفان، أو من جمهورهم كما هي بيعة أبي بكر وعلي، وخالف بعض المتكلمين المتأخرين فقالوا تنعقد ببيعة الواحد والاثنين والعدد القليل، ورد شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم قولهم ونقل عن أئمة أهل السنة أنها لا تنعقد إلا ببيعة الجمهور الذين تتحقق بهم الشوكة والقدرة والطاعة، قال ابن تيمية ـ في منهاج السنة(1/530-531) ـ(بعض أهل الكلام يقولون: إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة، كما قال بعضهم: تنعقد ببيعة اثنين، وقال بعضهم: تنعقد ببيعة واحد، فليست هذه أقوال أئمة السنة، بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة ..ولو قُدِّر أن عمر وطائفة معه بايعوه، وامتنع سائر الصحابة عن البيعة، لم يصر إماماً بذلك، وإنما صار ـ أبو بكر ـ إماماً بمبايعة جمهور الصحابة، والذين هم أهل القدرة والشوكة، ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة، لأن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية، فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح الإمامة، وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك، فمن قال إنه يصير إمامًا بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة، وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة، فقد غلط؛ كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو الاثنين والعشرة يضر، فقد غلط) ثم نص على بيعة عمر وعثمان وعلي وأنها كلها تمت بمبايعة الجميع أو الجمهور وهم الأكثرية.
فهذا مذهب أئمة أهل السنة والجماعة فهم يرون الإمامة والسلطة تقوم على أساس عقد اتفاق بين الأمة والإمام بالبيعة بعد الشورى والرضا، كوكيل عن الأمة، وأنه لا بد أن تكون بموافقة الجميع ورضاهم، أو بموافقة الجمهور والأكثرية، وهو معنى قوله تعالى {وأمرهم شورى بينهم} وقول عمر (الإمارة شورى بين المسلمين)، وقد تحققت بيعة الإجماع لعمر وعثمان حيث لم يخالف فيهما أحد، وتحققت بيعة الجمهور والأكثرية لأبي بكر وعلي رضي الله عنهم جميعا.
3 ـ وقال أهل السنة والجماعة بأن الإمامة والخلافة والإمارة لا يدخلها التوارث وليست الإمامة والسلطة من باب الحقوق الخاصة التي يصلح توريثها، بل نقل ابن حزم إجماع الأمة على ذلك فقال الفصل (4/130) (ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث فيها).
4 ـ وقال أهل السنة والجماعة قاطبة وهو إجماع عند الفقهاء بأنه لا يجوز تعدد الأئمة، ولا يكون للأمة إلا إمام واحد واجب الطاعة ـ كما سبق ذكره ـ قال ابن عبد البر في الاستذكار (3/190) (الخليفة لا يحل إلا أن يكون واحدا في المسلمين كلهم)، وقال ابن حزم في المحلى (9/360) (ولا يحل أن يكون في الدنيا إلا أمام واحد، والأمر للأول البيعة).
فإن تعددوا فالبيعة للأول منهما، وإمامة الثاني باطلة، فإن لم تجتمع الأمة على واحد فهو زمن فتنة وفرقة لا تبذل فيه البيعة لأحد، ولا تجب على الأمة طاعة أي منهما، كما ثبت عن ابن عمر (والله لا أبذل بيعتي في فرقة، ولا أمنعها من جماعة) مع أنه كان في المدينة وكانت تحت ولاية ابن الزبير فأبى أن يبايعه حتى تجتمع الأمة على إمام واحد، وخالف الكرامية فقالوا بأنه يجوز ذلك لأن علي بن أبي طالب كان واجب الطاعة في العراق، ومعاوية واجب الطاعة في الشام، ورد عليهم أهل السنة وأبطلوا حججهم، لمعارضتها لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، قال عبد القاهر البغدادي في أصول الدين (ص 274) عن أهل السنة والجماعة أنهم لا يجوزون أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد واجبي الطاعة، ثم رد على من جوزها من الكرامية فقال (فيا عجبا من طاعة واجبة على خلاف السنة! ولو جاز إمامان وأكثر لجاز أن ينفرد كل ذي صلاح بالإمامة فيكون كل واحد منهم بولاية محلته وعشيرته وهذا يؤدي إلى سقوط فرض الإمامة من أصلها) أي يبطل أصل الخلافة ووحدة السلطة والدولة، ويبطل أصل الجماعة ووحدة الأمة، وهذا مضاد لقوله تعالى{ولا تنازعوا} وقوله {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} وجاء في الأحاديث الصحيحة المتواترة الأمر بلزوم الجماعة، وفسر الصحابة قوله تعالى {واعتصموا بحبل الله جميعا} بأن المراد بحبل الله هو الجماعة، وقال بعضهم هو القرآن، وكلا القولين صحيح فإن القرآن حبل الله، وقد أمر بالجماعة وحرم الفرقة والاختلاف والتنازع قال ابن عبد البر في التمهيد (21/272) في شرح حديث (إن الله يرضى لكم ثلاثا.. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) (وفيه الحض على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف، وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان: أحدهما كتاب الله، والآخر الجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، وهو عندي معنى متداخل متقارب، لأن كتاب الله يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، قال الله عز وجل {وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا} الآية وقال {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا} .. والظاهر في حديث سهيل وقوله (وأن تعتصموا بحبل الله جميعا) أنه أراد الجماعة، وهو أشبه بسياق الحديث) وكذا قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (21/278) (وأما قوله صلى الله عليه وسلم “ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم” أو “هي من ورائهم محيطة” فمعناه عند أهل العلم أن أهل الجماعة في مصر من أمصار المسلمين إذا مات إمامهم، ولم يكن لهم إمام فأقام أهل ذلك المصر ،الذي هو حضرة الإمام وموضعه، إماما لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه، فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام، إذا لم يكن معلنا بالفسق والفساد معروفا بذلك، لأنها دعوة محيطة بهم يجب إجابتها ولا يسع أحدا التخلف عنها لما في إقامة إمامين من اختلاف الكلمة وفساد ذات البين).
وقد خالف أصل الوحدة والجماعة أهل الأهواء والبدع الذين فارقوا جماعة المسلمين، وهجروا الجمع والجماعات في المساجد، وتركوا الجهاد في سبيل الله، واشتغلوا في إكفار المسلمين، وتضليلهم واستباحة قتالهم، كما جاء وصفهم في الصحيح(يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام).
وجاء في الحديث المرفوع (وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن الجماعة، والسمع، والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه، إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من حثاء جهنم” قال رجل وإن صام وصلى قال “وإن صام وصلى أدعو بدعوى الله الذي سماكم المؤمنين عباد الله”).
وقد صارت هذه الأوامر الإلهية والوصايا النبوية من أصول أهل السنة والجماعة التي تميزوا بها عن كل الطوائف الأخرى، وكان لها الأثر في حفظ وحدة الأمة من جهة، وبقاء الخلافة مدة ثلاثة عشر قرنا قائمة على الجهاد لم يتعطل إلا في هذا العصر من جهة أخرى، وكما قال الأوزاعي (كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، وإتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله).
فمن أجاز افتراق الأمة إلى دويلات طوائف كما هو الحال اليوم، وأضفى على افتراقها وعلى دويلاتها الشرعية الدينية، أو تصور أن كل شعب في دولة هو جماعة للمسلمين، فقد خالف إجماع أهل السنة القطعي الذين لا يقرون الافتراق ولا يعترفون إلا بالخلافة الواحدة والأمة الواحدة إذ هذا من التوحيد كما قال تعالى {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا}.
5 ـ وأجمع أهل السنة والجماعة والمسلمون كافة على أنه يشترط في الإمام شروط يجب توفرها فيه ليصلح لها، وذلك أن يكون مسلما عدلا كفؤا قادرا على القيام بأعبائها، وأجمعوا على أن الكافر والظالم والفاسق لا يكون إماما لقوله تعالى {إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهدي الظالمين}.
قال القرطبي في تفسير هذه الآية (استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يجب أن يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينازعوا الأمر أهله على ما تقدم من القول فيه، فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل لقوله تعالى {لا ينال عهدي الظالمين }، ولهذا خرج ابن الزبير والحسن بن علي رضي الله عنهم، وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجاج، وأخرج أهل المدينة بني أمية وقاموا عليهم، فكانت الحرة التي أوقعها بهم مسلم بن عقبة.
قال ابن خويز منداد:وكل من كان ظالما لم يكن نبيا، ولا خليفة، ولا حاكما، ولا مفتيا، ولا إمام صلاة، ولا يقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة، ولا تقبل شهادته في الأحكام، غير أنه لا يعزل بفسقه حتى يعزله أهل الحل والعقد، وما تقدم من أحكامه موافقا للصواب ماض غير منقوض، وقد نص مالك على هذا).
وقال ابن كثير في تفسيره للآية(قال سفيان بن عيينة لا يكون الظالم إماما).([1])
كما ذكر عبد القاهر في أصول الدين (ص 277) الشروط الواجبة للإمامة عند أهل السنة (وهي الأول العلم ..والثاني العدالة والورع وأقل ما يجب له أن يكون ممن تجوز قبول شهادته، والثالث الاهتداء إلى وجوه السياسة وحسن التدبير..الخ ).
كما أجمعوا على أنه إن كفر خرج من حكم الإمامة ووجب قتاله وجهاده لقوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} وجاء في حديث البيعة المتواتر (إلا أن تروا كفرا بواحا) وللحديث الصحيح (أفلا ننابذهم السيف؟ قال لا ما صلوا).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (4/85) (الدليل الرابع ـ على كفر من ترك الصلاة ـ إن هذا كله محمول على من يؤخرها عن وقتها وينوي قضاءها، أو يحدث به نفسه كالأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت، وكما فسره ابن مسعود و بين إن تأخيرها عن وقتها من الكبائر، وإن تركها بالكلية كفر، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالكف عن قتال هؤلاء الأئمة ما صلوا، فعلم إنهم لو تركوا الصلاة لقوتلوا، والإمام لا يجوز قتاله حتى يكفر، وإلا فبمجرد الفسق لا يجوز قتاله، ولو جاز قتاله بذلك لقوتل على تفويتها، كما يقاتل على تركها، وهذا دليل مستقل في المسألة).
وقال ابن حزم في الشروط التي لا تصح الإمامة إلا بها في الفصل:
(شروط الإمامة التي لا تجوز الإمامة لغير من هن فيه:
أولا ـ أن يكون مسلما لأن الله تعالى يقول (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)، والخلافة أعظم السبيل.
ثانيا ـ وأن يكون متقدما لأمره، عالما بما يلزمه من فرائض الدين، متقيا لله تعالى بالجملة، غير معلن بالفساد في الأرض لقول الله تعالى{وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، لأن من قدم من لا يتقي الله عز وجل، معلنا بالفساد في الأرض، غير مأمون، أو من لا ينفذ أمرا، أو من لا يدري شيئا من دينه، فقد أعان على الإثم والعدوان ولم يعن على البر والتقوى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)، وقال عليه السلام يا أبا ذر (إنك ضعيف لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم)، وقال تعالى{فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل}، فصح أن السفيه والضعيف، ومن لا يقدر على شيء، فلا بد له من ولي، ومن لا بد له من ولي فلا يجوز أن يكون وليا للمسلمين، فصح أن ولاية من لم يستكمل هذه الشروط باطل لا يجوز ولا ينعقد أصلا).([2])
وقال القاضي عياض: (أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها.. فلو طرأ عليه كفر أو تغيير للشرع أو بدعة ـ أي مكفرة ـ خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها).([3])
وقال ابن حجر: (ينعزل بالكفر إجماعا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك).([4])
وقال ابن بطال(إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها).([5])
6 ـ وقال أهل السنة والجماعة قاطبة بوجوب اتباع سنن الخلفاء الراشدين في باب الإمامة وسياسة الأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور) وقوله (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر) وقال (خلافة النبوة ثلاثون سنة) وكلها توجب الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم في سنن الإمامة وسياسة الأمة، ونبذ كل سنة تخالف سنتهم في هذا الباب، ومن ذلك سنن الملك العضوض، والملك الجبري، لحديث (وإياكم ومحدثات الأمور) وبينها حديث (ثم يكون ملكا عضوضا ثم ملكا جبريا ثم تعود خلافة على منهاج النبوة).
وقد وافق أهل السنة والجماعة على وجوب الاقتداء بالشيخين أبي بكر وعمر عامة الطوائف، كالمرجئة والمعتزلة والخوارج والشيعة الزيدية، إلا الشيعة الإمامية الذين قالوا بالنص، وأما سنن عثمان وعلي فاختلفت فيها الفرق، فالشيعة طعنت بعثمان، والخوارج طعنت بعلي، والمعتزلة فسقوا أهل الجمل وصفين، وهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق، وأجمعوا على أنهم جميعا خلفاء راشدون مهديون اختارتهم الأمة بالشورى والرضا، وليسوا معصومين، ولهذا كان لزم سنة الخلفاء الراشدين في باب سياسة الأمة وشئون الدولة من أصول أهل السنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (3/157) (ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول الله باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله حيث قال: “عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة”).
وقال في الفتاوى (4/108) (فسنة خلفائه الراشدين: هي مما أمر الله به ورسوله).
وقال أيضا في الفتاوى(31/37) (ففي هذا الحديث، أمر المسلمين باتباع سنته، وسنة الخلفاء الراشدين، وبين أن المحدثات التي هي البدع التي نهى عنها، ما خالف ذلك).
وقال أيضا (24/209) (فمن تمسك بسنة الخلفاء الراشدين فقد أطاع الله ورسوله).
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى أيضا (35/22) في بيان وجوب الاقتداء بالشيخين ولزوم سنن الخلفاء الراشدين كما في حديث (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) وحديث (اقتدوا بالذين من بعدي من بعدي أبي بكر وعمر) (فهذا أمر وتحضيض على لزوم سنة الخلفاء، وأمر بالاستمساك بها، وتحذير من المحدثات المخالفة لها، وهذا الأمر منه، والنهي: دليل بَيِّن في الوجوب، ثم اختص من ذلك قوله: “اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر، وعمر” فهذان أمر بالاقتداء بهما، والخلفاء الراشدون أمر بلزوم سنتهم، وفي هذا تخصيص للشيخين من وجهين:
أحدها: أن (السنة) ما سنوه للناس، وأما (القدوة) فيدخل فيها الاقتداء بهما فيما فعلاه مما لم يجعلوه سنة.
الثاني: أن السنة أضافها إلى الخلفاء؛ لا إلى كل منهم، فقد يقال: إن ذلك فيما اتفقوا عليه؛ دون ما انفرد به بعضهم، وأما القدوة فعيَّن القدوة بهذا، وبهذا، وفي هذا الوجه نظر، ويستفاد من هذا، أن ما فعله عثمان وعلي من الاجتهاد الذي سبقهما بما هو أفضل منه أبو بكر وعمر ودلت النصوص، وموافقة جمهور الأمة على رجحانه وكان سببه افتراق الأمة: لا يؤمر بالاقتداء بهما فيه؛ إذ ليس ذلك من سنة الخلفاء؛ وذلك أن أبا بكر وعمر ساسا الأمة بالرغبة والرهبة، وسلما من التأويل في الدماء، والأموال، وعثمان رضي الله عنه غلب الرغبة، وتأول في الأموال، وعلي غلب الرهبة، وتأول في الدماء، و أبو بكر وعمر كمل زهدهما في المال، والرياسة، وعثمان كمل زهده في الرياسة، وعلي كمل زهده في المال…).
وقال أيضا في الفتاوى 32/347 إن (الخلفاء الراشدين إذا خالفهم غيرهم كان قولهم هو الراجح؛ لأن النبي (قال: “عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة”).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (28/493) عن تقرر ذلك في أصول أحمد بن حنبل الفقهية (وقد تنازع العلماء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في إجماع الخلفاء، وفي إجماع العترة هل هو حجة يجب اتباعها؟ والصحيح أن كلاهما حجة، فإن النبي قال “عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ” وهذا حديث صحيح في السنن، وقال “إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض” رواه الترمذي وحسنه، وفيه نظر، وكذلك إجماع أهل المدينة النبوية في زمن الخلفاء الراشدين هو بهذه المنزلة).
وقال أيضا في الفتاوى (12/235) (فالواجب على المسلم أن يلزم سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين، والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه، إن أمكنه أن يفصل النِّزاع بالعلم والعدل وإلا استمسك بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا، فإن مواضع التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تهوى الأنفس {وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى}).
7 ـ ولا يرى أهل السنة والجماعة شرعية أي ولاية ولا أي نظام حكم إلا الخلافة على أصولها التي أجمع عليها الصحابة لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الأمر المشروع في الإسلام بعد النبوة هو الخلافة كما في الصحيح(كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر؛ قالوا فما تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول؛ ثم أعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم) وقال (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما) وقال (لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش) وقال (تكون النبوة ثم خلافة نبوة ثم خلافة رحمة..) وأمر عند حدوث الفتن والافتراق (إن كان لله في الأرض خليفة فالزمه) وقال (إلزم جماعة المسلمين وإمامهم) فإن لم يكن لهم جماعة واحدة ولا إمامة واحدة (فاعتزل تلك الفرق كلها).
فالخلافة هي النظام السياسي الوحيد المشروع عند أهل السنة والجماعة وعليه أجمعوا كما أجمع عليها الصحابة والخلفاء الراشدون، وهو النظام السياسي والولاية الشرعية التي تعبر عن وحدة الأمة ووحدة الدار ووحدة الدولة ووحدة المرجعية وحاكمية الشريعة، وهي التي تقيم الجهاد وتحمي البيضة، إذ من أصولهم أن الجهاد ماض مع كل إمام، وكل نظام غير ذلك فلا شرعية له عندهم سواء كان ملكيا أو جمهوريا أو عسكريا، بل هذه المحدثات التي حذر منها الشارع، وأبطلها كلها، وأمر باعتزالها، وعدم السمع والطاعة لها، إلا ما كان من طاعة قهرية فسيأتي تفصيل القول فيها.
ولم يختلف أهل السنة قاطبة في عدم شرعية ما سوى الخلافة كالملك المحض ونحوه، وإنما وقع الخلاف بين أهل السنة والجماعة في الخلافة إذا شابها وخالطها ملك وسلطان، كما في خلافة بني أمية وبني العباس وبني عثمان، حيث إن الشارع سماهم خلفاء، وأمر بالسمع والطاعة والوفاء لهم بالبيعة إذا كانوا عدولا، واجتمعت عليهم الأمة، واستقر لهم الأمر، ورضيت بهم الأمة ابتداء أو انتهاء، كما في الحديث الصحيح (يكون خلفاء فيكثرون فأوفوا بيعة الأول فالأول) وقوله في الحديث الصحيح (لا يزال هذا الأمر عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش) وقوله في الصحيحين (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)، فدخل في عموم ذلك خلفاء بني أمية وبني العباس، وجاء الحديث الصحيح بفضل بني عثمان (لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش)، وسئل صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أم روما؟ فقال (مدينة هرقل أولا) وإنما كان فتحها على يد السلطان العثماني محمد الفاتح في آخر خلافة بني العباس في مصر وبداية خلافة بني عثمان وفتوحاتهم في أوربا.
وعامة خلفاء المسلمين بعد الخلافة الراشدة كانوا عدولا صلحاء فقهاء علماء، وعامتهم بويع لهم بالخلافة دون قتال ولا دماء، بعد استقرار الأمر في الخلافة الأموية ثم استقراره في الخلافة العباسية ثم استقراره في الخلافة العثمانية، وعامتهم بايعهم أهل الحل والعقد بعد توفر الشروط فيهم كالعلم والعدالة والكفاءة، وكان منهم من اجتهد في التشبه بالخلفاء الراشدين، واشتهروا بالعدل والعلم والصلاح والفضل ـ كما فصلته في الحرية أو الطوفان ـ وكانت خلافتهم من حيث العموم خلافة رحمة، وإن تخللها بعض أهل الجور والظلم، إذ ظهر في خلافتهم دين الإسلام على الأديان، وساد المسلمون العالم، وكانوا رحمة للعالمين، حتى إذا سقطت الخلافة عم الكفر الأرض، وظهرت كلمة الذين كفروا وصارت العليا، وكلمة الذين آمنوا السفلى، وكان ضحايا هذا الطغيان في أوربا وحدها قتل مائة مليون إنسان جراء الحرب العالمية الأولى والثانية، ومازالت الملايين تسفك دماؤها، وتنتهك أعراضها، لما غابت الخلافة الإسلامية عن الأرض، فكانت حقا خلافة رحمة بالأمة وبالعالم كله، ثم ظهر الملك العضوض والملك الجبري في هذا العصر على نحو لم تعرفه الأمة من قبل وكانوا (دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها)، وستعود كما أخبر صلى الله عليه وسلم من جديد (خلافة على نهج النبوة) وبعدها تفتح روما كما فتحت القسطنطينية، إذ الفتوح لا تكون إلا في ظل الخلافة، ولم تفتح أرض منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا تحت ظل الخلافة، ولم تتعطل الفتوح إلا بعد سقوطها، فصار المسلمون يغزون في أرضهم، وتتداعى عليهم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، وهم غثاء كغثاء السيل!
وقد حاول شيخ الإسلام ابن تيمية بيان بطلان الملك المحض وحل إشكال شوب الخلافة بالملك وأحكام ذلك فقال في الفتاوى (35/22):
(في الحديث الذي رواه مسلم ـ كذا قال وليس في مسلم ـ (ستكون خلافة نبوة ورحمة، ثم يكون ملك ورحمة، ثم يكون ملك وجبرية، ثم يكون ملك عضوض) وقال في الحديث المشهور في السنن وهو صحيح (إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور) ويجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين “خلفاء” وإن كانوا ملوكا ولم يكونوا خلفاء الأنبياء ـ أي خلافة ملك لا خلافة نبوة راشدة ـ بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر؛ قالوا فما تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول؛ ثم أعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم)، فقوله (فتكثر) دليل على من سوى الراشدين فإنهم لم يكونوا كثيرا، وأيضا قوله (فوا ببيعة الأول فالأول) دل على أنهم يختلفون؛ والراشدون لم يختلفوا، وقوله (فأعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم) دليل على مذهب أهل السنة في إعطاء الأمراء حقهم من المال والمغنم …
والغرض هنا بيان جماع الحسنات والسيئات الواقعة بعد خلافة النبوة في الإمارة وفي تركها فإنه مقام خطر، وذلك أن خبره بانقضاء خلافة النبوة فيه الذم للملك والعيب له، لا سيما وفى حديث أبى بكرة أنه استاء للرؤيا وقال (خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء)، ثم النصوص الموجبة لنصب الأئمة والأمراء وما في الأعمال الصالحة التي يتولونها من الثواب حمد لذلك وترغيب فيه، فيجب تخليص محمود ذلك من مذمومه، وفى حكم اجتماع الأمرين، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن الله خيرنى بين أن أكون عبدا رسولا وبين أن أكون نبيا ملكا فاخترت أن أكون عبدا رسولا)، فإذا كان الأصل في ذلك شوب الولاية من الإمارة والقضاء بالملك هل هو جائز في الأصل والخلافة مستحبة؟ أم ليس بجائز إلا لحاجة من نقص علم أو نقص قدرة بدونه؟
فنحتج بأنه ـ أي الملك ـ ليس بجائز في الأصل، بل الواجب خلافة النبوة، لقوله صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فكل بدعة ضلالة) بعد قوله (من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا) فهذا أمر وتحضيض على لزوم سنة الخلفاء وأمر بالاستمساك بها وتحذير من المحدثات المخالفة لها، وهذا الأمر منه والنهي دليل بين في الوجوب… وأيضا فكون النبي صلى الله عليه وسلم استاء للملك بعد خلافة النبوة دليل على أنه متضمن ترك بعض الدين الواجب، وقد يحتج من يجوز الملك بالنصوص التي منها قوله لمعاوية (إن ملكت فأحسن) ونحو ذلك وفيه نظر! ويحتج بأن عمر أقر معاوية لما قدم الشام على ما رآه من أبهة الملك لما ذكر له المصلحة فيه، فإن عمر قال لا آمرك ولا أنهاك، ويقال في هذا إن عمر لم ينهه لا أنه أذن له في ذلك، لأن معاوية ذكر وجه الحاجة إلى ذلك ولم يثق عمر بالحاجة فصار محل اجتهاد في الجملة!
فهذان القولان متوسطان أن يقال الخلافة واجبة، وإنما يجوز الخروج عنها بقدر الحاجة، أو أن يقال يجوز قبولها من الملك بما ييسر فعل المقصود بالولاية ولا يعسره، إذ ما يبعد المقصود بدونه لا بد من إجازته…
وهنا طرفان:
أحدهما: من يوجب ذلك ـ أي خلافة النبوة ـ في كل حال وزمان وعلى كل أحد ويذم من خرج عن ذلك مطلقا أو لحاجة، كما هو حال أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وطوائف من المتسننة والمتزهدة.
والثانى: من يبيح الملك مطلقا من غير تقيد بسنة الخلفاء كما هو فعل الظلمة والإباحية وأفراد ـ كذا في الأصل والظاهر أفراخ ـ المرجئة وهذا تفصيل جيد وسيأتي تمامه).
فهنا يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية ما يلي :
أولا: بأن الشارع أخبر كما جاء في الأحاديث بأن بعد النبوة ستكون خلافة النبوة وهي الخلافة الراشدة، ثم خلافة ملك ورحمة، وهم الخلفاء المسلمون الذين جاءوا بعد الخلفاء الراشدين، وهم كثير ويتفاوتون في قربهم وبعدهم عن السنة، إلا أنهم يشملهم اسم الخلافة، ثم بعد الخلافة ـ وهو الذي لم يحصل إلا في العصر الحالي حيث غابت الخلافة عن الأرض كلية ولا يوجد حتى من يدعيها ـ يكون ملك عضوض، ثم ملك جبري!
ثانيا : بأن الخلافة على نهج النبوة هي الواجبة بنص الشارع، وما سواها فهو محدثات يجب ردها وإبطالها والتحذير منها، ورد على من حاولها الاحتجاج بما ورد في شأن معاوية بأنه فيه نظر.
ثالثا: إذا شاب الخلافة وخالطها شيء من سنن الملوك وهيئاتهم وأفعالهم في ظل الإمامة والخلافة الشرعية، فهل ذلك مشروع أم ممنوع، ورجح شيخ الإسلام بأنه ممنوع غير مشروع في الأصل، إلا أنه في حال عدم القدرة أو عدم العلم، فيقال بأن سنن الخلافة الراشدة واجبة ولا يجوز الخروج عنها إلا بقدر الحاجة، أو يقال يجوز من الملك ما يحقق مقصود الولاية وما لا تتم الواجبات الشرعية إلا به لا مطلقا.
رابعا : ثم يذكر شيخ الإسلام هنا طائفتين من أهل الأهواء والبدع:
فطائفة ترى الخروج عن سنن الخلفاء الراشدين ممنوعا مطلقا لا يسوغ بأي حال من الأحوال وفي أي ظرف من الظروف وتذم من خرج عنها مطلقا ولو لحاجة أو ضرورة، كحال الخوارج والمعتزلة والصوفية من أهل السنة الذين يذمون كل من خرج عن سنن الخلفاء الراشدين وإن كان من الخلفاء المسلمين الصالحين الذين شابوا الخلافة بشيء من الملك كمعاوية رضي الله عنه مع ما تحقق على أيديهم من الفتوحات وظهور الإسلام في الأرض.
وطائفة على النقيض وهي التي تسوغ الخروج عن سنن الخلافة وتجوز الملك مطلقا وهذه الطائفة هم الإباحيون والظلمة والمرجئة المحضة الذين لا يرون أنه يضر مع الإيمان ذنب فيسوغون للملوك فعل كل شيء!
وهذا كله في الخلافة التي يشوبها ويخالطها بعض الملك أما الملك العضوض والملك الجبري حيث لا خلافة راشدة ولا خلافة رحمة فهذا الموضوع خارج دائرة المناقشة.
ثم قال شيخ الإسلام (وتحقيق الأمر أن يقال انتقال الأمر عن خلافة النبوة إلى الملك ـ أي إلى خلافة الملك والرحمة كخلافة معاوية ـ إما أن يكون لعجز العباد عن خلافة النبوة، أو لاجتهاد سائغ، أو مع القدرة على ذلك علما وعملا، فإن كان مع العجز علما أو عملا كان ذو الملك معذورا في ذلك، وإن كانت خلافة النبوة واجبة مع القدرة، كما تسقط سائر الواجبات مع العجز، كحال النجاشي لما أسلم وعجز عن إظهار ذلك في قومه، بل حال يوسف الصديق تشبه ذلك من بعض الوجوه، لكن الملك كان جائزا لبعض الأنبياء كداود وسليمان ويوسف.
وإن كان مع القدرة علما وعملا وقُدّر أن خلافة النبوة مستحبة ليست واجبة، وأن اختيار الملك جائز فى شريعتنا كجوازه فى غير شريعتنا، فهذا التقدير إذا فرض أنه حق فلا إثم على الملك العادل أيضا.
وهذا الوجه قد ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد لما تكلم في تثبيت خلافة معاوية وبنى ذلك على ظهور إسلامه وعدالته وحسن سيرته وأنه ثبتت إمامته بعد موت علي لما عقدها الحسن له وسمى ذلك عام الجماعة، وذكر حديث عبد الله بن مسعود (تدور رحى الإسلام على رأس خمس وثلاثين) قال: قال أحمد في رواية ابن الحكم يروى عن الزهري أن معاوية كان أمره خمس سنين لا ينكر عليه شيء، فكان هذا على حديث النبي (خمس وثلاثين سنة) قال ابن الحكم قلت لأحمد من قال حديث بن مسعود (تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين) أنها من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقد أخبر هذا، وما عليه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما يصف ما يكون بعده من السنين.
قال وظاهر هذا من كلام أحمد أنه أخذ بظاهر الحديث وأن خلافة معاوية كانت من جملة الخمس والثلاثين، وذكر أن رجلا سأل أحمد عن الخلافة فقال كل بيعة كانت بالمدينة فهي خلافة نبوة لنا، قال القاضي وظاهر هذا أن ما كان بغير المدينة لم يكن خلافة نبوة.
قلت نصوص أحمد على أن الخلافة ـ أي الراشدة ـ تمت بعلي كثيرة جدا.
ثم عارض القاضي ذلك بقوله (الخلافة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا).
قال السائل فلما خص الخلافة بعده بثلاثين سنة كان آخرها آخر أيام علي، وأن بعد ذلك يكون ملكا، دل على أن ذلك ليس بخلافة؟
فأجاب القاضي أبو يعلى بأنه يحتمل أن يكون المراد به الخلافة التي لا يشوبها ملك بعده ثلاثون سنة، وهكذا كانت خلافة الخلفاء الأربعة، ومعاوية قد شابها الملك، وليس هذا قادحا في خلافته، كما أن ملك سليمان لم يقدح في نبوته وإن كان غيره من الأنبياء فقيرا.
قلت ـ أي ابن تيمية ـ فهذا يقتضي أن شوب الخلافة بالملك جائز في شريعتنا وأن ذلك لا ينافي العدالة، وإن كانت الخلافة المحضة أفضل، وكل من انتصر لمعاوية وجعله مجتهدا في أموره ولم ينسبه إلى معصية فعليه أن يقول بأحد القولين إما جواز شوبها بالملك أو عدم اللوم على ذلك….
وأما إذا كانت خلافة النبوة واجبة وهي مقدورة وقد تركت فترك الواجب سبب للذم والعقاب ثم هل تركها كبيرة أو صغيرة؟ إن كان صغيرة لم يقدح في العدالة، وإن كان كبيرة ففيه القولان، لكن يقال هنا إذا كان القائم بالملك والإمارة يفعل من الحسنات المأمور بها ويترك من السيئات المنهي عنها ما يزيد به ثوابه على عقوبة ما يتركه من واجب أو يفعله من محظور فهذا قد ترجحت حسناته على سيئاته..) انتهى كلام ابن تيمية.
وهنا يقرر شيخ الإسلام ما يلي بأن الخروج عن سنن الخلافة الراشدة إلى خلافة الملك له ثلاث صور :
1 ـ أن يكون ذلك لعدم العلم أو لعدم القدرة العملية فهنا يسقط الواجب وهو لزوم سنن الخلافة الراشدة للعجز كما تسقط سائر الواجبات عند عدم القدرة، وقاس ذلك على حال النجاشي حين أسلم سرا ولم يستطع تغيير شيء، وقاسه أيضا على حال النبي يوسف، إلا أن شيخ الإسلام استشكل ذلك لكون يوسف على شريعة أخرى كان الملك فيها جائزا بخلاف شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءت شريعته بالخلافة وأبطلت الملك.
وفيما ذكره شيخ الإسلام هنا نظر وأي نظر إذ النجاشي لم يخاطب بأحكام الشريعة آنذاك، حتى يوصف بالعجز وعدم القدرة، وإنما آمن بما أخبره به جعفر بن أبي طالب إيمانا إجماليا، وأسلم ولم يظهر شيئا من ذلك، إذ لم يجب عليه ذلك حتى يوصف بالعجز.
2 ـ والصورة الثانية أن يكون الخروج عن سنن الخلافة الراشدة مع العلم والقدرة لا عن جهل وعجز، فإن قيل بأن لزوم سنن الخلافة الراشدة مستحب لا واجب، وفرض أن اختيار الملك جائز في شريعتنا كجوازه في غير شريعتنا، فهنا لا إثم على الملك العادل، وهذا كله افتراض جدلي أراد منه شيخ الإسلام الاعتذار لمعاوية لما شاب خلافته بالملك.
ثم ذكر شيخ الإسلام أجوبة القاضي أبي يعلى الحنبلي ورده على من طعن في معاوية بأنه ليس خليفة وإنما هو ملك لحديث (الخلافة ثلاثون سنة ثم تكون ملكا)، فقال بأن المراد هنا خلافة النبوة ثلاثون سنة، أما بعد ذلك فهي خلافة ملك، وقاسها القاضي على خلافة النبي سليمان، وقد استشكل شيخ الإسلام ذلك إذ هذا يقتضي جواز شوب الخلافة بالملك في شريعتنا، مع أن الظاهر المنع كما نص عليه شيخ الإسلام في أول البحث!
3 ـ والصورة الثالثة أن يكون الخروج عن سنن الخلافة الراشدة مع العلم والقدرة مع القول بوجوب لزوم سنن الخلافة الراشدة، فالخروج عنها يقتضي اللوم والذم، وهل هو كبيرة أم صغيرة..الخ
ويلاحظ هنا بأن شيخ الإسلام وقبله القاضي أبو يعلى كانوا بصدد الرد على المخالف دفاعا عن معاوية، وإلا لو حققا القول في حديث (خلافة النبوة ثلاثون سنة) لعلما بأن قوله في آخر الحديث (ثم يصير ملكا) إنما هي زيادة من كلام الراوي ولا يصح رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترد في أكثر روايات هذا الحديث، وأما قوله في الحديث الصحيح في الرؤيا (خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء) فالمراد بالملك الخلافة، إذ الخلافة هي ملك وسلطان أيضا، كما قال مجاهد في تفسير قوله تعالى {والله يؤتي ملكه من يشاء} قال (الملك السلطان)! وقال ابن جرير الطبري في تفسيره 15/159 (الملك سلطان، والطاعة ملك)، فالخلافة رئاسة عامة وسلطة وطاعة فيطلق عليها في اللغة ملك.
وحديث الرؤيا ذكر فيه أبو بكر وعمر وعثمان فقط، ولم يذكر علي، فدل على أن المراد (ثم يؤتي الله الملك من يشاء) أي الخلافة، إذ الخلافة ملك وسلطة وعلي رضي الله عنه خليفة وليس بملك بلا خلاف، والصحيح أن الشارع تواتر عنه بأنه سيسوس أمته بعده الخلفاء الراشدون، ثم يكون بعدهم خلفاء فيكثرون، وأمر بلزوم هدي الخلفاء الراشدين ونبذ المحدثات بعدهم، كما أمر بالوفاء بالبيعة للخلفاء المسلمين العدول، وأما الملك العضوض والملك الجبري، فلم يأمر الشارع بالبيعة لهم ولا الوفاء لهم، بل ذكرهم للتحذير منهم ومن طاعتهم، إذ هم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها!
والمقصود أن الإسلام أبطل الملك كله كما في الحديث الصحيح (أغيظ رجل على الله رجل تسمى بملك الملوك لا ملك إلا الله) وجاء أيضا (ينادي الله يوم القيامة أنا الملك أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟)!
وإنما جاء الإسلام بنظام سياسي فريد غير مسبوق يعبر عن طبيعة أصول الإسلام العقائدية والفقهية وهو الخلافة حيث المسلمون أخوة متساوون، لا أحد يملك أحدا، وحيث الأرض لله ولرسوله وللمؤمنين وليست ملك أحد، وحيث الولاية للمؤمنين جميعا {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف} {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا}، وحيث الأمر شورى بينهم لا يستبد به أحد على أحد، والله وحده لا شريك له هو الملك والرب {رب الناس. ملك الناس}!
فهذه هدايات الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة في باب الأصول السياسية العقائدية وللحديث بقية!
([1]) تفسير ابن كثير 1/227.
([2]) الفصل في الملل والنحل 4/130 .
([3]) شرح مسلم للنووي 12/229 .
([4]) فتح الباري 3/123 .
([5]) المصدر السابق.
6 – الأصول السياسية والعقيدة الغائبة (3)
بقلم د. حاكم المطيري
سبق تفصيل القول في الأصل السياسي الأول عند أهل السنة والجماعة وهو المرتبط بالإمامة والخلافة والدولة وهذا أوان الشروع في الأصل الثاني وبيان أحكامه عندهم:
الأصل السياسي الثاني : إثبات إسلام أهل القبلة بجميع طوائفهم، وعدم إكفارهم، وتحريم استحلال دمائهم وأموالهم، والشهادة لهم بالإسلام، والعدل معهم في الأحكام، والسمع والطاعة للأئمة منهم، والصلاة في الجمع والجماعات والأعياد خلفهم، والجهاد معهم.
فهذا هو الأصل السياسي العقائدي الثاني من أصول أهل السنة والجماعة التي أجمعوا عليها، كما ثبتت بنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقد صاروا ينصون على هذا الأصل العظيم في مؤلفاتهم العقائدية تمييزا لهم عمن خالفهم فيه من أهل الأهواء الذين يبتدعون الرأي، ثم يفارقون الأمة، ثم يكفرون من خالفهم، ثم يرون السيف عليهم، كما هو شأن الخوارج الذين كفروا المسلمين واستحلوا قتالهم ودماءهم وأموالهم، وكذا الإمامية الذين قالوا بالنص في الإمامة وكفروا الصحابة وكفروا من لا يؤمن بنظرية النص على علي وأبنائه!
وقد كان من شأن هذه العقيدة الدينية الشرعية السياسية عند أهل السنة وسلف الأمة، أن حافظت على وحدة الأمة السياسية من جهة، وصانت الخلافة والدولة من السقوط من جهة أخرى، وحالت دون الحروب الطائفية الداخلية من جهة ثالثة، حيث التزم عامة الأمة وعموم المسلمين من أهل السنة والجماعة بهذا الأصل، فلم يؤثر على الدولة والخلافة الإسلامية تخلي الفرق الصغيرة عن نصرتها والوقوف معها في وجه الأعداء الخارجيين، فلم تتعطل الفتوح، ولم يتوقف الجهاد، ولم تتعطل الجمع والحج والجماعات، حتى في ظل وصول المعتزلة للسلطة والخلافة في عهد المأمون والمعتصم والواثق، ولهذا كانت الفتوحات، والتاريخ الإسلامي، والحضارة الإسلامية، هي فتوحات الخلافة وانجازاتها وتاريخها وحضارتها، وتاريخ سلف الأمة، وأهل السنة والجماعة، وهم عموم الأمة، منذ الخلافة الراشدة، ثم الخلافة الأموية، ثم الخلافة العباسية، ثم الخلافة العثمانية!
قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/171)(واعلموا أن جميع فرق الضلالة لم يجر الله على أيديهم خيرا، ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية، ولا رفع للإسلام بهم راية، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين، ويفرقون كلمة المؤمنين، ويسلون السيف على أهل الدين، ويسعون في الأرض مفسدين).
وقال أبو المظفر طاهر الإسفرائيني في كتابه التبصير في الدين (1/195) (وأما أنواع الاجتهادات الفعلية التي مدارها على أهل السنة والجماعة في بلاد الإسلام فمشهورة مذكورة، ومن آثارهم الاجتهادية سدهم ثغور الإسلام، والمرابطة بها في أطراف الأرض، مثل ثغور الروم، وثغور أرمينية، وانسداد جميعها ببركات أصحاب الحديث، وأما ثغور بلاد الترك فمشتركة بين أهل الحديث والرأي، وليس لأهل الأهواء في شيء من الثغور مرابطة، ولا أثر ظاهر، بل هم أشد ضلالة، فبان لك بما ذكرناه من مساعي أهل السنة والجماعة في العلوم والاجتهادات أنهم أهل الاجتهاد والجهاد، والجهاد في الدين يكون تارة بإقامة الحجة في الدعوة إلى المحجة، ويكون تارة باستعمال السيف مع المجاهدين ضد أهل الخلاف من الأعداء، وببذل الأموال والمهج، وقد خص الله تعالى فيهم قوله {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين}).
وفي الوقت الذي كان أهل السنة وعامة الأمة يسهمون في الفتوحات التاريخية، ويواجهون الغزو الخارجي، ويوجبون ذلك على الأمة، في جميع الأحول، مهما وقع انحراف في السلطة مراعاة للمصالح الكلية، كانت الفرق الأخرى تشتغل في إشعال الفتن الداخلية، والاضطرابات، أو الاعتزال في أحسن الأحوال، فلا جهاد دفع، ولا جهاد فتح، بدعوى جور الأئمة أو كونهم مبتدعة، أو انتظارا للمهدي الغائب!
وقد كانت هذه القضية ثمرة من ثمار الموقف من فاعل الكبيرة، ومن صاحب البدعة، وهل هو مسلم أم كافر؟ وهل يصلى خلفه أم لا؟ وهل يجاهد معه؟ وهل يسمع له ويطاع إذا كان إماما أو أميرا؟ ..الخ
ولهذا عالج أئمة أهل السنة كل هذه القضايا من منظور الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، حيث استطاعوا الجمع بين صحيح المنقول وصريح المعقول، وما يتوافق مع سنن الله الاجتماعية في قيام الدول والأمم بالعدل والحكمة التي جاء بها الشرع، فكانوا أقدر على التوفيق بين النصوص وموافقة ما تقضي به العقول في سياسة الأمة، من المعتزلة الذين قدموا حجج العقول بزعمهم، وقالوا بالإرادة الحرة للإنسان، فلما ساسوا شئون الأمة فإذا هم أبعد الناس عن العقل والسياسة في إدارة شئون الأمة، فامتحنوا الأمة في عقيدتها، وسجنوا علماءها، وعذبوهم، وكفروهم، وحرموهم أرزاقهم، ليحملوهم على القول بخلق القرآن، فكان التناقض صارخا بين إيمانهم بالقدر والإرادة الحرة من جهة وممارساتهم السياسية التي صادرت حرية الرأي والاعتقاد من جهة أخرى، وكانت عقولهم مع دعواهم الاحتجاج بالمعقول أعجز من الاهتداء إلى الحق في باب حسن سياسة الأمة بالعدل والقسط، وكان أثر فقه أئمة السنة والمدرسة النقلية على الأمة ووحدتها والمحافظة على خلافتها ودولتها في هذه الفتن الداخلية خيرا من أثر أصحاب المدرسة العقلية!
ويمكن إيجاز هذه القضية في أربع مسائل رئيسة :
المسألة الأولى : إثبات إسلام أهل القبلة أجمعين وعدم إكفار المخالفين من المسلمين:
وقد بنى أئمة أهل السنة والجماعة هذه المسألة على قولهم بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص كما ثبت بنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة فقد قال تعالى {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} فأثبت لهم وصف الإيمان مع وقوعهم في كبيرة من الكبائر وهي الاقتتال فيما بينهم، وقال تعالى {ليزدادوا إيمانا} فأثبت زيادة الإيمان ونقصانه بزيادة الأعمال الصالحة ونقصانها، وجاءت الحدود الشرعية كفارات لما يقع به المؤمنون من المعاصي والذنوب، وكما جاء في الصحيح (كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون) وقال تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} وكل ذلك يؤكد أن المسلم والمؤمن بشر تقع منه المعاصي والذنوب ولا يخرجه ذلك من دائرة الإسلام والإيمان إذا جاء بالأصول والأركان.
وعليه فمن ثبت إسلامه بيقين لم يخرج منه إلا بيقين، وثبتت له جميع حقوق المسلمين على المسلمين،وقد خالف في ذلك الخوارج الذين كفروا كل من لم يقل بقولهم، وكفروا أهل الذنوب والكبائر، حتى كفروا علي بن أبي طالب ومعاوية والصحابة الذين اقتتلوا في الجمل والصفين، وكذا كفر الشيعة الإمامية الصحابة كلهم إلا نفرا، بدعوى مخالفتهم أصلا من أصول الدين عندهم وهو إثبات إمامة علي ومن بعده، وقالت المعتزلة بأن من فعل كبيرة هو في منزلة بين المنزلتين لا كافر ولا مسلم، وهو في الآخرة خالد في النار، وقد تصدى أئمة أهل السنة لهذه الآراء المتطرفة المخالفة لهدايات الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة:
قال سفيان الثوري إمام أهل الحديث والسنة في عصره (ت160هـ) في بيان اعتقاد أهل السنة ـ (كما في الشريعة للآجري 5/279) ـ (ولا يكفرون أحدا بذنب، ولا يشهدون عليه بشرك).
وكذا نقل الإمام الطحاوي (ت 321) في عقيدته عن إمام أهل الرأي أبي حنيفة وعن صاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن قولهم (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله..ونرى الصلاة على من مات منهم).
وقال أحمد بن حنبل (ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه، ويستغفر له، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل).
ونقل إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256) ـ كما في اعتقاد أهل السنة للآلكائي (1/173) ـ إجماع أئمة أهل السنة والجماعة على هذا القول فقال (لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر لقيتهم فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء.. ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب لقوله {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (5/95) (من شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالا يجعلونها واجبة في الدين، بل يجعلونها من الإيمان الذي لا بد منه، ويكفِّرون من خالفهم فيها، ويستحلُّون دمه، كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم، وأهل السنة لا يبتدعون قولاً، ولا يكفِّرون من اجتهد فأخطأ، وإن كان مخالفًا لهم، مكفرًا لهم، مستحلاً لدمائهم، كما لم تكفِّر الصحابة الخوارج، مع تكفيرهم لعثمان وعليّ ومن والاهما، واستحلالهم لدماء المسلمين المخالفين لهم).
وقال شيخ الإسلام أيضا ـ كما في الفتاوى (3/282-283) ـ في بيان أن كل طوائف أهل القبلة في دائرة الإسلام والإيمان لا يخرجون منها ببدعهم (والخوارج المارقون الذين أمر النبي بقتالهم، قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام، وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم، وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين أشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضًا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعًا جهال بحقائق ما يختلفون فيه).
وقال أيضا (فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به، وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع، فهذا ليس بكافر أصلاً، والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيرً لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع، وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة، من كان منهم منافقًا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقًا بل كان مؤمنًا بالله ورسوله في الباطن، لم يكن كافرًا في الباطن، وإن أخطأ في التأويل كائنًا ما كان خطؤه؛ وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، ومن قال: إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرًا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضًا ببعض المقالات) (الفتاوى (7/217-218) و(7/472)).
المسألة الثانية : إثبات كل حقوقهم في الإسلام والعدل معهم في القضاء والأحكام:
فقد ترتب على هذه العقيدة الإيمانية ـ في عدم إكفار المخالفين من أهل القبلة وإثبات إسلامهم ـ آثارها العملية والسياسية، حيث تقررت لهم جميع حقوق المسلمين:
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ـ كما في الأم (4/309) ـ في بيان ما للخوارج وأهل الأهواء من حقوق:(ولو أن قوما أظهروا رأى الخوارج وتجنبوا جماعات الناس، وكفروهم لم يحلل بذلك قتالهم، لأنهم على حرمة الإيمان، لم يصيروا إلى الحال التي أمر الله عز وجل بقتالهم فيها.
بلغنا أن عليا رضي الله تعالى عنه بينا هو يخطب إذ سمع تحكيما من ناحية المسجد: لا حكم إلا لله عز وجل!
فقال علي رضي الله تعالى عنه:”كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نبدؤكم بقتال”.
قال الشافعي: وبهذا كله نقول، ولا يحل بطعنهم للمسلمين دماؤهم، ولا أن يمنعوا الفيء ما جرى عليهم حكم الإسلام وكانوا أسوتهم في جهاد عدوهم، ولا يحال بينهم وبين المساجد والأسواق، ولو شهدوا شهادة الحق وهم مظهرون لهذا قبل الاعتقاد أو بعده وكانت حالهم في العفاف والعقول حسنة انبغى للقاضي أن يحصيهم بأن يسأل عنهم..وهكذا من بغى من أهل الأهواء ولا يفرق بينهم وبين غيرهم فيما يجب لهم وعليهم من أخذ الحق والحدود والأحكام).
وعلى هذا القول أجمع أئمة أهل السنة والجماعة نظريا وعمليا فلم يأذنوا لأحد من الخلفاء ولا الأمراء بالتعرض بالقتل أو السجن للمخالفين في الدين من المسلمين، كما فعل أحمد بن حنبل لما رفع المتوكل الفتنة، حيث نهى عن التعرض لكل من آذاه كالقاضي ابن أبي دؤاد، بل يرون وجوب العدل معهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ولهذا كان أهل السنة مع أهل البدعة بالعكس، إذا قدروا عليهم لا يعتدون عليهم بالتكفير والقتل وغير ذلك، بل يستعملون معهم العدل الذي أمر الله به ورسوله، كما فعل عمر بن عبد العزيز بالحرورية والقدرية، وإذا جاهدوهم، فكما جاهد علي رضي الله عنه الحرورية بعد الأعذار وإقامة الحجة ـ أي لكف عدوانهم ـ وعامة ما كانوا يستعملونه معهم الهجران والمنع من الأمور التي تظهر بسببها بدعتهم، مثل ترك مخاطبتهم ومجالستهم، لأن هذا هو الطريق إلى خمود بدعتهم، وإذا عجزوا عنهم لم ينافقوهم، بل يصبرون على الحق الذي بعث الله به نبيه، كما كان سلف المؤمنين يفعلون، وكما أمرهم الله في كتابه، حيث أمرهم بالصبر على الحق، وأمرهم أن لا يحملهم شنآن قوم على أن لا يعدلوا) انظر التسعينية (2/698-701).
وبهذه الأصول العقائدية السياسية عند أهل السنة والجماعة عصم الله الأمة من الاقتتال الداخلي بين طوائفها وفرقها، حيث كان أهل السنة هم عامة الأمة، فكان في كفهم وعدلهم مع الأقلية المخالفة إقرارا للتعددية والحرية الدينية، والعدل والتسامح الذي أدى إلى وحدة الأمة وقوتها وازدهار نهضتها، ولم يؤثر فيها ما كانت عليه الأقلية من تطرف وغلو، بخلاف أوربا التي كانت الأكثرية الكاثوليكية هي التي تقاتل الأقليات المسيحية وتضطهدها، وتسومها سوء العذاب، فكانت أوربا تعيش في ظلم الكنيسة وظلماتها، حين كانت مساجد المسلمين وجوامعهم في دمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة وعواصم الإسلام في كل الأمصار منارات نور وهداية وعلم وحرية وتسامح!
ولم يشهد المسلمون اقتتالا طائفيا دينيا داخليا إلا حين تصل الأقلية المتطرفة للسلطة، كما فعل المعتزلة في الخلافة العباسية، وكما فعل الصفويون في إيران الذين استباحوا قتل أهل السنة الذين كانوا يمثلون الأكثرية في إيران إلى القرن العاشر الهجري، حتى أحرقوا آلاف العلماء بالنار، فكان الصفويون المتطوفون يقيمون محاكم التفتيش شرقا، في الوقت الذي كانت محاكم التفتيش الكاثوليكية المسيحية وجيوشها المتطرفة تشن حروب إبادة جماعية للقضاء على المسلمين في الأندلس غربا!
وما زلنا في الأصول العقائدية السياسية إذ ما زال للحديث بقية!
7 – الأصول السياسية والعقيدة الغائبة (4)
ذكرنا في الحلقة السادسة من هذه الدراسة أن أهل السنة والجماعة لهم أصولهم العقائدية السياسية في الموقف من الأمة ووحدتها تتجلى في أربعة مسائل:
الأولى في عدم إكفار المسلمين المخالفين وكذا العصاة والمذنبين.
والثانية في تقرير جميع حقوقهم ووجوب العدل معهم.
وهذا تفصيل القول في الثالثة والرابعة:
المسألة الثالثة: صحة الصلاة خلف الأئمة منهم، والجهاد معهم، والطاعة لهم بالمعروف:
وهذه من أصول أهل السنة والجماعة العقائدية النظرية والفقهية العملية بناء على ما سبق من أصولهم في الموقف من أهل الفسق والكبائر، ومن أهل القبلة المخالفين في الرأي من أهل الأهواء والبدع، حيث أثبت أهل السنة والجماعة لهم حكم الإسلام، ومن ثم صححوا صلاتهم، كما صححوا الصلاة خلفهم في الجمع والجماعات والأعياد التي هي شعائر المسلمين العامة التي توحدهم روحيا واجتماعيا وسياسيا، وكذا رأوا صحة الجهاد معهم، والطاعة للأئمة منهم، مع اشتراط أهل السنة والجماعة في الأئمة العدالة ابتداء، إلا أنهم رأوه شرط صحة في حال السعة والاختيار لا حال الضيق والاضطرار، فمن صار إماما أو ولاه الإمام الصلاة أو الحج أو الجهاد صح الإتمام به وإن لم يكن عدلا إذا لم تقدر الأمة على صرفه وتغييره، ولهذا لم يتخلف أهل السنة والجماعة عن الصلاة والجهاد زمن المأمون والمعتصم والواثق، وقد كانوا على رأي المعتزلة، بل حملوا الأمة على القول بالاعتزال بالسيف والسجن، ومع ذلك ظل أهل السنة يحافظون على الجماعة ووحدة الأمة التي هي أصل الأصول بعد التوحيد، كما في الحديث الصحيح (إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا).
وهذا الموقف موافق للنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، ولما ثبت عن السلف أنهم كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف بعد أن عجزوا عن تغييره، إذ حاولوا الخروج عليه مع ابن الأشعث فلم يستطيعوا، ثم صلوا خلفه، حفاظا على وحدة الأمة السياسية، وعدم تفرقها وتشرذمها، وهو ما تقرر عند أئمة أهل السنة والجماعة كما في العقيدة الطحاوية عن أبي حنيفة وأصحابه (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم).
بل عد الإمام أحمد بن حنبل من أعاد الصلاة خلفهم من أهل البدع فقال (وصلاة الجمعة خلفه ـ أي الإمام برا كان أو فاجرا ـ وخلف من ولاه جائزة تامة ركعتين من أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة).
وقال أيضا في رسالة عبددوس ـ كما في أصول السنة (1/44) ـ (والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك…وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع).
وهو إجماع أهل السنة والجماعة حفاظا على هذا الأصل السياسي الديني، وهو وحدة الأمة والدولة وعدم تفرقها، وحفاظا على مصلحة الجهاد حتى لا يتعطل، وهو الضمانة لحماية الأمة، وحفظ البيضة، وإقامة الشعائر والشرائع، فاغتفر الشارع له ما قد يقع من قصور في الأئمة ـ كبدعة ومعصية ـ تعظيما لشأن هذه الأصول التي بها قيام الإسلام وظهور الأحكام، كما قال ابن حزم في الفصل في الملل (4/135):
(فصل في الكلام في الصلاة خلف الفاسق والجهاد معه والحج ودفع الزكاة إليه ونفاذ أحكامه من الأقضية والحدود وغير ذلك: ذهب الصحابة كلهم دون خلاف من أحد منهم، وجميع فقهاء التابعين كلهم دون خلاف من أحد منهم، وأكثر من بعدهم، وجمهور أصحاب الحديث، وهو قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة وداود وغيرهم إلى جواز الصلاة خلف الفاسق الجمعة وغيرها، وبهذا نقول وخلاف هذا القول بدعة محدثة، فما تأخر قط أحد من الصحابة الذين أدركوا المختار بن عبيد والحجاج وعبيد الله بن زياد وحبيش بن دلجة وغيرهم عن الصلاة خلفهم وهم من أفسق الفساق..
وقال تعالى {أجيبوا داعي الله} فوجب بذلك ضرورة أن كل داع دعا إلى خير من صلاة أو حج أو جهاد أو تعاون على بر وتقوى ففرض إجابته وعمل ذلك الخير معه، لقول الله تعالى {تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} وإن كل داع دعا إلى شر فلا يجوز إجابته بل فرض دفاعه ومنعه…
وهكذا القول في الأحكام كلها من الحدود وغيرها إن أقامها الإمام الواجبة طاعته والذي لا بد منه فإن وافقت القرآن والسنة نفذت وإلا فهي مردودة لما ذكرنا، وإن أقامها غير الإمام أو واليه فهي كلها مردودة، ولا يحتسب بها لأنه أقامها من لم يؤمر بإقامتها، فإن لم يقدر عليها الإمام فكل من قام بشيء من الحق حينئذ نفذ، لأمر الله تعالى لنا بان نكون قوامين بالقسط، ولا خلاف بين أحد من الأمة إذا كان الإمام حاضرا متمكنا أو أميره أو واليه فإن من بادر إلى تنفيذ حكم هو إلى الإمام فإنه إما مظلمة ترد وإما عزل لا ينفذ، على هذا جرى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع عماله في البلاد، بنقل جميع المسلمين عصرا بعد عصر، ثم عمل جميع الصحابة رضي الله عنهم، وأما الجهاد فهو واجب مع كل إمام وكل متغلب وكل باغ وكل محارب من المسلمين، لأنه تعاون على البر والتقوى وفرض على كل أحد دعا إلى الله تعالى وإلى دين الإسلام ومنع المسلمين ممن أرادهم قال تعالى {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد}الآية فهذا عموم لكل مسلم بنص الآية في كل مكان وكل زمان).
فهذا ابن حزم الذي يرى وجوب الخروج على الإمام الجائر إذا استطاعت الأمة ذلك، ووجوب نصرة العدل إذا خرج على الإمام الجائر، ومع ذلك يقرر أنه مادام الإمام إماما لم يتم عزله برا كان أو فاجرا فالواجب الصلاة خلفه والجهاد معه ودفع الزكاة إليه ما دام يؤديها في مصارفها، إذ فسقه على نفسه، بينما مصلحة الجهاد معه وكذا رعاية المصالح العامة ونفوذ أمره في إقامة الحقوق والحدود كل ذلك لصالح الأمة، فلا يمنع ذلك من التعاون معه على البر والخير والتقوى، إلى أن يتم تغييره بمن هو خير منه، فإن عجز الإمام عن القيام بمسئولياته برا كان أو فاجرا، وجب على من قدر من الأمة القيام بها، ووجب على الأمة التعاون معه على البر والتقوى، ولا تتعطل الأحكام والحقوق بأي حال من الأحول.
وهذا كله يؤكد أن موقف أهل السنة والجماعة هو الأقرب للمعقول والأصوب في المنقول، إذ نظروا إلى الإسلام على أنه دين وأمة ودولة وخلافة وشريعة وأحكام، وهذه كلها ثوابت وأصول يجب المحافظة عليها بقطع النظر عن حال السلطة ورجالها، التي قد تتغير وتتقلب بهم الأحوال، فالإمام فرد قد يطرأ عليه فسوق أو جور وقد يتوب، فلا تتعطل الأحكام في الدولة بل يجب إنفاذ ما وافق الحق منها، وإعانة السلطة على البر والتقوى، إلى أن تتمكن الأمة من تغييرها، فأهل السنة والجماعة نظروا إلى الإمام من خلال نظرهم إلى مصالح الأمة والدولة، وبهذا الفقه استطاعت الدولة والأمة والخلافة مواجهة كل التحديات طوال مرحلة الاستخلاف مدة ألف وثلاثمائة سنة من تاريخ الإسلام إلى سقوط الخلافة وعودة مرحلة الاستضعاف في هذا العصر الذي بدأت فيه تباشير وإرهاصات عودة مرحلة الاستخلاف الثانية كما في البشارة النبوية (ثم تعود خلافة على منهاج النبوة)!
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ كما في منهاج السنة (1/65) ـ (ومن أوجب الإعادة على كل من صلى خلف كل ذي فجور وبدعة فقوله ضعيف، فإن السلف والأئمة من الصحابة والتابعين صلوا خلف هؤلاء وهؤلاء لما كانوا ولاة عليهم، ولهذا كان من أصول أهل السنة أن الصلوات التي يقيمها ولاة الأمور تُصلى خلفهم على أي حالة كانوا، كما يُحج معهم ويُغزى معهم).
وقال أيضا ـ كما في الفتاوى(23/342-345) ـ (أما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع، وخلف أهل الفجور، ففيه نزاع مشهور، لكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره، فإن من كان مظهرًا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته … فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته، لم يجز ذلك، بل يصلى خلفه مالا يمكنه أن يفعلها إلا خلفه، كالجمع، والأعياد، والجماعة، إذا لم يكن هناك إمام غيره، ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج، والمختار بن أبي عبيد الثقفي، وغيرهما الجمعة والجماعة، فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادًا من الاقتداء فيهما بإمام فاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره، فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة، ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمة الجور مطلقًا معدودين عند السلف، والأئمة من أهل البدع، وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء، منهم من قال: أنه يعيد لأنه فعل مالا يشرع، بحيث ترك ما يجب عليه من الإنكار بصلاته خلف هذا، فكانت صلاته خلفه منهيًا عنها فيعيدها، ومنهم من قال: لا يعيد، قال: لأن الصلاة في نفسها صحيحة…).
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على صحة الصلاة خلف الجهمي والرافضي والخارجي، إذ كلام أئمة أهل السنة والجماعة إنما هو في مثل هؤلاء، حيث قال (وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور، ولم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة، فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلف الإمام الأفضل أفضل، وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق، أو بدعة، تظهر مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الرافضة، والجهمية ونحوهم…وأما الصلاة خلف المبتدع: فهذه المسألة فيها نزاع، وتفصيل، فإذا لم تجد إمامًا غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد، وكالعيدين وكصلوات الحج، خلف إمام الموسم فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة، وإنما يدَعُ مثل هذه الصلوات خلف الأئمة؛ أهلُ البدع كالرافضة ونحوهم، ممن لا يرى الجمعة والجماعة، فإذا لم يكن في القرية إلا مسجد واحد، فصلاته في الجماعة خلف الفاجر خير من صلاته في بيته منفردًا؛ لئلا يفضي إلى ترك الجماعة مطلقًا.
وأما إذا أمكنه أن يصلي خلف غير المبتدع فهو أحسن، وأفضل بلا ريب، لكن إن صلى خلفه ففي صلاته نزاع بين العلماء، ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة تصح صلاته، وأما مالك وأحمد، ففي مذهبهما نزاع وتفصيل، وهذا إنما هو في البدعة التي يعلم أنها تخالف الكتاب والسنة، مثل بدع الرافضة والجهمية ونحوهم، فأما مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير من الناس في هذه البلاد، مثل “مسالة الحرف والصوت” ونحوها، فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعًا، وكلاهما جاهل متأول، فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس، فأما إذا ظهرت السنة وعلمت فخالفها أحد، فهذا هو الذي فيه النِّزاع). (الفتاوى (23/351-356) و(360-368،361-369).
وقال أيضا ـ كما في المستدرك على مجموع الفتاوى 3/117 ـ (أهل الحديث والسنة كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم متفقون على أن صلاة الجمعة تصلى خلف البر والفاجر حتى أن أهل البدع كالجهمية الذين يقولون بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ومع أن أحمد ابتلي بهم وهو أشهر الأئمة بالإمامة في السنة ومع هذا لم تختلف نصوصه أنه تصلى الجمعة خلف الجهمي والقدري والرافضي وليس لأحد أن يدع الجمعة لبدعة في الإمام).
وهذا أوضح دليل على أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى إثبات إسلامهم وعدم إكفارهم وهو الصحيح عن أئمة أهل السنة والجماعة، إذ لا تصح الصلاة خلف الكافر بالنص والإجماع، ومعلوم أن هذه الفرق (الجهمية والرافضة) هي في نظر الأئمة أبعد فرق أهل القبلة عن أهل السنة والجماعة وأكثرها تطرفا، بخلاف المعتزلة والشيعة الزيدية والإباضية والمرجئة، فإذا صحت الصلاة خلف الجهمي والرافضي فمن باب أولى صحتها خلف من هو أخف بدعة، وهذا أوسع باب لتوحيد الأمة ورص صفوفها، إذ وحدة مساجدها وصلواتها هي السبب في وحدة قلوبها وائتلافها، ولهذا صحح شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا دعوة أهل البدع لغير المسلمين للدخول في الإسلام وأنها خير من بقاء الكفار على شركهم ووثنيتهم حيث قال ـ كما في الفتاوى (13/96) (وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، فأسلم على يديه خلق كثير، وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفارا، وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزوا يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون آثما بذلك، ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفارا فصاروا مسلمين، وذاك كان شرا بالنسبة إلى القائم بالواجب، وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير).
وكل ذلك يؤكد موقف أهل السنة والجماعة من أهل القبلة وحفاظهم على أصل الجماعة ووحدة الأمة وانتظام أمرها، وحماية بيضتها، والجهاد مع كل من قاتل عدوها دفاعا عنها، ولا يلتفتون إلى عقيدته وبدعته، بل يعينونه على البر والتقوى، ولهذا لم يتعطل جهاد الفتح والدفع في الثغور حتى في ظل ضعف الخلافة في أواخر القرن الرابع الهجري، الذي وصل فيه أهل الأهواء والبدع للسلطة في بغداد، والقاهرة، الشام، حيث يقرر عبد القاهر البغدادي (ت 429) في كتابه أصول الدين (ص317) وهو معاصر لتلك الفترة بأن كل (ثغور الروم والجزيرة وثغور الشام وثغور أذربيجان وباب الأبواب ـ أرمينيا ـ كلهم على مذهب أهل الحديث من أهل السنة، وكذلك ثغور أفريقيا والأندلس وكل ثغور بحر المغرب أهله من أهل الحديث، وكذلك ثغور اليمن على ساحل الزنج، وأما ثغور أهل ما وراء النهر في وجوه الترك والصين فهم فريقان إما شافعية وإما من أصحاب أبي حنيفة، وقد قال تعالى {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا} فالجهاد مع الكفرة في الثغور منهم، وليس لأهل الأهواء ثغر).
فالجهاد عند أهل السنة والجماعة هو ذروة سنام الإسلام وهو ماض عندهم إلى يوم القيامة لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، كما قال أحمد بن حنبل وكما قال الطحاوي في عقيدة أبي حنيفة وأصحابه (والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما)، وذلك لقوله تعالى في شأن أعداء المسلمين وبقاء عداوتهم وعدوانهم {ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا} وقوله {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} وما زال المسلمون منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودخولهم في الإسلام إلى اليوم وإلى آخر الدهر وهم يتعرضون للظلم والعدوان في حال الاستضعاف وفي حال الاستخلاف، فهم في جهاد دفع أو جهاد فتح، وكما في الصحيح (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة).
المسألة الرابعة : تحريم سل السيف على أهل القبلة :
وهو من أهم أصول أهل السنة والجماعة المنصوص عليه في كتب عقائدهم لشدة حرمة دماء المسلمين كما ثبتت بنصوص القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة، ولهذه العقيدة أربعة معان عندهم، وربما اختلطت على المتأخرين حتى صارت عندهم معنى واحدا، وربما لبس بعضهم الحق بالباطل فيها مشايعة منهم لأهواء الملوك، والصحيح التفصيل فيها على النحو التالي :
المعنى الأول : حرمة سل السيف على المسلمين وحرمة استباحة دماء المخالفين كما تفعل الخوارج الحرورية الذين كفروا كل من خالفهم وسلوا السيف عليهم، وهذا هو المعنى المقصود عند الإطلاق، ردا على الخوارج، كما جاء في عقيدة الإمام الطحاوي عن أئمة أهل العراق من أهل الرأي أبي حنيفة وأصحابه (ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف).
وكذا قال إمام أهل الحديث في عصره سفيان الثوري ـ كما في الشريعة للآجري (5/279) ـ (وكل أهل هوى، فإنهم يرون السيف على أهل القبلة، وأما أهل السنة فإنهم لا يرون السيف على أحد، وهم يرون الصلاة والجهاد مع الأئمة تامة قائمة، ولا يكفرون أحدا بذنب، ولا يشهدون عليه بشرك).
وكذا قال البخاري ـ كما في أصول السنة للالكائي (1/174) ـ (لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر لقيتهم فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء…وأن لا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه و سلم).
فالمقصود هنا أنهم لا يرون استباحة دماء أحد من أهل القبلة من المسلمين مهما كانوا مخالفين في الرأي، لا كما يستحله الحرورية من الخوارج الذين صالوا على الأمة بالسيف (يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان) كما جاء وصفهم في الحديث الصحيح.
المعنى الثاني : حرمة سل السيف على المسلمين في القتال في الفتن، وهو كل قتال بين طائفتين من المسلمين على التنازع في الإمامة، أو القتال في حال عدم وجود إمام عام، أو القتال على شيء من حظوظ الدنيا، أو القتال على تأويل في الدين، وهذا قول عامة أهل السنة اتباعا للأحاديث التي جاء فيها النهي عن القتال في الفتن التي تقع بين المسلمين، كما فعل أكثر الصحابة الذين اعتزلوا القتال في الجمل وصفين، لحديث (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ كما في منهاج السنة(8/522-526) ـ (والذي عليه أكابر الصحابة والتابعين أن قتال الجمل وصفين لم يكن من القتال المأمور به، وأن تركه أفضل من الدخول فيه، بل عدُّوه قتال فتنة، وعلى هذا جمهور أهل الحديث، وجمهور أئمة الفقهاء، فمذهب أبي حنيفة فيما ذكره القدوري أنه لا يجوز قتال البغاة إلا أن يبدؤوا بالقتال، وأهل صفين لم يبدؤوا عليًا بقتال، وكذلك مذهب أعيان فقهاء المدينة والشام والبصرة، وأعيان فقهاء الحديث كمالك وأيوب والأوزاعي وأحمد وغيرهم أنه لم يكن مأمورًا به، وأن تركه كان خيرًا من فعله، وهو قول جمهور أئمة السنة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا الباب).
فهذا القتال بين المسلمين لا يسوغ المشاركة فيه حتى وإن كان الإمام خليفة راشدا كعلي رضي الله عنه، إذ هو قتال لم يستبن فيه وجه الحق للجميع، وطاعة الإمام الشرعي منوطة بالمعروف كما في الصحيح (إنما الطاعة بالمعروف)، أما في المتشابهات فلا طاعة له، ولهذا كان الحسن بن علي رضي الله عنه يشير على أبيه بتركه، حتى ندم علي بعد ذلك وبكى وتنمى أن لو مات قبل تلك الفتنة، وقال (لله موقف وقفه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر) وهم من الذين اعتزلوا كلا الطائفتين ولم يشاركوا في القتال، فلما اصطلحوا على التحكيم شارك هؤلاء فيه، إذ هو المشروع للأمة عند وقوع القتال فيما بينها أن تحتكم إلى الكتاب والسنة وإلى الأمة دون لجوء للسيف والقتال، كما في الصحيح (قتال المسلم كفر وسبابه فسوق) وحديث (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) وحديث (إن دماءكم حرام عليكم كحرمة يومك هذا في بلدكم هذا)..الخ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان صحة مذهب أهل المدينة ـ كما في مجموع الفتاوى (20/393) ـ (ودين الإسلام : أن يكون السيف تابعا للكتاب، فإذا ظهر العلم بالكتاب والسنة وكان السيف تابعا لذلك كان أمر الإسلام قائما، وأهل المدينة أولى الأمصار بمثل ذلك، أما على عهد الخلفاء الراشدين فكان الأمر كذلك وأما بعدهم فهم في ذلك أرجح من غيرهم، وأما إذا كان العلم بالكتاب فيه تقصير وكان السيف تارة يوافق الكتاب وتارة يخالفه : كان دين من هو كذلك بحسب ذلك، وهذه الأمور من اهتدى إليها وإلى أمثالها تبين له أن أصول أهل المدينة أصح من أصول أهل المشرق بما لا نسبة بينهما، ومن ذلك أن القتال في الفتنة الكبرى، كان الصحابة فيها ثلاث فرق : فرقة قاتلت من هذه الناحية، وفرقة قاتلت من هذه الناحية، وفرقة قعدت، والفقهاء اليوم على قولين : منهم من يرى القتال من ناحية علي – مثل أكثر المصنفين – لقتال البغاة، ومنهم من يرى الإمساك، وهو المشهور من قول أهل المدينة وأهل الحديث، والأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هذه الفتنة توافق قول هؤلاء، ولهذا كان المصنفون لعقائد أهل السنة والجماعة يذكرون فيه ترك القتال في الفتنة والإمساك عما شجر بين الصحابة، ثم إن أهل المدينة يرون قتال من خرج عن الشريعة كالحرورية وغيرهم، ويفرقون بين هذا وبين القتال في الفتنة، وهو مذهب فقهاء الحديث، وهذا هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين فإنه قد ثبت عنه الحديث في الخوارج من عشرة أوجه خرجها مسلم في صحيحه وخرج البخاري بعضها…وقد ثبت اتفاق الصحابة على قتالهم وقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر فيهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتضمنة لقتالهم، وفرح بقتلهم وسجد لله شكرا لما رأى أباهم مقتولا، وهو ذو الثدية، بخلاف ما جرى يوم الجمل وصفين؛ فإن عليا لم يفرح بذلك بل ظهر منه من التألم والندم ما ظهر، ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سنة بل ذكر أنه قاتل باجتهاده، فأهل المدينة اتبعوا السنة في قتال المارقين من الشريعة، وترك القتال في الفتنة، وعلى ذلك أئمة أهل الحديث، بخلاف من سوى بين قتال هؤلاء وهؤلاء، بل سوى بين قتال هؤلاء وقتال الصديق لمانعي الزكاة، فجعل جميع هؤلاء من باب البغاة كما فعل ذلك من فعله من المصنفين في قتال أهل البغي؛ فإن هذا جمع بين ما فرق الله بينهما، وأهل المدينة والسنة فرقوا بين ما فرق الله بينه، واتبعوا النص الصحيح، والقياس المستقيم العادل ؛ فإن القياس الصحيح من العدل وهو : التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المتخالفين، وأهل المدينة أحق الناس باتباع النص الصحيح والقياس العادل).
المعنى الثالث: سل السيف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الذي عناه الإمام أبو الحسن الأشعري ـ في مقالات الإسلاميين (1/451) ـ (واختلف الناس في السيف على أربعة أقاويل :
1 ـ فقالت المعتزلة والزيدية والخوارج وكثير من المرجئة ذلك واجب إذا أمكننا أن نزيل بالسيف أهل البغي ونقيم الحق واعتلوا بقول الله عز و جل {وتعاونوا على البر والتقوى} وبقوله {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} واعتلوا بقول الله عز وجل {لا ينال عهدي الظالمين}
2 ـ وقالت الروافض بإبطال السيف ولو قتلت حتى يظهر الإمام فيأمر بذلك.
3 ـ وقال أبو بكر الأصم ومن قال بقوله السيف إذا اجتمع على إمام عادل يخرجون معه فيزيل أهل البغي.
4 ـ وقال قائلون السيف باطل ولو قتلت الرجال وسبيت الذرية، وأن الإمام قد يكون عادلا ويكون غير عادل، وليس لنا إزالته وإن كان فاسقا وأنكروا الخروج على السلطان ولم يروه وهذا قول أصحاب الحديث).
ولم يستوعب الأشعري المقالات هنا وقد استوعبها أبو محمد ابن حزم وفصل القول فيها وبيان حججها ـ في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/132) ـ فقال:
(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : قال أبو محمد اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم لقول الله تعالى {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} ثم اختلفوا في كيفيته:
1 ـ فذهب بعض أهل السنة من القدماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم وهو قول أحمد بن حنبل وغيره وهو قول سعد بن أبي وقاص وأسامة ابن زيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى أن الفرض من ذلك إنما هو بالقلب فقط ولا بد، وباللسان إن قدر على ذلك، ولا يكون باليد ولا بسل السيوف ووضع السلاح أصلا، وهو قول أبي بكر ابن كيسان الأصم، وبه قالت الروافض كلهم ولو قتلوا كلهم إلا أنها لم تر ذلك إلا ما لم يخرج الناطق فإذا خرج وجب سل السيوف حينئذ معه، وإلا فلا، واقتدى أهل السنة في هذا بعثمان رضي الله عنه، وممن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم، وبمن رأى القعود منهم، إلا أن جميع القائلين بهذه المقالة من أهل السنة إنما رأوا ذلك ما لم يكن عدلا، فإن كان عدلا وقام عليه فاسق وجب عندهم بلا خلاف سل السيوف مع الإمام العدل، وقد روينا عن ابن عمر أنه قال لا أدري من هي الفئة الباغية ولو علمنا ما سبقتني أنت ولا غيرك إلى قتالها.
قال أبو محمد وهذا الذي لا يظن بأولئك الصحابة رضي الله عنهم غيره.
2 ـ وذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك، قالوا فإذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا ييئسون من الظفر ففرض عليهم ذلك، وإن كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد، وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وكل من كان معهم من الصحابة، وقول معاوية وعمرو والنعمان بن بشير وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول عبد الله بن الزبير ومحمد والحسن بن علي وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار والقائمين يوم الحرة رضي الله عن جميعهم أجمعين، وقول كل من قام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عنهم جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين كعبد الرحمن ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير وابن البحتري الطائي وعطاء السلمي الأزدي والحسن البصري ومالك بن دينار ومسلم بن بشار وأبي الحوراء والشعبي وعبد الله بن غالب وعقبة بن عبد الغافر وعقبة بن صهبان وماهان والمطرف بن المغيرة ابن شعبة وأبي المعد وحنظلة بن عبد الله وأبي شيخ الهنائي وطلق بن حبيب والمطرف بن عبد الله ابن الشخير والنضر بن أنس وعطاء بن السائب وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبي الهوجاء وجبلة بن زحر وغيرهم، ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر وكعبد الله بن عمر ومحمد بن عجلان، ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر ومطر، ومن أخرج مع إبراهيم بن عبد الله، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن حيي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابهم.
فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك في فتواه وإما الفاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رآه منكرا.
قال أبو محمد احتجت الطائفة المذكورة أولا بأحاديث فيها أنقاتلهم يا رسول الله؟ قال (لا ما وصلوا) وفي بعضها (إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان) وفي بعضها وجوب الصبر وإن ضرب ظهر أحدنا وأخذ ماله، وفي بعضها (فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فاطرح ثوبك على وجهك وقل إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار) وفي بعضها (كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل) وبقوله تعالى {واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر} الآية.
قال أبو محمد كل هذا لا حجة لهم فيه لما قد تقصيناه غاية التقصي خبرا خبرا بأسانيدها ومعانيها في كتابنا الموسوم بـ (الاتصال إلى فهم معرفة الخصال) ونذكر منه إن شاء الله هاهنا جملا كافية، أما أمره صلى الله عليه وسلم بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر فإنما ذلك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك بحق، وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا الصبر له، وإن من امتنع من ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب عليه، فهو فاسق عاص لله تعالى، وأما إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك، برهان هذا قول الله عز وجل {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} وقد علمنا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام ربه تعالى قال الله عز وجل {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} وقال تعالى {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} فصح أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو وحي من عند الله عز وجل ولا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض, فإذا كان هذا كذلك فيقين لا شك فيه يدري كل مسلم أن أخذ مال مسلم أو ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حق إثم وعدوان وحرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم) فإذ لا شك في هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين، فالمسلم ماله للآخذ ظلما، وظهره للضرب ظلما، وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأي وجه أمكنه، معاون لظالمه على الإثم والعدوان، وهذا حرام بنص القرآن، وأما سائر الأحاديث التي ذكرنا وقصة ابني آدم فلا حجة في شيء منها، أما قصة ابني آدم فتلك شريعة أخرى غير شريعتنا، قال الله عز وجل {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا}، وأما الأحاديث فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ليس وراء ذلك من الإيمان شيء) وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا طاعة في معصية إنما الطاعة في الطاعة) (وعلى أحدكم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) وأنه عليه السلام قال (من قتل دون ماله فهو شهيد، والمقتول دون دينه شهيد، والمقتول دون مظلمة شهيد) وقال عليه السلام (لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده) فكان ظاهر هذه الأخبار معارضا للآخر فصح أن إحدى هاتين الجملتين ناسخة للأخرى، لا يمكن غير ذلك، فوجب النظر في أيهما هو الناسخ، فوجدنا تلك الأحاديث التي منها النهي عن القتال موافقة لمعهود الأصل، ولما كانت الحال فيه في أول الإسلام بلا شك، وكانت هذه الأحاديث الأخر واردة بشريعة زائدة وهي القتال، هذا ما لا شك فيه، فقد صح نسخ معنى تلك الأحاديث ورفع حكمها، حين نطقه عليه السلام بهذه الأخر بلا شك، فمن المحال المحرم أن يؤخذ بالمنسوخ ويترك الناسخ، وأن يؤخذ الشك ويترك اليقين، ومن ادعى أن هذه الأخبار بعد أن كانت هي الناسخة فعادت منسوخة فقد ادعى الباطل وقفا ما لا علم له به، فقال على الله ما لم يعلم وهذا لا يحل، ولو كان هذا لما أخلا الله عز و جل هذا الحكم عن دليل وبرهان يبين به رجوع المنسوخ ناسخا لقوله تعالى في القرآن {تبيانا لكل شيء}.
وبرهان آخر وهو أن الله عز وجل قال {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء} لم يختلف مسلمان في أن هذه الآية التي فيها فرض قتال الفئة الباغية محكمة غير منسوخة، فصح أنها الحاكمة في تلك الأحاديث، فما كان موافقا لهذه الآية فهو الناسخ الثابت، وما كان مخالفا لها فهو المنسوخ المرفوع، وقد ادعى قوم أن هذه الآية وهذه الأحاديث في اللصوص دون السلطان.
قال أبو محمد وهذا باطل متيقن لأنه قول بلا برهان، وما يعجز مدع أن يدعي في تلك الأحاديث أنها في قوم دون قوم، وفي زمان دون زمان، والدعوى دون برهان لا تصح، وتخصيص النصوص بالدعوى لا يجوز، لأنه قول على الله تعالى بلا علم، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سائلا سأله عن من طلب ماله بغير حق؟ فقال عليه السلام (لا تعطه) قال فإن قاتلني؟ قال (قاتله) قال فإن قتله؟ قال (إلى النار) قال فإن قتلني؟ قال (فأنت في الجنة)، وصح عنه عليه السلام أنه قال (المسلم أخو المسلم لا يسلبه ولا يظلمه) وقد صح أنه عليه السلام قال في الزكاة (من سألها على وجهها فليعطها ومن سألها على غير وجهها فلا يعطها) وهذا خبر ثابت عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يبطل تأويل من تأول أحاديث القتال عن المال على اللصوص، لأنهم لا يطلبون الزكاة، وإنما يطلبها السلطان، فاقتصر عليه السلام معها إذا سألها على غير ما أمر به عليه السلام.
قال أبو محمد وما اعترضوا به من فعل عثمان فما علم قط أنه يقتل، وإنما كان يراهم يحاصرون فقط، وهم لا يرون هذا اليوم للإمام العدل، بل يرون القتال معه ودونه فرضا، فلا حجة لهم في أمر عثمان رضي الله عنه.
وقال بعضهم أن في القيام إباحة الحريم وسفك الدماء وأخذ الأموال وهتك الأستار وانتشار الأمر!
فقال لهم الآخرون كلا لأنه لا يحل لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يهتك حريما، ولا أن يأخذ مالا بغير حق، ولا أن يتعرض لمن لا يقاتله، فإن فعل شيئا من هذا فهو الذي فعل ما ينبغي أن يغير عليه، وإما قتاله أهل المنكر قلوا أو كثروا فهذا فرض عليه، وأما قتل أهل المنكر الناس، وأخذهم أموالهم، وهتكهم حريمهم، كله من المنكر الذي يلزم الناس تغييره، وأيضا فلو كان خوف ما ذكروا مانعا من تغيير المنكر ومن الأمر بالمعروف لكان هذا بعينه مانعا من جهاد أهل الحرب، وهذا ما لا يقوله مسلم، وإن أدى ذلك إلى سبي نساء المؤمنين وأولادهم، وأخذ أموالهم، وسفك دمائهم، وهتك حريمهم، ولا خلاف بين المسلمين في أن الجهاد واجب مع وجود هذا كله، ولا فرق بين الأمرين، وكل ذلك جهاد ودعاء إلى القرآن والسنة.
فإن قالوا لا يجوز القيام عليه، وأجازوا الصبر على هذا، خالفوا الإسلام جملة، وانسلخوا منه.
وإن قالوا بل يقام عليه ويقاتل، وهو قولهم، قلنا لهم فان قتل تسعة أعشار المسلمين أو جميعهم إلا واحد منهم، وسبى من نسائهم كذلك، وأخذ من أموالهم كذلك، فان منعوا من القيام عليه تناقضوا، وان أوجبوا سألناهم عن أقل من ذلك، ولا نزال نحيطهم إلى أن نقف بهم على قتل مسلم واحد أو على امرأة واحدة، أو على أخذ مال أو على انتهاك بشرة بظلم، فان فرقوا بين شيء من ذلك تناقضوا وتحكموا بلا دليل، وهذا مالا يجوز، وان أوجبوا إنكار كل ذلك رجعوا إلى الحق.
ونسألهم عمن غصب سلطانه الجائر الفاجر زوجته وابنته وابنه ليفسق بهم أو ليفسق به بنفسه، أهو في سعة من إسلام نفسه وامرأته وولده وابنته للفاحشة أم فرض عليه أن يدفع من أراد ذلك منهم؟
فإن قالوا فرض عليه إسلام نفسه وأهله أتوا بعظيمة لا يقولها مسلم، وان قالوا بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل رجعوا إلى الحق ولزم ذلك كل مسلم في كل مسلم وفي المال كذلك.
قال أبو محمد : والواجب إن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك، ويمنع منه، فان امتنع وراجع الحق، وأذعن للقود من البشرة، أو من الأعضاء، ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه، فلا سبيل إلى خلعه، وهو إمام كما كان، لا يحل خلعه، فان امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه، ولم يراجع، وجب خلعه، وإقامة غيره ممن يقوم بالحق، لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع).
المعنى الرابع : سل السيف على الأئمة من المسلمين، والخروج عليهم ونزع طاعتهم، وهو على قسمين :
الأول : الخروج على إمام عادل اختارته الأمة بالرضا والشورى، أو عهد إليه بالأمر فرضيته الأمة وظهر عدله، أو إمام تصدى للأمر والأمة في حال فوضى واضطراب حتى جمعها ولم شعثها ووحدها وظهر عدله وفضله ورضيته الأمة، فهذا الذي أجمع أهل السنة وسلف الأمة على تحريم الخروج عليه بأي حال من الأحوال، وأنه إن ضعف أو عجز أو طرأ عليه ما أخرجه عن حد العدالة، فالأمة هي التي تعزله بلا سيف ولا فتنة، وكل من خرج على الإمام الشرعي العادل الذي أجمعت عليه الأمة ورضيت به فهو خارجي، كما قال الشهرستاني ـ في الملل والنحل (1/ 113) ـ (كل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان).
الثاني : الخروج على الإمام الجائر، كما قال الطحاوي (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ما لم يأمروا بمعصية).
والإمام الجائر هو كل من اغتصب الإمامة قهرا بالسيف بلا رضا الأمة ولا شورها، أو من اختارته الأمة ثم جار عليها وتتابع ظلمه حتى غلب على أحواله ولم تستطع عزله إلا بالسيف والقتال، وهذا هو الذي اختلف فيه أهل السنة والجماعة كما اختلف فيه سلف الأمة، ومنهم من يجري الخلاف في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا، والصحيح أن هذه المسألة أخص من مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأشد خطرا، ويجري فيها النظر الفقهي والمصلحي أكثر من النظر العقائدي.
قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الشافعي (ت 478هـ) ـ كما في غياث الأمم (ص126) :(الخلع إلى من إليه العقد [أي أهل الحل والعقد]) ثم قال عن طروء تغيّير على حال الإمام :
(فأما إذا تواصل منه العصيان، وفشا منه العدوان، وظهر الفساد، وتعطلت الحقوق والحدود، وارتفعت الصيانة، ووضحت الخيانة، واستجرأ الظلمة، ولم يجد المظلوم منتصفا ممن ظلمه، وتداعى الخلل إلى عظائم الأمور، وتعطيل الثغور، فلابد من استدراك هذا الأمر المتفاقم، وذلك أن الإمامة إنما تعنى لنقيض هذه الحالة، فإذا أفضى الأمر إلى خلاف ما تقتضيه الزعامة والإيالة ـ أي السياسة ـ فيجب استدراكه لا محالة، وترك الناس سدى ملتطمين لا جامع لهم على الحق والباطل أجدى لهم من تقريرهم على اتباع ونصب من هو عون الظالمين، وملاذ الغاشمين، ومعتصم المارقين، فإن تيسر نصب إمام مستجمع للخصال المرضية تعين البدار إلى اختياره، وإن علمنا أنه لا يتأتى نصب إمام دون إراقة دماء، ومصادمة أهوال، وإهلاك أنفس، ونزف أموال، فالوجه أن يقاس ما الناس مدفوعون إليه، فإن كان الواقع الناجز أكثر [ضررًا] مما يقدر وقوعه، فيجب احتمال المتوقع لدفع البلاء الناجز، ومبنى هذا على طلب مصلحة المسلمين وارتياد الأنفع لهم، واعتماد خير الشرين إذا لم يتمكن من دفعهما جميعًا، فالمتصدي للإمامة إذا عظمت جنايته، وكثرت عاديته، وتتابعت عثراته، وخيف بسببه ضياع البيضة، وتبدد دعائم الإسلام، ولم نجد من ننصبه للإمامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة، فإن اتفق رجل مطاع، ذو أتباع وأشياع، يقوم محتسبًا آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، وانتصب لكفاية المسلمين ما دفعوا إليه، فليمض في ذلك والله نصيره).
بل إن الفقهاء اختلفوا في الإمام العدل إذا فقد شرطا من شروط الإمامة كالاجتهاد هل تصح إمامته أم لا؟ وهل تجب طاعته أم لا؟ دع عنك شرط العدالة!
كما قال الإمام الغزالي (ت 555) ـ في الاقتصاد في الاعتقاد (ص77) ـ في مسألة ما إذا مات الإمام ولم تستطع الأمة انتخاب خليفة له بالشورى والاختيار، واضطربت أحوالها، وتصدى للأمر ذو كفاية واقتدار، وجمع شملها إلا أنه فاقد لشرط الاجتهاد:
(فإن قيل: فإن كان المقصود حصول ذي رأي مطاع يجمع شتات الآراء ويمنع الخلق من المحاربة والقتال ويحملهم على مصالح المعاش والمعاد، فلو انتهض لهذا الأمر من فيه الشروط كلها سوى شروط القضاء، ولكنه مع ذلك يراجع العلماء ويعمل بقولهم فماذا ترون فيه، أيجب خلعه ومخالفته أم تجب طاعته ؟ قلنا: الذي نراه ونقطع أنه يجب خلعه إن قدر على أن يستبدل عنه من هو موصوف بجميع الشروط من غير إثارة فتنة وتهييج قتال، وإن لم يكن ذلك إلا بتحريك قتال وجبت طاعته وحكم بإمامته، لأن ما يفوتنا من المصارفة بين كونه عالماً بنفسه أو مستفتياً من غيره دون ما يفوتنا بتقليد غيره إذا افتقرنا إلى تهييج فتنة لا ندري عاقبتها، وربما يؤدي ذلك إلى هلاك النفوس والأموال، وزيادة صفة العلم إنما تراعى مزية وتتمة للمصالح فلا يجوز أن يعطل أصل المصالح في التشوق إلى مزاياها وتكملاتها).
وقد سبق تعريف الخلافة وأنها رئاسة عامة للإمام على الأمة بالشورى والرضا والاختيار، وقد أجمعت الأمة على اشتراط العدالة ابتداء عند اختيار الإمام، ولا خلاف بين الأئمة وسلف الأمة أنه يشترط فيمن يترشح لها أن يكون مسلما عدلا كفؤا، والعدالة وصف قائم بمن اتصف بها تتمثل في أدائه للواجبات، واجتنابه المحرمات، واشتهاره بالصدق والأمانة، وحسن السيرة والصيانة، وكذلك هي شرط أثناء قيامه بأعباء الإمامة، وإنما اختلف أهل السنة فيمن طرأ عليه الفسق وخرج عن حد العدالة بجور أو فجور، هل يخرج بذلك عن كونه إماما؟ أم لا بد للأمة من عزله؟ وإذا لم تفعل أو لم تستطع هل يظل إماما واجب الطاعة؟ وهل يجب الخروج عليه بالسيف؟
ففي حال السعة والاختيار وقدرة الأمة على إقامة حكم الله في الإمام فالواجب هو ما ذكره ابن حزم من أنه يخاطب الإمام بذلك ليقام عليه الحق أو الحد، فإن نفذ ذلك عليه فهو على إمامته ورئاسته، إذ حكم الله فوق الحاكم والمحكوم والجميع تحت حكم الشريعة سواء، كما قال عبد القاهر البغدادي في أصول الدين (ص 378) (فمتى أقام الإمام في الظاهر على موافقة الشريعة كان أمره في الإمامة منتظما، ومتى زاغ عن ذلك كانت الأمة عيارا عليه في العدول به من خطئه إلى الصواب، أو في العدول عنه إلى غيره، وسبيلهم معه فيها كسبيله مع خلفائه وقضاته وعماله وسعاته إن زاغوا عن سننه عدل بهم أو عدل عنهم).
أي أن الأمة قيم على الإمام تراقبه وتقومه وتحتسب عليه فإن زاغ وجار عن الحق كانت الأمة عيارا عليه وحكما فيه، فتعدله عن الخطأ وترده إلى الصواب، أو تعدل عنه إلى غيره فتعزله، كما قال أبو بكر (فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم).
والأمة مع الإمام في محاسبتها لها كوكيل عنها كالإمام مع نوابه ومساعديه كوكلاء عنه، فإن زاغوا ومالوا عن الحق كان للإمام أن يصرفهم إلى الحق أو يصرفهم من المسئولية ويأتي بغيرهم، فالإمام مسئول عن وكلائه وتصرفاته لأنه اختارهم، والأمة مسئولة عن الإمام وتصرفاته لأنها التي تختاره.
أما في حال الضيق والاضطرار إذا كان الإمام قاهرا للأمة مغتصبا للسلطة بحيث لا تستطيع الأمة أن تخاطبه فهذه مواطن اجتهاد ونظر وقد فصل أبو بكر الجصاص الفقيه والمفسر الحنفي في هذه المسألة أحسن تفصيل ـ في أحكام القرآن (1/86) ـ وذكر مذهب أبي حنيفة فقال في اشتراط العدالة ابتداء في الإمام :
(لم يخل قوله تعالى {لا ينال عهدي الظالمين} من أن يريد أن الظالمين غير مأمورين، أو أن الظالمين لا يجوز أن يكونوا بمحل من يقبل منهم أوامر الله تعالى وأحكامه، ولا يؤمنون عليها، فلما بطل الوجه الأول لاتفاق المسلمين على أن أوامر الله تعالى لازمة للظالمين كلزومها لغيرهم، وأنهم إنما استحقوا سمة الظلم لتركهم أوامر الله ثبت الوجه الآخر، وهو أنهم غير مؤتمنين على أوامر الله تعالى، وغير مقتدى بهم فيها، فلا يكونون أئمة في الدين، فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق، وأنه لا يكون خليفة، وأن من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه ولا طاعته، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، ودل أيضا على أن الفاسق لا يكون حاكما ـ أي قاضيا ـ وأن أحكامه لا تنفذ إذا ولي الحكم، وكذلك لا تقبل شهادته، ولا خبره إذا أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فتياه إذا كان مفتيا، وأنه لا يقدم للصلاة، وإن كان لو قدم واقتدى به مقتد كانت صلاته ماضية، فقد حوى قوله {لا ينال عهدي الظالمين} هذه المعاني كلها.
ومن الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة تجويز إمامة الفاسق وخلافته، وأنه يفرق بينه وبين الحاكم فلا يجيز حكمه، وذكر ذلك عن بعض المتكلمين وقد كذب في ذلك وقال بالباطل، ولا فرق عند أبي حنيفة بين القاضي وبين الخليفة في أن شرط كل واحد منهما العدالة، وأن الفاسق لا يكون خليفة، ولا يكون حاكما، كما لا تقبل شهادته ولا خبره لو روى خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون خليفة وروايته غير مقبولة، وأحكامه غير نافذة، وكيف يجوز أن يدعى ذلك على أبي حنيفة وقد أكرهه ابن هبيرة في أيام بني أمية على القضاء وضربه فامتنع من ذلك وحبس..).
ثم ذكر أبو بكر الجصاص مذهب أبي حنيفة في الإمام الجائر وإيجابه الخروج عليه فقال: (وكان مذهبه مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجور، ولذلك قال الأوزاعي احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف يعني قتال الظلمة فلم نحتمله، وكان من قوله وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض بالقول، فإن لم يؤتمر له فبالسيف على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله إبراهيم الصائغ وكان من فقهاء أهل خراسان ورواة الأخبار ونساكهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال هو فرض، وحدثه بحديث عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتل) فرجع إبراهيم إلى مرو وقام إلى أبي مسلم صاحب الدولة فأمره ونهاه وأنكر عليه ظلمه وسفكه الدماء بغير حق، فاحتمله مرارا ثم قتله، وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته والقتال معه، وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن، وقال لأبي إسحق الفزاري حين قال له لم أشرت على أخي بالخروج مع إبراهيم حتى قتل؟ قال مخرج أخيك أحب إلي من مخرجك، وكان أبو إسحق قد خرج إلى البصرة وهذا إنما أنكره عليه أغمار أصحاب الحديث الذين بهم فُقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تغلب الظالمون على أمور الإسلام، فمن كان هذا مذهبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف يرى إمامة الفاسق؟!).
ثم فسر أبو بكر الجصاص مذهب أبي حنيفة وأن التعامل بالواقعية السياسية لا تقتضي الاعتراف للإمام الجائر بالشرعية، حيث رد على من غلط على أبي حنيفة وأهل العراق ولم يفهم مذهبهم كيف يسوغون تولي القضاء للإمام الجائر (فإنما غلط من غلط في ذلك من جهة قوله وقول سائر من يعرف قوله من العراقيين أن القاضي إذا كان عدلا في نفسه فولي القضاء من قبل إمام جائر أن أحكامه نافذة وقضاياه صحيحة، وأن الصلاة خلفهم جائزة مع كونهم ـ أي الأئمة ـ فساقا وظلمة، وهذا مذهب صحيح ولا دلالة فيه على أن من مذهبه تجويز إمامة الفاسق، وذلك لأن القاضي إذا كان عدلا فإنما يكون قاضيا بأن يمكنه تنفيذ الأحكام وكانت له يد وقدرة على من امتنع من قبول أحكامه حتى يجبره عليها، ولا اعتبار في ذلك بمن ولاه، لأن الذي ولاه إنما هو بمنزلة سائر أعوانه وليس شرط أعوان القاضي أن يكونوا عدولا، ألا ترى أن أهل بلد لا سلطان عليهم لو اجتمعوا على الرضا بتولية رجل عدل منهم القضاء حتى يكونوا أعوانا له على من امتنع من قبول أحكامه لكان قضاؤه نافذا وإن لم يكن له ولاية من جهة إمام ولا سلطان، وعلى هذا تولى شريح وقضاة التابعين القضاء من قبل بني أمية، وقد كان شريح قاضيا بالكوفة إلى أيام الحجاج …وقد كان الحسن وسعيد بن جبير والشعبي وسائر التابعين يأخذون أرزاقهم من أيدي هؤلاء الظلمة لا على أنهم كانوا يتولونهم ولا يرون إمامتهم، وإنما كانوا يأخذونها على أنها حقوق لهم في أيدي قوم فجرة، وكيف يكون ذلك على وجه موالاتهم وقد ضربوا وجه الحجاج بالسيف وخرج عليه من القراء أربعة آلاف رجل هم خيار التابعين وفقهاؤهم فقاتلوه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بالأهواز ثم بالبصرة ثم بدير الجماجم من ناحية الفرات بقرب الكوفة وهم خالعون لعبد الملك بن مروان لاعنون لهم متبرئون منهم، فليس إذا في ولاية القضاء من قبلهم ولا أخذ العطاء منهم دلالة على توليتهم واعتقاد إمامتهم).
وهذا الذي ذكره الجصاص في مشروعية تولي القضاء للإمام الجائر حكم صحيح، والتعليل الصحيح له هو كون ولاية القاضي مستمدة من الولاية العامة للأمة، والخليفة والسلطان وكيل عنها، فتنفذ أحكام القاضي حتى لو بطلت ولاية الخليفة أو مات أو فقد، لأن الأمة وهي الأصيل موجودة لا تبطل ولايتها بحال من الأحوال، وهذا السبب الذي يفسر تولي كثير من أئمة التابعين لبعض أئمة الجور لأنهم يتولونه لصالح المسلمين وفي ولايتهم وشوكتهم ودولتهم، وأما الإمام فهو فرد منهم قد يتغير وتتقلب فيه الأحوال، وتبقى الأمة والدولة.
وما ذكره الجصاص عن أبي حنيفة وأهل العراق مشهور متواتر عنهم فلا يشكل عليه قول الطحاوي في عقيدته كما سبق عنه، إذ قول الطحاوي (ولو جاروا) أي لو وقع منهم جور على حد لا يخرجهم من وصف العدالة التي تغلب على أحوالهم.
وهذا هو أيضا مذهب مالك والشافعي وداود الظاهري وعامة فقهاء أهل السنة كما ذكره عنهم ابن حزم، وكما هو منصوص في كتب أصحابهم، وهو مشهور عن مالك وهو إمام أهل السنة والجماعة في عصره بلا منازع كما فصلته في الحرية أو الطوفان وتحرير الإنسان.
وأما أهل الحديث فقد قال الإمام الإسماعيلي ـ في اعتقاد أئمة الحديث (ص30) ـ (ويرون جهاد الكفار معهم، وإن كانوا جورة، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم، ولا قتال الفتنة، ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العادل، إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك).
فهنا فصل الإسماعيلي بين ثلاثة أنواع من القتال : الأول قتال أئمة الجور ، والثاني القتال في الفتن، وهذان القسمان محرمان عند أهل الحديث.
والثالث القتال مع الإمام، وهنا فرق بين الجهاد معه في حرب الكفار فيجاهد معه مطلقا برا كان أو فاجرا، والقتال معه ضد البغاة والخارجين عليه، فهنا ذكر أنهم لا يرون القتال معه، بل لا يقاتلون إلا مع الإمام العدل بشروطه وهو أن يدعو البغاة إلى حكم الله ورسوله، فإن كان لهم مظلمة ردها، وإن كانت شبهة كشفها، فإن فاءوا وإلا جاز قتالهم إن لم يندفعوا إلا به.
وهذا الأمر يوافقه عليه عامة أهل السنة والجماعة من أئمة المذاهب الفقهية.
وقال أبو القاسم التيمي الأصبهاني (ت 535) ـ في الحجة في بيان المحجة (2/466) ـ (ومن مذهب أهل السنة: أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وإن كان منهم بعض الجور ما أقاموا الصلاة).
وهذه العبارة تختلف عن عبارة الإسماعيلي من وجهين :
الأول : أنه لم يتحدث عن الجورة وأئمة الجور، وإنما عن الأئمة إذا وقع منهم بعض الجور، وهذا لا يخالف فيه عامة أهل السنة والجماعة، وأن الإمام لا يجوز الخروج عليه لوقوع بعض الجور والظلم الذي لا يصل به إلى حد وصفه بإمام جائر، وهو من فشى ظلمه، وعم جوره، إذ حتى الإمام العدل قد يقع في سلطانه شيء من الجور، ولا يخرج به ذلك من حد العدالة الغالبة على أحواله، فلا يحل الخروج عليه بمجرد وقوع مثل ذلك، وهذه كعبارة الطحاوي (وإن جاروا).
الثاني : ترك الصلاة وهذا القيد ليس المقصود به حتى يكفر ـ إذ الخروج على الكافر وسقوط طاعته، واجب بالنص والإجماع وهو من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة القطعية كما سبق بيانه، إذ لا يتصور أن يجاهد المسلمون عدوهم الكافر الخارجي، والجهاد ماض عندهم إلى يوم القيامة، ويتركون الكافر الداخلي يحكمهم ويسوس أمورهم ـ وإنما نص الأصبهاني على الصلاة لحديث (لا ما صلوا) مع كون تارك الصلاة عند جمهور أهل السنة والجماعة مسلما عاصيا وليس كافرا، وقد سبق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على وجوب قتال الإمام إذا ترك الصلاة بناء على أن تركها كفر عند أحمد وطائفة من أهل السنة، بينما الجمهور يرون أنه مسلم عاص ومع ذلك يرون أنه إذا ترك الصلاة وجب الخروج عليه، أما إذا منع من الحكم بينهم بما أنزل الله وألزم القضاة أن يحكموا بين المسلمين بغير حكم الله فهنا تجاوز أمره ترك الصلاة التي هي عبادة خاصة بينه وبين ربه إلى تعطيل الشريعة كلها التي يلزم الأمة كلها التحاكم إليها طاعة لله ورسوله وتوحيدا لله جل جلاله بالعبودية والطاعة، وهذا أوجب للخروج عليه بلا خلاف بين المسلمين كلهم سنيهم وبدعيهم، كما سبق بيانه!
وكل ما سبق يؤكد أن هناك فرق بين :
1 ـ سل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل القبلة جميعا فهذا محرم بإجماع أهل السنة والجماعة، وهو فعل الحرورية.
2ـ وسل السيف في الفتن بين المسلمين وهو محرم عند جمهور أهل السنة والجماعة وعليه أكثر الصحابة وأهل الحديث وأكثر الفقهاء.
3 ـ وسل السيف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإزالة المنكر دون السلطان إذا لم يغيره الإمام، وقد منع منه بعض السلف وأحمد بن حنبل وأكثر أهل الحديث، وخالفهم أكثر السلف من الصحابة ومن بعدهم من أئمة أهل السنة فرأوا وجوب تغيير المنكر بالقوة إذا لم يمنعه الإمام كما نقله عنهم ابن حزم.
مع أن التحقيق والصحيح هو أن مذهب أحمد موافق لمذهب باقي الأئمة في جواز قتال الرجل دون نفسه ومحارمه إذا أريد بظلم، كما يرى جواز تغيير المنكر باليد دون استخدام السيف، كما حرره ابن رجب في الآداب الشرعية وغيره من المحققين في المذهب.
4 ـ وسل السيف على الإمام الجائر وخلعه وهي فرع المسألة الثالثة، والخلاف فيها مشهور بين أئمة أهل السنة، فمن منع منه ـ كأحمد بن حنبل ـ فلأنه عده من القتال في الفتن، ومن أوجبه أو أجازه ـ كأبي حنيفة ومالك والشافعي وداود الظاهري ـ فلأنه من النهي عن المنكر، هذا إذا كان تغيير الجائر لا يكون إلا بالقوة، أما إذا كانت الأمة من القوة والقدرة بالمكان الذي يؤهلها من عزله بلا قتال فلا خلاف بينهم جميعا على وجوب عزله وتولية العدل، وهذا كله في ظل خلافة الإسلام وظهور الأحكام.
وكل ما سبق ذكره من أصول عقائدية سياسية عند أهل السنة والجماعة تم طمسها وتغييبها، في عصور التخلف والانحطاط، وبلغ ذروته بعد سقوط بغداد على يد المغول، وذهب العلم ودرست معالمه، وتعطلت علومه ومدارسه، وبدأ الانحراف والتطرف يزداد في خطاب الطوائف السنية، الفقهية والحديثية والصوفية، حتى تصدى لها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ما سنفصل القول فيه لاحقا فللحديث بقية!
8 – أهل السنة والجماعة إشكالية الشعار وجدلية المضمون
أهل السنة وملامح الإنحراف
(1)
بقلم د. حاكم المطيري
تعرض المسلمون ـ وعامتهم من أهل السنة والجماعة ـ إلى فترات تاريخية عصيبة وتحديات كبرى، كالحروب الصليبية في القرن الخامس الهجري التي قضت على معاهد العلم ومدارسه في سواحل الشام مدة قرن أو يزيد، حتى حررها صلاح الدين الأيوبي، ثم كان أبرز تلك الفواجع سقوط العالم الإسلامي الشرقي كله من بخارى إلى بغداد، في القرن الهجري السابع على يد حملات جنكيز خان المغولي وأتباعه، وبلغ السقوط ذروته حين احتلوا عاصمة العالم الإسلامي وحاضرة الخلافة العباسية مدينة السلام بغداد سنة 656 هـ، حيث قتلوا الخليفة المستنصر العباسي وآل البيت الشريف، وسبوا حرائر بيت الخلافة، وبلغ القتلى في بغداد وحدها مليوني مسلم، وكانت أحداثا كبرى تشيب لها الولدان، حتى عدها المؤرخون المعاصرون لها كالقرطبي بأنها نهاية العالم وقرب قيام الساعة لهول المصيبة، وقد فنى فيها كثير من العلماء، ودرست محاضن العلم ومحاضره في الشرق الإسلامي، حيث كانت جيوش المغول تحرق المدن والمكتبات والمدارس والمساجد، فأفلت شمس المشرق الإسلامي منذ ذلك الحين، وشاعت البدع والخرافات بعد ذلك تحت حكم الممالك المغولية في الشرق، فاستعصم المسلمون بالشام أرض الرباط، ومن ورائها مصر التي انتقلت إليها الخلافة العباسية، وقام المماليك بحماية الإسلام وخلافته، فتصدى المجاهد البطل السلطان قطز للمغول في عين جالوت وهزمهم، وأوقف مدهم الزاحف، وتنفس المسلمون الصعداء، غير أن تلك النوازل القوارع، والمصائب والفواجع كانت بداية سقوط الحضارة الإسلامية على المستوى العلمي والمعرفي، حيث أدت إلى شيوع حالة من الجاهلية العلمية والسلوكية والعقائدية، بين أوساط المنتسبين إلى العلم والدين، من المتكلمة والمتفقهة والمتصوفة والساسة، كما قال ابن أبي العز الحنفي (ت792) في شرح العقيدة الطحاوية (ص71) (وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إلى الدين، فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة والسياسة، أو نسبوا إلى الشريعة بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها، فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق، ودرس كثير من علم الرسالة النبوية)!
وقد كان أهل السنة على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم ومدارسهم عرضة للانحرافات بسبب دروس العلم وشيوع التقليد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ في الفتاوى (13/64-66) ـ(فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهرا لهم، ودق على كثير من الناس ما كان جليا لهم، فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف، وإن كانوا مع هذا مجتهدين معذورين يغفر الله لهم خطاياهم، ويثيبهم على اجتهادهم، وقد يكون لهم من الحسنات ما يكون للعامل منهم أجر خمسين رجلا يعملها في ذلك الزمان؛ لأنهم كانوا يجدون من يعينهم على ذلك وهؤلاء المتأخرون لم يجدوا من يعينهم على ذلك).
وقد خالف كثير من أهل السنة في العصور المتأخرة أصول أهل السنة والجماعة وما كان عليه سلف الأمة، وكثر فيهم الابتداع، وافترقوا أشد الافتراق، حتى كفر بعضهم بعضا في عصور انحطاطهم كما جرى بين الشافعية والحنفية، وبين الحنبلية والأشعرية، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ في الفتاوى(3/383) ـ (فإذا كان على عهد رسول الله وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة؛ حتى أمر النبي بقتالهم، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة، حتى يدَّعي السنة من ليس من أهلها، بل قد مرق منها، وذلك بأسباب… منها التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز).
وقال أيضا ـ الفتاوى (20/184-185) ـ (المنحرفون من أتباع الأئمة في الأصول والفروع، المنتسبين إلى أحمد وغير أحمد، انحرافهم أنواع: … الثالث: قول قاله الإمام فزيد عليه قدرا أو نوعا، كتكفيره نوعا من أهل البدع كالجهمية، فيجعل البدع نوعا واحدا حتى يدخل فيه المرجئة والقدرية، أو ذمه لأصحاب الرأي بمخالفة الحديث والإرجاء، فيخرج ذلك إلى التكفير واللعن، أو رده لشهادة الداعية وروايته، وغير الداعية في بعض البدع الغليظة، فيعتقد رد خبرهم مطلقًا، مع نصوصه الصرائح بخلافه).
ومن أبرز ملامح الانحراف ومظاهره عند طوائف أهل السنة والجماعة المتأخرين والمعاصرين:
أولا : الانحراف العقائدي :
ومن ذلك :
1 ـ شيوع ظاهرة إكفار المخالفين من طوائف المسلمين حتى من المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة، إذ صاروا يتنازعون فيما بينهم أيهم أحق بهذا الاسم من غيره، وصار بعض أهل الحديث والحنابلة يبالغون في الإثبات وفي الرد على المخالفين حتى ربما كفروهم، وربما اخترعوا الرأي وابتدعوه ثم روجوه باسم السنة وسلف الأمة، احتجاجا بضعيف المنقول وسخيف المعقول، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وصار أهل الرأي والمتكلمون يبالغون في التأويل والرد على المخالفين حتى كفروهم، فخرجت الطائفتان بذلك عن أصل من أصول السنة وما كان عليه سلف الأمة، وهو عدم الحكم بالكفر على أهل القبلة فضلا عن المخالف من أهل السنة!
وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية أشهر من تصدى لهذه الانحرافات وزيفها وأثبت بطلانها وأبان عن أسباب وقوعها حيث قال ـ كما في الصفدية 1/392 ـ (وإنما جماع الشَّر تفريط في حق أو تعدي إلى باطل، وهو تقصير في السنة أو دخول في البدعة، كترك بعض المأمور وفعل بعض المحظور، أو تكذيب بحق وتصديق بباطل، ولهذا عامة ما يؤتى الناس من هذين الوجهين: فالمنتسبون إلى أهل الحديث والسنة والجماعة يحصل من بعضهم، تفريط في معرفة النصوص أو فهم معناها أو القيام بما تستحقه من الحجة ودفع معارضها، فهذا عجز وتفريط في الحق، وقد يحصل منهم دخول في باطل: إما في بدعة ابتدعها أهل البدع وافقوهم عليها، واحتاجوا إلى إثبات لوازمها، وأما في بدعة ابتدعوها هم لظنهم أنها من تمام السنة).
وقال أيضا ـ في الفتاوى 4/23-25 ـ (وإذا قابلنا بين الطائفتين -أهل الحديث، وأهل الكلام – فالذي يعيب بعض أهل الحديث وأهل الجماعة بحشو القول؛ إنما يعيبهم بقلة المعرفة، أو بقلة الفهم، أما الأول: فبأن يحتجوا بأحاديث ضعيفة أو موضوعة، أو بآثار لا تصلح للاحتجاج، وأما الثاني: فبأن لا يفهموا معنى الأحاديث الصحيحة، بل قد يقولون القولين المتناقضين، ولا يهتدون للخروج من ذلك.
والأمر راجع إلى شيئين: إما زيادة أقوال غير مفيدة يظن أنها مفيدة، كالأحاديث الموضوعة، وإما أقوال مفيدة، لكنهم لا يفهمونها، إذ كان اتِّبَاع الحديث يحتاج أولاً إلى صحة الحديث، وثانياً إلى فهم معناه، كاتباع القرآن، فالخلل يدخل عليهم من ترك إحدى المقدمتين، ومن عابهم من الناس، فإنما يعيبهم بهذا،ولا ريب أن هذا موجود في بعضهم ؛ يحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل “الأصول والفروع”، وبآثار مفتعلة، وحكايات غير صحيحة، ويذكرون من القرآن والحديث مالا يفهمون معناه، وربما تأولوه على غير تأويله، ووضعوه على غير موضعه، ثم إنهم بهذا المنقول الضعيف، والمعقول السخيف، قد يُكَّفِرون ويُضَلِّلون، ويُبَدِّعون أقواماً، من أعيان الأمة، ويُجِّهِلُونهم، ففي بعضهم من التفريط في الحق، والتعدي على الخلق، ما قد يكون بعضه خطأ مغفوراً، وقد يكون منكراً من القول وزوراً، وقد يكون من البدع، والضلالات التي توجب غليظ العقوبات، فهذا لا ينكره إلا جاهل، أو ظالم، وقد رأيت من هذا عجائب، لكن هم بالنسبة إلى غيرهم في ذلك, كالمسلمين بالنسبة إلى بقية الملل، ولا ريب أن في كثير من المسلمين من الظلم، والجهل، والبدع، والفجور مالا يعلمه إلا من أحاط بكل شيء علماً، لكن كل شر يكون في بعض المسلمين، فهو في غيرهم أكثر، وكل خير يكون في غيرهم، فهو فيهم أعلى وأعظم، وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم).
وما ذكره شيخ الإسلام من الغلو والتطرف عند بعض أهل الحديث والسنة كانت بوادره وجذوره موجودة مبكرا ومنذ القرن الثالث، إلا لأنها لم تكن ظاهرة شائعة، فقد كان الإمام البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث من ضحايا هذا التطرف، فقد بدعه وهجره بل وكفره بعض أئمة الحديث والسنة بفتنة (اللفظ بالقرآن) ـ كما في سير الأعلام 12/453 ـ حتى أخرجوه من بلدهم بدعوى أنه جهمي، مع أنه كان في تلك المسألة على الحق وكانوا هم على الخطأ، فخرج طريدا ومات حيدا!
وكذا تعرض ابن جرير الطبري صاحب التفسير لمثل ذلك من بعض أهل الغلو!
وقد بالغ بعضهم في إثبات الصفات بأحاديث ضعيفة، أو بدلالات ضعيفة، وتجاوز إلى حد تبديع المخالف له فيها، وربما كفره، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ في الفتاوى 16/432 ـ (والسنة ينبغي معرفة ما ثبت منها وما علم أنه كذب، فإن طائفة ممن انتسب إلى السنة، وعظم السنة والشرع، وظنوا أنهم اعتصموا في هذا الباب بالكتاب والسنة، جمعوا أحاديث وردت في الصفات، منها ما هو كذب معلوم أنه كذب، ومنها ما هو إلى الكذب أقرب، ومنها ما هو إلى الصحة أقرب، ومنها متردد، وجعلوا تلك الأحاديث عقائد، وصنفوا مصنفات، ومنهم من يكفر من يخالف ما دلت عليه تلك الأحاديث).
وقال رحمه الله ـ في الصفدية 1/163 ـ (لا ننكر ما يوجد في بعض أهل السنة والجماعة من جهل وظلم).
وقال أيضا ـ في الصفدية 2/606 ـ (…وإذا قُدِّر أن في الحنبلية -أو غيرهم من طوائف أهل السنة- من قال أقوالاً باطلة، لم يبطل مذهب أهل السنة والجماعة ببطلان ذلك بل يُرد على من قال ذلك الباطل، وتنصر السنة بالدلائل).
وقال أيضا ـ في منهاج السنة (7/193ـ192) ـ (وأنت تجد كثيرًا من المنتسبين إلى علم ودين لا يكذبون فيما يقولونه، بل لا يقولون إلا الصدق، لكن لا يقبلون ما يخبر به غيرهم من الصدق، بل يحملهم الهوى والجهل على تكذيب غيرهم وإن كان صادقا).
وهذه النصوص المذكورة عن شيخ الإسلام ابن تيمية تؤكد وقوع الانحراف والغلو عند بعض طوائف من أهل السنة والجماعة من أهل العلم والدين من الغالين والمتنطعين، وما تزال هذه الظاهرة إلى اليوم، ثم لا يترددون برمي من خالف آراءهم بالبدع والإخراج من أهل السنة، وقد كان في عصرنا هذا من بدعوا الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني بدعوى المخالفة لقول أهل السنة ومنهج سلف الأمة!
ورأينا من كفر الفرق المخالفة احتجاجا بأصول أهل السنة والجماعة وسلف الأمة!
ولهذا فليس يجب عند أهل السنة والجماعة اتباع أحد كائنا من كان إلا نص من كتاب أو سنة أو إجماع سلف الأمة، فهذه فقط هي الأصول الثلاثة المحفوظة المعصومة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ـ في منهاجه 2/145 ـ (فمذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة، وهو القول المطابق لصحيح المنقول وصريح المعقول).
وقال ـ في الفتاوى 20/164 ودرء التعارض 1/272 ـ (فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة رسوله وما اتفقت عليه الأمة، فهذه الثلاثة هي أصول معصومة).
وكما وقع عند أهل الحديث تطرف وغلو، وقع عند الفقهاء مثله، وربما ادعى بعض أهل السنة من الفقهاء الإجماع على مسائل خلافية فأخرج بها من دائرة أهل السنة المخالفين له بالرأي وقد يكون الصواب فيها معهم!
وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه أحد ضحايا تطرف المنتسبين إلى فقهاء أهل السنة والأئمة الأربعة، حتى كفروه بمسائل فقهية كالطلاق الثلاث وأنها تقع طلقة واحدة، حيث ادعوا الإجماع على هذه المسألة، وكذا كفروه بمسألة شد الرحال إلى القبور، وقد بلغ بهم الغلو والتطرف أن حكم قضاة المذاهب الأربعة بسجنه، ومات سجينا وحيدا!
لقد أدرك شيخ الإسلام ابن تيمية من خلال تجربته أبعاد تلك الأزمة العميقة التي يعيشها أهل السنة والجماعة وظهور الغلو في بعض طوائفهم من أهل الحديث وأهل الرأي ومن المتكلمين فصار يؤكد على بطلان الاعتقاد بأن هناك طائفة من أهل السنة على الحق في كل ما هي عليه، وفي كل ما تقوله، وبين أن الكتاب والسنة والإجماع المعلوم هي الأصول التي يقطع بأنها هي الحق دون الإجماع المظنون أو الموهوم فقال ـ في الفتاوى 20/9 ـ (فمبنى أحكام الدين على ثلاثة أقسام: الكتاب، والسنة، والإجماع.. وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم؛ فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعًا ولا يكون الأمر كذلك، بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة).
ولهذا كان يقرر أن الإجماع المعصوم من الخطأ هو إجماع الصحابة لا إجماع غيرهم لتعذر معرفته فقال ـ في الفتاوى 11/341 ـ (الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة، لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة، وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبًا).
وقد كان من آفات ظاهرة التبديع للمخالف عند هذه الطوائف شيوع حالة من الرضا الكاذب عن النفس عند أتباعها والمنتسبين إليها، والغرور بما عليه هذه الطوائف، وتزكية كل طائفة وفرقة لطريقتها ولنفسها، بدعوى أنهم الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية، بينما كان السلف من الصحابة ومن بعدهم من أئمة التابعين أشد ما يخشون على أنفسهم من النفاق، وكان عمر الفاروق يسأل حذيفة بن اليمان هل ذكره رسول الله في المنافقين!
لقد شاعت هذه الظاهرة في عصرنا الحالي بين كثير من المنتسبين إلى أهل السنة، وهي أثر من آثار ذلك الانحراف العقائدي، إذ عقلية الوصاية والحكم على الآخرين تفضي بأصحابها من حيث لا يشعرون إلى الرضا عن الذات، والاطمئنان إلى ما هم عليه، ثم تنشغل هذه الطوائف عن عيوب نفسها بعيوب الآخرين، وبالرد على المخالفين، فترتكس في حضيض الباطل، من حيث تظن أنها على المحجة البيضاء!
ولهذا يقل فيهم محاسبة الطائفة ونقد الذات، فتتراكم الانحرافات، وتتعاظم المحدثات، حتى تندرس بينهم معالم الدين، وتنطمس حقائق الإيمان، حتى رأينا في هذا العصر من أدعياء العلم من يخرج باسم السنة وسلف الأمة ليقول للمسلمين بأن طاعة الطاغوت ـ الذي يحكم بغير شرع الله ـ بل طاعة كل الطواغيت والرضا بهم والتحاكم إليهم والدعاء لهم كل ذلك من التوحيد والسنة وطريقة سلف الأمة بدعوى أنهم أئمة وولاة أمر!
هذا مع احتجاج الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ في رسالته إلى الشيخ ابن عيسى كما في تاريخ ابن غنام ص 355 ـ بقول ابن القيم في أعلام الموقعين 1/53 (أخبر سبحانه أن من تحاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه قال تعالى {يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به} والطاغوت كل ما تجوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يتبعونه أو يطيعونه…)!
وقد وصل الهوس بهم أن صار كل من يدعو إلى توحيد الله في الحكم وتحكيم شرعه في نظرهم خارجي وحروري، وصاروا يشبهون العلماء المجاهدين الربانيين الذين يدعون إلى الحكم بما أنزل الله بدل القوانين الوضعية، بمن خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب وقالوا لا حكم إلا لله!
ويشبهون ولاة أمرهم وطواغيتهم بالخلفاء الراشدين!
وبلغ بهم الحال أن نفى بعضهم توحيد الله في الحاكمية، لأنهم لا يعرفون ذلك عن شيوخهم وأهل طائفتهم! مع أنه صريح القرآن {إن الحكم إلا لله} وأجمع عليه أهل الإسلام، وهو من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة القطعية، حتى لا يكاد كتاب في أصول الفقه يخلو من تقرير أصل أن الحاكم هو الله وحده، وقد احتج الشيخ محمد بن عبد الوهاب على ابن سحيم ـ كما في تاريخ ابن غنام ص 475 ـ (أنه ذكر أن {قل هو الله أحد} كافية في التوحيد : فوحد نفسه في الأفعال فلا خالق إلا الله، وفي الألوهية فلا يعبد إلا الله، وفي الأمر والنهي فلا حكم إلا لله، فيكرر هذه الأنواع الثلاثة، ثم يكفر بها كلها).
وحتى خرج من هذه الطائفة وعلى مسمعها ومرآها من يقول بأن طاعة بول بريمر الحاكم العسكري الأمريكي المحتل الذي يحكم العراق واجبة وأنها السنة والسلفية فلا يرد عليه من أحبار هذه الطائفة ورهبانها أحد!
وقد بلغ الحال بهم أن ظنوا أن كل ما يقوله علماؤهم هو الحق، بل ربما ظنوا بأن ما اتفقوا عليه إجماع لا يحل مخالفته!
وقد أبطل شيخ الإسلام مثل هذا الادعاء لأي طائفة مهما كانت فقال ـ في التسعينية 3/902 ـ (وليس الحق -أيضًا- لازمًا لطائفة دون غيرها إلا للمؤمنين، فإن الحق يلزمهم، إذ لا يجتمعون على ضلالة، وما سوى ذلك فقد يكون الحق فيه مع الشخص أو الطائفة في أمر دون أمر، وقد يكون المختلفان كلاهما على باطل، وقد يكون الحق مع كل منهما من وجه دون وجه، فليس لأحد أن يسمي طائفة منسوبة إلى إتباع شخص – كائنًا من كان – غير رسول الله بأنهم أهل الحق، إذ ذلك يقتضي أن كل ما هو عليه فهو حق، وكل من خالفهم في شيء من سائر المؤمنين فهو مبطل، وذلك لا يكون إلا إذا كان متبوعهم كذلك، وهذا معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام، ولو جاز ذلك لكان إجماع هؤلاء حجة، إذا ثبت أنهم هم أهل الحق).
ولهذا اعترف شيخ الإسلام مع كونه حنبلي المذهب بأن في الحنابلة مبتدعة، وبأن أحمد بن حنبل مع إمامته في السنة والحديث قد وقع منه ما يقع من مثله من أئمة الدين من الخطأ فليس كل ما يقوله صواب، وهذا غاية العدل والإنصاف من النفس، فقال ـ في الفتاوى 20/186 ـ (وفي الحنبلية أيضا مبتدعة؛ وإن كانت البدعة في غيرهم أكثر، وبدعتهم غالبًا في زيادة الإثبات في حق الله، وفي زيادة الإنكار على مخالفهم بالتكفير وغيره؛ لأن أحمد كان مثبتا لما جاءت به السنة؛ منكرًا على من خالفها، مصيبًا في غالب الأمور، مختلفًا عنه في البعض، ومخالفًا في البعض، وأما بدعة غيرهم فقد تكون أشد من بدعة مبتدعهم في زيادة الإثبات والإنكار؛ وقد تكون في النفي، وهو الأغلب كالجهمية؛ والقدرية؛ والمرجئة، والرافضة، وأما زيادة الإنكار من غيرهم على المخالف من تكفير وتفسيق فكثير).
ولهذا ظل بعض أهل الحديث وبعض الحنابلة إلى اليوم من أكثر المذاهب السنية غلوا في باب الإثبات في الصفات وفي تبديع وإكفار المخالفين من المسلمين، حتى صدر عنهم من الكتب والفتاوى في هذا العصر في كثير من المسائل ما يبرأ من القول به أهل السنة وسلف الأمة!
وتكمن خطورة شيوع ظاهرة إكفار المخالفين من المسلمين في آثارها السياسية على أرض الواقع، إذ صار يستتبع ذلك مواقف سياسية خطيرة أدت إلى سقوط الأمة كلها تحت الاستعمار الخارجي، بل والادعاء بأن سيطرة العدو الكافر أهون من ظهور أهل البدع، حتى صدرت الفتاوى بتحريم الوقوف مع من يقاتل إسرائيل بدعوى أنهم أخطر على الأمة من اليهود! في الوقت الذي لا يرون حرجا على حكوماتهم أن تتحول إلى قواعد عسكرية للحملة الصليبية على العالم الإسلامي لتحتل منها العراق وأفغانستان، ولا يحرمون عليها تحالفها مع الاستعمار في حروبه على الأمة، مع أن كل ذلك ناقض من نواقض الإسلام!
وقد نجحت الحكومات في استغلال هذه الظاهرة وفي توظيف بعض علماء السنة في خدمة أغراضها السياسية، فصارت فتاواهم في الحكم على المخالفين من المسلمين بالشرك والكفر أحد أهم الأدوات لتبرير تخاذل تلك الحكومات عن نصرتهم من جهة، وتسويغ تحالفها مع الدول الصليبية من جهة أخرى، بدعوى دع الله ينتقم من الظالم بظالم مثله!
وتجاوز الأمر إلى تحشيد الجماهير وشحنها بالروح الطائفية لاستثمار ذلك كله لصالح ما يقوم به الاستعمار في المنطقة من فرض سيطرته عليها والتحكم بها، فإذا كان بعض الشيعة وأحزابهم الطائفية الدينية في العراق قد وقفوا مع الاحتلال لتحقيق مصالحهم الطائفية على حساب الأمة ومصالحها الاسترتيجية، ففي الطرف الآخر من يريد توظيف العالم الإسلامي السني وحشده خلف الحكومات العميلة للوقوف خلف أمريكا وحلف النيتو لضرب إيران ومفاعلها النووي لتكريس سيطرتها على الأمة!
وقد سمعنا من شيوخ هذه الطائفة من حاول تبرير تخاذله عن نصرة المسلمين في العراق وأفغانستان بأن أكثرهم مشركون أو مبتدعون!
هذا مع وضوح أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب، واعتقادهم بأن أهل القبلة، على اختلاف طوائفهم، مسلمون لهم حقوق الإسلام، إلا أن المتأخرين من أتباع الأئمة الأربعة، لم يفهموا نصوصهم حين أطلقوا كلمة الكفر على بعض البدع، فحملها المتأخرون على كفر الردة، لا كفر التأويل الذي يعذر صاحبه، كما قال شيخ الإسلام ـ في منهاجه 5/239 ـ (المتأوِّل الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر، بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية، وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفَّر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع، الذين يبتدعون بدعة ويكفّرون من خالفهم، كالخوارج والمعتزلة والجهمية، ووقع ذلك في كثير من اتباع الأئمة، كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وقد يسلكون في التكفير ذلك؛ فمنهم من يكفّر أهل البدع مطلقا، ثم يجعل كل من خرج عمّا هو عليه من أهل البدع، وهذا بعينه قول الخوارج والمعتزلة والجهمية،وهذا القول أيضًا يوجد في طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة، وليس هو قول الأئمة الأربعة ولا غيرهم، وليس فيهم من كفّر كل مبتدع، بل النقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك، ولكن قد ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال، ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليُحذر، ولا يلزم إذا كان القول كفرًا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل؛ فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين، كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، وذلك له شروط وموانع).
وقد احتج شيخ الإسلام على عدم كفرهم، بأن هؤلاء الأئمة الأربعة مع صدور ذلك منهم إلا أنهم ثبت عنهم ثبوتا قطعيا متواترا أنهم يرون صحة الصلاة خلفهم، ويقبلون شهادتهم، وقد اشترط الله في الشهادة العدالة، كما ثبت عنهم أنهم كانوا يرون السمع والطاعة للأئمة منهم، بناء على القول بإسلامهم، كما ثبت عن أحمد مع المأمون والمعتصم والواثق، فقال ـ في الفتاوى(12/487-489) ـ (التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وتكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة: الذين أطلقوا هذه العمومات، لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه، فإن الإمام أحمد – مثلاً- قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن، ونفي الصفات، وامتحنوه وسائر علماء وقته، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس، والقتل والعزل عن الولايات، وقطع الأرزاق، ورد الشهادة، وترك تخليصهم من أيدي العدو، بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم: يكفرون كل من لم يكن جهميًا موافقًا لهم على نفي الصفات، مثل القول بخلق القرآن، ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر، فلا يولونه ولاية، ولا يفتكونه من عدو، ولا يعطونه شيئًا من بيت المال، ولا يقبلون له شهادة، ولا فتيا، ولا رواية، ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادة، والافتكاك من الأسر وغير ذلك، فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيمان، ومن لم يقر به لم يحكموا له بحكم أهل الإيمان، ومن كان داعيًا إلى غير التجهم قتلوه أو ضربوه أو حبسوه، ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم، فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها، وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها، والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب، ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره، ممن ضربه وحبسه، واستغفر لهم، وحللهم مما فعلوه به من الظلم، والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم؛ فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية، الذين كانوا يقولون: القرآن مخلوق، وأن الله لا يرى في الآخرة).
وقال أيضا (ومع ذلك فالإمام أحمد رحمه الله ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك) وكذا احتج شيخ الإسلام بقول الشافعي لحفص الفرد حين قال القرآن مخلوق، فقال الشافعي : كفرت بالله العظيم، ومع ذلك (لم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك، لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله، وقد صرح الشافعي في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء، والصلاة خلفهم، وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد في القدري..) (الفتاوى 23/349).
وقد كان شيخ الإسلام مع شدته على أهل البدع وإطلاقه الحكم العام بكفر بعض أقوالهم لمصادمتها ظاهر القرآن والسنة، إلا أنه لا يرى كفر أعيانهم ولا ردتهم، وقد قال عن نفسه ـ في الرد على البكري (1/377-385) ـ (ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن يكون الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال، وكان هذا خطابًا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم، وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور في معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له، فكان هذا خطابنا…).
فهؤلاء الذين جادلهم شيخ الإسلام في عصره كانوا أشد ضلالا من الجهمية في عصر الإمام أحمد، لما زادوه من القول بالحلول والاتحاد، ومع ذلك لم يحكم بكفرهم، مع أنه حكم على أقوالهم بأنها كفر، بل إنه تدخل لما أراد السلطان أن يقتلهم، ونهاه عن التعرض لهم بالأذية وقال(هؤلاء قضاتك وعلماؤك من لك بعدهم؟) فكانوا يعجبون من شيخ الإسلام ودفاعه عنهم أمام السلطان مع شدة إيذائهم له!
ويرجع السبب في ذلك لكون كفرهم في نظر شيخ الإسلام هو كفر التأويل، وهو الذي يقصد صاحبه طاعة الله ورسوله فيخطئ من حيث يظن أنه أصاب، فالمخالفون من أهل القبلة، ممن يؤمنون بالله ورسوله وبأركان الإيمان وفرائض الإسلام، يدخلون في عموم قوله تعالى {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} قال الله كما في الصحيح (قد فعلت)!
قال رحمه الله ـ في الفتاوى (3/229-231) ـ (…نعم وقوع الغلط في مثل هذا يوجب ما نقوله دائمًا: إن المجتهد في مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه في طلب الحق، فإن الله يغفر له خطأه، وإن حصل منه نوع تقصير، فهو ذنب لا يجب أن يبلغ الكفر، وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفر، كما أطلق السلف الكفر على من قال ببعض مقالات الجهمية، مثل القول بخلق القرآن، أو إنكار الرؤية، أو نحو ذلك مما هو دون إنكار علو الله على الخلق، وأنه فوق العرش، فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من أظهر الأمور، فإن التكفير المطلق، مثل الوعيد المطلق، لا يستلزم تكفير الشخص المعَّين حتى تقوم عليه الحجة التي تكفِّر تاركها، كما ثبت في الصحاح عن النبي (في الرجل الذي قال: “إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذرُّوني في اليم، فوالله لئن قدر الله عليّ ليعذبني عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين، فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له) فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك، أو شك، وأنه لا يبعثه، وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه الحجة، لكنه كان يجهل ذلك، ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله، وكان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده، فخاف من عقابه، فغفر الله له بخشيته.
فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد، من أهل الإيمان بالله ورسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح، لم يكن أسوأ حالاً من هذا الرجل، فيغفر الله خطأه، أو يعذّبه إن كان منه تفريط في اتّباع الحق على قدر دينه).
وقال شيخ الإسلام أيضا ـ الفتاوى(12/180) ـ (وليس كل مخطئ ولا مبتدع، أو جاهل، أو ضال، يكون كافرا، بل ولا فاسقا، بل ولا عاصيا).
وما ذكره شيخ الإسلام حكم عام في كل المخالفين من أهل القبلة من المسلمين، ويدخل فيه الفرق الرئيسة التي خرجت في الصدر الأول واختلفت في تأويل القرآن، كالخوارج والشيعة والمعتزلة والمرجئة، قال رحمه الله ـ في الفتاوى (7/217-218) ـ (فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع، فهذا ليس بكافر أصلاً، والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيرً لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع، وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة، من كان منهم منافقًا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقًا بل كان مؤمنًا بالله ورسوله في الباطن، لم يكن كافرًا في الباطن، وإن أخطأ في التأويل كائنًا ما كان خطؤه؛ وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، ومن قال: إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرًا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضًا ببعض المقالات).
2 ـ تسويغهم افتراق الأمة وتبريره باسم السنة والسلفية :
فقد تطور هذا الانحراف والغلو في تبديع وإكفار المخالفين، حتى وصل الحال ببعض المعاصرين من المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة أن صاروا دعاة فرقة وفتنة، لا دعاة سنة وجماعة، بل إنهم لا يرون اجتماع الأمة اليوم، ولا يحثون عليه، ولا يدعون إلى جماعة، بل يكرسون القطرية التي فرضها الاستعمار الخارجي، بدعوى أنه يشترط لتوحيد الكلمة أن تكون على كلمة التوحيد!
فإذا نظرت فإذا التوحيد في نظرهم ليس هو الإقرار بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله)، ولا الإقرار الإجمالي بأركان الإيمان وفرائض الإسلام وترك الشرك، بل هو القول بكل ما يقولونه في مسائل الاعتقاد على وجه التفصيل!
وهو ما لم يشترطه سلف الأمة وأهل السنة والجماعة لوجوب الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق، إذ وحدة الأمة السياسية أصل من أصول الدين، لا يحول دونها تفرق المسلمين في الآراء والعقائد ما داموا في دائرة الإسلام، ولهذا اغتفر سلف الأمة وأئمة أهل السنة والجماعة ـ من أجل المحافظة على الجماعة ووحدة الأمة وبقائها في كيان سياسي واحد تحت سلطة واحدة ـ ما وقع من بدع وكبائر قد تقع من الأمراء والولاة دع عنك من دونهم، مع إنكارهم لتلك البدع وردهم لها، كل ذلك حفاظا على هذا الأصل الذي اشتهر به أهل السنة خاصة وهو وصفهم بـ (الجماعة)، بينما لم يحتمل ذلك الخوارج ولا المعتزلة ولا الشيعة فكانوا لا يرون الجماعة إلا على وفق أصولهم أو يعتزلون الأمة!
فخالف المنتسبون إلى أهل السنة المعاصرون هذا الأصل الأصيل، وابتلوا بما ابتلي به أهل البدع السابقون، كما قال شيخ الإسلام عنهم ـ منهاج السنة (5/95) ـ (من شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالا يجعلونها واجبة في الدين، بل يجعلونها من الإيمان الذي لابد منه، ويكفِّرون من خالفهم فيها ويستحلُّون دمه، كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم، وأهل السنة لا يبتدعون قولاً ولا يكفِّرون من اجتهد فأخطأ وإن كان مخالفًا لهم، مكفرًا لهم، مستحلاً لدمائهم، كما لم تكفِّر الصحابة الخوارج، مع تكفيرهم لعثمان وعليّ ومن والاهما، واستحلالهم لدماء المسلمين المخالفين لهم).
وفي الوقت الذي ترى بعض هؤلاء يغض الطرف عن موبقات الطغاة وكفرهم بدعوى مراعاة المصلحة والمفسدة، لا تراه في المقابل يغض الطرف عن اختلاف أهل القبلة فيما اختلفوا فيه من التأويل مراعاة لمصلحة وحدة الأمة في ظل ضعفها وتدخل العدو الخارجي في شئونها، واستغلاله الخلاف العقائدي فيما بينها لتحقيق سيطرته عليها! فلا يلتفت إلى هذه المصالح الكلية، فتراه يجهد نفسه وخيله ورجله في إثارة الفتن بين المسلمين، وتفريق كلمتهم، والدعوة إلى التهاجر والتباغض بين أهل القبلة، حتى في البلد الواحد، في وقت أحوج ما تكون الأمة فيه لوصية رسولها صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح (لا تدابروا ولا تهاجروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا) (بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)!
لقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية في حياته العملية السياسية داعية للوحدة والجماعة حتى قال عن نفسه ـ في الفتاوى 3/227 ـ (والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرة، وأنا كنت من أعظم الناس تأليفا لقلوب المسلمين، وطلبا لاتفاق كلمتهم، واتباعا لما أمرنا به من الاعتصام بحبل الله جميعا، وأزلت عامة ما كان في النفوس من الوحشة..).
وقد حرض الأمة على الجهاد وخرج في أهل الشام في معركة (شقحب) لمواجهة المغول وكانوا من كل الطوائف، فلم يشترط أن لا يخرج معه إلا أتباعه وأنصاره، بل دعا المسلمين جميعا إلى الجهاد فنفروا معه من أهل الحديث والأشعرية والصوفية وعامة المسلمين، حتى نصرهم الله.
لقد صارت الفرقة عند بعض المعاصرين هي الجماعة! وبلغ الحال ببعض المنتسبين إلى السنة حين ذكرت له ضرورة وحدة المسلمين في الخليج وجزيرة العرب، وأن العدو الخارجي إنما سيطر عليهم، وتحكم بهم، بسبب تشرذمهم وتفرقهم وضعفهم، وقد أوجب الله عليهم أن يعتصموا بحبل الله جميعا، فما كان منه إلا أن قال بأن الفرقة أحيانا قد تكون أرحم من الاجتماع، وأنه لا بد لتوحيد الكلمة أن تكون على كلمة التوحيد!
ولشيوع هذه العقيدة التي يصرح بها كثيرون من أدعياء السنة ويستبطنها كثيرون اعتقادا منهم بأنهم موحدون لا يسوغ لهم أن يتوحدوا مع غيرهم من المسلمين المشركين والمبتدعين، تراهم يقرون الحالة القطرية التي فرضها الاستعمار، ولا يكاد يوجد في خطابهم دعوة إلى الوحدة والجماعة، حتى صارت الأمة تتطلع للقوميين العرب لينقذوها من ضعفها وتشرذمها الذي يسوغه الموحدون الجدد!
9- أهل السنة والجماعة إشكالية الشعار وجدلية المضمون
أهل السنة وملامح الانحراف
(2)
الانحرافات السياسية
ثانيا : الانحراف السياسي ومظاهره عند أهل السنة:
وكما كانت لدى طوائف المتأخرين من أهل السنة انحرافاتها العقائدية والسلوكية، فقد كانت أيضا لديها انحرافاتها السياسية والفقهية، وهذه الانحرافات أبرز ما تكون لدى الفقهاء والمذاهب الفقهية، منها عند أهل الحديث والصوفية، ومن هذه الانحرافات التي تصدى لها شيخ الإسلام ابن تيمية وأبان عن خطورتها:
1 ـ فصل السياسة عن الشريعة :
فقد كانت بوادر هذا الانحراف جلية مبكرا، في هذا الجانب، لما سبق ذكره من حدوث المحدثات السياسية بعد فترة الخلافة الراشدة، وتقبل الخطاب المؤول لها شيئا فشيئا، كما فصلته في (الحرية أو الطوفان) وفي (تحرير الإنسان)، وقد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية عن بدايات هذا الانحراف في هذا الباب ـ كما في مجموع الفتاوى (20/391) ـ فقال (وكما يجب أن يعرف أن أمر الله تعالى ورسوله متناول لكل من حكم بين الناس سواء كان واليا أو قاضيا أو غير ذلك، فمن فرق بين هذا وهذا بما يتعلق بأمر الله ورسوله فقد غلط، وأما من فرق بينهما بما يتعلق بالولاية لكون هذا ولي على مثل ذلك دون هذا فهذا متوجه، وهذا كما يوجد في كثير من خطاب بعض أتباع الكوفيين وفي تصانيفهم إذا احتج عليهم محتج بمن قتله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بقتله؛ كقتله اليهودي الذي رض رأس الجارية، وكإهداره لدم السابة التي سبته وكانت معاهدة، وكأمره بقتل اللوطي ونحو ذلك، قالوا : هذا يعمله سياسة! فيقال لهم: هذه السياسة : إن قلتم هي مشروعة لنا فهي حق؛ وهي سياسة شرعية، وإن قلتم : ليست مشروعة لنا فهذه مخالفة للسنة، ثم قول القائل بعد هذا سياسة : إما أن يريد أن الناس يُساسون بشريعة الإسلام، أم هذه السياسة من غير شريعة الإسلام؟ فإن قيل بالأول فذلك من الدين وإن قيل بالثاني فهو الخطأ، ولكن منشأ هذا الخطأ أن مذهب الكوفيين فيه تقصير عن معرفة سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسياسة خلفائه الراشدين، وقد ثبت في الصحيح عنه أنه قال(إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي قام نبي، وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء يكثرون؛ قالوا : فما تأمرنا؟ قال: أوفوا بيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم) فلما صارت الخلافة في ولد العباس واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيا في السياسة العادلة، احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال: الشرع والسياسة، وهذا يدعو خصمه إلى الشرع وهذا يدعو إلى السياسة، سوغ حاكما أن يحكم بالشرع والآخر بالسياسة ، والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود حتى تسفك الدماء وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات؟ والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة، وخيرهم الذي يحكم بلا هوى، وتحرى العدل، وكثير منهم يحكمون بالهوى ويحابون القوي ومن يرشوهم ونحو ذلك، وكذلك كانت الأمصار التي ظهر فيها مذهب أهل المدينة يكون فيها من الحكم بالعدل ما ليس في غيرها من جعل صاحب الحرب متبعا لصاحب الكتاب ما لا يكون في الأمصار التي ظهر فيها مذهب أهل العراق ومن اتبعهم حيث يكون في هذه والي الحرب غير متبع لصاحب العلم، وقد قال الله تعالى في كتابه{لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم} الآية فقوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر {وكفى بربك هاديا ونصيرا}) انتهى كلامه.
والمقصود هنا بالسياسة التي صارت مقابل الشرع في اصطلاح الفقهاء القدماء، والتي تحدث عنها شيخ الإسلام كمظهر من مظاهر الانحراف، ليست هي السياسة بمفهومها المعاصر التي موضوعها الدولة والسلطة ووظيفتها، بل معناها الأفعال التي يحتاجها الولاة لتنفيذ أحكام الشرع وسياسة شئون الأمة بالاجتهاد فيما لا نص فيه، أما الفصل بين الشرع والسياسة اليوم فقد وصل حدا لم يخطر على فقهاء الأمة ببال، ولم يتصور لها في خيال، وهو تعطيل أحكام الشرع نفسها وإبطالها بقطعياتها، واستبدال القوانين الوضعية بها، وهو الكفر البواح الصراح، ومع ذلك فلا تكاد تجد اليوم حكومة إلا ولها فقهاء يسوغون لها مثل هذا الانحراف، أو يبررونه ويعتذرون لها عنه!
2 ـ مشايعتهم السلطان بالأهواء واستباحتهم الأموال والدماء :
وقد كان علماء أهل السنة وفقهاؤهم أكثر عرضة لهذا الانحراف من غيرهم، بسبب وقوفهم مع الخلافة والدولة لإقامة الإسلام، وشرائع الأحكام، إلا أنهم ربما مال بعضهم في أهواء السلطان، كما قال ابن أبي ليلى (أكلنا من حلوائهم وملنا في أهوائهم)! وذلك لكون السلطة مظنة الفساد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين سأله الولاية (إنك امرؤ ضعيف، وإنها أمانة، وإنها خزي وندامة يوم القيامة، إلا من أداها بحقها)!
وقد تحدث شيخ الإسلام عن بعض صور هذا الانحراف في هذا الباب ـ في مجموع الفتاوى (4/451) ـ وكيف أن الفقهاء المتأخرين خلطوا بين حكم من خرجوا عن طاعة ذي سلطان الذي لم تأمر النصوص بقتالهم، ومن خرجوا عن حكم الشريعة وخرجوا على الأمة، وهم الذين وردت النصوص بمشروعية قتالهم لردهم عن كفرهم كالمرتدين، أو دفعا لشرهم كالحرورية المارقين، فقال (الأصل الثابت بكتاب الله وسنة رسوله هو الفرق بين القتال لمن خرج عن الشريعة والسنة، فهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما القتال لمن لم يخرج إلا عن طاعة إمام معين، فليس في النصوص أمر بذلك، فارتكب الأولون ـ أي الفقهاء الذين يشايعون أهواء الأمراء ـ ثلاثة محاذير:
الأول: قتال من خرج عن طاعة ملك معين وإن كان ـ الخارج عليه ـ قريبا منه أو مثله، في السنة والشريعة، لوجود الافتراق، والافتراق هو الفتنة.
والثاني: التسوية بين هؤلاء وبين المرتدين عن بعض شرائع الإسلام.
والثالث: التسوية بين هؤلاء وبين قتال الخوارج المارقين من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ولهذا تجد تلك الطائفة ـ أي من هؤلاء الفقهاء ـ يدخلون في كثير من أهواء الملوك وولاة الأمور، ويأمرون بالقتال معهم لأعدائهم بناء على أنهم أهل العدل وأولئك البغاة؛ وهم في ذلك بمنزلة المتعصبين لبعض أئمة العلم أو أئمة الكلام أو أئمة المشيخة على نظرائهم مدعين أن الحق معهم أو أنهم أرجح بهوى قد يكون فيه تأويل بتقصير لا بالاجتهاد، وهذا كثير في علماء الأمة وعبادها وأمرائها وأجنادها، وهو من البأس الذي لم يرفع من بينها؛ فنسأل الله العدل؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا به) انتهى كلامه رحمه الله.
فقد صار هؤلاء الفقهاء يجوزون القتال مع الولاة لتأييد سلطانهم وفرض طغيانهم، واستباحة دم كل من خرج عليهم، وإن كانوا خرجوا دفعا للظلم عن أنفسهم، الذي أجمع سلف الأمة وأئمة أهل السنة أنه لا يحل قتالهم حتى مع الإمام العدل، إلا بعد التحكيم ورفع الظلم عنهم، كما قال علي في شأن الخوارج (إن خرجوا على إمام جور فلا تقاتلوهم فإن لصاحب الحق مقالا، وإن خرجوا على إمام عدل فقاتلوهم).
وأما الإمام الجائر فلا يرى أهل السنة القتال معه على من خرج عليه مطلقا، خاصة إذا خرج عليه أهل العدل ـ كما سبق تفصيله ـ ومع ذلك كله فقد بلغ الانحراف في هذه الطائفة من المتفقهة المشايعة لأهواء أمرائها وولاتها أن جعلت حكم كل من خرج عليهم حكم الخوارج المارقين أو الكفار المرتدين!!
وهذا الانحراف الذي تحدث عنه شيخ الإسلام إنما كان حين كان، لما كانت الخلافة قائمة، والشريعة حاكمة، والجهاد ماض، ولم يبلغ الأمر ما بلغ اليوم في ظل عصر دويلات الطوائف، وسلطان الطواغيت، من تعطيل أحكام الإسلام وقطعيات الدين، وإعلان الحرب على الله ورسوله والمسلمين!
فمن تأمل هذه النصوص عن شيخ الإسلام عرف أسباب انحلال قوة المسلمين، وفساد أحوالهم، بسبب تحالف أئمة الجور، وفقهاء السلطة، لتكون الأمة هي الضحية!
3 ـ إباحة أن يخرج الولاة عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين في سياسة شئون الأمة، وفي المقابل تحريم خروج الأمة عن طاعة الولاة مطلقا :
وهذا شائع بين طوائف الفقهاء الذين يعملون للأمراء، فيسوغون لهم كثيرا من المحرمات، ويوجبون طاعتهم مطلقا عمليا وواقعيا، وإن كانوا ينفون وجوبها نظريا، وقد تحدث شيخ الإسلام عن انحراف هذه الطائفة من الفقهاء ومشايعتها لأهواء الأمراء، فقال في الفتاوى (35/22) ـ عنهم وأن منهم (من يبيح الملك مطلقا من غير تقيد بسنة الخلفاء كما هو فعل الظلمة والإباحية وأفراخ المرجئة)!
وقد عمت هذه الفتنة وطمت في العصر الحديث، حتى لا يكاد فقهاء أي دولة يخرجون عما تذهب إليه السلطة التي تحكمهم، وحتى صارت الفتوى مرهونة بموقف السلطة السياسية، وحتى صار الشيء يكون حراما تارة، وحلالا فترة أخرى، لا لسبب إلا لكون السلطة أرادت ذلك، ثم لا يقف الانحراف والإباحية عند ذلك حتى يُمنع بل يُقمع كل من أراد بيان المنكر، أو من يبدي اعتراضا عليه، ولو بالكلمة! وكل ذلك لترسيخ ظلم السلطة وطغيانها باسم الإسلام والسنة!
وإذا أردت أن ترى الصورة جلية واضحة أشد ما تكون في هذا الانحراف، فانظر إلى الفتاوى والرسائل ـ ككتاب حمد عثمان وتقريض الفوزان ـ التي تدعو إلى طاعة الطاغوت الذي لا يحكم أصلا بشريعة الإسلام، وإلى نصرته وتوليه، والذب عنه، والدعوة إليه، والرضا به، والدعاء له, بدعوى أنه ولي أمر للمسلمين، مع قوله تعالى {يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به}!
ثم لا يتردد هؤلاء المتفقهة أن يصفوا من يدعو إلى هذه الوثنية بأنه على السنة والسلفية، ويصفوا في المقابل من يدعو إلى توحيد الله في الحاكمية وجعل الكتاب والسنة هو المرجعية التشريعية بأنه من المعتزلة والحرورية، ليجعلوا للطاغوت ـ في كل بلد ابتلي المسلمون فيه بحكمه ـ ذريعة لسفك دماء العلماء المصلحين، والدعاة المجاهدين، بدعوى أنهم بغاة على الطاغوت يحل قتلهم وسجنهم حتى يتوبوا ويؤمنوا بالطاغوت وحده، وحقه في الحكم بينهم من دون حكم الله ورسوله!
وإنما حمل هؤلاء المفتونين في دينهم : غرورهم بما هم عليه من دعوى أنهم أهل التوحيد والسنة والسلفية، ورضاهم بما هم عليه من الفتنة في الحياة الدنية، ظنا منهم أنهم على الحق، وما شعروا بمدى الانحراف الذي آلت إليه أمورهم حد عبادة الطاغوت ومولاته وحزبه!
ولا يعتذر مفتون بأن هذا الكفر من هؤلاء الطواغيت هو كفر تأويل، كما أطلق بعض السلف على بعض خلفاء المسلمين كالمأمون، فهذا اعتذار باطل، وتبرير عاطل، فإن كفر التأويل هو اجتهاد من مسلم أراد طاعة الله ورسوله تعظيما لشرعه ودينه، كما فعل المأمون والمعتصم، فإنهم كانوا يتصورون أن ما هم عليه هو دين الله وشرعه فأرادوا حمل الأمة عليه، وكذا أهل الأهواء من أهل القبلة، فأكثرهم اجتهد فيما ذهب إليه خشية الله واليوم الآخر، حتى قال علي في شأن من خرجوا عليه وكفروه، حين سئل عنهم أكفار هم؟ قال من الكفر فروا! قيل أمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا!
فهؤلاء يدخلون في عموم قوله تعالى {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} قال الله (قد فعلت) وفي الحديث (إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) فرفع الله عن هذه الأمة المؤمنة به إثم الخطأ والنسيان والإكراه.
أما هؤلاء الطواغيت فأكثرهم كما يعرف من حالهم وأقوالهم ماديون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا بأركان الإيمان، ولا بفرائض الإسلام، ولا بوجوب التحاكم إلى الله ورسوله، ولا يعظمون حرمات الله، بل الإسلام والشريعة في نظرهم تخلف ورجعية، وهم جادون في حرب كل من يدعوهم إلى العودة إلى الإسلام وتحكيم شريعته، بالقتل والسجن والتهجير، فكفرهم كفر إباء واستكبار في الأرض بغير الحق، فمن قاس حال هؤلاء بحال خلفاء المسلمين الذين وقع بعضهم بكفر التأويل، فإنما هو كمن قاس حال آدم حين عصى الله بحال إبليس!
ومن لم يفرق بين هذا وهذا، فقد خلط بين أحكام التأويل، وأحكام الردة التي لا يخلو كتاب فقهي من بيانها!
ثم إن كفر التأويل إنما هو في مسائل عقائدية نظرية غيبية لا يترتب عليها عمل، ولم يخض فيها سلف الأمة بل اكتفوا فيها بالإيمان الإجمالي، فجاء من بعدهم فتعمقوا وتأولوا القرآن على غير وجهه فأخطأوا، أما تعطيل الشرع فهو قضية عملية إجماعية قطعية لا يتصور فيها التأويل والخطأ، فالمسلمون كافة على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وعقائدهم مجمعون على وجوب الحكم بين المسلمين بحكم الله ورسوله، وأن هذا هو الإسلام منذ أن جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل به بعده الخلفاء الراشدون ثم الخلفاء المسلمون مدة ألف وثلاثمائة عام، لم يقع بينهم خلاف في ذلك، ولا يتصورون الخلاف فيه لكونه من الإجماع العملي المقطوع به، حتى أنهم اختلفوا في توحيد الصفات ومسائل الإيمان والأسماء والأحكام والقضاء والقدر، ولم يختلفوا في حاكمية الله وضرورة التحاكم إليه والنزول على حكمه للدخول في عقد الإسلام!
بل أجمع السلف وأهل السنة على وجوب جهاد وقتال من لم يلتزم بشريعة واحدة من شرائع الإسلام ولو كان يقر بها، فالترك وحده موجب لجهاده، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ في الفتاوى (28/ 502- 503) ـ (كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة – مع أنهم لم يجحدوا وجوب الزكاة عليهم – وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم، فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام، عملاً بالكتاب والسنة…فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه، ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله، وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب، فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء، والأموال، والخمر، والزنا، والميسر، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته، التي يكفر الجاحد لوجوبها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها، وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء).
فتأمل هذا النص كيف نقل فيه شيخ الإسلام إجماع سلف الأمة على وجوب جهاد وقتال أي طائفة لا تلتزم بممنع المحرمات القطعية كالربا، والزنا، والخمر، حتى لو أقرت بحرمتها! دع عنك عدم تطبيق الشريعة كلها وتعطيلها جملة، وفرض القوانين المسيحية الإنجليزية والفرنسية بدل الكتاب والسنة، فهذه ردة جامحة لا يشك فيها إلا من لم يعرف القرآن وحقائق الإيمان!
فكيف يسوغ القول بأن لمثل هذه الطوائف وحكوماتها طاعة شرعية وولاية على الأمة، مع أن الواجب هو جهادها ومفارقتها والبراءة منها، لا الجهاد معها، والسمع والطاعة لها!
وقد قرر شيخ الإسلام أيضا – كما في الفتاوى (28/356-359) ـ بأن هذا حكم عام في كل طائفة تدعي الإسلام وتترك شيئا من شرائعه الظاهرة ولو شريعة واحدة، وجهادها واجب على الأمة كلها، فمن قدر عليه وجب عليه (وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام، وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة، فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين، حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة، ثم اتفقوا، حتى قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ( “أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدًا رسول الله، فإذا قالوها، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها؛ وحسابهم على الله”؛ فقال له أبو بكر: فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها، قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال: فعلمت أنه الحق) …فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام، وإن تكلم بالشهادتين… وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.. فهو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين، وكان الفضل لمن قام به).
فصارت هذه الطوائف الممتنعة بحكوماتها اليوم، التي لا تلتزم منع الربا في دولها، ولا منع الزنا، ولا منع الخمر، ولا منع سفك الدماء ظلما وعدوانا، ولا الحكم بشريعة الإسلام : كلها – في نظر هؤلاء الفقهاء – حكومات شرعية لها على الأمة وجوب السمع والطاعة، لا جهادها ومجاهدتها، ثم لا يتردد هؤلاء الفقهاء المفتونون، والأئمة المضلون أن ينسبوا أقوالهم إلى سلف الأمة وأهل السنة!
4 ـ تعطيل فرض الجهاد والتخذيل عنه والاعتذار لتركه :
وهذا من مظاهر الانحراف السياسي عند كثير من الفقهاء، فهم في هذا الباب أجبن مما سواه، وإنما أُتيت الأمة من هؤلاء، حتى وقع المسلمون في كثير من البلدان تحت الاحتلال، بخور هؤلاء الفقهاء وجبنهم، فقد أفتى كثير من علماء الشام حين غزاها التتار بحرمة جهادهم، وقاموا بتخذيل الناس عنه، تارة بدعوى عدم القدرة عليهم، وتارة بدعوى أن مع التتار مسلمين معصومي الدم، وقد تصدى شيخ الإسلام لكل هذه الشبه، وأكثر من الردود عليهم، وقرر جواز رميهم، وإن قتل المسلمون الذين معهم إذا كانوا مكرهين، وإلا فحكمهم إن كانوا غير مكرهين حكم أهل الردة، ونعى على فقهاء عصره تخليهم عن الجهاد وتقاعسهم عنه، حتى قال – كما في الاستقامة (1/265) – عن الجهاد في سبيل الله بأنه (أعلى ما يحبه الله ورسوله، واللائمون عليه كثير،إذ كثير من الناس الذين فيهم إيمان يكرهونه، وهم إما مخذِّلون مفتِّرون للهمة والإرادة فيه، وإما مرجفون مضعِّفون للقوة والقدرة عليه، وإن كان ذلك من النفاق، قال تعالى{قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَلِيلاً}[الأحزاب:18]، وقال تعالى{لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً} [الأحزاب:60]).
وقد أوجب شيخ الإسلام في جهاد الدفع ـ إذا دهم العدو دار الإسلام ـ صد العدو وقتاله بكل وسيلة، على كل المسلمين، سواء من قصدهم العدو، أو من لم يقصدهم العدو، وأنه لا يشترط لجهاد الدفع أي شرط، وأن من امتنع عن هذا النوع من الجهاد فحكمه حكم الطائفة الممتنعة من بعض شرائع الإسلام يجب جهادها كما يجاهد العدو! فقال ـ كما في الفتاوى (28/359) ـ (فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين، فإنه يصير دفعه واجبًا على المقصودين كلهم، وعلى غير المقصودين، لإعانتهم، كما قال الله تعالى{وَإِنْ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} [الأنفال:72]، وكما أمر النبي النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال ـ أي جندي ـ أو لم يكن، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله، مع القلة والكثرة، والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد، كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو، الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج، بل ذم الذين يستأذنون النبي {َقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَارًا} [الأحزاب:13]، فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال اضطرار، وذلك قتال اختيار: للزيادة في الدين وإعلائه، ولإرهاب العدو، كغزاة تبوك ونحوها، فهذا النوع من العقوبة ـ أي القتال لمن لم يجاهد جهاد الدفع ـ هو للطوائف الممتنعة).
وقد رأينا في هذه العصر الذي استولى العدو على الأمة بجيوشه وحروبه الاستعمارية كيف خرج بعض المفتين المفتونين ليقول بأنه لا جهاد اليوم، وأنه لا جهاد بلا راية وإمام؟ مع أن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى الجهاد والقتال والتعبئة والتحريض عليه! ثم لا يترددون عن تسويق باطلهم وخيانتهم لله ورسوله وللمسلمين من ادعاء أن قولهم هذا قول أهل السنة وسلف الأمة!
وقد كانت مساجد المسلمين قبل عشرين سنة تعج وتضج بالدعوة لجهاد الروس حين احتلوا أفغانستان، ولم يتخلف الفقهاء في كل بلد من إصدار الفتاوى بوجوب ذلك، مشايعة من أكثرهم لأهواء حكوماتهم التي تدور في فلك أمريكا، فلما خرج الروس وجاء الصليبيون الغربيون، واحتلوا العراق وأفغانستان، فإذا فقهاء السلطة يبتدعون شرط الراية والإمام من عند أنفسهم افتراء على الله وعلى السنة وسلف الأمة!
فتارة يصفون الجهاد بأنه فتنة، وتارة بأنه إرهاب، وتارة بأنه خروج وإفساد في الأرض، وتارة بأنه عبث لا مصلحة منه، وأحسنهم طريقة من لا يرى وجوبه على الأمة، والعدو يدهم بلدان المسلمين بلدا بلدا!
فإذا نظرت في الأمور وخباياها فإذا القوم يقولون ما يقولون، مشايعة لحكوماتهم وتوجهاتها السياسية لا طاعة لله ولا هم يحزنون!
هذا مع أن كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والمواثيق الدولية تقرر حق كل شعب في مقاومة الأجنبي المحتل، ومع ذلك صادر علماء الفتنة على الأمة ما تقرره كحق إنساني كل أمم الأرض!
هذا مع إجماع الأمة على قتال العدو إذا دهم أرض المسلمين، وأن قتاله ليس قتال فتنة، بل الفتنة هي في تركه وعدم مدافعته، بل ليس بعد الشرك بالله أعظم من الصد عن قتاله، كما قال ابن حزم في المحلى 7 / 300 (ولا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم)!
كما لا شيء أوجب بعد الإيمان بالله من دفع العدو عن أرض الإسلام، ولا يشترط للجهاد في هذه الحال أي شرط إطلاقا ـ خلا شروط التكليف العامة في كل واجب ـ بل على كل أحد الدفع بما استطاع فلا يستأذن الولد والده، ولا الزوجة زوجها،ولا الغريم غريمه، وكل هؤلاء أحق بالإذن والطاعة من الإمام، ومع ذلك سقط حقهم في هذه الحال، إذ الجهاد فرض عين على الجميع فلا يشترط له إذن إمام فضلا عن وجوده، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ في الفتاوى المصرية 4 / 508 – (أما قتال الدفع عن الحرمة والدين فواجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان)، وقال أيضا(وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليها بلا إذن والد ولا غريم)، وقال (وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين به، لكن يخافون إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين، فهنا صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا،ونظيره أن يهجم العدو على بلاد المسلمين، وتكون المقاتلة أقل من النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريم، فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الانصراف فيه بحال).
وليس وجود الإمام شرطا في وجوب الجهاد بنوعيه عند أهل السنة والجماعة، فضلا عن إذنه، وإنما يشترط وجوده الشيعة الإمامية، أما عند أهل السنة فالعكس هو الصحيح، إذ إقامة الجهاد شرط لصحة إمامة الإمام، فلا إمام بلا جهاد، لا أنه لا جهاد بلا إمام، كما قال العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في بيان بطلان هذا الشرط ـ في الدرر السنية في الفتاوى النجدية 7/ 97 ط أولى ـ(بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع؟ هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين، والأدلة على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكر من ذلك عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد في تركه)، ثم استدل على مشروعية ذلك بجهاد أبي بصير ومن معه للمشركين فقال(فهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأتم في قتال قريش لأنكم لستم مع إمام؟ سبحان الله ما أعظم مضرة الجهل على أهله؟!)، ثم قرر هذه القاعدة السياسية العظيمة في باب الإمامة وحكم الجهاد، وأن الإمام لا شرعية له إذا ترك الجهاد في سبيل الله (كل من قام بالجهاد في سبيل الله فقد أطاع الله وأدى ما فرضه الله، ولا يكون الإمام إماما إلا بالجهاد، لا أنه لا يكون جهاد إلا بإمام).
ثم إن أخطر ما في هذه الآراء القاديانية أنها تعرض على الأمة باسم السنة والسلفية!
فانظر في حال هذه الطوائف السنية كيف صار عندهم اليوم أصلا من أصول الدين، ما كان بالأمس من الفرية في الدين، والعدول عن سبيل المؤمنين!
وانظر كيف أطبقوا على السكوت عن وجوب نصرة المسلمين في أفغانستان والعراق، وهو جهاد دفع بأوضح صوره، حتى لا تكاد تسمع فتوى من عالم من علماء هذه الطوائف بوجوب ذلك لا فرض عين ولا فرض كفاية! بل فتاواهم على عكس ذلك فهي أشد فتكا بالأمة من أسلحة عدوها!
5 ـ حملهم الأمة على فتاواهم الفقهية وآرائهم السياسية السلطانية والحبس لمن خالفها :
وهذا من مظاهر الانحراف عند بعض متأخري فقهاء أهل السنة، هذا مع أن المعلوم من أصول أهل السنة أنهم لا يوجبون اتباع أحد بعينه في مواطن النزاع والاجتهاد، دع عنك إلزامهم بما يرونه حراما في مذاهبهم، فضلا عن الحبس والتعذيب، مما لا تعرفه إلا محاكم التفتيش المسيحي!
وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية قد تعرض هو نفسه لطغيان الخطاب الديني السياسي حتى سجن بسبب فتواه بأن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة، وقد حاول السلطان والقضاة منعه من ذلك بحجة أنه مخالف لإجماع المذاهب الأربعة! فلم ير ابن تيمية للسلطان الحق في منعه، لحديث (من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار)، وكان لا يرى أن السكوت يسعه، ولهذا نعى على قضاة عصره وفقهاء مصره مثل هذه التجاوزات والانحرافات في سياسة الأمة، وكان يبين أصول أهل السنة والجماعة وسلف الأمة في إقرار التعددية الاجتهادية، واحترام الاختلاف في الرأي، فقال ـ في الفتاوى (20/10) ـ (وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم؛ فليس حجة لازمة ولا إجماعًا باتفاق المسلمين، بل قد ثبت عنهم رضي الله عنهم، أنهم نهوا الناس عن تقليدهم؟ وأمروا إذا رأوا قولاً في الكتاب والسنة أقوى من قولهم: أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب أو السنة ويدعوا أقوالهم؛ ولهذا كان الأكابر من أتباع الأربعة لا يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب أو السنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك).
كما قال أيضا ـ في الفتاوى (35/378-381) ـ (كان أئمة السنة والجماعة لا يلزمون الناس بما يقولونه من موارد الاجتهاد ولا يكرهون أحدًا عليه، ولهذا لما استشار هارون الرشيد مالك بن أنس في حمل الناس على موطئه، قال له: (لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن أصحاب رسول الله ( تفرقوا في الأمصار فأخذ كل قوم عمن كان عندهم وإنما جمعت علم أهل بلدي)، أو كما قال، وقال مالك أيضًا (إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة).
وقال أبو حنيفة (هذا رأي فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه).
وقال الشافعي (إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط)، وقال (إذا رأيت المحجة موضوعة على الطريق فإني أقول بها).
وقال المزني في أول مختصره (هذا كتاب اختصرته من علم أبي عبدالله الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه، مع إعلامه نهيه عن تقليده)) انتهى كلام شيخ الإسلام.
وقال أيضا (وقد فرض الله على ولاة أمر المسلمين اتباع الشرع الذي هو الكتاب والسنة، وإذا تنازع بعض المسلمين في شيء من مسائل الدين ولو كان المنازع من آحاد طلبة العلم لم يكن لولاة الأمور أن يلزموه باتباع حكم حاكم ـ أي حكم القاضي ـ بل عليهم أن يبينوا له الحق كما يبين الحق للجاهل المتعلم، فإن تبين له الحق الذي بعث الله به رسوله وظهر وعانده بعد هذا استحق العقاب،وأما من يقول: إن الذي قلته هو قولي، أو قول طائفة من العلماء المسلمين؛ وقد قلته اجتهادًا، أو تقليدًا: فهذا باتفاق المسلمين لا تجوز عقوبته، ولو كان قد أخطأ خطأ مخالفًا للكتاب والسنة، ولو عوقب هذا لعوقب جميع المسلمين، فإنه ما منهم من أحد إلا وله أقوال اجتهد فيها أو قلد فيها وهو مخطئ فيها؛ فلو عاقب الله المخطئ لعاقب جميع الخلق، فالمفتي والجندي والعامي إذا تكلموا بالشيء بحسب اجتهادهم اجتهادًا أو تقليدًا قاصدين لاتباع الرسول بمبلغ علمهم لا يستحقون العقوبة بإجماع المسلمين، وإن كانوا قد أخطأوا خطأ مجمعًا عليه،وإذا قالوا إنا قلنا الحق، واحتجوا بالأدلة الشرعية: لم يكن لأحد من الحكام أن يلزمهم بمجرد قوله، ولا يحكم بأن الذي قاله هو الحق دون قولهم، بل يحكم بينه وبينهم الكتاب والسنة والحق الذي بعث الله به رسوله لا يغطى بل يظهر، فإن ظهر رجع الجميع إليه، وإن لم يظهر سكت هذا عن هذا وسكت هذا عن هذا؛ كالمسائل التي تقع يتنازع فيها أهل المذاهب لا يقول أحد إنه يجب على صاحب مذهب أن يتبع مذهب غيره لكونه حاكمًا، فإن هذا ينقلب، فقد يصير الآخر حاكمًا فيحكم بأن قوله هو الصواب، فهذا لا يمكن أن يكون كل واحد من القولين المتضادين يلزم جميع المسلمين اتباعه، بخلاف ما جاء به الرسول فإنه من عند الله؛ حق وهدى وبيان، ليس فيه خطأ قط، ولا اختلاف ولا تناقض قال تعالى{أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا}،وعلى ولاة الأمر أن يمنعوهم من التظالم، فإذا تعدى بعضهم على بعض منعوهم العدوان؛ وهم قد أُلزموا بمنع ظلم أهل الذمة؛ وأن يكون اليهودي والنصراني في بلادهم إذا قام بالشروط المشروطة عليهم، لا يلزمه أحد بترك دينه؛ مع العلم بأن دينه يوجب العذاب، فكيف يسوغ لولاة الأمور أن يُمكِّنوا طوائف المسلمين من اعتداء بعضهم على بعض؛ وحكم بعضهم على بعض بقوله ومذهبه، وهذا مما يوجب تغير الدول وانتقاضها؛ فإنه لا صلاح للعباد على مثل هذا، وهذا إذا كان الحكام قد حكموا في مسألة فيها اجتهاد ونزاع معروف، فإذا كان القول الذي قد حكموا به لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، ولا هو مذهب أئمتهم الذين ينتسبون إليهم؛ ولا قاله أحد من الصحابة والتابعين؛ ولا فيه آية من كتاب الله وسنة رسوله، بل قولهم يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأئمة، فكيف يحل مع هذا أن يُلزم علماء المسلمين باتباع هذا القول، وينفذ فيه هذا الحكم المخالف للكتاب والسنة والإجماع، وأن يقال: القول الذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال السلف لا يقال، ولا يفتى به بل يعاقب ويؤذى من أفتى به، ومن تكلم به، ويؤذى المسلمون في أنفسهم وأهليهم وأموالهم لكونهم اتبعوا ما علموه من دين الإسلام وإن كان قد خفي على غيرهم، وهم يَعذرون من خفي عليه ذلك ولا يُلزمون باتباعهم، ولا يعتدون عليه، فكيف يعان من لا يعرف الحق بل يحكم بالجهل والظلم، ويلزم من عرف ما عرفه من شريعة الرسول أن يترك ما علمه من شرع الرسول لأجل هذا؟ لا ريب أن هذا أمر عظيم عند الله تعالى وعند ملائكته وأنبيائه وعباده، والله لا يغفل عن مثل هذا)انتهى كلامه رحمه الله.
وما ذكره شيخ الإسلام هو بعينه ما يجري اليوم في أكثر بلدان المسلمين، فصار يعاقب بالسجن والتهجير كل من يفتي بخلاف هوى الحكومات، دع عنك من يتصدى لجورها، حتى امتلأت السجون من يرون ـ مجرد رأي ـ وجوب جهاد العدو المحتل الصائل على المسلمين، وكل من يجاهده بماله ونفسه وفتواه، مع أن ذلك من المعلوم وجوبه بالضرورة القطعية في دين الإسلام، وليس من القضايا الخلافية التي نقل شيخ الإسلام بأنه لا عقاب على من قال فيها باجتهاده أو بتقليده لإمام من أئمة المسلمين!
فتأمل كيف كان أئمة أهل السنة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ينهون عن التقليد، ويدعون إلى الاجتهاد، ويقررون احترام التعددية الفقهية، ويمنعون من إلزام أحد بغير مذهبه الفقهي، ثم كيف آل الأمر بالمتأخرين حتى ضاق بهم العطن ليس في القضايا الخلافية، بل حتى في القضايا الإجماعية فيريدون حمل الأمة كلها على أهواء طغاتهم وطواغيتهم وأحبارهم ورهبانهم مما خالفوا فيه الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة!
بل حتى مسألة الإمام الجائر وطاعته وحدود هذه الطاعة كل ذلك قضايا خلافية عند أئمة أهل السنة لا يسوغ حمل أحد على خلاف ما يدين الله به من هذه الأقوال كما يحاول ذلك فقهاء السوء في هذا العصر ليستحل الطغاة دماء الأبرياء ظلما وعدوانا بفتاوى فقهاء الفتنة!
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كون هذه القضية خلافية أيضا ـ في منهاج السنة (4/525-527) ـ (وللناس نزاع في تفاصيل تتعلق بهذه الجملة ليس هذا موضعها، مثل إنفاذ حكم الحاكم الفاسق إذا كان الحكم عدلاً، ومثل الصلاة خلف الفاسق هل تعاد أم لا؟ والصواب الجامع في هذا الباب أن من حكم بعدل أو قسم بعدل نفذ حكمه وقسمه، ومن أمر بمعروف أو نهى عن منكر أعين على ذلك، إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة، وأنه لا بد من إقامة الجمعة والجماعة، … وإذا لم يمكن صلاة الجمعة والجماعة وغيرهما إلا خلف الفاجر والمبتدع صليت خلفه ولم تعد).
وقال أيضا ـ في منهاج السنة (3/390-391) ـ (الناس قد تنازعوا في ولي الأمر الفاسق والجاهل: هل يطاع فيما يأمر به من طاعة الله، وينفَّد حكمه وقسمه إذا وافق العدل؟ أو لا يطاع في شيء، ولا ينفذ شيء من حكمه وقسمه؟ أو يفرَّق في ذلك بين الإمام الأعظم وبين القاضي ونحوه من الفروع؟ على ثلاثة أقوال، أضعفها عند أهل السنة هو رد جميع أمره وحكمه وقسمه، وأصحها عند أهل الحديث وأئمة الفقهاء هو القول الأول، وهو أن يطاع الله مطلقًا وينفذ حكمه وقسمه إذا كان فعله عدلاً مطلقًا، والقول الثالث: هو الفرق بين الإمام الأعظم وبين غيره، لأن ذلك لا يمكن عزله إذا فسق إلا بقتال وفتنة، بخلاف الحاكم ونحوه، فإنه يمكن عزله بدون ذلك، وهذا فرق ضعيف، فإن الحاكم إذا ولاَّه ذو الشوكة لم يمكن عزله إلا بفتنة، ومتى كان السعي في عزله مفسدة أعظم من مفسدة بقائه، لم يجز الإتيان بأعظم الفسادين لدفع أدناهما، وكذلك الإمام الأعظم).
فتأمل كيف جعل شيخ الإسلام قضية طاعة الجائر خلافية عند أهل السنة، بينما يريد دعاة الفتنة جعلها أصل من أصول الدين، مع أن شيخ الإسلام إنما يتحدث عن الإمام الفاسق أو الجائر في ظل دولة الإسلام وخلافته هل يطاع وينفذ حكمه أم لا؟ بينما دعاة الفتنة يقررون وجوب طاعة طواغيتهم الذين لا يحكمون أصلا بالإسلام، ويجعلون طاعتهم ليس قضية اجتهادية لا تثريب على من خالفهم فيها، بل قضية إجماعية وأصلا من أصول أهل السنة وسلف الأمة!!
وشيخ الإسلام يقرر أن القول الراجح عند أهل السنة تنفيذ أمره وطاعته في حال واحده وهو ما كان عدلا وحقا موافقا الكتاب والسنة، بينما دعاة الفتنة يوجبون طاعته فيما هو مضاد لحكم الله ورسوله، كسجن الحكومات لمن جاهد العدو، ولمن أعانه، ولمن أفتى له، مع أن هؤلاء إنما قاموا بما أوجب الله ورسوله عليهم، ومما لا يحتاجون فيه إلى إذن أحد بإجماع الأمة!
وقد أدى انحراف الفقهاء المتأخرين إلى فتنة كبرى للمسلمين، حتى صاروا أحد أسباب تخلف الأمة السياسي، حين يزينون للطغاة ظلمهم وعدوانهم وطغيانهم واستبدادهم، ويوجبون على الأمة طاعتهم، كما أدى ضيق عطنهم بالرأي المخالف لأهوائهم وأهواء ولاة أمرهم إلى ضيق الأمة بهم، وتخوفها منهم، حتى صار الناس يفضلون العلمانية وإقصاء الدين ورجاله عن شئون الأمة، لما رأوه من فظائعهم، فهم حين يتدخلون في السلطة وشئونها يفرقون الأمة، ويمزقون شملها، ويحرضون الطغاة عليها، وهي فتنة عامة في كل بلد، على اختلاف درجاتها شدة وخفة، وقد رأى الشعب العراقي من ذلك أهوالا تشيب لها الولدان حين حكم رجال الدين الطائفيون، فاستباحوا الدماء حتى بلغ عدد من صدرت فيهم أحكام بالإعدام خلال خمس سنوات فقط خمسة عشر ألف، سوى عشرات الآلاف من القتلى دون محاكمات تم تصفيتهم بفرق الموت بالطرقات، ليستعيد التاريخ ذكرى الحشاشين وفرق موتهم!
وفي الطرف الآخر استباح المتطرفون باسم السنة والسلفية دماء الأبرياء بحجة المقاومة!
فصار الشعب العراقي يفضل العلمانيين والليبراليين على رجال الدين وأحزابهم الطائفية السنية والشيعية، لما رأوه من عجزهم عن إقامة العدل بينهم!
فهذه فتنة عامة فلم يعد الإسلام الممسوخ الذي يدعو إليه هؤلاء الفقهاء قادرا على جمع كلمة الأمة، ولا على تحقيق العدل بينها، ولا على تحريرها من الظلم والطغيان، ولا على تحررها من الاستعمار والاحتلال، فحيثما وليت وجهك وجدت دعاة الفتنة وفقهاء السلطة يحولون بين الأمة وبين كل ذلك، حتى فتنوها في دينها ودنياها، فصارت تبحث عن حل مشاكلها بالقومية تارة، وبالشيوعية والاشتراكية تارة، وبالديمقراطية والليبرالية تارة، لتخرج من هذا التيه الذي هي فيه، مع أن الحل جلي بين كما جاء في الحديث الصحيح (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي) وقال (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور).
وإنما لما كان هؤلاء الفقهاء من حيث العلم والمعرفة أجهل من أن يعرفوا سنن النبوة والخلافة الراشدة، فضلا عن أن يجتهدوا في التفقه فيها والغوص في غاياتها ومراميها، لحل مشكلات الأمة ونوازلها، وكانوا أيضا من حيث الإرادة والعزيمة أجبن من أن يقوموا لله بالقسط ليصدعوا بالحق ويأمروا بالعدل، فضلا عن أن يجاهدوا في الله حق جهاده، كانت النتيجة هذه الفتنة التي افتتنوا فيها ، وفتنوا معهم الأمة!
وقد نبه شيخ الإسلام لخطورة هذا الانحراف وما يقع بسببه من ظلم وعدوان، وبغي وطغيان، فدعا إلى احترام التعددية والخلاف في الأصول والفروع، وأن يقر الناس بعضهم بعضا على ما هم عليه من خلاف في الدين، فإن تجادلوا ففي الأدلة من الكتاب والسنة، وحرم العدوان بسبب مثل هذا الاختلاف فقال ـ في الفتاوى (17/311-312) ـ (مسائل النِّزاع التي تنازعت فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضًا، ولم يبغ بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضًا، ولا يعتدي عليه، وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم، فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله،وهذه حال أهل البدع والظلم كالخوارج وأمثالهم، يظلمون الأمة ويعتدون عليهم، إذا نازعوهم في بعض مسائل الدين، وكذلك سائر أهل الأهواء، فإنهم يبتدعون بدعة، ويكفرون من خالفهم فيها، كما تفعل الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، والذين امتحنوا بخلق القرآن كانوا من هؤلاء؛ ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها، واستحلوا منع حقه وعقوبته، فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون، وإما ظالمون، فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره، كما قال تعالى{وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ} [آل عمران:29]، وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضًا، كالمقلدين لأئمة الفقه الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابًا عن الرسول، وقالوا هذه غاية ما قدرنا عليه، فالعادل منهم لا يظلم الآخر، ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعي أن قول متبوعه هو الصحيح بلا حجة يبديها، ويذم من يخالفه مع أنه معذور).
وقال أيضا في بيان أن كلام الفقهاء يحتج له لا يحتج به – في الفتاوى (26/502-503) – (وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النِّزاع، وإنما الحجة النص والإجماع، ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية، لا بأقوال بعض العلماء؟ فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية، لا يحتج بها على الأدلة الشرعية، ومن تربى على مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه وهو لا يحسن الأدلة الشرعية وتنازع العلماء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول بحيث يجب الإيمان به، وبين ما قاله بعض العلماء، ويتعسر أو يتعذر إقامة الحجة عليه، ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام العلماء، وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم، مثل المحدث عن غيره، و الشاهد على غيره لا يكون حاكمًا، والناقل المجرد يكون حاكيًا لا مفتيًا).
ولهذا كان شيخ الإسلام مع شدته على أهل الأهواء والبدع إلا أنه كان يعاملهم بالعدل والإنصاف، ولا يبخسهم حقهم، ولم يأمر بظلمهم أو حبسهم، ولا يرد الحق الذي عندهم، وكان يذكر ما لهم وما عليهم، ويقر بفضل أهل الفضل منهم، فقد قال عن التنازع بين أهل السنة في مسألة الإيمان التي خالف فيها حماد وتلميذه أبو حنيفة فأخرجوا الأعمال من اسم الإيمان بأن الخلاف بين الفريقين خلاف لفظي صوري لا حقيقي – كما في مجموع الفتاوى (ج 7 / ص 297) – (ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء، كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم، متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد وإن قالوا : إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة، ويقولون أيضا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة، والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار، فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد، وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها ولا يخلد منهم فيها أحد، ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء ولكن ” الأقوال المنحرفة ” قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، وقول غلاة المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار ؛ بل نقف في هذا كله، وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام).
وقال أيضا عن المتكلمين وما لهم من مساع مشكورة – في درء تعارض العقل والنقل (2/102-103) – (ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة، وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع، والانتصار لكثير من أهل السنة مالا يخفى على من عرف أحوالهم، وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف، لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة، وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه، فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكر المسلمون من أهل العلم والدين، وصار الناس بسبب ذلك؛ منهم من يعظمهم؛ لما لهم من المحاسن والفضائل، ومنهم من يذمهم؛ لما وقع في كلامهم من البدع والباطل، وخيار الأمور أوساطها، وهذا ليس مخصوصًا بهؤلاء، بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين، والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات، ويتجاوز لهم عن السيئات {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [الحشر:10]. ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول وأخطأ في بعض ذلك فالله يغفر له خطأه، تحقيقًا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286]، ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ يشنِّع على من خالفه بما وقع فيه من خطأ ظنه صوابًا بعد اجتهاده، وهو من البدع المخالفة للسنة، فإنه يلزمه نظير ذلك أو أعظم فيمن يعظمه هو من أصحابه، فقل من يسلم من مثل ذلك في المتأخرين، لكثرة الاشتباه والاضطراب، وبُعد الناس عن نور النبوة وشمس الرسالة الذي به يحصل الهدى والصواب، ويزول به عن القلوب الشك والارتياب).
وقال أيضا – في الفتاوى (3/348-349) – (ومما ينبغي أيضًا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام؛ على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة، ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه؛ فيكون محمودًا فيما رده من الباطل وقاله من الحق؛ لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل، فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها؛ ورد بالباطل باطلاً بباطل أخف منه، وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة، ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولاً يفارقون به جماعة المسلمين؛ يوالون عليه ويعادون؛ كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك، ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها: لهم مقالات قالوها باجتهاد، وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة؛ بخلاف من والى موافقه؛ وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين، وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات؛ واستحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلاف).
ولا شك أن الأمة اليوم تحت نفوذ عدوها وشوكته أحوج ما تكون إلى مثل هذه الأصول التي تجمع ولا تفرق، وتعصم الدماء والأموال والأعراض ولا تصطلم، وتقر التعددية وتحترمها.
وقال شيخ الإسلام أيضا عن الشيعة الإمامية – في منهاج السنة (2/369) – وأن فقههم في الفروع غالبه موافق لمذاهب أهل السنة (الرافضة قولهم في الشرائع غالبه موافق لمذهب أهل السنة، أو بعض أهل السنة، ولهم مفردات شنيعة لم يوافقهم عليها أحد، ولهم مفردات عن المذاهب الأربعة قد قال بها غير الأربعة من السلف وأهل الظاهر وفقهاء المعتزلة وغير هؤلاء، فهذه ونحوها من مسائل الاجتهاد التي يهون الأمر فيها، بخلاف الشاذ الذي يُعرف أنه لا أصل له لا في كتاب ولا سنة رسول الله ولا سبقهم إليه أحد).
وقد اختار شيخ الإسلام في مسألة الطلاق الثلاث أنها تقع طلقة واحدة، مع أنه لم يبق من يقول بذلك في عصره إلا الشيعة الزيدية والشيعة الإمامية، وقد عُدّ هذا القول شعارا للرافضة منذ القرن الثاني، وأطبقت المذاهب الأربعة على الأخذ بقول عمر بأنه يقع ثلاث طلقات، فلم يلتفت شيخ الإسلام على ذلك، ونصر القول الآخر، واحتج بالسنة الصحيحة كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم.
وكذا اختار أن الطلاق في الحيض لا يقع، وكذا الطلاق البدعي، وقال بأن الحلف بالطلاق فيه كفارة يمين، وكل ذلك مما اشتهر أنها أقوال للشيعة، مع أنها أيضا قول الظاهرية من أهل السنة، وقول كثير من السلف.
وقد تأثر ابن القيم خطا شيخه ابن تيمية واحتج – في الصواعق المرسلة 2/117 – بنقل الإمامية في مسألة الحلف بالطلاق حيث قال ( الوجه التاسع : أن فقهاء الإمامية من أولهم إلى آخرهم ينقلون عن أهل البيت أنه لا يقع الطلاق المحلوف به، وهذا متواتر عندهم عن جعفر بن محمد وغيره من أهل البيت، وهب أن مكابرا كذبهم كلهم، وقال قد تواطؤوا على الكذب عن أهل البيت، ففي القوم فقهاء وأصحاب علم ونظر واجتهاد، وإن كانوا مخطئين مبتدعين في أمر الصحابة، فلا يوجب ذلك الحكم عليهم كلهم بالكذب والجهل، وقد روى أصحاب الصحيح عن جماعة من الشيعة، وحملوا حديثهم، واحتج به المسلمون، ولم يزل الفقهاء ينقلون خلافهم، ويبحثون معهم، والقوم وإن أخطأوا في بعض المواضع لا يلزم من ذلك أن يكون جميع ما قالوه خطأ حتى يرد عليهم هذا..).
6- تهوينهم من شأن الظلم وتعظيمهم أمر الإثم :
وهي من أبرز مظاهر الانحراف السياسي عند كثير من المتفقهة من أهل السنة، فتحت ذريعة طاعة ولي الأمر، والصبر على الجور، هان في نظرهم قيمة العدل، وسوء عاقبة الظلم، وانقلبت في نظرهم الأولويات، فصار موضوع منع المنكر والإثم، أهم عندهم من منع الجور والظلم، لأن الأول يقع من العامة أكثر، فيسهل على المتفقهة وأهل الاحتساب التصدي له، وتسليط ولاة الأمر عليهم لمنعه، بينما الظلم والجور إنما يقع عادة من الولاة، ولهذا شاع في الثقافة العامة عن أهل السنة تعظيم المنكرات كلها إلا الظلم والجور، وصاروا أزهد ما يكون بالعدل والقسط، بل صاروا يتمنون الظلم والطغيان العام، مع منع المنكرات، على العدل العام مع وقوعها!
وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على خطورة هذا الانحراف في المفاهيم والتصورات، فأكد على أن العدل هو نظام الحياة، وعليه تستقيم أحوال الأمم، وإن وقع منها إثم، وأن الله ينصر الكافر العادل ويخذل المسلم الظالم، فقال – في مجموع الفتاوى – (28/ 14) –(وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم : أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم ؛ ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة؛ ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال : الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام! وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم) فالباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة، وذلك أن العدل نظام كل شيء ؛ فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة ..
والناس هنا ثلاثة أقسام : قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم ؛ فلا يرضون إلا بما يعطونه، ولا يغضبون إلا لما يحرمونه ؛ فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال والحرام زال غضبه وحصل رضاه وصار الأمر الذي كان عنده منكرا، ينهى عنه ويعاقب عليه؛ ويذم صاحبه، ويغضب عليه، مرضيا عنده، وصار فاعلا له، وشريكا فيه؛ ومعاونا عليه؛ ومعاديا لمن نهى عنه وينكر عليه، وهذا غالب في بني آدم يرى الإنسان ويسمع من ذلك ما لا يحصيه، وسببه : أن الإنسان ظلوم جهول ؛ فلذلك لا يعدل، بل ربما كان ظالما في الحالين، يرى قوما ينكرون على المتولي ظلمه لرعيته واعتداءه عليهم ؛ فيرضي أولئك المنكرين ببعض الشيء فينقلبون أعوانا له، وأحسن أحوالهم أن يسكتوا عن الإنكار عليه، وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم إلى أقبح من الحال التي كانوا عليها، وقد يعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظيره، وقوم يقومون ديانة صحيحة يكونون في ذلك مخلصين لله مصلحين فيما عملوه ويستقيم لهم ذلك حتى يصبروا على ما أوذوا، وهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم من خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر).
وهذا الانحراف ظاهر في هذا العصر أكثر من أي عصر مضى حتى استبيحت المحرمات، وشاع الظلم، وتعطل العدل، في أكثر بلدان المسلمين، حتى صاروا يفرون من بلدانهم إلى بلدان غير المسلمين، لما يجدونه عندهم من التناصف والعدل فيما بينهم، ما لا يجدونه في بلدانهم!
وقد رأينا ما ذكره شيخ الإسلام عن هذه الطوائف رأي العين حتى ربما تصدى للمنكر طائفة من هؤلاء، ثم يرضيهم السلطان بشيء من حطام الدنيا، ثم لا يلبثون أن يكون هؤلاء المحتسبين سدنة له وأعوانا له على الأمة!
فهذه بعض ـ وليس كل ـ الانحرافات السياسية وللحديث بقية!
10- أهل السنة والجماعة إشكالية الشعار وجدلية المضمون
بقلم د. حاكم المطيري
سبق في الحلقات الماضية من هذه السلسلة تسليط الضوء على أزمة أهل السنة والجماعة العقائدية والسياسية، التي أدت إلى انحرافهم وضلالهم عن سنن النبوة والخلافة الراشدة في باب الإمامة وسياسة الأمة، حتى بلغ الانحراف بالأمة وبأهل السنة أن صار أكثرهم اليوم وهم دعاة التوحيد إلى عبادة الله، يدعون في الوقت ذاته وفي كل بلد إلى طاعة الطاغوت الذي يحكم بينهم بغير ما أنزل الله!
كما أصبح أكثرهم دعاة فرقة واختلاف بعد أن كانوا دعاة وحدة وجماعة وائتلاف!
فجاءت هذه الخاتمة تبشر بمشروع المستقبل للأمة كلها، كما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يجب أن يقوم على أصول الخطاب القرآني والنبوي والراشدي، كما في الحديث الصحيح (ثم تعود خلافة على منهاج النبوة)، وكما في الحديث (بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس)، وقد بلغ الفساد في هذا العصر ذروته، وهي المرحلة الثالثة التي وردت في الحديث الصحيح، وهي فترة الشر المحض حيث حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عصر تزول فيه الخلافة ويسود فيه (دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوها فيها.. هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا) وهم الذين وصفهم في الحديث الآخر (ثم يكون الطواغيت) حيث يستحلون سفك الدماء، واستباحة كل المحرمات والموبقات -كما سبق بيانه في كتاب الفرقان – وذلك حين تزول الخلافة عن الأرض، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة الواحدة والجماعة والأمة الواحدة هي العصمة من هذه الفتنة العامة، التي يدعو إليها دعاة الفتنة والفرقة على أبواب جهنم، فقال (الزم جماعة المسلمين وإمامهم)، وقال (إن كان لله في الأرض خليفة فالزمه)!
فكان الواجب على الأمة كلها اليوم إعادة الأمة الواحدة، وإقامة الخلافة الراشدة، وبعث الخطاب السياسي القرآني والنبوي والراشدي من جديد كما أمرهم الله ورسوله، كما في الحديث الصحيح (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)، وهو ما أجمع عليه الصحابة والخلفاء الراشدون وجاهدوا فيه ومن أجله حق الجهاد، وضرورة طرحه كمشروع سياسي استراتيجي، يواكب تطور العصر، ويأخذ بأسباب الحضارة وتقدمها، ويخاطب الأمة كلها ويبشرها بتحقق أحلامها وآمالها بالعدل والحرية والعزة والوحدة والكرامة، لتناضل الشعوب من أجله، وتضحي في سبيله، حتى يحقق لها وحدتها، وحريتها، وسيادتها، وكرامتها، ويقيم لها دينها وشريعتها!
لقد ظلت الأمة ـ التي يمثل أهل السنة والجماعة عامتهم وتسعين بالمئة منهم ـ مائة عام بعد سقوط الخلافة العثمانية بلا مشروع سياسي، يعبر عن هويتهم، ويقوم على أصول الخطاب السياسي الإسلامي، وظلت الحركات الإسلامية – التي قامت أصلا من أجل استعادة الخلافة واستئناف الحياة الإسلامية من جديد – حركات عقائدية ودعوية وتربوية دون أي مشروع سياسي استراتيجي يعبر عن طبيعة النظام السياسي الإسلامي وفق أصول أهل السنة والجماعة – الذي لم يعرف المسلمون غيره منذ عصر الخلفاء الراشدين إلى آخر الخلفاء العثمانيين – المتمثل بالخلافة بأصولها ومبادئها وغاياتها وأحكامها التي أجمع عليها سلف الأمة وأهل السنة، فتعايشت تلك الحركات السنية مع كل الأنظمة التي قامت في كل بلد قومية كانت أو قطرية، ملكية أو جمهوية، رأسمالية أو اشتراكية، بل وأضفت عليها الشرعية، ومن مارس العمل السياسي منها مارسه بلا عقيدة سياسية، وبلا هوية دينية، بل تحت شعار فضفاض (الإسلام هو الحل) دون الإجابة عن تحديد الموقف العقائدي من إشكالات الواقع السياسي، ومن رفض هذا الواقع منها ولم يعترف به، اعتزله وظل بعيدا عن واقع الأمة ومشكلاتها – واكتفى بالنضال الفكري، الذي وإن كان ضروريا إلا أنه لا يحدث التغيير وحده – عاجزا عن طرح مشروع سياسي يحقق للأمة ما تصبو إليه من الحرية والعدل والمساواة والوحدة، ولو مرحليا وفق فقه المقاربات لحديث (ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)، وظلت عودة الخلافة عندهم حلما جميلا يراود خيالهم، ويداعب آمالهم، غير أنهم لم يستطيعوا تحويل أمانيهم إلى مشروع سياسي يناضلون من أجله نضالا سياسيا، كما ناضلت كل حركات التغيير في العالم لتحقيق مشاريعها السياسية على أرض الواقع، كما قال تعالى {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم} بل ظل نضالهم نضالا فكريا في أفضل حالاته، بل سيطرت عليهم فكرة عقائدية يستبطنها أكثر أهل السنة اليوم، ترى بأن مهمة إعادتها (أمة واحدة وخلافة راشدة) من جديد، ليست مسئوليتهم، بل مسئولية المهدي المنتظر، أو مسئولية الله الذي يبعث الخلافة متى شاء! دون أن يقوم المسلمون أنفسهم بهذا الواجب كما فعل الشيوعيون الماديون الذين استطاعوا في نصف قرن أن يجعلوا من الشيوعية والاشتراكية واقعا يحكم نصف العالم!
بل صار من يتحدث عن ضرورة بعث الخطاب الراشدي في نظرهم أشبه بالخيالي الحالم، منه بالمجاهد العالم، حتى قال لي بعض كبار الدعاة المصلحين : يتهمك المشايخ بأن ما تدعو إليه ضرب من الخيال، وأقرب إلى المحال!
فقلت له: إنما يصدق هذا الاتهام على دعاة الشيوعية، حين دعا لها ماركس في كتابه (رأس المال)، وكان الحديث حينها عن قيام دولة ونظام شيوعي اشتراكي تحكم فيه الطبقة العمالية حديث خرافة، حتى قامت الثورة البلشفية في روسيا سنة 1917 م، فلم يمض عليها نصف قرن حتى كانت نصف حكومات العالم اشتراكية!
أو كدعوة مفكري أوربا قبل الثورة الفرنسية سنة 1789 م إلى الحرية والديمقراطية، حتى ذهب في سبيل ذلك نصف مليون من علماء أوربا ومفكريها حرقا وشنقا من أجل تغيير واقعهم، فكانت ثمرة نضال تلك الشعوب سيادة العالم اليوم!
أو كدعوة استقلال أمريكا وتوحيد ولاياتها التي بدأت فكرة جنونية لدى بعض الحالمين، فصارت بنضال الثوار واقعا سياسيا، ثم لم يمض مائة عام فإذا الولايات المتحدة تسود العالم!
أو كدعوة الشيخ المدرسي الشيعي حين كان ينظّر لولاية الفقيه حتى تلقفها الخميني، وقامت الثورة على الشاه، من أمة ظلت أكثر من ألف عام تنتظر المهدي في سردابه، فصارت اليوم بفضل نضالها قوة يحسب العالم حسابها!
أو كحلم العودة التي ظل يراود خيال اليهود مدة ألفي عام، فمازال دهاتهم يضعون الخطط ويبذلون الغالي والنفيس، حتى صارت دولتهم حقيقة على أرض الواقع ظلما وعدوانا، إلا أن السنن الاجتماعية الإلهية لا تحابي أحدا أبدا، فمن يعمل يحصد ويصل، ومن يكسل يهن ويذل!
أما ما ندعو نحن إليه فليس حلما أو خيالا، بل هو تكليف رباني شرعي، وواجب ديني قطعي، بإجماع الأمة وأئمة أهل السنة، كما أن عودتها بشارة نبوية لا شك فيها ولا ريب لمن كان يؤمن بالله ورسوله، كما وأنه الواقع التاريخي السياسي للأمة منذ العصر الرشيد، إلى عهد السلطان عبد الحميد!
فكيف توصف الدعوة إلى استعادة الخلافة التي سادت الأمة العالم به كنظام سياسي مدة ألف وثلاثمائة سنة بأنها ضرب من الخيال، وطلب للمحال!
هذا والأمة اليوم ألف وخمس مائة مليون مسلم كلهم مخاطبون بإقامة أحكام الله في الأرض وأولها الخلافة على سنن الخلفاء الراشدين!
إن ما ندعو إليه إنما هو دين الله وشرعه وهداياته، وإنما صرف الأمة عنه الأئمة المضلون، وتقاعست عنه همم المصلحون المخلصون، كما في الحديث (بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن، حب الحياة وكراهية الموت)!
وكما في الحديث (أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون)!
وكما في الحديث (إذا تبايعتم بالعينة – الربا – وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم) فدل على أنهم ليسوا على دين حق!
فصار العالم الإسلامي السني يعيش منذ مائة عام حالة من غيبة الوعي، وفقدان الذاكرة، وعقيدة الانتظار للخلافة الغائبة، التي سيعيدها في نظرهم رجل مجهول يوما ما خلافة على نهج النبوة، وليسوا هم المخاطبين بذلك لا غيرهم!
هذا في العصر الذي تخلى الشيعة عن عقيدة الانتظار بعد أن طال عليهم الأمد ألف عام، فلم يخرج المهدي، فبادروا إلى تغيير واقعهم السياسي وفق ولاية الفقيه التي لا يوجد لها أي سند شرعي لا عند السنة ولا عند الشيعة، ومع ذلك صارت واقعا سياسيا بعد نضال سياسي!
وإذا كان سؤال ذلك الشيخ الفاضل لي يدل على أزمة عزيمة، وضعف همة، فأشد منه خطرا الأسئلة التي تدل على أزمة معرفية علمية، فقد قال لي أحد المشايخ ممن ابتليت الأمة بهم : إن الأمة أصلا لم تجتمع في دولة واحدة منذ القرن الثاني!
فقلت له: عجبا ! كيف يكون ذلك؟ وآخر خلافة ظلت تسود العالم الإسلامي والمسرح الدولي خمسة قرون تقريبا، يخطب للخليفة فيها على منابر مساجد المسلمين من أقصى الهند شرقا، إلى أقصى المغرب، ومن أقصى آسيا الوسطى شمالا، إلى أواسط أفريقيا جنوبا، طول هذه القرون إلى الحرب العالمية الأولى؟! يوم أن كان ولاة أمرك أقصى أماني أحدهم أن يوظف قائمقام عثماني، وهو ما يعادل مدير بلدية أو محافظ مدينة!
وحتى عندما سقطت أطراف بلدان العالم الإسلامي تحت الاحتلال الأوربي، كان المسلمون لا يعترفون إلا بالخليفة العثماني في إسطنبول، فكان أقصى أماني بريطانيا والدول الاستعمارية آنذاك عدم استثارة الخلافة حتى لا يدعو الخليفة المسلمين للجهاد؟!
لقد تعرض هؤلاء المشايخ لغسيل دماغ حتى لم يعد تاريخ الأمة تاريخهم، بل تاريخهم يبدأ من بداية عصر أمراء طوائفهم!
إن الأمة قد تعرضت بعد سقوط الخلافة العثمانية، وإقامة الاستعمار دويلاته الصليبية على أنقاضها، إلى هزيمة نفسية كبرى، جعلها عرضة للمسخ المعرفي الذي فرضه الاحتلال من خلال المناهج التعليمية التي كان لبريطانيا وفرنسا يد طولى في وضعها، حتى خرجت أجيال لا تعرف من تاريخها إلا من حيث بدأ المشروع البريطاني الفرنسي الاستعماري للعالم الإسلامي!
وإن أكثر علماء الأمة فضلا عن عامتها لا يعرف تاريخ الأمة وتاريخ خلافتها في الأرض، ومراحل قوتها وضعفها! ولا يعرفون أن الخلافة كانت في أوج قوتها نظاما سياسيا مركزيا كما في عصر الخلافة الراشدة، ثم الخلافة الأموية، ثم بداية الخلافة العباسية، حيث ضعف مركز الخلافة فصارت الدولة لا مركزية، للأمراء في الأقاليم سلطة ذاتية تابعة للخلافة، ولم يستطع أحد تجاوز شرعية الخلافة، ولم يستطع الأمويون في الأندلس أن يجرؤا على إعلان استقلالهم عن الخلافة في بغداد، إلا في عهد عبد الرحمن الناصر بعد نحو مائي سنة من الحكم الذاتي، فلما تجرأ على ذلك لم يلتفت إليه حتى علماء بلده، ولم يعترفوا له بالخلافة، ولم يدعها أحد بعده، بل حتى العبيديون الباطنيون حين حكموا مصر وامتد نفوذهم، لم يجدوا بدا من ادعاء الخلافة كنظام سياسي ليقبل المسلمون حكمهم، ولم يّدعوا الإمامة وفق مذهبهم الباطني الشيعي، غير أنهم لم تطل مدتهم، ولا اعترفت الأمة بهم، وظل الخليفة العباسي في بغداد هو خليفة المسلمين، وإن ضعفت سلطته وشوكته أحيانا، وقويت أحيانا، حتى انتقلت الخلافة العباسية إلى مصر، وأحاطها المماليك بسيوفهم، ووحدوا الأمة وحموها بشرعية الخلافة عندهم، حتى إذا ضعفوا، وقام العثمانيون في تركيا وأخذوا يفتحون أوربا شمالا، فإذا العرب يستصرخونهم جنوبا، ويستغيثون بهم لحمايتهم من الأسبان والبرتغال الذين بدؤوا يهددون جزيرة العرب، فتوجه العثمانيون شطر الشرق الإسلامي، وتنازل آخر الخلفاء العباسيين للسلطان سليم الأول، فكان أول خليفة للمسلمين من غير العرب، فأعادها من جديد دولة مركزية، فكانت دار الإسلام واحدة، والأمة واحدة، والسلطة واحدة، والمرجعية التشريعية واحدة، والجيوش واحدة، من أقصى شمال البلقان إلى أقصى جنوب السودان، ومن أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، مدة أربعة قرون، ولم يخرج عن سلطة الخلافة العثمانية في أوج قوتها، ولم يتجاوز نفوذها والاعتراف بشرعيتها، سوى الصفويين الشيعة في إيران، بتحالفاتهم مع الأوربيين!
لقد صار هذا التاريخ – الذي هو ذاكرة الأمم والذي يصوغ نظرياتها وتطلعاتها – نسيا منسيا حتى رضيت الأمة بهذا البديل الممسوخ الذي فرضه الصليبيون على الأمة باسم القومية والوطنية!
وإن إصلاح هذا الخلل العقائدي والسياسي والثقافي الخطير عند أهل السنة الذين يمثلون عامة الأمة، يحتاج إلى جهد سياسي وفكري وثقافي ومعرفي كبير، يعالج مشكلاته، ويقدم لها الحلول الشرعية السياسية، ويبعث الخطاب الراشدي من جديد، ويعمل على التبشير به، وتهيئة الظروف له، ودعوة الأمة كلها شعوبا وحكومات إليه بكل الوسائل المشروعة.
وقد جاء في الحديث (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة عام من يجدد لها دينها)، ولفظ (من) من صيغ العموم، فيدخل فيه كل من يسهم في تجديد الدين فردا كان أو جماعة، تجديدا جزئيا أو كليا، وهو إعادته إلى الأصل الذي كان عليه، وإن التاريخ لا يصنعه إلا الرجال الأفذاذ، فالإنسان حيث يضع نفسه، وإنما قاد حركة التغيير في المجتمعات الإنسانية كلها أفراد كان يحدوهم الأمل، ويسددهم الرأي، ويشد أزرهم الصبر، فإذا أحلامهم تتحقق في حياتهم أو بعد موتهم، وإذا هم في ذاكرة سفر الخلود الإنساني عند أممهم، وما كان ذلك ليتحقق لهم إلا بقوة الإرادة، ووضوح الغاية، ونفاذ البصيرة، وللأمم عبرة فيما تحقق على يد حركات التغيير في العالم كله، التي بدأت حلما لدى نفر قليلين مستضعفين، فأصبحت واقعا يعيشه الملايين!
إن بعث الخطاب السياسي القرآني والنبوي والراشدي من جديد – نظريا أولا وسياسيا ثانيا – ليس فقط ضرورة شرعية كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار) وبقوله (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي) وقوله (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)…الخ.
وليس فقط بشارة نبوية لا بد أن تقع قضاء وقدرا كما أخبر المصطفى وبشر فقال (تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم يكون ملكا عضوضا ثم ملكا جبريا – ثم يكون الطواغيت – ثم تعود خلافة على منهاج النبوة)..الخ.
بل هي أيضا ضرورة سياسية بعد أن جربت الأمة كل المشاريع السياسية الأخرى فلم تحقق لها وحدتها، ولم تحافظ على أمنها وسيادتها، ولا استعادت حقوقها وحريتها، فكان لا بد من إعادة النظر في أسباب قوتها سابقا، وأسباب ضعفها لاحقا، وطرح الحلول السياسية والعلمية والفكرية لمشكلاته وإشكالاته، وليس أمامها إلا مشروع (الأمة الواحدة والخلافة الراشدة) غير أنه لن يستطيع حمل هذا المشروع والنهوض به جماعات دعوية أو مؤسسات مجتمعية، بل لن ينهض به إلا تنظيمات سياسية تؤمن بالخطاب السياسي الراشدي، وتقوم في كل بلد، وتناضل نضالا سياسيا لتحقيقه على أرض الواقع في أقطارها أولا، وعلى مستوى الأمة كلها ثانيا، وتشترك فيما بينها في منظمة سياسية دولية، أو اتحاد سياسي عالمي، أو تنظيم سياسي دولي، يستفيد من كل المؤسسات ومراكز الدراسات، ويضع الخطط والبرامج المشتركة، ويحدد الأهداف والوسائل لكل مرحلة، كما يحتاج إلى خطاب سياسي وديني وفكري وعلمي قادر على استثارة الحس الجماهيري الشعبي، وإثارة العقل العربي الذي يحتاج إلى ثورة جذرية دينية وفكرية وسياسية تغير واقعه نحو مستقبل أفضل!
ويجب البدء في العالم العربي لكونه الحلقة الأضعف في منظومة العالم الإسلامي، حيث ما تزال شعوبه تخضع للاستبداد من جهة، والاحتلال الأجنبي من جهة أخرى، ولكونه قلب العالم الإسلامي كله جغرافيا وروحيا وثقافيا، فإذا صلح، صلح سائر الجسد، وإذا فسد، فسد سائر الجسد، ولأنه منطقة التحدي الحضاري في نظر الغرب الصليبي، بسبب موقعه الإستراتيجي وثرواته الطبيعية التي تمثل 60 بالمئة من احتياطي العالم من النفط، ولهذا يخشى الغرب من تحرره أشد من خشيته من تحرر ما سواه من شعوب العالم الإسلامي، ولهذا أكد بيرجنسكي مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقا في كتابه (رقعة الشطرنج) على ضرورة إبقاء العالم العربي كما تم تقسيمه منذ سايكس بيكو، والحيلولة دون وحدته ولو على نمط الاتحاد الأوربي، من أجل المحافظة على السيطرة على المنطقة وثرواتها!
كما إن العالم العربي يشكل أكبر قومية في العالم الإسلامي، وهي أكثر القوميات قدرة على جمع الأمة حولها، إذ إن من أصول أهل السنة والجماعة تفضيل العرب ومعرفة حقهم، لما لهم من السبق في حمل الإسلام، ولما لهم من الخصوصية في بعض الأحكام، ولمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، ولهذا فالشعوبية – التي تنتقص العرب، أو تحتقرهم، أو تعاديهم، خاصة السابقين من المهاجرين والأنصار الذين نصروا الله ورسوله، وفتحوا العالم وحرروه من عبادة كسرى وقيصر – معدودة عند أهل السنة من فرق الابتداع والانحراف، وكان أول من ذكرهم من أئمة السنة الإمام أحمد بن حنبل حيث جاء عنه من رواية الكرماني لعقيدته (ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها، ونحبهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حبهم إيمان وبغضهم نفاق، ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي، الذين لا يحبون العرب، ولا يقرون لها فضل، فإن لهم بدعة ونفاقا وخلافا).[1]
وروى أحمد بن جعفر الأصطخري عن أحمد قوله (والشعوبية وهم أصحاب بدعة وضلالة، وهم يقولون إن العرب والموالي عندنا واحد، لا يرون للعرب حقا، ولا يعرفون لهم فضلا، ولا يحبونهم، بل يبغضون العرب، ويضمرون لهم الغل والحسد والبغضة في قلوبهم، وهذا قول قبيح ابتدعه رجل من أهل العراق).[2]
كما ذكرهم عبد القاهر البغدادي كفرقة من فرق أهل البدع المتأثرة بدين الباطنية، حيث قال عنهم (والذي يروج عليهم مذهب الباطنية أصناف: أحدها العامة الذين قتلت بصائرهم بأصول العلم والنظر كالنبط والأكراد وأولاد المجوس، والصنف الثاني الشعوبية الذين يرون تفضيل العجم على العرب، ويتمنون عود الملك إلى العجم).[3]
ولا شك بأن إيمان أهل السنة والجماعة – الذين يمثلون أكثر من تسعين بالمئة من الأمة – بهذا الأصل العقائدي، وبوجوب حب العرب المسلمين، ومعرفة حقهم وفضلهم، سيجعل من العرب كقومية، من أقدر أمم العالم الإسلامي على اجتماع الأمة عليهم، حين تتحقق وحدتهم ونهضتهم!
وهذا واضح جلي فإن شعوب العالم الإسلامي بثقافتها الدينية الفطرية من أقصى الصين والهند وأفغانستان إلى أندونيسيا وماليزيا إلى أقصى أفريقيا إلى المسلمين في أوروبا، يعظمون العرب المسلمين وسلفهم الصالحين، ويحبونهم ويجلونهم، لكون عامة شعوب العالم الإسلامي من أهل السنة، ولرسوخ هذه العقيدة بينهم، إلا ما كان من الإيرانيين بسبب تشيعهم الغالي الذي اختلط بالشعوبية، فصاروا يبغضون العرب خاصة السلف الصالح، ويحتقرونهم، ولهذا لم تستطع إيران تجاوز هذه الإشكالية إلى اليوم، حتى داخل إيران، لأن التشيع يحمل في طياته الشعوبية التي صارت حاجزا بينهم، وبين العرب خاصة والأمة عامة، ولهذا لم يستطع التشيع الشعوبي أن يخترق العالم العربي مدة ألف ثلاثمائة سنة حتى اليوم، لكون العرب بفطرتهم يرفضون الشعوبية التي تحتقرهم وتزدري تاريخهم الإسلامي كله، وفتوحاتهم، وأبطالهم، منذ خلافة أبي بكر الصديق ومن بعده، وتصويره على أنه ظلمات بعضها فوق بعض، حتى جاء الخميني وخامنئي ورافسنجاني بالإسلام الحق!
إن هذه العقيدة السنية السياسية في الموقف من العرب ستكون حجر الأساس لوحدة العالم العربي، واتحاده مع محيطه الإسلامي مرحليا، ولو على نمط وحدة الاتحاد الأوربي، بعد عقود من النعرات القومية التي نقلتها أوربا إلى العالم الإسلامي فقسمته شذر مذر بالعصبيات الجاهلية!
ولعل أحد أهم أسباب ضعف الأمة اليوم غياب الأيديولوجيا السياسية، وهي العقيدة السياسية التي يقوم عليها أي مشروع سياسي، وقد أدى غيابها إلى هذه الفوضى التي أصيبت بها الجماعات الإسلامية على اختلاف ألوان طيفها، فتارة تقاوم الاحتلال، وتارة تتعاون معه وتعمل تحت ظله، وتارة تناوئ المستبد، وتارة تآزره وتقف معه، وتارة تدعو إلى العدل، وتارة ترفضه، وتارة تنادي بالحرية، وتارة تتراجع عنها، فليس عندها في السياسة محددات لا تقبل المساومات، بل كل شيء قابل للتأويل، والأخذ والرد، والبيع والشراء!
ولم يعد شعار (الإسلام هو الحل) مفهوما عند شعوب الأمة، حين تطرحه هذه الجماعات وتبشر به، فهو يحمل في كل قضية الشيء ونقيضه!
هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى نزل قوله تعالى{اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} وحتى قال صلى الله عليه وسلم (تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك) وقال(تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي).
وقد حدد صلى الله عليه وسلم طبيعة النظام بعده وأنه خلافة تقوم على الشورى والرضا، وتعبر عن وحدة الأمة والدولة والسلطة، وذلك في أحاديث متواترة تواترا معنويا فقال(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور).
كما قال أيضا (تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم يكون ملكا عضوضا ثم ملكا جبريا ثم تعود خلافة على منهاج النبوة).
وكما في قوله (يكون خلفاء فيكثرون فأوفوا بيعة الأول فالأول).
وقال(إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما) …الخ.
فأجمع الصحابة على ذلك كله، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لوضوح هذا الأصل عندهم وثبوته ثبوتا قطعيا، وأن الأمر في الإسلام – بعد النبوة – خلافة لها أصولها وقواعدها، وأحكامها ومقاصدها، وقد عبرت الخلافة كنظام سياسي عن طبيعة الدولة، وهوية الأمة، على مر العصور، ومع ما طرأ عليها من تراجعات وتطورات، إلا أن الخلافة كنظام سياسي ظلت الجامعة لوحدة الأمة، والحامية لكيانها المادي والمعنوي السياسي والأيديولوجي، والمعبرة عن هويتها وخصوصيتها، وهو ما جعل الغرب الصليبي يجعل من أولى أولوياته القضاء على الخلافة كنظام سياسي، وقد بدأ التخطيط لذلك منذ معاهدة كارلوفوجه سنة 1699م كما ذكره المؤرخ الفرنسي غروسيه في كتابه(وجه آسيا)، ثم في مؤتمر برلين سنة 1880 م، وتوج ذلك بإسقاطها بعد الحرب العالمية الأولى سنة 1924م، وقد ضج العالم الإسلامي آنذاك من أقصاه إلى أقصاه، وأدرك علماء الأمة مدى خطورة سقوطها، وأنه لا بقاء للإسلام دينا وأمة وشريعة بسقوط الخلافة الدولة والسلطة والنظام السياسي، كما عبر عن ذلك آخر شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية الشيخ مصطفى صبري، والشيخ محمد رشيد رضا، فلم يكن سقوط الخلافة بعد الحرب العالمية الأولى على يد الحملة الصليبية الثامنة على العالم الإسلامي حدثا سياسيا فقط ـ كما يتصوره البعض ـ بل كان حدثا مفصليا في تاريخ العالم الإسلامي ما زالت الأمة كلها تعيش تداعياته إلى يومنا هذا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وروحيا، حيث تعيش الأمة أزمة هوية كبرى عبر عنها كثير من المفكرين والمؤرخين الغربيين أنفسهم كما تنبه له فرومكين في كتابه(ولادة الشرق)حيث يقول:
(أصبح الشرق الأوسط على ما هو عليه الآن، لأن الدول الأوربية أخذت على عاتقها أن تعيد تشكيله من جهة، ولأن بريطانيا وفرنسا أخفقتا في ضمان استمرار الأسر الحاكمة، والدول، والنظم السياسية، التي أوجدتاها، بعد أن قضتا خلال الحرب العالمية الأولى قضاء مبرما على النظام القديم في المنطقة – أي الخلافة – وحطمتا الحكم العثماني للشرق الأوسط العربي تحطيما لا خلاص منه، ولكي تأخذ الدولتان مكان النظام القديم، أوجدتا بلدانا، وعينتا حكاما، ورسمتا حدودا، وأدخلتا نظام دول، ولكنهما لم تقضيا على كل معارضة محلية هامة لقراراتهما، ولا تزال إلى يومنا هذا قوى محلية ذات بأس في الشرق الأوسط غير موافقة على هذه الترتيبات، وقد تطيح بها، إن ثمة مطالب هي أكثر صلة بالجوهر، وهذه الخلافات لا تقتصر على الحدود فحسب، بل تطرح أيضا حق الوجود لبلدان انبثقت عن القرارات البريطانية الفرنسية في أوائل العشرينات من القرن العشرين، وهذه الخلافات تذهب إلى غور أعمق، وتبحث مسائل تبدو مستعصية على الحل وهي: هل يستطيع النظام الحديث الذي ابتكرته أوربا ونقلته إلى المنطقة، ومن مميزاته تقسيم الأرض إلى دول علمانية مستقلة أساسها مواطنية قومية أن يكون هو البديل؟
إن الأفكار السياسية الأوربية ومنها الحكومة المدنية العلمانية، تعد عقيدة غريبة على منطقة أكد معظم سكانها، ولمدة تربو على ألف عام، إيمانهم بشريعة دينية تحكم كل جوانب الحياة، ومنها الحكومة والسياسة، لقد أقر فعلا رجال الدولة الأوربيون في زمن الحرب العالمية الأولى بوجود المشكلة وبأهميتها، فما إن بدأ قادة الحلفاء يخططون لضم الشرق الأوسط إلى دولهم، حتى أدركوا أن سلطة الإسلام على المنطقة هي الخاصية الرئيسية للخريطة السياسية، التي يتحتم عليهم أن يجابهوها، وقد شن كيتنشر عام 1914م سياسة هدفها جعل الإسلام تحت سيطرة بريطانيا، فلما ظهر أن هذه السياسة لن تنجح، رأى معاونو كيتنشر البديل في رعاية ولاءات أخرى، لاتحاد شعوب عربية، أو لأسرة الشريف حسين، أو لبلدان كان عليها أن تخرج للوجود كالعراق، وأن تكون هذه الولاءات منافسة للوحدة الإسلامية، والحقيقة أنهم عندما صاغوا تسوية الشرق الأوسط لما بعد الحرب، كان هذا الهدف نصب أعينهم، بيد أن فهم المسئولين الأوربيين في ذلك الحين للإسلام كان ضئيلا، فقد هونوا الأمور باقتناعهم أن المعارضة الإسلامية للعصرنة لإضفاء الصبغة الأوربية كانت في طريقها للتلاشي، ولو أبصروا النصف الثاني من القرن العشرين لأدهشتهم حمية المذهب الوهابي في المملكة العربية السعودية، وعاطفة الإيمان الديني في أفغانستان المتحاربة، واستمرار حيوية الأخوان المسلمين في مصر وسوريا، وغيرهما من العالم السني، والثورة الخمينية في إيران الشيعية، إن استمرارية المقاومة المحلية لتسوية عام 1922م، وللأفكار الأساسية التي قامت على أساسها، تفسر أنه لا وجود في الشرق الأوسط للإحساس بالشرعية، وليس في المنطقة إيمان يشارك فيه الجميع بأن الكيانات التي تسمي نفسها بلدانا، والرجال الذين يدعون أنهم حكاما، لها أو لهم حق الاعتراف بهم كبلدان أو كحكام، ولا يمكن القول بأن الذين خلفوا السلاطين العثمانيين، قد نصبوا في مناصبهم بصفة دائمة، مع أن هذا ما اعتقد الحلفاء أنهم فاعلوه بين عامي 1919 و1922م.)[4].
ويقول فرومكين أيضا:( إذا استمر زخم التحديات، لتسوية 1922م أي لوجود الأردن، وإسرائيل، والعراق، ولبنان، على سبيل المثال، فإننا سنرى يوما ما الشرق الأوسط الذي عرفناه في القرن العشرين في وضع يشبه وضع أوربا في القرن الخامس الميلادي، عندما ألقى انهيار الإمبراطورية الرومانية في الغرب، شعوب الإمبراطورية في خضم أزمة حضارة، لقد احتاجت أوربا إلى ألف وخمسمائة عام لتحل أزمة هويتها الاجتماعية والسياسية بعد زوال الإمبراطورية الرومانية، منها نحو ألف سنة لكي يستقر النظام السياسي على شكل الدولة الأمة، ونحو خمسمائة سنة أخرى لتقرير من هي الأمم التي تملك الحق في أن تشكل دولا، وهل يكون الولاء للسلالات الأسرية، أو للدولة القومية، أو لدول المدن؟ لقد تبين أن موضوع أزمة الشرق الأوسط المستمرة في زمننا، هو مثيل موضوع أزمة أوربا الغربية، وإن لم يكن بنفس العمق وطول الزمن، فكيف تستطيع شعوب متنوعة أن تعيد تجميع نفسها لخلق هويات سياسية جديدة، بعد انهيار نظام إمبراطوري طويل العهد اعتادت عليه؟ لقد اقترحت دول الحلفاء في مطلع العشرينيات من القرن العشرين شكلا للمنطقة بعد زوال الدولة العثمانية، لكن السؤال الذي لا يزال قائما:هل تقبله شعوب المنطقة؟ ولذلك فإن تسوية 1922م لا تخص الماضي، بل هي في قلب الحروب والنزاعات والسياسات الراهنة في الشرق الأوسط).[5]
انتهى كلام فرومكين وهو تفسير دقيق، وتحليل عميق، للأزمة التي يعيشها العالم الإسلامي، فقد سقطت الخلافة العثمانية ـ مع ضعفها وهشاشتها قبيل سقوطها ـ فسقط معها الإسلام الدين والهوية، والإسلام الأمة والوطن، والإسلام النظام والدولة، والإسلام الشريعة والقانون، ليعيش المسلمون حالة من الاغتراب السياسي والفكري والثقافي والتشريعي غير مسبوقة في تاريخهم كله، لتعصف بهم الأحداث السياسية والمحدثات الأيديولوجية، فكان البديل العلمانية المادية الشيوعية والاشتراكية، والقومية والوطنية، والليبرالية والرأسمالية، التي اجتاحت العالم العربي والإسلامي، وقامت دويلات الطوائف الجمهورية والملكية، المدنية والعسكرية، فما ازدادت الأمة معها إلا ضعفا وتشرذما وتخلفا واغترابا، فهي بلا دولة، وبلا دين، وبلا مشروع سياسي وأيديولوجي، وبلا أهداف إستراتيجية!
لقد صدق فرومكين في تحليله ولم يصب في تنبؤاته، فلن يمر العالم الإسلامي بما مرت به أوربا ألف سنة ليحدد مستقبله، بل ستعود خلافة راشدة وأمة واحدة من جديد، كما بشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الذي بشر بفتح القسطنطينية فتحققت بشارته في أضعف مرحلة تاريخية مرت بها الأمة!
لقد ظهرت الحركات الإسلامية بعد سقوط الخلافة العثمانية، كردة فعل واستجابة طبيعية، وحاولت إحياء موضوع الخلافة إلا أنها أخفقت في ذلك وكان الخلل يتمثل في:
1 ـ عدم بلورة مشروع الخلافة كنظام سياسي واضح المعالم يعبر عن الإسلام كدين وعقيدة ـ كالنظم الاشتراكية للشيوعية والنظم الديمقراطية لليبرالية ـ والعجز عن بعثه من جديد على أصول الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة في عصر الخلفاء الراشدين، ومعالجة مشكلات الواقع من خلال فقه المقاربات لهذا الخطاب مرحليا، فكانت الحركات الإسلامية على حالين:
· إما حركات همشت هذا الموضوع ولم يعد من أولوياتها واهتماماتها أصلا كالحركات الصوفية والحركات السلفية المعاصرة.
· أو حركات أولتها أهمية غير أن تصوراتها عن الخلافة ظلت رهينة الخطاب المؤول وما قرره الفقه المؤول كما عبرت عنه كتب الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية، وهو ما لم يجد قبولا لدى عامة المسلمين ونخبهم السياسية والثقافية التي تتطلع إلى واقع جديد لم تجده في خطاب هذه الحركات، فليس في خطابها تأكيد على حق الأمة في اختيار السلطة، ولا حقها في الحرية السياسية والتعددية، ولا حقها في العدل والمساواة، ولا حقها في مقاومة الاستبداد، ولا حقها في مقاومة الاستعمار- وإن حاولت مؤخرا استدراك ذلك – وظلت أشد الحركات الإسلامية عناية بموضوع الخلافة أبعد الحركات عن ممارسة أي عمل سياسي يؤدي إلى التمكين! بل ظلت حبيسة تصورات سطحية غير شرعية وغير عقلية وغير سياسية عن كيفية إعادة الخلافة!
فلما قامت أول تجربة في السودان بعد ستين سنة من العمل الإسلامي السياسي كانت أسوأ نموذج يمكن تقديمه باسم الإسلام، فهي تجربة بلا هوية دينية، ولا عقيدة سياسية، ولا حرية وتعددية، فكانت أشبه بأي نظام عربي آخر منها بالنظام السياسي الإسلامي!
وفي الوقت الذي نجحت فيه الأقلية الشيعية في إيران من بلورة مشروع سياسي وفق نظرية ولاية الفقيه، بعد تجاوز إشكالية انتظار المهدي ليقف الشعب الإيراني مع مشروعها السياسي، ظلت الأكثرية التي تمثل تسعين بالمئة من الأمة بلا مشروع سياسي!
2 ـ عدم قيام تنظيمات سياسية سنية، تحمل مشروعا سياسيا يعبر عن الخطاب السياسي السني الراشدي، وتناضل من أجل تحقيقه، وهو نتيجة حتمية لعدم وجود المشروع السياسي السني أصلا، ففي الوقت الذي قامت تنظيمات شيعية تحمل المشروع السياسي لولاية الفقيه وهي نظرية حديثة لم يعرفها الشيعة إلا في هذا العصر، لم يقم في المقابل أي تنظيم سياسي يحمل المشروع السياسي السني الراشدي مع أن الخلافة الإسلامية كنظام سياسي ظل يحكم واقع الأمة ثلاثة عشر قرنا! وحتى حزب التحرير الذي جعل قضيته المركزية قضية الخلافة، وتسمى باسم الحزب، ظل جماعة إسلامية دعوية وفكرية دون أي نضال وصراع سياسي من أجل تحقيق ما يصبو إليه!
3 ـ عجز الحركات الإسلامية في العالم العربي خاصة، عن التأثير في الواقع السياسي، وعجزها عن معالجة مشكلات الأمة من خلال منظورها الأيديولوجي السني، ابتداء من مشكلة القطرية وتحديد الموقف منها وكيفية التعامل معها، ومشكلة الاستبداد السياسي الذي جعل ثلاثمائة وخمسين مليون عربي مسلوبي الإرادة والتأثير في واقعهم وكيفية مواجهته، ومشكلة الاحتلال الأجنبي وسيطرته على المنطقة، ومشكلة انتهاك حقوق الإنسان، ومشكلة الفقر، وتخلف التنمية، إلى آخر المشكلات التي تعصف في العالم العربي خاصة، والإسلامي عامة!
إن ضرورة استدعاء الخطاب السياسي السني الراشدي اليوم ـ فضلا عن كونه ضرورة شرعية وسياسية ـ وأهمية بلورة مشروع سياسي يقوم على أصوله وقواعده تكمن في عناصر القوة التي يضمنها مثل هذا الاستدعاء لهذا الخطاب والتي تتجلى فيما يلي:
أولا : ربط المشروع السياسي الإسلامي بالأيديولوجيا العقائدية التي هي الأساس لنجاح أي مشروع سياسي لكي تتجاوب معه الحماهير المؤمنة به، فإذا كان النظام السياسي الاشتراكي يعبر عن الفلسفة الشيوعية كأيديولوجيا وعقيدة سياسية، والنظام الديمقراطي يعبر عن الفلسفة الليبرالية التي عبرت عن المسيحية البرتستانتية كدين وعقيدة سياسية، والنظام السياسي الإيراني اليوم يقوم على أساس ولاية الفقيه الذي يستند على عقيدة انتظار المهدي والعقيدة الشيعية الإمامية، والصهيونية تستند على وعود التوراة المزعومة، فإن المشروع السياسي الإسلامي يحتاج إلى أيديولوجيا عقائدية يعبر عنها، ويقوم عليها، ويستند إليها في إثبات مشروعيته وضرورته وقدرته على تحقيق الهوية والمحافظة على خصوصيتها.
ثانيا: وضوح أصول الخلافة الإسلامية كنظام سياسي وقوة أساسها الديني الذي تقوم عليها، إذ تواترت نصوصها تواترا قطعيا، كما أجمعت الأمة على أصولها العامة، ونقل ذلك علماء السنة في كتبهم العقائدية والفقهية كما قال النووي (وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة).
وقال أيضا (واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا).
ونقل الإجماع عليه القرطبي وقال (هذه الآية ـ {إني جاعل في الأرض خليفة} ـ أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة .. فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين).
كما أجمعوا على أنها تنعقد بالشورى والاختيار …الخ.
فإذا كانت ولاية الفقيه تجد اعتراضا شديدا من عامة المراجع الشيعية لكونها تعارض أصل الانتظار للمهدي الغائب، فإن أصول الخلافة العامة محل أجماع سلف الأمة، وأئمة علماء السنة، بل لا وجود ولا قيام لمذهب أهل السنة والجماعة إلا بالخلافة (الدولة الواحدة)، والجماعة (الأمة الواحدة)، بل إن شعار (السنة) قائم أصلا على عقيدة إثبات خلافة الخلفاء الراشدين، وأنها بالشورى والاختيار لا بالنص أو الاضطرار أو الإجبار!
ثالثا: أن الخلافة ليست نظرية سياسية أو عقيدة دينية فقط، بل هي الواقع السياسي التاريخي للأمة مدة 1300 سنة ففي ظلها قامت الدولة الإسلامية، وبفتوحاتها التاريخية امتدت جغرافيا وديمغرافيا، وفي أحضانها قامت الحضارة والرقي والتطور الذي عاشه العالم الإسلامي على تنوعه القومي والديني والثقافي، ولم يمض على سقوطها وغيابها أكثر من مائة عام، بل مازال بين أظهرنا اليوم من أدركها وعاش تحت ظلها كنظام سياسي إسلامي قائم على وحدة الأمة، ووحدة الدار، ووحدة السلطة، ومعبر عن دينها وهويتها وخصوصيتها، وهو ما يجعل استدعاءها اليوم أسهل وأيسر، لا من حيث التنظير فقط بل التطبيق أيضا.
رابعا: أن الخلافة كنظام سياسي ومؤسسة حكم نجحت في عصور كثيرة من تطوير مؤسساتها وآلياتها مع تطور الحياة السياسية، فكانت أقدر على الاستجابة للظروف المحيطة بها من كل الأنظمة التي عرفها العالم، ولهذا عرفت الخلافة صلاحيات الخليفة والوزير، والخليفة والسلطان في العصر العباسي – بعد أن قويت شوكة الأمراء وضعفت شوكة الخلفاء – وهو نظام أشبه برئاسة الوزراء – كما عرفت صلاحيات الخليفة والصدر الأعظم، والدستور والبرلمان، في العصر العثماني، وهو ما يؤكد حيويتها وقدرتها على مسايرة تطور العصور كمؤسسة حكم وكنظام سياسي ما جعلها تواجه كل التحديات مدة 1300 عام، وهي أطول الأنظمة السياسية التي عرفها العالم عمرا، ومن ثم فالواجب أن تكون الخلافة كمشروع نظام سياسي مواكبا لتطور العصر وضروراته، فكل وحدة أو اتحاد ترتضيه شعوب الأمة ودولها كلها، أو أكثرها، أو مجموعة من الدول الرئيسة فيها ذات السيادة والاستقلال عن أي نفوذ أجنبي، وتجتمع في أي إطار وحدوي أو اتحادي، وتكون حكوماته منتخبة من شعوبها، ويختار مجلسا رئاسيا يمثل الأمة التي اختارته كمجلس خلافة للأمة، ومجلس شورى منتخب يمثل شعوبه وأهل الحل والعقد منهم، فهو خلافة شرعية.
خامسا: أن البديل عنها الذي أقامه الاستعمار الغربي قد أثبت فشله وضعفه، فلا هو حقق أمنها واستقرارها، ولا حقق تطورها ونموها وازدهارها، ولا حافظ على هويتها وخصوصيتها، ولا أقام دينها وشريعتها.
سادسا: أن عودة الخلافة من جديد هي بشارة نبوية تواترت تواترا معنويا في أحاديث كثيرة كما في حديث (ثم تعود خلافة على نهج النبوة) ولم تعرف الأمة في تاريخه كله غيبة الخلافة إلا في هذا العصر مما يبشر بعودتها، ومعلوم ما للبشارة العقائدية من قدرة على استثارة المشاعر الجماهيرية نحو تحقيق أهدافها.
سابعا: أن اتجاه دول العالم نحو الوحدة والاتحاد الإقليمي والقاري، كما في الاتحاد الأوربي، يفرض على العالم الإسلامي الاتجاه نحو الوحدة والاتحاد الطوعي الاختياري برضا الشعوب وحكوماتها، في عالم ليس للضعفاء فيه مكان، كما يؤكد هذا الاتجاه العالمي إمكانية الوحدة والاتحاد بين دول العالم الإسلامي، إذ ليس في الاتحادات الأخرى من الشروط الموضوعية المتوفرة لتحققها، كالدين الجامع، واللغة الجامعة، والتاريخ المشترك، والمصلحة المشتركة، كما في العالم العربي والإسلامي، حيث اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة الإسلام في كل مكان، وحيث القبلة الواحدة نحو البيت الحرام، وحيث الحج إلى مكان واحد، وحيث الثقافة الروحية الواحدة!
إن كل هذه العناصر تجعل من العمل على بلورة هذا المشروع السياسي خيارا استراتيجيا إلا أن نجاحه وتحققه على أرض الواقع مرهون بتحقق أهدافه المرحلية المفصلية التي تتمثل في:
1 ـ تعزيز الحريات العامة في كل بلد لتحرير إرادة شعوب الأمة من الاستبداد الذي صادر حريتها وإرادتها حتى لم يعد لشعوبها أي أثر في مجريات الأحداث التي تعصف بها، فمتى تحررت إرادتها، واختارت حكوماتها التي تعبر عن توجهاتها وتطلعاتها، فلن تختار الأمة إلا الإسلام.
2 ـ تعزيز الوحدة بين شعوبها لتحقيق التكامل السياسي والاقتصادي والعسكري بين دولها.
3 ـ التحرر والاستقلال عن كل أشكال الاحتلال والنفوذ الأجنبي الذي يحول دون حريتها ووحدتها وعودة شريعتها وخلافتها.
ولن يتحقق ذلك كله ما لم يقم التنظيم السياسي الدولي الذي يعمل على بناء نفسه، وبناء مشروعه، فكريا وتنظيميا، وتعزيز قدراته، ليكون قادرا على التأثير في مجريات الواقع السياسي في كل بلد يقوم فيه، ويستخدم كل الوسائل السلمية والمشروعة المتاحة لتحقيق ذلك، وهو ما يحتاج إلى تظافر جهود كبيرة من قبل قوى سياسية واقتصادية واجتماعية مؤثرة مع العزيمة والصبر والتضحية!
ويجب أن يكون شعاره (نحو أمة واحدة وخلافة راشدة) وأن يكون تحت اسم (مؤتمر الأمة) ليستعيد مفهوم الأمة الواحدة من جديد!
إن قيام (مؤتمر الأمة) سيمثل تطورا سياسيا كبيرا على مستوى العمل الإسلامي لسببين :
الأول : كونه أول اتحاد لتنظيمات سياسية إسلامية قطرية تتفق على مشروع سياسي جامع على مستوى الأمة.
الثاني: أنه المرة الأولى التي يطرح فيها المشروع السني الذي ظل يحكم العالم الإسلامي مدة ثلاثة عشر قرنا كمشروع سياسي منذ سقوطه، بحيث تحدد له العقيدة السياسية، والأهداف المرحلية والنهائية، وتنطلق فيه تنظيمات سياسية في كل قطر، ليتحقق على أرض الواقع من خلال جهاد ونضال سياسي يتخذ من كل الوسائل المتاحة المشروعة سبيلا للوصول إلى الغاية المنشودة.
ولا يخفى أن مثل هذا الهدف التاريخي العظيم يحتاج من القائمين عليه وضع خطة إستراتيجية وسياسية، يمكن على ضوئها مراجعة الأداء وتقويمه بشكل دوري، من خلال تحديد العناصر الرئيسة الأربعة :
1 ـ النظام الأساسي للتنظيم السياسي .
2 ـ الأهداف المرحلية والنهائية للتنظيم.
3 ـ أولويات العمل .
4ـ آليات التنفيذ وخططه.
وإذا كانت النظم السياسية تعبر عن أيديولوجيا عقائدية، ومبادئ وقضايا رئيسية، يؤمن بها الزعماء المناضلون، ومن أجلها يضحون، وتقوم زعامتهم على أساس:
· الإيمان المطلق بالقضية التي يدعون إليها.
· والقدرة منهم على الإلهام لتحريك الجماهير.
· والإرادة الصادقة والعزيمة القوية التي تلهب حماسة الشعوب وتفيض عليها من سحرها وإلهامها العاطفي.
فإن ذلك كله في حاجة إلى القادة والمخططين الإستراتيجيين الذين يحددون الأهداف السياسية، ويضعون لها الخطط المبتكرة، ويتخذون من الإبداع العقلي وسيلة للوصول إلى تحقيق المبادئ التي يناضل من أجلها الزعماء الملهمون.
ولن ينجح المخططون الإستراتيجيون أيضا ما لم يقم على تنفيذ تلك الخطط الإستراتيجية منفذون حركيون واعون يستوعبون تلك الخطط ويدركونها إدراكا كاملا، ويتفاعلون معها من خلال الآليات والوسائل التي يتبعونها، لتنفيذ تلك الخطط.
أي أن (مؤتمر الأمة) لن ينجح في تحقيق مهمته التاريخية ما لم يتوفر له :
1 ـ الزعماء التاريخيون الملهمون المناضلون الذين ينفخون في الأمة من روحهم ليبعثوها من جديد، لتؤمن الأمة معهم بقضية (الخلافة الراشدة والأمة الواحدة) كإيمانهم هم بها، ولا شك بأن القيادة الجماعية لهذا المؤتمر ستتحمل هذا العبء التاريخي بشكل فردي وجماعي، ولن تتحقق الزعامة والرمزية التاريخية إلا بعد حركة نضال طويل تتعرف الأمة من خلاله على قياداتها وزعامتها التاريخية.
2 ـ القادة والمخططون الإستراتيجيون المبدعون الذين سيحددون الأهداف السياسية (تحرير إرادة شعوب الأمة، وتحرير سيادة أوطانها، وتعزيز الوحدة بينها) وكيفية الوصول من خلال الخطط الإستراتيجية والبرامج السياسية للتخلص من الاستبداد السياسي في كل قطر، والوصول لحكومات منتخبة تعبر عن إرادة الأمة، والتخلص من الاحتلال الأجنبي، وتحرير المنطقة من نفوذه ووجوده للوصول إلى الاستقلال والسيادة، وتعزيز التكامل بين شعوبها ودولها، لتحقيق الوحدة بينها، وترتيب الأولويات، وتحديد مدى فرص النجاح في كل قطر، ومعرفة العوائق والآفاق من خلال دراسة عميقة لأوضاع كل بلد سياسية واجتماعية واقتصادية.
وسيحتاج (مؤتمر الأمة) إلى الطاقات المتخصصة في هذا المجال، وإلى كل من يستطيع المشاركة في التخطيط الإستراتيجي لمشروع مؤتمر الأمة، كما يمكن للمؤتمر الاستفادة من الطاقات والعقليات من داخل العالم العربي وخارجه ممن يؤمنون بهذا المشروع للمشاركة والمساهمة في وضع الخطط والبرامج.
3 ـ الحركيون المنفذون الواعون للبرامج والخطط الذين سيتولون مهمة تنفيذ ما يضعه المخططون لهم، وسيتفاعلون معها، وسيخترعون من الوسائل والأساليب والآليات ما يحققون به تلك البرامج، فهم القادة الميدانيون والإداريون للتنظيمات في كل قطر، فيجب تطوير مهاراتهم ليكونوا على مستوى المسئولية المطلوبة منهم.
مواصفات القيادة وشروط نجاحها:
وبناء على كل ما سبق فإن القيادة التاريخية الجماعية المؤسسة لتنظيم (مؤتمر الأمة) أحوج ما تكون ـ مع إيمانها المطلق بمشروعية قضيتها عقائديا وسياسيا ـ إلى الوحدة ورص الصف، إذ نجاح العمل مرهون بوحدة صفها وذلك منوط بتحقق:
1ـ الأخوة والمحبة الإيمانية العقائدية وهو أول أسباب النصر كما قال تعالى {هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بينهم لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم}، وكما قال تعالى {واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا}.
ولا شك بأن الأخوة والمحبة تقوى بأسبابها التي حث عليها الشارع كتعزيز أواصر التعارف (ما تعارف منها ائتلف)، وإفشاء التحية (لن تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم)، وتبادل الهدية (تهادوا تحابوا)، والابتسامة والكلمة الطيبة (تبسمك في وجه أخيك صدقة والكلمة الطيبة صدقة)، والاحترام بين القيادات (ليس منا من لم يوقر كبيرنا)، وتجنب كل ما من شأنه إضعاف عرى الأخوة والمحبة كالغيبة والنميمة والقيل والقال واللمز والنبز الخ، مما تعنى به كتب السلوك والتصوف السني، فإذا ما تحول ذلك من سلوك وممارسة إلى سجية وطبع، صارت ثقافة عامة تطبع سلوك جميع الأفراد في كل التنظيمات بطابعها وهي تحتاج إلى تزكية للنفس وتهذيب للسلوك واستحضار دائم للمسئولية.
2 ـ الثقة المطلقة بين القيادات حتى لا يخالطها شك، ولا يخالجها ريب فيما بينها، وحتى لا يسمع أحد بأحد قالة سوء، ولا يصدق فيه قول قائل أو قدح قادح، فإنه كلما كانت المسئولية أكبر، كانت التحديات أعظم، والمؤامرات أخطر، والمخرج منها هو غرس الثقة فيما بين القيادات حتى يكون من غاب منهم كمن حضر، وحتى لا يتناجى اثنان حتى كأن الثالث يسمع نجواهما ويعلم دعواهما، فهذه الضمانة الثانية لوحدة القيادة.
3ـ الوضوح والمصارحة والشفافية التي تعزز الثقة بين القيادات، حتى لا يكون لأحد منهم خصوصية في العمل دون أحد، ولا يكون لأحد علاقة مع أي جهة قد تؤثر على المشروع تخفى على المؤتمر، فيكون (مؤتمر الأمة) بتنظيماته كالجسد الواحد، وقياداته هي كالقلب والمرجع للجميع فيما يأتون وفيما يذرون من أعمال تخص المشروع.
4 ـ الصبر وسعة الصدر على العمل الجماعي وأعبائه، وعلى تبعاته ولأوائه، وعلى الشورى الجماعية ونتائجها وقراراتها، فإن النصر مع الصبر، وإن الظفر صبر ساعة، وفي صبر القيادات على بعضها، وتحملها هفوات بعضها، واللين والرفق في معالجة ما قد يقع من قصور وخلل ضمانة لنجاح العمل وكما في الأثر (يد الله على الجماعة) .
5 ـ التضحية بلا حدود في الوقت والجهد والنفس والمال، وهي ضريبة القيادة الفردية والجماعية، فلا قيادة بلا سيادة، ولا سيادة بلا ريادة، يبادر فيها القائد والزعيم إلى كل ما يقتضيه نجاح العمل حتى يكون قدوة وأسوة وكما قال أبو الطيب
(لولا المشقة ساد الناس كلهم.. الجود يفقر والإقدام قتال) .
مواصفات المخططين الإستراتيجيين وشروط نجاحهم :
وكما يجب توافر شروط النجاح للزعماء لقيادة العمل، فكذلك يجب توافر شروطه لقادة التخطيط الإستراتيجي وأهمها ـ بعد وضوح الأهداف النهائية والمرحلية للمشروع السياسي لهم ـ القدرة على التخطيط السليم، والإبداع في التخطيط، والخبرة التراكمية ما يجعل فرص نجاح خططهم وبرامج عملهم أكبر، ومخاطرها أقل، ووقتها أقصر، وهم العقول التي تشرف على وضع البرامج، وتحديد الأولويات والإمكانات، وفرص النجاح، وتحديد الوسائل وتقديرها، ورصد النتائج وتقييمها، وإعادة النظر فيها، وتغيير البرامج بتغير المعطيات والمستجدات .
وأهم أعمالهم :
1ـ تحديد الأهداف السياسية المرحلية والأهداف النهائية.
2ـ ووضع برنامج عمل لكل مرحلة مع تحديد المدة الزمنية المطلوب تنفيذ الأعمال خلالها.
3ـ تقييم العمل وتقويمه وإعادة أو تعديل الخطط والبرامج بتغير المستجدات.
مواصفات القادة الميدانيين والمنفذين وشروط نجاحهم :
وهم الحركيون، وعليهم يقوم العمل، وبهم تصبح الخطط والبرامج واقعا سياسيا يمارس على الأرض، وتحصد نتائجه، وتتحقق أهدافه، وأهم مواصفاتهم :
1 ـ القدرة على فهم الخطط واستيعابها والتفاعل معها والحركة الدءوب من أجل تنفيذها.
2ـ القدرة على استيعاب الطاقات، واحتواء الكوادر، وحشد الجماهير وتنظيمها.
3ـ التفاني والإخلاص للقيادة وللمشروع وللقضية.
4ـ القدرة على تطوير الوسائل وابتكارها والتعامل مع البرامج بحسب مستجدات الواقع.
أسس عمل (مؤتمر الأمة) وقواعده :
وإذا كان كل ما سبق في مرتكزات التخطيط الإستراتيجي من المشتركات بين كل التنظيمات على اختلاف توجهاتها سياسية كانت أو اقتصادية، فإن خصوصية كل عمل تفرض تحديد أسسه وقواعده وهي بالنسبة لـ (لمؤتمر الأمة) تتمثل في :
1 ـ تحديد الهوية الفكرية والسياسية لمؤتمر الأمة:
وهي الهوية الجامعة للتنظيمات الأعضاء في المؤتمر، والعقيدة التي يؤمن بها الجميع، والتي بها يُعرف المشروع، ويمتاز بها عما سواه، وتمثل خصوصيته في الساحة التي يعمل بها، ويمكن تحديدها بالتالي:
تعريف مؤتمر الأمة :
هو اتحاد تنظيمات سياسي إسلامي يؤمن بمشروع (الأمة الواحدة والخلافة الراشدة) على أصولها المجمع عليها كما جاءت في الكتاب والسنة النبوية وسنن الخلفاء الراشدين .
فمؤتمر الأمة هو أول تنظيم إسلامي يطرح الخطاب السني الراشدي كمشروع عقائدي وسياسي يناضل من أجل تحقيقه على أرض الواقع في كل قطر عربي وإسلامي.
وهو امتداد تاريخي لمشروع الشيخ محمد رشيد رضا، والشيخ حسن البنا، والشيخ تقي الدين النبهاني، والشيخ عبد السلام ياسين، وغيرهم من المصلحين الذين عاصروا سقوط الخلافة، ودعوا إلى استئناف الحياة الإسلامية، واستعادة الخلافة من جديد، ومن هنا تمثل الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي السني على اختلاف ألوان طيفها عمقا استراتيجيا لمؤتمر الأمة، ومن ورائهم الأمة كلها.
2 ـ المشروعية والمرجعية :
يستمد عمل (مؤتمر الأمة) السياسي مشروعيته من نصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة ومن ذلك :
قوله تعالى {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويؤمرون بالمعروف} وقوله {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف}.
وقوله صلى الله عليه وسلم (بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس).
وقوله (الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم).
وقوله (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور).
وقوله (ثم تعود خلافة على منهاج النبوة).
وقوله (الزم جماعة المسلمين وإمامهم ).
وقوله (إن كان لله في الأرض خليفة فالزمه).
وهو ما يوجب على الأمة في ظل غياب الجماعة الواحدة والإمامة الواحدة العمل على عودتهما، إذ بهما يظهر الإسلام في الأرض، وبزوالهما يزول الإسلام من الأرض، والواقع شاهد صادق.
وقد أجمع سلف الأمة والأئمة من أهل السنة على وجوب وضرورة إقامة الخلافة ووجوب وحدة الأمة كما نص على ذلك الفقهاء وأئمة المتكلمين في مؤلفاتهم كما سبق ذكره.
المشكلة التي يقوم (مؤتمر الأمة) لعلاجها :
وتتمثل في :
1ـ سقوط الخلافة كنظام سياسي جامع لوحدة الأمة .
2ـ تفرق الأمة إلى دويلات تحت الاحتلال الأجنبي .
3ـ إقصاء الشريعة وأحكامها عن واقع حياة الأمة .
4 ـ شيوع حالة الظلم والاستبداد السياسي والتخلف بكل أشكاله.
وقد جاء في الحديث بيان هذه المشكلات كما في قوله صلى الله عليه وسلم عن زوال الخلافة (ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم يكون ملكا عضوضا ثم ملكا جبريا ثم تعود خلافة على منهاج النبوة).
وعن زوال الدولة والأمة الواحدة (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها).
وعن سقوطها تحت نفوذ العدو (تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها)..الخ
3 ـ الهدف والمهمة :
(من الحكومات القطرية الراشدة إلى الأمة الواحدة والخلافة الراشدة)
ولا يخفى أن الحديث عن عودة الخلافة الراشدة سيظل ضربا من الخيال، وطلبا للمحال، ما لم يسبق ذلك معالجة مشكلات قطرية تحول دون وحدة الأمة ودولها، كالاستبداد السياسي، والوجود العسكري الأجنبي، والتشرذم القطري، والتخلف التنموي، فكان لا بد من أن تسعى التنظيمات في أقطارها ودولها إلى:
أولا : الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها بهدف إقامة الحكم الراشد في كل قطر عربي وإسلامي، كهدف سياسي مرحلي.
والحكم الراشد هو كل نظام سياسي :
1 ـ تختاره الأمة في أي قطر عربي أو إسلامي بانتخاب حر يمثل إرادة الأمة تمثيلا حقيقيا.
2ـ ويحقق سيادتها ويحافظ على استقلالها في ذلك القطر.
3ـ ويعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مجالات الحياة.
4ـ ويعمل على تعزيز الوحدة والتكامل مع الأقطار الأخرى .
5 ـ ويحقق التنمية الاقتصادية والنهضة الاجتماعية الشاملة .
ثانيا – العمل على إعادة الخلافة الراشدة والأمة الواحدة كهدف استراتيجي .
والخلافة الراشدة هي النظام السياسي الإسلامي الذي يقوم على :
1 ـ اختيار الأمة كلها أو أكثر أقطارها للسلطة عن طريق الانتخاب لها بالشورى والرضا.
2 ـ سياسة شئون الأمة وفق أصول الكتاب والسنة والخطاب الراشدي.
3 ـ الحكم بالشريعة الإسلامية في كل شئون الحياة.
4ـ حماية الأمة والمحافظة على سيادتها وقوتها ووحدتها.
5 ـ تحقيق التنمية الشاملة في كل المجالات.
ولا شك بأن هذه الأهداف المرحلية والنهائية تحتاج إلى عمل سياسي منظم على مستوى الأمة كلها، وتنظيمات قطرية تسعى لتكون:
1 ـ رديفا قويا في كل قطر قادرا على التأثير في القرار السياسي وإن كان خارج السلطة.
2ـ بديلا جاهزا في حال حدوث فراغ سياسي مفاجئ، أو في حال فتح الأبواب للتداول السلمي للسلطة بصورة حقيقية فعلية، أو في حال الحاجة لإحداث التغيير بالثورة، حين القدرة على ذلك، عند انغلاق سبل الإصلاح السياسي السلمي.
4 ـ الوسائل :
يجب أن يعمل (مؤتمر الأمة) في كل قطر من خلال تنظيماته لتحقيق مشروعه بالجهاد السياسي السلمي بكل الأساليب المشروعة والمتاحة، ابتداء بـ :
· جهاد الكلمة الحرة كما في الحديث (سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر)، وحديث (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر).
· والتصدي للظلم كما في حديث (لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا).
· والعمل على تغييره بكل الوسائل المتاحة (من رأى منكم منكرا فليغيره)، وحديث (يكون أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن).
· والمشاركة السياسية الإيجابية في كل المناشط العامة.
· مع حق المقاومة المسلحة للتنظيمات التي توجد في أقطار تقع تحت ظل الاحتلال الأجنبي.
وكل ذلك بحسب ظروف كل قطر وأوضاعه، مع الالتزام بالأصل وهو العمل السياسي السلمي، الذي ينأى بالأمة عن الاحتراب الداخلي، ويحول دون الاصطلام بالأنظمة، للحفاظ على التماسك المجتمعي، وحماية الإنجازات التي تحققت للأمة في كل قطر، إلا في حالات الضرورة حين تقرر الأمة في قطر من الأقطار تغيير الأوضاع بالثورة الشعبية، مع تحقق القدرة على تحقيق ذلك سياسيا.
إن كل ما سبق ذكره من أهداف استراتيجية بعيدة المدى، قد تحتاج إلى عقود من السنين، وأهداف مرحلية متوسطة المدى قد تحتاج إلى بضع سنين، يجعل من تطوير التنظيمات السياسية وتطوير أدائها هدفا قريبا أوليا، وأمرا ضروريا، للوصول إلى باقي الأهداف، ولن تستطيع التنظيمات القطرية تحقيق ذلك ما لم:
1ـ تستقطب الشباب والطاقات الحركية والفكرية إلى صفوفها وتبني نفسها بناء تنظيميا محكما.
2 ـ وتقف الأمة معها في مشروعها المرحلي (الحكم الراشد) والنهائي (الخلافة الراشدة).
3 ـ وتحسن أداءها السياسي مع الداخل والخارج الدولي بما يطمئن الجميع على مصالحه المشروعة.
4 ـ وتتعاون مع كل القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية على اختلاف توجهاتها بما يحقق الأهداف المشتركة.
5 ـ وتضع الخطط والبرامج والدراسات التي من خلالها تتعرف على :
أ – واقع المجتمع واحتياجاته الأساسية وثقافته وكيفية تعاطي التنظيم معها وفق مبادئه وأهدافه.
ب – القوانين والأنظمة الموجودة وكيفية الاستفادة منها بما يحقق أهداف التنظيم.
ج – القوى الأساسية في المجتمع وكيفية التعامل والتفاهم معها .
د – التقنيات والوسائل المتاحة وفرص الاستفادة منها لتحقيق الأهداف.
هـ – قدرات التنظيم الذاتية وإمكاناته المادية والفرص أمامه وكيفية اقتناصها، والمعوقات والمخاطر وكيفية التعامل معها، ومكامن القوة لديه وكيفية استثمارها، ونقاط الضعف عنده وكيفية معالجتها.
5- أولويات العمل :
إن تحديد أولويات العمل على مستوى القطر أو الأمة هو ثمرة تلك الدراسات العميقة لواقع التنظيمات في كل قطر، ولعل أهم الأولويات على مستوى (مؤتمر الأمة) :
1 ـ بناء المؤتمر نفسه بناء تنظيميا محكما واستكمال وجوده في كل قطر عربي بحسب الهامش الذي تسمح به القوانين في كل قطر أو يسمح به الواقع السياسي.
2 ـ بلورة مشروعه الفكري والسياسي وتحديد رؤيته في أدبياته المنشورة.
3 ـ تعزيز موارده المالية وقدراته الإدارية والفنية.
4 ـ تحديد دوائر التواصل والتنسيق مع كافة القوى والمؤسسات في العالم العربي والإسلامي وكيفية التعامل معها.
كما يجب أن يكون نظام مؤتمر الأمة الأساسي واضحا في مبادئه وأهدافه، بعيدا عن التعقيد في ألفاظه، عمليا في لوائحه الداخلية، على النحو التالي:
(النظام الأساسي المقترح لمؤتمر الأمة)
مبادئ مؤتمر الأمة وأصوله:
1ـ الإسلام دين الدولة الأمة مصدر السلطة والشريعة مصدر التشريع.
2ـ الخلافة الراشدة نظام الحكم بالشورى والرضا والاختيار.
3ـ وحدة الأمة واستقلالها وسيادتها حق لها وواجب عليها.
4ـ الحقوق والحريات العامة والخاصة مصونة.
5ـ العدل والمساواة والحياة الكريمة حق للجميع.
أهداف مؤتمر الأمة: يسعى المؤتمر إلى تحقيق الأهداف المرحلية والنهائية التالية:
1 ـ تحرير الأمة وشعوبها من الاستعمار والاستبداد بكل صوره وأسلمة كافة القوانين والتشريعات.
2ـ تحقيق الوحدة بين دولها وتعزيز التكامل السياسي والاقتصادي والتشريعي والعسكري بينها.
3ـ اختيار الأمة لحكوماتها بالتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
4 ـ حماية أموال الأمة وثرواتها وتوزيعها بالعدل.
5 ـ تحقيق النهضة والتنمية والتطوير في جميع المجالات.
الوسائل : يعمل المؤتمر لتحقيق أهدافه بكل الوسائل السلمية والمشروعة ومن ذلك:
1ـ الدعوة العامة والخاصة للمشروع بكل وسائل النشر .
2ـ المشاركة السياسية للوصول للسلطة التشريعية والتنفيذية.
3ـ التعاون مع الجميع بما يحقق هذه الأهداف أفرادا كانوا أو جماعات.
4ـ تأسيس الأحزاب السياسية والاتحادات الطلابية والنقابات العمالية والجمعيات المهنية والمراكز الثقافية والقنوات الفضائية والصحف.
النظام الداخلي لمؤتمر الأمة :
1ـ يتكون المؤتمر من التنظيمات القطرية التي شاركت في تأسيسه أو وافقت على الانضمام إليه، وتكون اجتماعاته دورية، ويرأسه أكبر الأعضاء سنا، وتتخذ قراراته بالأغلبية، مع حق التحفظ لكل تنظيم على أي قرار، فيصبح القرار ملزما فقط لمن وافق عليه.
2ـ يختار المؤتمر المنسق العام الذي يقوم بترتيب اجتماعاته وجدول أعماله ودعوة أعضائه وتسجيل قراراته وتوصياته.
3ـ لكل تنظيم قطري اختيار ثلاثة أعضاء ممثلين له في المؤتمر بصوت واحد، ويمكن زيادة أعضاء بعض الأقطار عند الحاجة بصوت واحد .
4ـ. يحدد المؤتمر العام موارده المالية ويضع ميزانيته السنوية وبرامج عمله .
5ـ يتم الإعلان عن المؤتمر العام واختيار مكتب الأمانة العامة بعد موافقة الثلثين مع حق كل قطر بالتحفظ عن الإعلان عن نفسه.
فهذا نظام أساسي مقترح للمؤتمر، وحين يتحقق كل ما سبق ذكره من أهداف قريبة على مستوى بناء التنظيمات القطرية والتنظيم الدولي، والأهداف المتوسطة على مستوى تحقيق الإصلاح السياسي في كل قطر عربي وإسلامي للوصول إلى حكومات راشدة، فلن يطول الوقت حتى تقوم تلك الحكومات الراشدة كلها أو أكثرها، بتعزيز الوحدة والتكامل بين دولها وأقطارها، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، لتمهد الطريق لتحقق الهدف النهائي وهو قيام (خلافة راشدة وأمة واحدة)، تحقق لشعوبها الأمن والاستقرار، والتنمية والازدهار، وتحقق للعالم السلم والعدل والتعاون الإيجابي الذي تنشده الإنسانية كلها.
هذا ونسأل الله التوفيق والسداد والنصر والثبات للمؤمنين المصلحين والمجاهدين الصابرين حتى تعود أمة واحدة وخلافة راشدة وما ذلك على الله بعزيز، ولا عن الأمة العظيمة ببعيد!
انتهت هذه الدراسة حول أهل السنة والجماعة
فجر الأحد 26 شعبان سنة 1431هـ
الموافق 8/8/2010م
[1] طبقات الحنابلة ، لأبي يعلى، (1/ 29).
[2] المصدر السابق (1/33).
[3] الفرق بين الفرق ، عبد القاهر البغدادي (ص285).
[4] ولادة الشرق 632-633 .
[5] ولادة الشرق 643 .
من موقع الدكتور حاكم المطيري
أهل السنة و الجماعة اشكالية الشعار و جدلية المضمون
أهل السنة و الجماعة اشكالية الشعار و جدلية المضمون
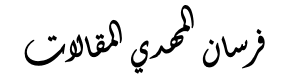
شكرا يااستاذي الفاضل
وفيت وكفيت استاذي الكريم