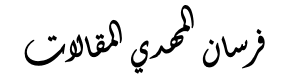طاغوت الأصولية العلمانية
إن القضية الفلسفية النظرية التي يمكن أن نحدد بالانطلاق منها الخلل الذي يطرأ على سلطتي الرمز من صورة العمران (التربية) ومن مادته (الثقافة) هي مسألة حدود المعرفة الإنسانية وطبيعتها الاجتهادية التي يؤدي إغفالها إلى تكون الطاغوت الرمزي في مجالي التربية والثقافة أعني في المقوم الرمزي لكل عمران إنساني سوي. وهذه القضية هي قضية الاجتهاد بمعناه القرآني من حيث هو بديل من المعرفة الميتافيزيقية المطلقة التي تفسد وظيفة النخب الرمزية سواء كانت علمانية أو أصولية[1]. وسنعود إلى المسألة الملازمة لكل المحاولة من بدايتها إلى نهايتها. إنها مسألة قانون التأويل الذي وضعه الغزالي وأطلقه الرازي وتمكن من تجاوزه الفيلسوفان المؤسسان لإصلاح فكر المسلمين النظري (ابن تيمية) لجعل العمل يعود فيصبح ممكنا[2] عند المسلمين أعني الجهاد الحقيقي ولإصلاح فكرهم العملي (ابن خلدون) لجعل النظر يعود فيصبح ممكنا[3] عند المسلمين أعني الاجتهاد الحقيقي: وإذن فالمشكل هو الاجتهاد والجهاد كيف يفسدهما طغيان النخب؟
ننطلق من أحد الرموز الناطقين باسم مدرسة التأويل العقلاني للمرجعيات الإسلامية وليكن ناصر حامد أبا زيد لبيان سوء الفهم المسيطر على المفكرين الذين يفسدون النهضة ببعديها التحديثي والتأصيلي (ردا من الثاني على الأول) فضلا عن إسقاط بعض الخصائص في المواقف الحديثة على المدارس القديمة. فكلا الحزبين يقول بهذه النظرية إما إيجابا (العلمانيون) أو سلبا (الدينيون).
يقول أبو زيد في كتابه فلسفة التأويل: “والمنظور الذي نفترضه هنا هو النظر إلى الفلسفة الإسلامية في جوانبها المتعددة من خلال جدلية بين عناصر ثلاثة هي العناصر المكونة لمضمون هذه الفلسفة. ومضمونها: العنصر الأول هو الواقع التاريخي والاجتماعي الذي نشأت فيه هذه الفلسفة وتطورت. والعنصر الثاني هو دور النص الديني بالمعنى الواسع الذي يشمل القرآن والأحاديث النبوية ونعني بالنص هنا التراث التفسيري في حركته المتطورة لا مجرد ما هو مكتوب بين دفتي المصحف وفي مجموعات الحديث. وأما العنصر الثالث فهو التراث الفلسفي السابق الذي انتقل إلى المسلمين بكل ما تعنيه كلمة تراث من شمول وتنوع ودون توقف عند حدود الفلسفة اليونانية في عصورها المختلفة. والأساسي في هذه العناصر هو العنصر الأول (=الواقع التاريخي والاجتماعي) وإن قامت العلاقة بين هذه العناصر الثلاثة على التفاعل المستمر[4]. ومما يؤكد هذه القضية أن القرآن قد نزل مستجيبا لحجات الواقع وحركته المنظورة خلال فترة زادت على العشرين عاما”[5].
لن نركز على عدم الوعي باستحالة المهمة[6] التي يريد القيام بها ولا بالعلامتين الدالتين على أن ما يسمى بالتأويل العقلاني هو في الحقيقة الفهم الماركسي اللاعقلاني للعلم عامة ولعلم التاريخ الإنساني خاصة أعني تقديم ما يسميه الواقع مبدأ وجوديا[7] والتثليث الجدلي مبدأ منهجيا[8]. ولن نهتم كذلك بالحجة المستمدة من صلة القرآن بحاجات الواقع طيلة ما يقرب من عقدين وما يترتب على ذلك من تاريخانية[9] ولا بالمكونات التي تحدد هذا المنظور التثليثي[10]. فهذه جميعا أمور ندرجها في تعليقات الهوامش لأنها قد تحول دون القارئ والنفاذ إلى الخلل الرئيسي الذي تصدر عنه في هذا الفكر العجول. ما يعنينا بالأساس هو نظرية التأويل التي يعتمدها المؤلف من حيث صلتها بالقانون التقليدي الذي انتهي الفكر المعتزلي والفكر الأشعري إلى شيء من الإجماع عليه: إذا تعارض العقل والنقل أجمعت المدرستان بضرورة تقديم العقل وتأويل النقل.
عندما قال علماء الكلام تقليدا للفلاسفة إن التعارض بين النقل والعقل إذا حصل فينبغي تأويل النقل بمقتضى ما توصل إليه العقل -دون أن يدركوا جيد الإدراك أن الموقف الفلسفي كان نتيجة حتمية لاعتبارهم الخطاب الديني مثالات عامية مما يتصورونه حقائق فلسفية مطلقة أي إن الدين عندهم مجرد إيديولوجيا شعبية بلغتنا الحديثة-كانوا يفترضون أمورا مقبولة في عصرهم. لكن ما افترضوه لم يعد مقبولا في عصرنا اللهم إلا إذا كان المزعوم من عقلانيي العرب يعيشون قبل المرحلة النقدية وما بعدها من الفكر الفلسفي الحديث حتى لا أتكلم على ثورة ابن تيمية وابن خلدون لأن ذلك قد لا يصدقه أحد من الحداثيين الذين معرفتهم بتاريخ فكرنا وبتاريخ الفكر الغربي لا تتجاوز المقدار الذي يقنع به أصحاب التقريب الجمهوري. فقد كان الفلاسفة يعتقدون أمرين لم يعد أحد يصدق بهما إلا إذا كان جاهلا بالفكرين الفلسفي والديني الحديثين:
الأول هو أن للعقل القدرة على إدراك حقائق الأشياء بإطلاق ومن ثم فالعلم الذي في الذهن ليس فيه من مخالفة لموضوعه في العين إلا بسبب الخطأ الإنساني الذي يمكن تجاوزه ومن ثم معرفة حقائق الأشياء كما هي في ذاتها فلا يبقى لمفهوم الغيب معنى ويصبح أصحاب هذا الرأي قادرين على الكلام في كل شيء كلاما وثوقيا هو عين الفكر الديني المتخلف الذي نهى عنه القرآن وهم يتصورون أنفسهم ثائرين عليه.
والثاني هو أن السبيل إلى ذلك هي الانطلاق من حقائق أولية هي جوهر العقل أو مبادئه التي تطابق قوانين الوجود في ذاته إن الغيرية الوجودية لم تكن واردة عندهم ومن ثم فالحقائق الأولية -ومنها مبادئ العقل-ليست مجرد مواضعات إنسانية لبناء الأنساق المعرفية التي هي مجرد أدوات للتعامل مع اللامتناهي المجهول بالطبع في الظاهرات التي تتلقاها حواسنا.
وهذان الأساسان صارا بعد الثورة النقدية وخاصة بعد الثورة على محاولات إصلاح الفلسفة النقدية لترميم حلولها أصبحا معتبرين عند كل الفلاسفة والعلماء مجرد حكمين مسبقين لم يعد أحد يقبل بهما حقائق مطلقة حتى وإن كان لا احد يشك في أنهما صالحان للعمل الفكري بعد التسليم بأنهما مواضعات تصورية لبناء الأنساق المعرفية والتعامل مع “خليط الظاهرات المتدفقة على الفكر” والمجهولة بالطبع. وقد كان المعتزلي والأشعري على حد سواء يقولان بهذا القانون لهاتين العلتين[11] اللتين لو صحتا لكان بقاؤهما على الإيمان عديم المعنى: لو قبلنا بهذين لأستغنينا عن الدين السوي الذي جاء لتحريرنا مما يستندان إليه من وهم أعني العقيدة الفاسدة التي تؤله الإنسان فتطلق علمه وعمله أو بعبارة ابن خلدون تحصر الوجود في الإدراك.
وقد اكتشف الفكر الغربي الحديث بعد النقد وهاء الحجتين بفضل الثورة النقدية وما بعدها. وهذا الاكتشاف متأخر بالقياس إلى ما حصل في الفكر النقدي الإسلامي منذ القرن الثامن|الرابع عشر. فقد كان الفكر العربي الإسلامي أدرك وهاء ذلك كله منذ القرن الرابع عشر في بدايته من منطلق نقد الفلسفة النظرية (ابن تيمية) وفي غايته من منطلق نقد الفلسفة العلمية (ابن خلدون) ولم ينتظر لا النقد الكنطي ولا ما بعده. وكلاهما كان يحلل فلسفة القرآن في نقد التحريف الوجودي وثمرتيه المعرفية والقيمية حتى وإن ظلت محاولتهما في شكلها الجنيني لعدم تطويرها واستثمارها. فعند ابن خلدون كل أوهام الميتافيزيقا العملية والنظرية علتها حصر الوجود في الإدراك أو اعتبار الإنسان مقياس كل شيء. وعند ابن تيمية مفهوم الحقائق الأولية مفهوم وهمي لأن مقدمات العلوم نسبية مرتين: فهي نسبية ذاتيا أو نسبية للذات العارفة وهي نسبية لما يراد البرهان عليه من القضايا في التعليم Théorèmes أو لما يراد علاجه من المشاكل Problèmes أو للإيجاد النظري الذي يبدع موضوعات تصورية فيجمع بين لجنسين السابقين في الأذهان قبل الأعيان ويسمى محصولات Porismes[12].
وتلك هي مطالب العلم القديم في شكله الأسمى معرفيا أعني في العلم الرياضي الذي يتعامل مع موضوعات فرضية تؤدي دور العلوم الأدوات في علم الموجودات الفعلية. والأمر لم يتغير في العلم الحديث من حيث المطالب بل هو أضاف إليها تنسيب هذه التمييزات فردها جميعا إلى النوع الأخير إذ حتى النظريات فإنها ليست إلا تحصيل الكائنات الذهنية التي لها انطباق على النظريات والبناءات التصورية في المشاكل الرياضية مع الانتقال من غفلة ظنها حقائق إلى الوعي بكونها مبدعات إنسانية لعلاج ذريعي لا يتجاوز الفاعلية النظرية والتقنية إما لمسائل نظرية في القول العلمي ذاته من حيث صورته (وكلها راجعة إلى قضايا المنطق الصوري: شروط التناسق العلمي التي هي دائمة التطور والتدرج) أو لمسائل نظرية في علاقة القول العلمي بموضوعاته أي من حيث صلته بمادته (وكلها راجعة إلى قضايا المنطق المتعالي: شروط المطابقة العلمية التي هي دائمة التطور والتدرج).
وطلب هذين النوعين من الشروط هو المحرك الأساسي للمعرفة الإنسانية. وكلاهما يقتضي نوعي المراجعة المدبرة والمقبلة. فبالمراجعة المدبرة يعاد النظر في الأسس لتحقيق التناسق بين النظريات. وبالمراجعة المقبلة يعاد النظر في المناهج لتحقيق أكبر قدر ممكن من المطابقة مع الموضوع. ولعل الجامع بين هذين النوعين من العلاج هو جوهر الفكر الرياضي المجرد والمطبق. وحتى لو سلمنا بأن الوجود الفعلي موضوع الميتافيزيقا أسمى وجوديا من الوجود التصوري موضع الرياضيات فإن علم الميتافيزيقا دون علم الرياضيات صرامة منطقية ودقة علمية ومن ثم فينبغي أن تكون الميتافيزيقا دون الرياضيات ادعاء للوثوقية: لأن ما يتوقف عنده الرياضي في المجال المعرفي حدا لا يمكن أن يتجاوزه الميتافيزيقي إلا إذا اعتبر أمانيه حقائق.
لذلك فابن خلدون وابن تيمية ينفيان كل إمكانية لتجاوز العقل الإنساني المعرفة المؤيدة بالتجربة بما في ذلك في العلم الرياضي بشرط أن نفهم أن القصد بالتجربة ليست التجربة الحاصلة بل التجربة الممكنة[13]: والتجريب هنا ليس بالضرورة تجريب المواد الطبيعية بل هو تجريب على المواد الرياضية المجردة أو ما يمكن أن يسمى بالتجريب العقلي الذي هو غير التجريب المعملي . والمعلوم أنه ليس عند الإنسان تجربة تشمل كل التراث ليعلم كيف يُصنع أو كيف يقع تبادل التأثر والتأثير بينه وبين الواقع وأيهما الظرف وأيهما المظروف على تشعبهما وتشاجنهما وكيف يتعين الفكر في صلته بهما على تشعبه المضاعف بسبب ذاته وبسبب كونه عندهم انعكاسا لما يسمونه الواقع.
لكن حتى لو سلمنا بكل خرافات الحداثيين العرب في تصوراتهم المتخلفة للعلم وللتاريخ من حيث دور العلاقة بين الرمزي وغير الرمزي (ما يسمونه الواقع) فيه فهل يمكن أن يفسر لنا المؤولون “قواعد العبور”[14] من ظاهر موضوع التأويل إلى باطن حقيقته؟ لا بد أن لهم علما بالحقائق غنيا عن التأويل يمكن بالعودة إليه أن نؤول ما عداه: وتلك هي العقبة التي يقف عندها حمار شيوخ التأويل جميعا. فلا بد للماركسي من علم تاريخ واجتماع لا يحتاج إلى التأويل أي بريء من أن يعد مجرد تعبير عن الوعي الطبقي. ولا بد للفرويدي من علم نفس وتأويل لا يحتاج إلى التأويل أي بريء من أن يعد مجرد تعبير عن اللاوعي. وكلا الشرطين ليس لهما عليه دليل فضلا عن كون الدليل نفسه لن يكون بمنأى عن مثل هذا الاعتراض.
ولنأخذ أوضح مثال لمفهوم التأويل في دلالته العلمية حتى نفهم هذه الإشكالية لأن تأويل النصوص مهما حاولنا رده إلى ممارسة علمية يبقى الغالب عليه الذوق الأدبي ومن ثم التحكم التأويلي بلغة حجة الإسلام في فضائح الباطنية حتى وإن لم يخل التأويل الأدبي من محددات منطقية ولسانية ونفسية واجتماعية قابلة للعلاج شبه العلمي فلا يكون أفضل مجال لبيان مصداقية المؤولين. لذلك فسنختار مثالنا من المجال الذي وضع أول نظرية في تأويل الأعراض الأقرب إلى العلم لقابلتيه لشرطي المعرفة العلمية أعني التجريب (تجريب العلاقة بين منظومات الأعراض والمرض المدلول عليه بها) والإحصاء (إحصاء الحالات التي يصدق فيها التوقع التأويلي للعلاقة بين منظومة الأعراض والمرض المدلول عليه بها): في التشخيص الطبي المجهز بتحليل الأعراض في المخابر فضلا عن فراسة الأطباء المجربين.
والمعلوم أن تأويل أعراض المرض عند الأطباء هو المعنى الأول لمفهوم السيميولوجيا العلمية التي تقبل الاحتكام إلى التجربة تجربة الفرضيات التأويلية الناقلة من الأعراض إلى تصنيف الأمراض بمقتضاها لتحديد عللها فعلاجها. فهل يوجد حقا علم يمكن الطبيب من استنتاج علمي دقيق يبرر التعصب لما يسمى بالتأويل العقلاني استنتاج للمرض من تأويل بسيط ومباشر للأعراض التي يلحظها على المريض في جل الحالات أو حتى في أغلبها فضلا عن توهم إمكان ذلك لها كلها؟ هل يوجد ما يجعل العقلاني يتكلم بكل وثوقية على معرفة تمكن صاحبها من زعم الحسم في مسائل الوجود والدين ؟ ما الذي يجعل الأطباء يحتاجون إلى الكثير من التحاليل وإلى لجان من الأطباء تقرأ نتائجها وتفحص المريض وتاريخه وتاريخ أسرته إلخ…وتتعاون في تأويل الأعراض لتحديد المرض دون جزم بالتحديد اليقيني إلا في الحالات البسيطة والنادرة ؟ وكم من طبيب متعنت أو متسرع في التأويل فوت على نفسه شروط الفهم هذا إن لم يقتل المريض بأدوية تخطئ ما يعاني منه المريض وتفقده الحصانة ؟
فسواء انطلقنا من أعراض المرض إلى تأويلاتها أو من أنظمة تأويل الأمراض إلى أعيان تطبيقاتها فإننا لا نملك طريقا ملكية نسكلها واثقين من الوصول إلى الغاية فنحدد المرض بصورة يقينية من تأويل الأعراض أو نحدد معاني الأعراض بصورة يقينية من تحليل النظرية التأويلية إلا بالتدرج البطيء علما وأن تعقيد بدن الإنسان يعد أمرا بسيطا بالمقارنة مع فهم الوجود التاريخي والروحي للإنسانية. ولعل الأمر في التأويل الطبي مناظر من حيث الصعوبة والتعقيد لعملية التحقق من الفرضيات العلمية في كل العلوم التجريبية. لذلك فالتأويل بهذا المعنى يقاس على بناء النظريات العلمية فيها. فمن الظاهرات الطبيعية التي هي أعراض ل”أمور مجهولة الطبيعة” تأويلها هو القانون إلى القانون الذي يؤولها نكتفي بالفرض والترجيح . ومن القانون إلى الظاهرات نكتفي بالتشاكل بين حدود العبارة الرمزية عن القانون الفرضي وما نعتبره مقوما من عناصر هذه الأمور المجهولة أو العوامل التي نتصورها ذات فاعلية فيها: أي إن كل ظاهرة نجد مشاكلة بين ما نتصوره مقوماتها وبين الرموز التي تتألف منها عبارة القانون نعتبرها عينا من الأمور المجهولة التي يصح عليها ذلك القانون. ولذلك كانت صفة القانون الأساسية من حيث هو رمز دال أنه رمز متشاكل ببنية عناصره الموضوعة مع المرموز ببنية عناصره المفروضة Diagramme.
لكن ذلك كله اجتهادات لا يحق لصاحبها أن يزعم لها أكثر مما يزعم لعبارة القانون العلمي من تفسير مؤقت للظاهرة الموضوع وللتشخيص الطبي للمرض. فقد نكتشف أن ما تصورناه عاملا مؤثرا ليس هو كذلك سواء في المرض الذي نطلب تشخيصه أو في الظاهرة التي نطلب قانونها ولا أحد يزعم أن ما عنده من معطيات كاف للحسم في مثل هذه الأمور بالوثوقية التي تجدها عند عقلانيينا المزعومين. وإذا كان ذلك كذلك في هذه الأمور البسيطة فكيف به في أسرار الوجود الإنساني أو الكوني أعني في ما تهتم به الأديان والفلسفات من قضايا كلية تخص معاني الوجود عامة والوجود الإنساني خاصة؟ العقلانية ليست هي إذن الموقف الذي يقول بالعقل دون تحديد بل هي بالذات الموقف الذي يقول بالعلم الاجتهادي أعني العقل الذي يعرف حدوده: إنه المعرفة التي تعلم حدودها فلا تؤله الإنسان بإطلاق عقله ومن ثم فهي تؤمن بأن وراء الشاهد غيبا مجهولا لا يدركه الإنسان بعلمه وعمله فيسلم وجهه لرب الغيب والشهادة.
[1]
نقتصر في هذا البحث على الطاغوت العلماني وسيأتي دور الطاغوت الأصلاني. لكن كل الأوهام التي تنتج عن إطلاق قدرات العقل يشترك فيها المتكلمون مع الفلاسفة المدرسيين أعني كل الفكر الذي يدعي العقلانية قبل تحقق ما كان يسعى إليه الفكر النقدي في محاولتي ابن تيمية وابن خلدون والذي لم يكتمل إلا في المدرسة النقدية الحديثة رغم أن هذا الاكتمال شوه مقاصد الحد من قدرات العقل بأن أطلق حدوده. فأصبح الحد من الإطلاق إطلاقا للحد في المدرسة النقدية وآل الأمر إلى اللاأدرية الدينية والعقلية في آن. وهو ما نبينه في دروس فلسفة الدين عندما نعالج مسألة العلاقة بين النقد عند مفكرينا ومآله في النقدية الكنظية كما يتبين من تحليلنا لمعاني العقل النظري والعملي وعلاقتهما بالجمالي والجلالي من منظور نظرية المعرفة والتربية القرآنيتين.
[2]
كيف يكون إصلاح النظر شرطا في العمل ؟ العلاج التيمي اعتمد على فرضيتين أولاهما دينية والثانية وفلسفية. فأما الدينية فهي اعتبار الشريعة تابعة للعقيدة لتبعية العمل للنظر. وأما الفلسفية فهي اعتبار ما بعد التاريخ أو الفلسفة العملية تابعة لما بعد الطبيعة أو الفلسفة النظرية لنفس التبعية الموضوعية. ولما كان تشخيصه للأزمة التي تمر بها الأمة هي بنسبة المرض إلى الجبرية في الفكرين الفلسفي الكلامي والصوفي الفقهي فإنه قد رأى أن العلاج يقتضي تحرير الإرادة الإنسانية بدحض الفلسفة والكلام والتصوف والفقه التي آلت كلها إلى القول بالجبرية. وإذن فإصلاح الفلسفة النظرية والعقيدة يؤديان في علاجه إلى إصلاح الفلسفة العملية والشريعة.
[3]
كيف يكون إصلاح العمل شرطا في النظر ؟ العلاج الخلدوني اعتمد على فرضيتين مقابلتين تمام المقابلة للتشخيص التيمي رغم أن المشكل الذي يتصدى له هو نفس المشكل. فعنده أن العقيدة والفلسفة النظرية يتبعان الشريعة والفلسفة العملية أي إن التربية والسياسة هما اللتان تكونان الإنسان على الخنوع والاستسلام للأقدار وفقدان معاني الإنسانية. لذلك فينبغي إصلاح السياسة والتربية أي الفلسفة العملية والشريعة لكي يصبح الإنسان قادرا على الاعتقاد الصحيح والفكر الصحيح فضلا عن الشجاعة الخلقية وطلب الفضائل الذي هو غير ممكن في رأيه إذا ربي الإنسان أو عاش في نظام يزيل معاني الإنسانية.
[4]
لن نسأل عن الكلمة السحرية للتفاعل. فهذا أمر يبدو عند هذا المفكر أمرا مفهوما ولا يحتاج إلى تحليل. سنكتفي بما هو أبسط لنسأل: إذا كانت العناصر الثلاثة هي على التفاعل المستمر فكيف تبقى ثلاثة؟ هل العلة هي أن الكاتب يميز بين جوهرين ثابتين ثم علاقة التفاعل بينهما فتكون بذلك العناصر ثلاثة ؟ لكن ماذا لو اعتبرنا الحدين اللذين بينهما التفاعل هما بدورهما كائنين غير ثابتين فلعلهما هما بدورهما تفاعلان لعناصر أخرى إلى غير غاية. وللمساعدة فلنسلم بأن العناصر المتفاعلة ثابتة ولنسأل: أليس التفاعل مشاركة بين المتفاعلين فهل نميز بين فعل س في ص وفعل ص في س أم نعتبرهما شيئا واحدا ذا اتجاهين ؟ إذا ميزنا فبم نمير ؟ وإذا لم نميز فلم لا نميز ؟ وفي حالة عدم التمييز ألا تكون الفاعلية في التراث ككل خاضعة لقاعدة مجموعة أقسام المجموعة فتكون 2 (الواقع والفكر) قوة ثلاثة (إما الفكر يفعل في ذاته أو في غيره أو الواقع يفعل في ذاته أو في غيره أو كلاهما يفعل بالتوازي دون تفاعل أو بالتفاعل أو لا واحد منهما يفعل كأن يجمد كل شيء وهو أمر ممكن وكل هذه الحالات تحصل بحسب الظاهرة التي نريد فهمها بهذا المنهج) وإذا ميزنا اتجاهي التفاعل ألا تصبح 2 قوة 6 ؟ فكيف سينحصر الأمر خاصة والتفاعل هو بدوره يتفاعل إلى غير غاية ؟ أم هل إن هذا ليس من العقل الذي يقول به صاحب التأويل العقلي ؟
[5]
ناصر حامد أبو زيد فلسفة التأويل ص.34. واختيارنا لنص من أعمال ناصر حامد أبي زيد لا يعني أننا نقبل بالرد الفقهي على سلوكه كما فعلت المؤسسة الدينية في مصر. فهذا العلاج جعل الرجل ضحية فصيره نجما دون أن يكون أهلا لأن يعتد بفكره لو كان بين علماء الدين من رد عليه ببيان خوائه العلمي في ما يدعيه من العلوم الحديثة. رد المؤسسة الدينية لم يكن ذا علاقة بالمسألة المعرفية بل هو صراع مصلحي بين النخب في لحظة معينة من لحظات المؤسسات النخبوية في مصر الحديثة. ما يعنينا من الكلام في المسألة هو فهم الأزمات التي يعاني منها الفكر الإسلامي والعلاج الفقهي القاصر لهذه الأزمات فضلا عن كونه خروجا عن دور الفقه الذي هو تنظيم للأفعال وليس للأفكار وخاصة للأفكار في مستوى البحث العلمي المختص الذي ليس له تأثير مباشر على الرأي العام الجمهوري (لأن الأفكار تصبح أفعالا عندما يريد أصحابها الانتقال من البحث العلمي إلى التأثير الجمهوري) لم يكن علاجا موفقا: فكيف يستنتج الفقهاء من آراء حامد أبي زيد أنه كافر وأنه ينبغي أن تطلق منه زوجته؟ هل صار التكفير حكما فقهيا من دون أن يسبق بإعلان المكفر أنه لم يعد يشهد الشهادة التي بإثباتها يدخل الإسلام وبنفيها يخرج منه ؟ وإذا نفاها فقد خرج من الإسلام ولم يعد خاضعا لحكم الفقه الإسلامي بل يصبح كما ورد في آية المرتدين مرجئا إذ قد يثوب إلى رشده فيعود إلى حظيرة الإسلام أو يبقى على ردته فيحاسبه ربه بصريح نص الآية 217 من البقرة. لذلك فإني اعتقد أن محنته لا علاقة لها بالمسألة الفكرية التي أناقش رأيه فيها دون سواها معتبرا الأمر الآخر ثمرة الصراع بين الأصوليتين اللتين أفسدتا الفكر العربي الإسلامي.
[6]
لا أحد سليم العقل يمكن أن يتصور كل هذه الأمور قابلة لأن يحيط بها عقل إنساني فيعالجها علاجا يزعم له أدنى قدر من العلمية. وإذا كنا قد أدركنا منذ أمد طويل أوهام العلم الميتافيزيقي الكلي لعالم الطبيعة فكيف لم يدرك هؤلاء بعد أن الاستحالة أكبر بخصوص عالم التاريخ الذي يقتضي حل معضلات الطبيعة بالإضافة إلى معضلاته حتى لو قبلنا بما يراه العقلانيون بأنه لا وجود لما وراء هذين العالمين ؟ وكان يمكن أن يقبل مثل هذا المشروع من شخص متواضع يريد أن يدلي برأي تحكمي حول تصوره لعلاقة هذه الأمور بعضها بالبعض بمجرد بادئ الرأي أما أن يزعم أن ذلك عمل يمكنه من الحكم في قضايا الوجود والدين والزعم بأنه يقدم معرفة ذات دلالة فإن ذلك إن لم يكن من السذاجة أو من الغفلة فهو من اللامبالاة بعقول المخاطبين. ولهذه العلة فإن المرء يحق له أن يزعم أن المتعاقل من المفكرين العرب أكثر تعصبا وأقل فهما لمعنى العقل من كل المتعصبين من الحزب المقابل رغم أن الحزبين كلاهما مجانب للصواب بسب الابتعاد عن معاني القرآن الكريم في مفهوم المعرفة الاجتهادية.
[7]
تقديم الواقع مبدأ وجوديا للتفسير علام يدل؟ إنه يدل على عدم إدراك امتناع ذلك وعلى الواقعية الغفلة التي تتصور الوجود شفافا بحيث يستطيع العقل الوصول إليه من غير وساطة الرموز الفاصلة بيننا وبينه دائما. ومما يعجب له المرء أن هذا الكلام يأتي ممن يزعمون الموقف التأويلي: فمن المفروض أن يكون أصحاب هذا الموقف أكثر فهما من غيرهم لدلالة التأويل وما تقتضيه من دور للرمز متقدم على ما يسمونه واقعا.
[8]
التثليث الجدلي مبدأ منهجيا وفيه من السذاجة المنطقية فضلا عن المعرفية القدر الكبير . فهبنا سلمنا بأن الأمر يتعلق بعلاقة بين الفكر والواقع فلم هي إذن في اتجاه واحد ؟ أليست علاقة ثنائية تقبل الاتجاهين ؟ وبأي معنى يعتبر فعل الواقع في الفكر وينسى فعل الفكر في الواقع ؟ ثم لم يعتبران أمرا واحدا إذا قبلنا بأن الوجه الثاني لم يهمل ؟ ثم أين نضع الاعتقاد بفاعلية الواقع أو بفاعلية الفكر أعني الموقف التفضيلي لأحد العاملين على الآخر في الفاعلية ؟ هل هو من الواقع أم من الفكر أم ماذا ؟
[9] استدلالا بالنص نفسه حجة على نفسه. هذه الحجة تعود إلى القول بأسباب النزول والتلازم بين القرآن كحديث والأسباب كأحداث. أليس هذا الوهم من جنس من يظن أن النظرية في العلم مثلا لها صلة بالأمثلة التي يضربها الأستاذ لتلاميذه في التدريس ليفهمهم النظرية ؟
[10]
ما المكونات؟ ولم حصرت في ثلاثة؟ حصرها في ثلاثة لأنه تثليثي أولا ولأن ذلك من شروط العلاج الجدلي. وهذا طبعا من التحكم. ذلك أن المعادلة الأصح حتى بمنطق هذا المتفلسف بغير علم تقتضي أن نميز بين واقع النصين المرجعيين وواقع التفاسير وواقع الفلسفة اليونانية وواقع الحصيلة من تفاعلاتها إن صح قوله. فكيف يعتبر هذه الأصناف المختلفة من الواقع واقعا واحدا ؟ وكيف يعتبر النصين والتفاسير من نفس الطبيعة ؟ ثم كيف له أن يأخذ الفلسفة اليونانية وكأنها لا واقع لها تكون في صلتها به قد كانت في ما يزعمه من صلة للقرآن والسنة بواقعهما ؟ فكان من المفروض بمنطقه أن يتكلم على ثلاثة أصناف من الواقع لأنه تكلم على ثلاثة أصناف من النصوص تسليما بأن هذه النصوص لها وحدة ما. وكان من المفروض ألا يتصور العلاقة بين النص وواقعه علاقة ذات اتجاه واحد: فمثلما أن للواقع فعلا في النص فللنص فعل في الواقع ومثلما أن النصوص تتفاعل فإن الواقعات تتفاعل فيكون النص القرآني مثلا متفاعل مع الحديث والحديث مع النص القرآني والتفسير معهما وهما معه والسيرة مع التفسير والتفسير مع السيرة إلخ..ونفس الأمر بين الأحداث التي يدور حولها القرآن والحديث لأن الحدث يفعل في الحدث وينفعل به بصرف النظر عن توسط الحديث وبتوسطه فنكون أمام شبكة من العلاقات لا حصر لها. فكيف استطاع هذا العبقري أن يفك هذا التشاجن بحيث استطاع أن يضع فلسفة في التأويل تعود في حقيقتها إلى فكرة سطحية هي قانون التأويل القديم: إذا تعارض العقل والنقل يقدم الأول ويؤول الثاني في ضوئه دون حصر للعقل ما هو ولا للنقل ما هو ولا خاصة لكيفية الانتقال من المعنى الظاهر إلى المعنى الباطن في عملية التأويل مع افتراض العلم الذي يحقق ذلك مستقلا عن كل هذه المؤثرات بحيث يمكن من تحرير سواه منها. ولسنا نعقد الأمر إلا لأننا بأخذ كلام أبي زيد مأخذ الجد. لكنه في الحقيقة لا يحتكم إلى الواقع كما يزعم بل هو يحتكم إلى نظرية في الواقع هي الفلسفة الماركسية نظرية تغنيه عن الكلام في تعدد الواقعات التي أشرنا إليها لأنها جميعا تعود إلى العملية الكيماوية السحرية الماركسية في العلاقة بين البنيتين التحتية (الواقع) والفوقية (النص). وهو لا يسأل عن الآليات التأويلية الناقلة من الواقعات المتعددة إلى دلالاتها لأنه يكتفي بآلية الانعكاس الماركسية الفجة. لكننا حاولنا بيان آليات القرآن في علاجه موضوعاته لما أشرنا إلى أسلوب التعبير بكونه ما بعد السرد الروائي وأسلوب الاستدلال بكونه ما بعد الطرد النظري منذ بداية المحاولة.
[11]
والمعلوم أن الفرقتين تستندان إلى أساس منعدم عند المزعوم عقلانيا من مفكرينا: فهم كانوا يؤمنون بأن القرآن وحي. ولذلك فلا يحق لأحد من مفكري العرب الحاليين أن يزعم الانتساب إلى أي من الفرقتين. فمهما كان المعتزلي مغاليا فهو لم يزعم أن القرآن من تأليف محمد لأن القول بخلقه لا يعني أن خالقه ليس هو الله. وفي الحقيقة فإن الخلاف بين الخلق والقدم في القرآن خلاف لفظي. ذلك أن القرآن من حيث هو فعل الكلام الإلهي صفة فعلية فلا يكون مخلوقا ككل الصفات التي هي عند المعتزلي اعتبارية ومن ثم فالكلام ذاتي لله إذ لا أحد من المعتزلة قال إن الله أبكم وأقصى ما يمكن أن يفعلوه هو رد الكلام إلى النطق ومن ثم إلى العلم وهم في ذلك لايكادون يختلفون حتى عن الحنابلة إذ إن أهم حجج ابن حنبل في المحنة كان الآيات الدالة على قدم العلم لا على قدم الكلام. ومن حيث هو مفعول الكلام أي الكلمات التي تنتج عن فعل الكلام فلا بد أن يكون مخلوقا مثل كل الكائنات الأخرى التي يصفها القرآن أيضا بكونها كلماته. ومن ثم فكل المشكل علته الخلط بين فعل الكلام ومفعوله. إذا ميزنا بين الأمرين وكلاهما تفيده مفردة كلام زال المشكل ولم يبق إلا الخلاف اللفظي: والعلة أن المصدر في العربية يفيد الأمرين الفعل والمفعول. وحتى لو سلمنا بكونه مخلوقا دون هذا التمييز الذي غاب عن أذهانهم غير المدركة للطائف المعاني فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنه تاريخي خاصة في عصر المعتزلة: إذ حتى الفلسفة فضلا عن الكلام كانت تعتبر عالم ما فوق القمر أزليا وأبديا أي قديما فيكون القرآن رغم كونه مخلوقا من هذا الجنس. كل الكلام الحالي عما كان يعنيه المعتزلة بالمخلوقية لا معنى له وهو إسقاط لمعاني حديثة لم تدر بخلد أي معتزلي: كل ما كان يعنيه المعتزلة هو اعتبار القدم خاصية إلهية لا يشاركه فيها أحد وهو من إفراط التنزيه الذي صار تعطيلا ومن ثم فهو يقابل تمام المقابلة ما يعنيه المحدثون بالمخلوقية التي تعني عندهم التاريخية.
[12]
للتدقيق حول هذه المطالب الثلاثة في العلم القديم راجع أبو يعرب المرزوقي الرياضيات القديمة ونظرية العلم الفلسفية الدار التونسية للنشر تونس 1985. ص.45 وما بعدها.
[13]
والتمييز بين التجربة الحاصلة والتجربة الممكنة من المبادئ الأساسية في كل مناقشات ابن تيمية للرازي. وأكثر النصوص صراحة ووضوحا في هذا المضمار وردت في “بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية” ” ردا على كتاب تأسيس التقديس للرازي (طبع المرة الأولى ناقصا في مطبعة الحكومة بالرياض في جزأين سنة 1979 ولم يعد طبعه كاملا إلا سنة 2006)
[14]
اختار كلمة “عبور” عن قصد لأن التأويل بالمعنى المستعمل في محاولات الحداثيين تقيسه على تأويل الأحلام في علم النفس. وذلك ما يسمى في القرآن تعبيرا للرؤى والأحلام. وهم يفترضون أساسا لهذا القياس بسبب تصورهم القرآن منتوجا مخياليا من جنس الأحلام والأساطير التي تحتاج إلى تعبير آليات العبور فيها هو نظرية اللاوعي الإنساني. ومن تناقضات هذه التصورات أنهم يظنون هذا الرد حلا كافيا لفهم ظاهرة الوحي. فهبنا سلمنا لهم تسامحا جدليا أن الوحي من إبداع الخيال: فهل لهم تفسير علمي للإبداع عامة فضلا عن الإبداع في النصوص الدينية ؟ إذا كنا لا نستطيع تفسير أي إبداع مهما كان ضئيلا في أي مجال من مجالات الإبداع الرمزي علميا كان أو فنيا أو شعريا أو روحيا فأي فائدة من هذا الكلام الذي يتصورونه جوابا عن مغلقات الوجود وهو في الحقيقة حل وهمي يحتاج إليه المثرثرون في ما لايفقهون.
17/01/2009