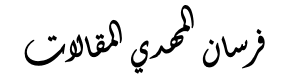ثورة الشعوب العربية بين الأنظمة الملكية والأنظمة الجمهورية
ثورة الشعوب العربية بين الأنظمة الملكية والأنظمة الجمهورية
بقلم د. حاكم المطيري

ما الفرق بين الثورات والاحتجاجات الشعبية العربية في الدول الجمهورية، والدول الملكية الوراثية؟
وما سبب قوة الاحتجاجات وحيويتها في الجمهوريات (تونس، مصر، اليمن، ليبيا، سوريا)، وضعفها وخورها في الملكيات (المغرب، الأردن، السعودية، دول الخليج)؟!
هل السبب الحالة المادية للمواطنين؟
لو كان الأمر كذلك لكانت المغرب البلد الفقير، أولى بالثورة من ليبيا الغنية!
أم السبب المدنية ورسوخها ؟
ولو كان الأمر كذلك أيضا لكانت ليبيا واليمن أبعد ما تكونان عن الثورة لوضعهما القبلي!
أم السبب هو استشراء الظلم والفساد، وظهور الطغيان والاستبداد؟
ولو كان الأمر كذلك لكانت الملكيات أولى بالثورة من الجمهوريات! فالفساد في الملكيات وانتهاك حقوق الإنسان فيها وإهدار كرامته أشد وأنكى!
إذن ما تفسير هذه الظاهرة الاجتماعية السياسية مادام الأمر لا يرتبط بالأوضاع الاقتصادية، ولا بمدى استشراء الظلم، ولا بالمدنية والقبلية؟
وما الفرق بين الإنسان العربي في ظل الجمهورية، والإنسان العربي في ظل الملكية؟
ولماذا كانت الجماهير العربية ترفع شعار (الشعب يريد إسقاط النظام) بكل شجاعة نفسية، بينما لا يجرؤ المتظاهرون في الملكيات برفع شعار أبعد من (الشعب يريد إصلاح النظام)!
فهل السبب هو الحب والهيام، والود والغرام، بين الشعوب وملوكها في الملكيات؟!
الحقيقية كما يظهر للمتأمل الاجتماعي أعمق من ذلك كله، فلكل نظام سياسي طابعه الذي يطبع به الإنسان الذي يعيش تحت ظله، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة الاجتماعية {إن الملوك إذا دخل قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون}!
إن الملك بطبيعته يقوم على الإذلال والقهر، وتحطيم الشخصية الإنسانية واستعبادها، ولهذا تتحلل مع طول الأمد وتوارث الملك من قيمها المعنوية لتتحول إلى مسخ مشوه، حتى ينشأ إنسان ذليل مقهور حتى لأضعف الملوك الذين لم يكن لهم يد في صناعة الملك، اللهم إلا أنه ورث العرش والصولجان، والأرض والإنسان!
وهذا بخلاف الجمهوريات مهما كانت مستبدة طاغية، فإن الإنسان فيها يتحين تغيرها وتبدلها، ويحتفظ بمخزون إنسانيته إلى حين ذلك، إذ لا يطبع بطابع العبودية التي يطبع بها الإنسان في الأنظمة الوراثية، فهو لا يستشعر أن بينه وبين من هو في السلطة أي فرق، ويرى بأن أي مواطن قد يصبح رئيسا بكفاحه ونضاله، بخلاف الأنظمة الوراثية التي يتحلل فيها شعور الإنسان شيئا فشيئا وجيلا فجيلا حتى ينعدم إحساسه بالمساواة بينه وبين الملك وسلالته، فيبدأ المخيال الشعبي باختلاق أوهام عن الخصوصية والاصطفاء والصفات التي جعلت من هذه السلالة تتبوأ هذا المقام السامي، ليتلاشى شيئا فشيئا إحساس الإنسان بإنسانيته أمام هذا الحاكم وسلالته ولو كانوا أطفالا صغارا!
بل قد يبلغ الأمر ذروته بالعلماء والمفكرين والأدباء والأذكياء أن يصبحوا أسرى الوهم في ظل الملكيات حتى أنهم لا يتصورون أصلا إمكان وجود المجتمع والدولة بدون الملك وأسرته!
وقد يبلغ بهم الخوف من تغير الأوضاع وزوال الملك وأسرته حد الهوس والجنون، كالعبد الذي لا يتصور أن بإمكانه العيش والحياة دون سيده!
لقد تحدث عن هذه الظاهرة الإنسانية وعبر عنها قبل أربعة قرون المفكر الفرنسي لوبواسييه في كتابه(العبودية المختارة)، ونجح في تحليل نفسية الإنسان في ظل عبودية الملك بقوله (إن السبب الذي يجعل الناس ينصاعون طواعية للاستعباد هو كونهم يولدون عبيدا، وينشأون على ذلك، ويسهل تحولهم تحت وطأة الطغيان إلى جبناء مخنثين، وإنه بزوال الحرية تزول الشهامة).([1])
فالفرق الأول بين إنسان الجمهورية وإنسان الملكية، هو في احتفاظ الأول بقدر من حريته وإنسانيته تتجدد كلما تغير رئيس مكان رئيس، بخلاف الثاني الذي يولد في العبودية كما ولد أبوه، ليورث العبودية إلى أبنائه من بعده، كما ورثها عن أبيه، حتى تصبح العبودية طبعا فيه!
فالفرق هنا هو بين الإنسان والإنسان، أما الفرق الثاني فهو بين السلطان والسلطان، والطغيان والطغيان، إذ يختلف طغيان الملكية عن طغيان الجمهورية، كما يقول لوبواسييه عن صور الطغيان:
(هناك ثلاثة أصناف من الطغاة : من يمتلك الحكم عن طريق انتخاب الشعب – ليستبدوا به بعد ذلك كما في الجمهوريات – أو من يملك بقوة السلاح – كالانقلابات العسكرية – أو بالوراثة المحصورة في سلالتهم، وهؤلاء عادة ولدوا وأرضعوا على صدر الطغيان، يمتصون جبلة الطاغية وهم رضع، وينظرون للشعوب الخاضعة لهم نظرتهم إلى تركة من العبيد، ويتصرفون في شئون المملكة كما يتصرفون في ميراثهم).([2])
فالفرق بين الرؤساء في الجمهوريات، والملوك في الملكيات، هو أن طغيان الرؤساء يكون طارئا عليهم بعد السلطة، وينشأ شيئا فشيئا، وقد يفقد الرئيس السلطة قبل أن يبلغ به طغيانه حد التأله، ثم لا يلبث أن يعود إلى طبيعته بعد تغير أحواله وخروجه من السلطة، بخلاف طغيان الملوك، فإنهم يرضعونه من ثدي أمهاتهم، فلا يصلون إلى الحكم إلا وقد بلغ الطغيان فيهم حد التأله، ويكون الشعب قد بلغ حد العبودية، من حيث لا يشعر بعبوديته لهم!
وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حين دخل عليه رجل فارتعدت فرائصه خوفا، فقال له صلى الله عليه وسلم (هون عليك فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة)!
فنفى عن نفسه أن يكون ملكا، مع كونه صلى الله عليه وسلم ذا سلطان وملك، ولهذا ذكّر الرجل بأنه ابن امرأة كباقي النساء، ليعيد لهذا الإنسان شعوره الطبيعي بإنسانيته، وليزول عنه الخوف والرهبة، التي اختزنتها ذاكرته عن الملوك وسطوتهم!
إنه حالة من العبودية التي تبذل بسببها الشعوب طاعتها بكل هدوء ووداعة للملوك والطغاة، كوداعة قطيع الأغنام لرعاتها، لا حبا ولا احتراما بل خشية وعبودية، كما قال لوبواسييه (لا أفهم كيف أمكن هذا العدد من البلدان والأمم أن يحتملوا طاغية واحدا لا يملك من السلطان إلا ما أعطوه، ولا كان يستطيع إذاءهم لولا إيثارهم الصبر عليه بدل مواجهته، فترى الملايين من البشر يخدمون في بؤس، وقد غلت أعناقهم دون أن ترغمهم على ذلك قوة أكبر منهم، وإنما سحرهم مجرد الاسم الذي ينفرد به الطاغية، وكان الأولى بهم ألا يخشوا جبروته فليس معه غيره، ولا أن يعشقوا صفاته فما يرون منه إلا خلوه من الإنسانية، إن ضعفنا نحن البشر كثيرا ما يفرض علينا طاعة القوة! أي تعس هذا! أي رذيلة هذه! أن نرى عددا لا حصر لهم من البشر لا أقول يطيعون بل يخدمون، ولا أقول يُحكمون بل يستعبدون، لا ملك لهم ولا أهل، بل حياتهم نفسها ليست ملكا لهم، ويحتملون السلب والنهب وضروب القسوة، لا من جيش أجنبي ينبغي عليهم الذود عن حياضهم ضده، بل من واحد لا هو هرقل ولا شمشون، بل هو في أكثر الأحيان أجبن من في الأمة، وأكثرهم تأنثا! ومع ذلك فهذا الطاغية لا يحتاج إسقاطه إلى محاربته وهزيمته، بل كاف الامتناع عن طاعته، فالشعوب هي التي تترك القيود تكبلها، أو قل تكبل نفسها بنفسها).([3])
وتزداد الخطورة حين تلبس هذه العبودية لبوس الدين، وتصبح باسم الله، فهنا يكون الأمر قد بلغ الغاية القصوى من الانحراف بالفطرة الإنسانية السوية، ليتجاوز الأمر طاعة الملوك والعبودية لهم، إلى المحبة والإخلاص في هذه الطاعة لتكون لهم وحدهم، وخالصة لهم!
(إن الطغاة أنفسهم يعجبون لقدرة الناس على احتمال ما يصبونه على رؤوسهم من العذاب، لقد احتموا بالدين واستتروا وراءه، ولو استطاعوا لاستعاروا نبذة من الألوهية سندا لهم، إن الطغاة كانوا يسعون دائما ليستتب لهم سلطانهم إلى تعويد الناس أن يدينوا لهم لا على الطاعة والعبودية فحسب، بل بالإخلاص كذلك).([4])
وفي مقابل ذلك وليعوض الطغاة عبيدهم عن الحرية الحقيقية التي استلبوها منهم، فتحوا أمامهم الباب لحرية زائفة يمنحها الطغاة لشعوبهم بل عبيدهم ليلهوهم بها، وليعيشوا وهم الحرية، وحرية الوهم!
كما قال لوبواسييه (ويتجلى التحايل من قبل الطغاة على التغرير برعاياهم – لاستعبادهم – بفتح دور الدعارة والخمر والألعاب الجماهيرية، فانصرف هؤلاء المساكين البؤساء إلى التفنن في اختراع الألعاب من كل لون وصنف، لقد كانت المسارح والألعاب والمصارعون والميداليات واللوحات وغيرها من المخدرات لدى الشعوب طُعْم عبوديتها، وثمن حريتها، وأدوات الاستبداد بها).([5])
إن من ينظر في واقع المجتمعات العربية اليوم، يجد أنها توافق تمام الموافقة، وتطابق تمام المطابقة حالة الشعب الفرنسي قبل أربعة قرون، ليصدق بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم (لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، فارس والروم)!
إن من يشد الأغلال في أعناق الشعوب، ويقيدها بحلق قوائم العروش، ليس الجنود والجيوش، بل هم عصابة بين السبعة والتسعة كما قال تعالى {وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون}!
إنهم مجموعة من السماسرة والنخاسين، من المفكرين ورجال الدين، من بطانة السوء، الذين يثرون فجأة من أموال الشعوب، فيجعلون أعراضهم دون عرض الرئيس والملك، وأرواحهم دون روحه، لا حبا فيه، بل خوفا من سقوطه، وذهاب مكانتهم وطريقتهم، كما حذر من ذلك الملأ الفرعوني {ويذهبا بطريقتكما المثلى}!
كما قال لوبواسييه (ليس فرق المشاة، ولا قوة الأسلحة، تحمي الطغاة، بل أربعة أو خمسة يبقون الطاغية في مكانه، ويشدون البلد كله إلى مقود العبودية،يتقربون أو يقربهم إليه،ليكونوا شركاء جرائمه،وقواد شهوته ولذته،هؤلاء الخمسة أو الستة يدربون رئيسهم على القسوة نحو المجتمع،وينتفع في كنفهم ست مئة يفسدهم الستة مثلما أفسدوا الطاغية،ثم هؤلاء الست مئة يفسدون معهم ستة آلاف تابع،يوكلون إليهم مناصب الدولة،والتصرف في الأموال، ويتركونهم يرتكبون من السيئات ما لا يجعل لهم بقاء إلا في ظلهم، ولا بعدا عن طائلة القانون إلا عن طريقهم، ليطيحوا بهم متى شاءوا، ليصبح ليس فقط الستة أو الستة آلاف بل الملايين يربطهم بالطاغية هذا الحبل، لو شده لجذبهم كلهم إليه، فصار خلق المناصب الجديدة، وفتح باب التعيينات والترقيات على مصراعيه، كل ذلك لا من أجل العدالة، بل من أجل أن تزيد سواعد الطاغية، فإذا الذين ربحوا من الطغيان، يعدلون – بل يعادون – في النهاية من يؤثرون الحرية،فما إن يستبد ملك حتى يلتف عليه حثالة المملكة وسقطها، ليصبحوا أنفسهم طغاة مصغرين في ظل الطاغية الكبير).([6])
إن سر وداعة الشعوب العربية وخورها في ظل الملكيات، وحيويتها وشجاعتها في ظل الجمهوريات، ليس الرضا عن الملوك، ولا الحب لهم، ولا الرغبة في حكمهم، إنما هي وداعة العبيد أمام سادتهم، حين يفقدون إنسانيتهم، ويتنازلون عن حريتهم، ويتجردون من كرامتهم، فيصبح ذلك فيهم مع توارث الأجيال طبعا وسجية، ثم تزداد الخطورة حين يصبح تدينا وورعا كاذبا، ويبلغ ذروته حين يصبح فكرا وفلسفة وحكمة يتمتع العبيد بها، ونعمة يرتعون فيها!
([1]) العبودية المختارة ص 72 بتصرف .
([2]) العبودية المختارة ص 63 بتصرف.
([3]) المصدر السابق بتصرف.
([4]) العبودية المختارة ص 78 .
([5]) المصدر السابق 74 بتصرف.
([6]) العبودية المختارة ص 81 بتصرف .
—
24 ربيع الثاني 1432 هجرية
> من موقعه الرسمي