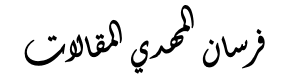لا.. لأوثان البشر، ولا..لأوثان أفكارهم
لا.. لأوثان البشر، ولا..لأوثان أفكارهم
الشيخ / بندر بن عبد الله الشويقي
من طريقةِ صاحبنا أبي عمرو د. محمد بن حامد الأحمري اختزال الآراء المتباينة في رأي واحدٍ قبيح المنظر، من أجل أن يتهيأ له هجاؤه بمثل تلك الطريقةِ التي رأيناها في “مفرقعته” الأخيرة التي طبع فيها بخاتم الوثنية على من يمسُّ جناب النظام الديمقراطي بأيِّ نقدٍ.
“الديمقراطية” منتَج بشريٌّ، وبالتالي لا يمكن أن تخلوَ من عيوبٍ وخللٍ. ومن الطبعي أن تتباين الآراء في حجم هذه العيوب وخطورتها، حسب الزاوية التي ينظر منها الناقد.
و من المعروف أن الفكرة وقت وهجها وسطوعها يقلُّ نقادها، فإذا سقطت وأدبرت تحدث عن عيوبها الجميع، بمن فيهم أولئك المقدِّسين لها قبل سقوطها. وها نحن اليومَ نسمع اللعنات تصب على مسوقي “النظام الاقتصادي الحر”، ومروجي فكرة “اقتصاد السوق”، بعدما كانت تلك الشعارات رمزاً للحداثة الاقتصادية.
والصورة –يقيناً- سوف تتكرر مستقبلاً بالنسبة للفكرة الديمقراطية التي لا زالت تنجب لأهلها مشاكل اجتماعيةً ضخمةً مستعصيةً على الحل. لكن بريق الفكرة الحالي يمنع من الربط بينها وبين تلك المشاكل المتراكمة التي تهدِّد مستقبل الأمم الغربية الاجتماعي.
و في المشرق فإن نقاد الديمقراطية اليومَ أنواع: أسوأهم أولئك الذين ذكرهم د. الأحمري في مقالته ممن يسبحون بحمد ربِّ العرش، ويقدسون صاحب الكرسي، فلا يريدون لأحدٍ أن يمس إحساسه بكلمةٍ، أو أن يطالبَ بنظامٍ يحد من سلطته المطلقة.
وأحسنهم حالاً: من يرفض الديمقراطية من منطلقٍ شرعيٍّ باعتبارها نظاماً لا يتَّفقُ ومنهج الحكمِ في شريعةِ الإسلام. لكنهم مع ذلك يؤمنون بضرورة الأخذ على يد الظالم حاكماً كان أو محكوماً، و يؤكدون على ضرورةِ أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، سواءٌ تعلق هذا المنكر بالسياسة أو بما سواها.
وهؤلاء -أيضاً- أنواعٌ: فمنهم العالم نظيف القلب واليد، الذي يجتهد في الإصلاح والنصح ما أمكنه. و قد يناله من الأذى في سبيل ذلك ما يناله. ومنهم: العالم المجتهد في التربية وإرشاد الناس للخير، لكنه يعتزل أبواب السلطان والشأن السياسي كله، لإقراره بعجزه وضعفه عن وظيفة الاحتساب عليه. ومنهم من يئس من الإصلاح السياسي، فانصرفَ عنه، ليهتم بما يرجو نفعه من استصلاح عموم الناسِ.
و هناك سوى هؤلاء أطيافٌ أخرى كثيرةٌ يعرفها من يخالط المجتهدين في الإصلاح، ويعيشونه كلَّ يومٍ. وهم جميعاً يتفقون على ما دلَّت عليه نصوص الوحي من النهي عن التهور في التغيير بالعنف أو التسبب في الفتنة وسفك الدماء. و قد يوجَد في هؤلاء من يغالي في سد هذا الباب، حتى ربما اعتبر بعض أنواعِ المطالبات السلمية دعوةً للفتنة.
وإن وسعنا دائرة رافضي “الديمقراطية”، فسوف نرصد أنواعاً أخرى انتهجت نهج المناقضة الصريحة لأنظمة الحكم القائمة، فهي تصرح علناً بتكفيرها، وعدم شرعيتها، و فيها من انخرط في التنظيمات المسلحة المصادمة لها والساعية في إسقاطها.
هذه الأطياف المتباينة، يقومُ الدكتور الأحمري باختزالها في صورةٍ واحدةٍ لا ثاني لها، وهي صورة: الوثني الذي يقدِّس الحاكم ويؤمن بعصمته. فكل من لا يؤمن بالديمقراطية أو يرفضها، أو يتحفظ على بعض جوانبها فقد تلطخ بالوثنية التي لا سبيل للسلامة منها إلا بحبس العقل عن نقد النظام الديمقراطي بما فيه من عيوبٍ يقر بها الديمقراطيون أنفسهم.
قديماً كان د.علي شريعتي يكتب منتقداً عيوبَ النظام الديمقراطي، ويصفه بأنه “نظامٌ هزيلٌ وخطير”. وكان يقول: إن “من السَّطحية بمكانٍ أن نفترض أن السوادَ العام من الجماهيرِ الذي يُشكل أكثريةَ الأصواتِ، ينتخبون مرشحيهم على أساس دراسةٍ دقيقة لشخصية المرشَّحين”.
كان علي شريعتي يقول هذا الكلام في وقتٍ لم تكثرْ فيه الكتابات الفاحصة للفكرة الديمقراطية بالصورة الموجودة اليومَ. فكانَ نقده المبكر دليل نظرةٍ ثاقبةٍ، وعقلٍ راجحٍ، استطاعَ به أن يميز بين المظهر والمخبر. فموقف الناخب الأمريكي لا تحدِّده معرفته ودرايته بكفاءة المرشَّح الذي سوف يعطيه صوته، لأنه -باختصارٍ- لا يعرف شيئاً عن هذا المرشَّح إلا من خلال حديثه عن نفسه في خطبه الانتخابية، أو من خلال برامج إعلامية وإعلانات مدفوعة الثمن تشبه الإعلانات التجارية، تحاول استمالة الأصوات إلى أحد الطرفين. فمن المجازفة القول بأن السبعين مليوناً الذين انتخبوا “أوباما” فعلوا ذلك عن درايةٍ بكفاءته السياسية.
وأنا حين أنقلُ كلام د. علي شريعتي هنا، فلأنه لا يمكنُ لصديقنا أبي عمروٍ وصفه بالوثنية وعبادة الحاكم، فالرجل ابتدأ حياته بالانضواء في حركة “محمد مصدق” المعارضة للشاه، ثم في وسط عمره القصير أصبح ضيفاً وزبوناً ثابتاً لسجون الشاه، ثم في خاتمة حياته القصيرة، لقي مصرعه في لندن برصاص عملاء السافاك (بوليس الشاه السري).
ثم هو –أيضاً- لم يكنْ “أستاذ عقيدة”، بل كان أستاذاً في علم الاجتماع، متخرجاً من الجامعات الفرنسية. كما أنه لم يكن سلفياً –والعياذ بالله-، بل كان “رافضيا” مُحَكحَكاً شتاماً لخيار الأمة –رضي الله عنهم-. فلعل في هذه السيرة ما يشفع له عند الأحمري كي يبرئه من تهمة الوثنية التي ألصقها بكل من تحدثه نفسه بالمساس بالفكرة الديمقراطية.
كان علي شريعتي قبل حوالي خمسةٍ و ثلاثين عاماً يشخص إحدى معضلات النظام الديمقراطي، فيذكر أن من السطحية بمكان اعتقاد أن الناخب يبني قراره عن معرفة ودراية بكفاءة المرشحين. كان يقول إننا في المشرق نعاني تزوير صناديق الاقتراع ليلاً، وهم في الغرب يمارسون تزوير عقول الناخبين ليلاً ونهارا.
لكن بعد هذه السنين الطوال، وبعد تتابع الكتابات والدراسات الناقدة للنظام الديمقراطي المؤكدة لما يقوله شريعتي، جاء د. الأحمري ليقول لنا: “انتصرت الديمقراطية العملية التي تجعل شعباً متعلماً جدلياً يعرف من هو الأكفأ والعملي”.
في ظني أن أبا عمروٍ لو تخلَّص من ضغط الواقع القائم، و سلط عقله على ما يراه أمامه، فسوف يدرك مباشرةً أن آخر شيءٍ يستطيع الناخب الأمريكي العادي قياسه هو الكفاءة السياسية التي لو وُجِدت في المرشَّح، فلن يعرف عنها الناخب العادي شيئاً، حتى يدخل مرشحه البيت الأبيض، ويبدأ في العبث بالعالم.
وقد انتخب الأمريكيون “جورج بوش” الابن مرتين، رغمَ حمقه ورعونته، بتأثيرٍ من حملةٍ انتخابيةٍ كانت الأضخم في تاريخ الانتخابات الأمريكية.
فالأمور في أحسن النظم الديمقراطية لا تجري بتلك الطريقةِ المثالية التي يحاول د. الأحمري تصويرها. ولعل مظهر الرئيس، وفصاحة لسانه، وأناقة زوجته وهي تقف بجانبه على المنصةِ أكثر تأثيراً في النتائج من كفاءته السياسية التي لا يُعرَف عنها الكثير بالنسبة للأغلبية الساحقة من الناخبين.
وكما يقولُ تشومسكي فإن الناخب الأمريكي يُنصَبُ له شيطانان ثم يُطلب منه أن يعطي أحدهما صوته. وإنما كان المرشحان شيطانين، لأن النظام الديمقراطي في صورته المثالية يجعل أوفر الناس حظاً للوصولِ لهرم السلطة أتقنهم لفنون الكذب و النفاق السياسي والقدرة على التلاعب بعواطف الجماهير عبر الخطب الانتخابية العامة، علاوةً على المهارة في كسب أصحاب رؤوس الأموال، وعقد الصفقات والتسويات مع جماعات الضغط المتنفذة.
لذا فإن مما اشتهر هناك أن طبقة الساسة في النظم الديمقراطية طبقةٌ نفعيةٌ قذرةٌ، تأتي المثاليات والقيم في آخر اهتماماتها. وأي قضيةٍ مهما كانت عادلةً، فإن المرشح لا يمكن أن يورط نفسه فيها إذا كانت تؤثر على مسيرته نحو الأعلى.
وبإمكان د. الأحمري أن يستمع اليوم لتباكي الرئيس الأسبق جيمي كارتر على مآسي الفلسطينين، وتصريحاته الناقدة للعنصرية اليهودية. فمثل هذه البكائيات ما كان كارتر ليجرؤ عليها وقتَ تربعه على عرش الرئاسة. ولو أتيح له اليوم العودة للكرسي، فسوف يلعن الإرهابيين الفلسطينيين، ويبكي على ضحاياهم من الإسرائيليين أصدقاء أمريكا.
هكذا هي أصول اللعبة الديمقراطية. فالقضية العادلة هي التي تجلب المزيد من الأصوات وحسب. فهل يمكنُ أن يكون هذا هو “المثال الأعلى للحكم”، كما يقول د. الأحمري.
د. الأحمري –رعاه الله- يقول في مقالته الأخيرة: “لقد تمكن المنهارون عقلياً أن يطمسوا أعينهم عن رؤية أهم سبب لتحكم ثلاثة ملايين يهودي في ثلاثمائة مليون عربي!”.
فأبوعمروٍ –أقال الله عثرته- يرى أن غياب الديمقراطية هو السبب في تحكم ثلاثة ملايين يهودي في ثلاثمائة مليون عربي، وأن من لا يؤمن بهذا، فهو منهارٌ عقلياً!
فليتَ أبا عمروٍ –بما أنه غير منهار عقلياً-، ليته يفسر لنا سبب تحكم خمسة ملايين يهودي في ثلاثمائة مليون أمريكي، بحيث لا يمكنُ أن يحكم الأمريكيين إلا رئيسٌ يبدأ حملته الانتخابية بتقديم فروض الولاء والإخلاص لدولة إسرائيل.
أوليس النظام الديمقراطي -الذي يُفترض فيه أنه “حكم الأغلبية”- هو السبب في ذلك، حين جعل كرسي الرئاسة مرهوناً بالمال والإعلام والخبث اليهودي القادر على ابتزاز مرشحي الرئاسة، وإخضاعهم لمصالح دولتهم؟!
النظام الديمقراطي في الظاهر حكم الأغلبية، لكنه في الحقيقة حكم أقلية قذرة. والدكتور محمد يعرف هذا، ولكن سوء الواقع الذي ينتقده ويضيقُ منه، هو الذي يجعله يغض الطرف عن الحقيقة التي لم تعد خافيةً على من هو أقل منه معرفةً ودرايةً.
في الانتخابات الأخيرة، وحين احتدم الصراعُ بين “أوباما”، و”هيلاري كلينتون”، على تمثيل الحزب الديمقراطي، لم يكن الحديث عن كفاءة الاثنين بقدر الحديث عن “سواد” الأول، و”أنوثة” الثانية.
فالنقطة الرئيسة و المركزية في مسيرة “أوباما” كونه أسود، مما يعني تأييد الملونين والتشكُّك في موقف البيض. بينما النقطة الرئيسة و المركزية في مسيرة “هيلاري” كونها أنثى، مما يعني تأييد الجماعات والأصوات النسوية (وهو ما حاول “جون ماكين” لاحقاً الاستفادة منه حين رشح أنثى لتكون نائبةً له).
و وسط سواد هذا وأنوثة تلك، ضاع التدقيقُ في كفاءة أيٍّ منهما.
كانت “هيلاري” تجتهد في إلصاق كلِّ عيبٍ في “أوباما”، وكانت تتحدث عن عدم كفاءته وضعف خبرته السياسية. هي لا تقولُ هذا شفقةً على مصلحة بلادها. ولكن لأن مصلحتها هي تقتضي تشويه صورة غريمها. لذا فبمجرد أن انتصر عليها “أوباما”، وفاز بترشيح الحزب الذي ينتميان إليه، انقلب حديثها عن عدم كفاءته، إلى حديثٍ عن مزاياه، فصرَّحت أنها تقف إلى جانبه، وتؤيده، وتدعو الناخبين لاختياره!
فمصلحتها الشخصية هي التي حركتها للطعن فيه.
ومصلحتها الحزبية هي التي حركتها لتأييده.
فهل هذا هو “المثال الأعلى للحكم”؟!!
النهج “الميكيافيلي” هو الطريق الوحيد الموصل لكرسي الرئاسة في النظم الديمقراطية. فكل ما يستطيع المرشح فعله لإسقاط خصمه لن يتردَّد في الإقدام عليه، وكل ما يمكن أن يجلب له المزيد من الأصوات –أي أصواتٍ- فسوف يبادر إليه، بما ذلك أصوات الأراذل والمنحطين. لذا فليس من الغريب أن تشارك “هيلاري كلينتون” في مسيرة للشواذ، أو أن يسارع زوجها لتقديم العزاء لأقدم زوجين شاذين في أمريكا في وفاة أحدهما. وليس من العجيب أن ترشح ممثلة الأفلام الإباحية “ماري كاري” نفسها لمنصب حاكم كاليفورنيا، لتنافس الممثل الآخر “أرنولد شوارزينيغر”، ثم تجعل ضمن برنامجها توزيع فيلم إباحي مقابل كل فيلم عنفٍ!
ومما رُصد وأُبرزَ إعلامياً في حملة “أوباما” أثناء حفل تدشين حملته بولاية “أيوا” دعم ومشاركة ممثلة هوليود ذات الثلاثة وعشرين عاماً (سكارليت جوهانسون)، والتي وُصفت بأنها “النجمة الأكثر إثارةً”. وقد أجرت مقابلةً معها وكالة أسوشيتدبرس، كي تعبِّرَ عن تأييدها ودعمها لأوباما، لكن لأنها “نجمة إثارة”، وليست “نجمة سياسة”، فقد كانت تتحدث عن كفاءة أوباما بطريقةٍ مختلفة. كانت تقول في تصريحاتها للوكالة: “استمعوا لأوباما كيف يتحدث، وكيف يبتسم، وكيف يصافح الناس. أليس جذاباً بما فيه الكفاية”!!
هكذا قاست نجمة الإثارة كفاءة أوباما.
و مقياسها هذا سيجلب أصوات شريحةٍ من الناخبين يفهمون في “الأفلام” و”الإثارة” أكثر مما يفهمون في الكفاءة السياسية. فيا لحظ “جون ماكين” العاثر، فشيبته و سنواته السبعين لن تؤهله للفوز بتأييد تلك الشقراء ومحبيها. ولعل الفرنسي “ساركوزي” كان يطلبُ المزيد من الأصوات حين أنفق على مكياجه أثناء الحملة الانتخابية (34000) يورو. في حين أنفقت منافسته سيغولين رويال (52000) دولار. فكلاهما كان يعلم أن المظهر و الوسامة قد يحققان في أوساط الناخبين ما تعجز عن تحقيقه الكفاءة السياسية.
انتهى الحديث عن تأييد نجمة الإثارة لأوباما، ثم جاء الحديث عن تأييد الراقصة “شاكيرا”. ومع أنها لا تحمل الجنسية الأمريكية، ولا تملك حق التصويت، لكن خصرها وهو يهتز سيكونُ له أثرٌ إعلاميٌّ قد يجلب أصواتاً يحتاجها الزعيم الكفء!
فهل هذا هو “المثال الأعلى للحكم”؟!!
لست أريد هنا أن أقول: هذه هي الديمقراطية.
ولكني أقول: هذه إحدى أهم الزوايا التي يجب النظر إليها عند الحديث عن الديمقراطية. وما ذكرته ليس حديثاً عن مظاهر جانبية على هامش النظام الديمقراطي، بل هو حديث عن نتيجة حتمية للمبدأ الذي أقيم عليه النظام الديمقراطي. لكن الوقتَ لم يحن بعد ليدرك الكثيرون ذلك.
لست هنا أجادل في وجود جوانب مشرقة في النظام الديمقراطي تتعلق بها و تتشوف إليها نفوسُ و قلوب المسحوقين و المكمَّمة أفواههم، و ما كان لأحدٍ أن يعترض لو أن الدكتور الأحمريَّ امتدح جوانب معينةٍ في النظم الديمقراطية. لكن ما لا يمكن قبوله تلك المغالاة التي برزت في حديث أبي عمروٍ حين أعلن بلغة قاطعةٍ أن النظام الديمقراطي هو “المثال الأعلى للحكم”، وأنه نظامُ يسكن “محبته ورهبته في كل قلبٍ”، وأن من يتجرأ فيينتقد أو يتحفظ على شيءٍ من جوانب الفكرة الديمقراطية، فهو من “السخفاء الضعفاء الجهلة الملبَّس عليهم”. الذي يعيشون في “أوحالٍ من الوثنية”، و “يستعيضون عن العزة والحرية والمسؤولية برغد العبودية”.
هذه اللغة التي تحدث بها الدكتور الأحمري تطابق تماماً لغة إبراهيم البليهي ومحمد المحمود وأمثالهم ممن يرتفع عنهم القلمُ أو يكادُ حين يضعون جباه أقلامهم وألسنتهم، ويعفرونها بالتراب، خضوعاً وخنوعاً لليبرالية الغربية. ومع أني أعلم أن الدكتور الأحمريَّ من أشد الناس نقداً لهؤلاء، لكنه الآن يغذُّ السير في الطريق الذي سبقوه إليه. فهم يسبحون بحمد الليبرالية، والدكتور يذبح ويطوف بالديمقراطية، و يعادي ويوالي عليها. وها هو الآن قد أعلن الجهاد المقدس ضد الوثنيين الكافرين بها، أو المعترضين على بعض جوانبها.
وحسب كلام الدكتور فإن آلة النقد والفحص يجب تعطيلها أمام جلالة الديمقراطية. وفي رأيي أن الذي يقدس الأفكار البشرية بهذه الصورة المغالية، هو –في الحقيقة- من وقع في أسر الوثنية الصريحة. فالدكتور محمد لم يزد أن نصب لنا وثناً آخرَ، لا يجوز المساس به من قريبٍ ولا من بعيدٍ. ثم جعل نفسه سادناً لهذا الوثن العصري، شتاماً لمن يشك في قدسيته.
كتبه/ بندر بن عبدالله الشويقي
18/11/1429هـ