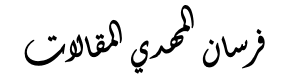من الشويقي إلى الأحمري: هذا الطريق سبقك إليه الكواكبي الذي انتهى بالدعوة للعلمانية الصَّريحة
من الشويقي إلى الأحمري: هذا الطريق سبقك إليه الكواكبي الذي انتهى بالدعوة للعلمانية الصَّريحة
بندر الشويقي
حين اتصل بي وقَّادُ المواجهات الصحفيَّة الصَّديق المحبُّ عبد العزيز قاسم، طالباً التعليقَ على لقائه مع أخينا الأكبر د.محمد الأحمري بجريدة عكاظ، ( وهو يزعم لي أن المداخلات إثراء للحوار وحراك للساحة الشرعية) توقعتُ سلفاً أني سأقرأ هجوماً عشوائياً، وعباراتٍ منفعلةً، تفتقر للموضوعية والاتزان، فضلاً عن العدلِ والإنصافِ في التعامل مع المخالفين..فهذا ما اعتدناه من أخينا أبي عمروٍ –عافاه الله-
وقد حصل ما توقَّعته…فأبو عمروٍ لم يخيب ظنوني كما هي عادته.
وقد رأيته يهاجمُ الذين يرفضون “الديمقراطية”، لأنهم ـ في رأيه ـ يخالفون الأنموذج النبويَّ وعمل الصحابة في الثقة بالمجتمعات المسلمة. قرأتُ هذا، فتساءلتُ كيفَ يثق أبو عمروٍ بتلك المجتمعاتِ التي يصرُّ على وصمها بالوثنية؟!
غير أن من الجميلِ ما أعلنه الآن من أن الديمقراطية، فيها “مصائب لا يشكُّ فيها عاقلٌ طرفةَ عينٍ”. فالوصولُ إلى مثل هذا المستوى من التقرير الواضح مكسبٌ لا بأس به. وإذا جمعنا هذا مع ما سبقَ أن أشارَ إليه أبو عمروٍ في مقالته الأصل، من أن (الديمقراطية) وثنيةُ جماهير، لكنَّها أهون من وثنية “الفرد” المستبد. إذا جمعنا هذا مع ذاك، فقد اتفقنا الآن على أن الديمقراطية: وثنيةٌ تشتملُ على مصائب لا يشكُّ فيها عاقلٌ طرفة عينٍ.
وأنا على يقينٍ أن دين الإسلام لا يقرُّ الوثنياتِ أياً كانَ نوعها، وأن الأنموذج النبويَّ يترفَّعُ عن أيِّ لونٍ من ألوانها. أما أبو عمروٍ فمن رأيه أن الأمةَ مخيرةٌ بين وثنيتين، إحداهما تناقض الإسلام و الأنموذج النبويَّ، و الوثنيةُ الأخرى توافقهما تمامَ الموافقة! والتوافق بين تلك الوثنية وبين دين الإسلامِ واضحٌ لدرجةِ ألا يشك فيه إلا “السُّخفاء والضُّعفاء والجهلاء والأميين من أصحاب الشهادات”!
قرأتُ لقاء أبي عمروٍ بجريدةِ عكاظ، ثم اندفعتُ لكتابةِ تعليقٍ مطوَّلٍ أخذ من وقتي الكثير…غير أني حين أعدتُ قراءته، وجدت قلمي قد انساق وراء لغة أبي عمروٍ الهائجة، فمحوتُ أكثر ما سودته، لما تذكرتُ أني أتحدثُ عن فاضلٍ صادقٍ غيورٍ، لكن مهارته في كسبِ عداواتِ إخوانهِ، لا يوازيها إلا قدرته الفائقة على الإساءة لقضيته.
* المثقفون وصراحة الحق:
وقد رأيتُ الأستاذ عبدالعزيز قاسم يسأله عن حدةِ كلماتهِ وعباراته القاسية. فأجابَ أبو عمروٍ بأن العيبَ ليس فيه هو، بل في أولئك المثقفين الذين لا يحتملون صراحةَ الحق!
فمن الواضحِ أن أبا عمروٍ لم يشعر إلى الآن بخطئه الأدبيِّ، فهو يرى أن المشكلة ليست فيه، بل في أولئك المثقفين الذين لا يتمتعون بالأريحيةِ، و لا تتسع صدورهم لقبول عبارات من جنس: “سخفاء، وجهلاء، وضعفاء، وأميون من حملة الشهادات…إلخ”.
فاللهم اغفر لأبي عمروٍ، واجعل قذائفه العشوائيةَ حوالينا ولا علينا.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
أينَ المشكلة في هذه الجملة:
(الديمقراطية فيها جوانب رئيسة تناقض نظام الحكم في شريعةِ الإسلام. لكن حيث يعيش المسلمون في ظلها، فلا حرج عليهم في المشاركة فيها، دفاعاً عن حقوقهم).
كلامٌ واضحٌ يدركُ معناه الصِّغار قبل الكبار، باستثناء حبيبنا الثائر بلا بوصلةٍ د.محمد الأحمري الذي خلطَ بينَ البحثِ في تقييمِ النَّظامِ ومدى موافقته للشرع، و بين الحديثِ عن الحاجة للمشاركة فيه بصفته واقعاً قائماً لا مناصَ منه.
وغموضُ هذه النقطة بالنسبة لأبي عمروٍ لم يكن بسبب قصورٍ في الفهم و الإدراك. بل بسبب تلك الآذان المقفلة التي تأبى السَّماعَ، حتى كادت تتحول إلى لسانٍ آخر، يساند اللسان الأصليَّ في هجاء “السلفية” الرجيمة، وتحقير الوثني الضَّال “أستاذ العقيدة”.
المسلم قد يعيش تحت مظلة دولةٍ مسلمة. و قد يعيش –أيضاً- في ظل دولةٍ كافرةٍ، وقد يحكمه نظامٌ ديمقراطيٌّ ليبراليٌّ، أو نظام عسكريٌّ متسلطٌّ، أو نظام ملكيٌّ وراثيٌّ فاسدٌ، أو غير ذلك من صور الحكم…. فكيفَ يتعامل مع هذه الأنظمة؟ هل يهجرها ويعتزلها؟
أو يشارك فيها، ويتعامل معها بما يحقق مصالحَ المسلمين ويخفف المفاسد والشرور؟
مسألةٌ مشهورةٌ معروفةٌ يكثر السؤال عنها. وقد كان الشيخان ابنُ بازٍ وابنُ عثيمين –رحمهما الله- يفتيان بالمشاركة إذا رجيت في ذلك مصلحةٌ راجحةٌ. لكنْ هذا شيءٌ والحديث عن موافقة تلك الأنظمة لشريعة الإسلام شيءٌ آخر. غيرَ أن حبيبنا أبا عمروٍ حين تركَ التروِّي وراء ظهره، و اختار الهجومَ الكاسحَ الأحمر، خلط بين المسألتين خلطاً عجيباً، فوجَّه فوهةَ مدفعه نحو المتلاعبين المتناقضين من “متسلفةِ زمانه” الذين ينتقدون الفكرةَ الديمقراطية، ثم هم يحثُّونَ على المشاركة في انتخاب حزب الإصلاح في اليمن، أو جبهة الإنقاذ في الجزائر.
* ابن باز والمشاركة الديمقراطية:
وأطرفُ ما رأيته في كلامه قوله: إن نُقادَ مقالته عن الديمقراطية، (قد تنكَّروا للشيخ ابنِ باز حين أصدر تأييده للمشاركة في مجلس الأمة الكويتي)!!
ففي رأي صاحبنا أبي عمروٍ أن الشيخَ ابن بازٍ حين أيد المشاركة في مجلس الأمة الكويتي، كان ينطلقُ في موقفه ذاك من إيمانٍ عميقٍ بالديمقراطية! فهو إذن موافقٌ لأبي عمروٍ، وبالتالي فإن من ينتقد أبا عمروٍ، يكونُ قد تنكَّر للشيخِ ابنِ بازٍ ـ رحمه الله ـ!
ولم ينسَ أبو عمروٍ بعد هذا الاستنباطِ البارعِ، أن يدبِّجَ المديح للشيخِ بصفته “أبرز رجال السَّلفية منذ قرونٍ و أوعاهم بالمقاصد العملية أو “البراجماتية” للشريعة”.
ورغمَ ضيقي من لغة الحبيبِ أبي عمروٍ المستفزةِ، إلا أنَّ هذه الفقرةَ من كلامه انتزعت مني ابتسامةً ودعواتٍ للشيخِ ابن بازٍ ـ رحمه الله ـ. فجلالةُ ذاك الإمامِ في النفوسِ لازالت مركباً مفضلاً لمن يريدُ إسنادَ آرائه.
وقد قرأتُ للكثيرين وهم يحاولون إلصاق آرائهم الخاصة بالشيخِ في مسائل فرعيةٍ يمكن أن يخفى فيها رأيُ الشيخ. لكني لم أتوقَّعْ قطُّ أن أسمعَ أو أقرأ لأحدٍ يزعم أن الشيخ كان مؤمناً بالديمقراطية! و أنا على يقينٍ من أنَّ أبا عمروٍ لو عرفَ الشيخ حقَّ المعرفةِ، ثم استخدم معه موازينه الجائرة، لجعله إمام الوثنيين في هذا الزمان، ولأعادَ النظر في تقييمه لوعي الشيخ بالمقاصد الشرعية!
وأسوأ من الالتصاق بابنِ بازٍ، الالتصاق بالصحابي الجليل عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ، ونسبته للإيمان بالديمقراطية. فأخونا الأكبرُ أبو عمروٍ لما سُئل عن وصفه ما سوى الديمقراطية بالوثنية، أجاب بأنه أخذ ذلك من وصف ابنِ عمر للنظام المتوارث بالكسروية والقيصرية. وذكر أنه إن كان أخطأ في هذا، فخطؤه من خطأ ابنِ عمر، فعلى معارضيه أن يوجِّهوا نقدهم لابن عمر.
ففي رأي صديقنا أبي عمروٍ أن ذمَّ ابنِ عمر للحكم المتوارث، يعني أن ما سوى الديمقراطية وثنية!! مع أن من المؤكد أن الديمقراطية ورأي الأغلبية لم يخطرا ببالِ ابنِ عمرَ ـ رضي الله عنه ـ وهو يذمُّ النظام الوراثي.
فإن كانَ صاحبنا أبو عمروٍ سينازعُ في هذا، ويصرُّ على أن ابنَ عمرَ كان يشير للديمقراطية حين ذمَّ النظام الوراثي، فأحبُّ أن أذكِّرَ بأنَّ ابنَ عمرَ مع ذمِّهِ للنظام الوراثي، إلا أنه كان خاضعاً له، مقراً بشرعيته حين أصبح أمراً واقعاً. لكن مع خضوعه، كان ناقداً معارضاً لمظاهر الفساد بلسان الناصح المشفق، وليس الثائر دون منهجٍ.
فابنُ عمرَ بخضوعه هذا، سيكون بموجب موازين أبي عمروٍ وثنياً أصيلاً، ذلك أنه كان أحد أشهر المقرِّينَ ببيعةِ يزيدَ بنِ معاوية، و كلامه مشهورٌ في نهى الناس عن التمرُّدِ عليه. و لما قامَ أهل المدينة لخلعه، جمعَ ابنُ عمرَ بنيه وخَدَمه وقال: “أما بعدُ، فإنا بايعنا هذا الرجلَ على بيعِ الله ورسوله…وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه، ولا تابع في هذا الأمر، إلا كانت الفيصل بيني وبينه”.
فليضف أبو عمروٍ عنده وثنياً آخرَ من خيارِ صحابة النبي –صلى الله عليه وسلم-!
وإن أراد المزيد من الوثنيين من الصحابةِ الكرامِ، فهناك المزيد…
لكنْ صديقنا أبو عمروٍ لا يشعر…
وقد رأيته ـ أصلح الله باله ـ بعدما أفرغ شحناته واحتقاناته في وجه إخوانه رأيته يقول: “الذي أتمنّاه مرةً أخرى أن يطالبوا أنفسهم بعدم التهجُّم على ما لا يحسنون. كما أطالب نفسي أولاً”.
وكم أتمنى لو أن أبا عمروٍ ـ بالفعل ـ يلتزم هذا النهج..لكنَّه لا يفعل. فأستاذُ العقيدةِ المسكين يشكو تسفيهات أبي عمروٍ له في فنِّه وتخصُّصِه. وأساتذة الفقه يتساءلون عن الفنِّ الذي أتقنه أبو عمروٍ حين طالبهم بالتخلي “عن ثقافةٍ ليست شرعيةً إسلاميةً ولا واقعيةً, بل مجرَّد تراث تاريخي يتوقَّعونه إسلاماً، وليس كذلك”.
* الإسلام والتكافؤ الإنساني:
والجميعُ يتساءلون عن الفنِّ الذي أحسن أصوله أبو عمروٍ حين أعلنَ أن “التكافؤَ الإنسانيَّ مطلبٌ بشريٌّ نادى به الإسلام”. فهذا مبدأ ليبراليٌّ صِرفٌ يعلمُ أهل الفقهِ ألا وجودَ له في شريعةِ الإسلام التي تمتلئ أحكامها بالتمييز بين المسلمِ وغيره في الحقوقِ والواجبات، مما يسمَّى في لغة الديمقراطية الليبرالية “تمييزاً عنصرياً” منافياً للتكافؤ الإنساني.
فلا أظنُّ أن من التكافؤ الإنساني جعلُ دية المسلم ضعف دية الكافر.
ولا أحسب أن من التكافؤ الإنسانيِّ أن تباح الكتابيةُ للمسلم، في حينِ يعتبر زواج الكتابي بالمسلمة جريمةً يعاقَب عليها بالقتل، حتى لو وقعت برضا الزوجين و موافقة أهليهما. وليس من التكافؤ الإنساني أن يقتصَّ من الكافر إن قتلَ مسلماً عمداً، في حين تكونُ عقوبةُ المسلمِ أقلَّ إن قتل الكافر عمداً.
ولا أظنُّ أن من التكافؤ الإنسانيِّ قبولُ شهادةِ المسلم على الكافرِ في القضاء، في حين لا تقبل شهادة الكافر على المسلم.
وعلى مستوى الأسرةِ، لا يتفق التكافؤ الإنساني مع الحكمِ بكون الأب المسلمِ أحقَّ بحضانةِ الأولاد من أمِّهم النصرانية، لمجرد كونه مسلماً.
هذه الأحكامُ لها نظائرُ كثيرةٌ جداً في شريعة الإسلام يطول تتبعها. وهي مبنيةٌ على مفاهيم إلهيةٍ ساميةٍ يقصر عنها ذاك النظام المبني على التكافؤ الإنساني، والذي يوصف الآن بأنه “المثال الأعلى للحكم”.
وأنا حين أتحدَّثُ عن شرورِ الديمقراطية الغربيةِ، فليس لأنها الآن تطرقُ أبوابنا وتكاد تنشرُ علينا رحمتها المتوهَّمة. بل لأني رأيتُ بعينيَّ كيف عملتْ عملها في تسميمِ عقولِ الكثير من أهل الإسلام، فحملتهم على التنكر لأحكام دينهم، ومعاداة شرعة ربهم، حتى انحط بعضهم لمرتبة الازدراء بشريعةِ الإسلام.
تخاطب بعضهم، فيقول أولَ الأمرِ إنه يقصد ديمقراطيةً مقيدةً بالشرعِ كما يقولُ حبيبنا أبو عمروٍ الآن. وعند المحاققة و التدقيق لا تجد إلا شرعاً مقيداً بالديمقراطية الليبرالية. ليس لأن القائل كاذبٌ في دعوته لديمقراطية إسلامية، بل لأنه لا يدرك مدى واقعية ما يدعو إليه.
فمثلاً نحن رأينا أبا عمروٍ لما سئلَ عن نوعِ الديمقراطية التي يدعو إليها، أجاب بأن “بأنَّ كلَّ انتخاباتٍ في بلادٍ إسلاميةٍ أو غيرها فغايتها حكمُ الشعبِ بما يدينُ به الشعب”. و سوف أتجاوز عن هذا الإطلاق –مع مافيه-. لكني أريد أن أكملَ الصورةَ وأقول لأبي عمروٍ: إن الأغلبية التي ستختار الشريعة حكماً، سوف يقابلها أقلية ترفضها…فهل يعرفُ أبو عمروٍ حكمَ من يرفض الحكم بالشريعةِ في دين الإسلام؟!!
الذي يرفض حكمَ الشريعة ويطالبُ صراحةً بتنحيتها يكون مرتكباً لخيانةٍ عظمى وجريمةٍ كبرى، وقد انطبقَ عليه وصف الردةِ عن دين الإسلام. وبالتالي فإن حكمه السيف بعد الاستتابة.
فهل يمكن أن يوجَد نظامٌ ديمقراطيٌّ يفتح بجوار البرلمان ساحة عدلٍ لتصفية المعارضة بعد التصويت؟!
الذين ينادون بديمقراطية مقيدة بالشرع، لا يستحضرون أن الشرع الذي يتحدثون عنه ليس أحكاماً معدودةً على الأصابعِ كما هو حال الديانة النصرانية أو اليهودية. بل هو قانونُ حياةٍ كاملٍ ينتظم شؤون الناسِ في ممارساتهم اليومية الخاصة والعامة.
فالغربيون اتخذوا من الديمقراطية وعاءً لليبراليتهم، وإن شئتَ فقل العكس. ولو أرادَ المسلمون أن يصبُّوا إسلامهم في ذلك الوعاء، فسوف يتحطم الوعاء لا محالةَ، إلا إن اختار المسلمون تحريف دينهم وتبديلَ أحكامه.
شريعة الإسلامِ تحوي قوانين و أحكاماً كثيرةً جداً تتعلق بالدماء، والأموال، والمعاملات، والنكاح، و الطلاق، والنفقة، والحضانة، والحدود، والقصاص، واللباس، والأطعمة، والأشربة، والقضاء، والشهادات، وأحكام الحرب والسلم (الجهاد)، والولايات، وصفة الحاكم الشرعي، ومتى يكونُ شرعياً، ومتى تزول شرعيته، وحقوقه على رعيته، وحقوق الرعية عليه، وأحكام الأموال العامة (بيت مال المسلمين) جبايةً وإنفاقاً، و الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وحقوق الأقليات (أهل الذمة)، وأحكام أهل البدع، وحدود حرية التعبير، وقيود ممارسة الشعائر، والعلاقات الدولية، وما يسوغ مما لا يسوغ من المعارضة السياسية …. إلخ.
وتحت هذه العناوين الكبرى أحكامٌ كثيرةٌ يعسر حصرها، كلها تدخل تحت مسمى (مرجعية الشريعة)، وفيها أحكامٌ واضحةٌ ينطبقُ عليها حسبَ المفاهيم الديمقراطية الليبرالية وصفُ (الاستبداد)، و(انتهاك الحريات)، و(التمييز العنصري). وسيرة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والخلفاء الراشدين من بعده مشتملة على الكثير من ذلك، مما هو عدلٌ في دين الله، وظلمٌ وجورٌ عند مقدِّسي قيم الحرية الغربية.
وهذه الأحكام إن سُلطت على الديمقراطية قتلتها، وإن سلطت عليها الديمقراطية فتكت بها.
لأجلِ هذا غالباً ما يقترنُ تعظيم الديمقراطية، بمناطحةِ الأحكام الشرعية التي تصادم النسخةَ الديمقراطية الوحيدة الجذابة، أعني النسخة الليبرالية. فكثيراً ما تسمعُ من معظمي الديمقراطية التشككَ والتشكيكَ في مثل حكم المرتد، وأحكام أهل الذمة، ونحو ذلك من الأحكام التي انطلقت من معارضتها شرارةُ نقضِ الشريعة في شتى أقطار المسلمين.
أقولُ هذا، وأنا أعلمُ أن طائفةً من تلك الأحكامِ قد تمَّ رفعُها بالفعلِ من بلادنا، كما رُفِعت من غيرها. غير أن حديثي عن مفاهيم سماويةٍ لا يجوز العبثُ بها، سواءٌ جحدتها الأنظمة أو عملت بها. فرَفعُ أحكام الشريعة من قوانين الدولِ يهونُ ويتصاغر عندما يقارنُ بنقض الشريعة في قلوب أهلها، حين يتنكرون لأحكامها، ويرون فيها تشريعاتٍ مخالفةً “للمثال الأعلى للحكم”.
* دعوة أخوية للتأمل:
وكلُّ الذي أرجوه من أخي أبي عمروٍ بعد هذه المجاذبات الطويلة أن يتنبه للطريق الذي وضع قدميه الآن على أوله، فهو طريقٌ سبقه إليه أمثال عبدالرحمن الكواكبي، الذي ابتدأ بمعارضةٍ عشوائيةٍ للاستبدادٍ، ثم انتهى به الأمرُ إلى الدعوة للعلمانية الصَّريحة، وإعلان أن الإسلام دين لا علاقةَ له بنظامِ الدولة. قال ذلك لما رأى أحكام الشرعِ الواضحةَ تفسدُ عليه مسيرته نحو مكافحة “الاستبداد”.
وأصلُ بلاءِ الكواكبي أنَّ سُلَّمَ الأولويات لديه اختلَّ واضطربَ، لما تشبَّعت نفسه بتقديس قيم (الحرية) الغربية، فصارت تلك القيمُ عنده أَولى الأولويات، وأهم الفرائض، ورأس المقاصد، فأراق على عتبتها دمَ الشريعةِ، فأفسد دينه، ولم يصلح دنياه. فتحولَ من داعية إصلاحٍ، إلى مسوِّقٍ للانسلاخِ من حكم الشرعِ. وهكذا كان حالُ نظرائه ممن ساروا على الطريقِ نفسه، فكان لهم أسوأ الأثر في الأجيال التي جاءت بعدهم.
وأذكرُ هنا ما شهد به الدكتور محمد كامل ضاهر (ليس سلفياً، ولا حتى إسلامياً)، حين تحدَّثَ عن مدرسة الإصلاح المصرية القديمة فقال: “ربما كان الدور الرئيسي الذي مثلته حركة الإصلاح الإسلامي هو التبشير بالمرحلة العلمانية، رغم محاولتها الوقوف سداً منيعاً أمامها، إلا أنها كانت -من حيث لا تدري- زاداً تغذَّت منه أفكار تلك المرحلة بمفاهيمها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية”.
وهذا توصيفٌ دقيقٌ للغاية، وقصة (مدرسة الإصلاح المصرية) التي مهَّدت الطريق للعلمانية هناك، تُعرَضُ الآن على المسرح السعودي، وأتمنى من كلِّ قلبي ألا يكونَ حبيبنا أبو عمروٍ أحد أبطالها.
سيأتي بعضُ هواةِ التحريشِ ليقولوا: إني وصمتُ أبا عمروٍ بالعلمانية. فليربعْ هؤلاء على أنفسهم. فما أقوله إني أحبُّ له الخير، وأراه وضع قدميه على أول طريقٍ لا خيرَ فيه، و غايةُ مطلبي وأمنيتي أن يكرم قدميه الطاهرتين عن الإمعان في ذلك الدرب.
أقولُ هذا، بعدما رأيتُ أمارات ذلك في كتاباته، فمن أهمِّ سماتِ تلك المدرسةِ: الجرأةُ على نسفٍ الأحكامِ الشرعية باعتبارها مجرد تراث تاريخي، و المغالاة الظاهرة في مدح القيم الغربية، مع الشراسة الواضحة في مهاجمة أهلِ العلمِ وطلابه بالجملةِ، والتعريض بكونهم أوعيةَ حفظٍ بلا فهمٍ.
وكل هذه المعاني موجودةٌ الآن في طروحاتِ أبي عمروٍ.
ونهاية هذا الطريق واضحةٌ، و لوضوحها فإني أكره أن يتورَّط فيها من أحبُّ.
تبدأ المسألة بنقد وتسفيهِ قولٍ يتبناه معاصرون، مثل من يسميهم أبو عمروٍ “متسلفة زماننا”.
فإذا اكتشف الناقد أن القولَ معروف ومجمع عليه لدى أهلِ العلمِ، وليس من اختراع “المتسلفة”، انتقل للحديث عن كون القول تراثاً وتاريخاً، وليس من الدين.
ثم إذا علمَ المعترضُ أن ثمة نصوصاً شرعيةً في المسألة، انتقل للوقوعِ في حفرة تاريخية النص، فتعلق بكونِ تلك النصوص والأحكام إنما جاءت في بيئات وظروف تختلف عن زماننا.
وهكذا تجد الخائضَ في هذا، ينتهي إلى حالٍ لا يوقفه فيها إجماعٌ ولا نصُّ كتابٍ و لا سنةٍ. والذين ولجوا هذا البابَ مع حسنِ مقاصدهم، إلا أنهم أفسدوا مفاهيمَ الشريعةِ وسمَّمُوا عقولَ المسلمين، ولم يحركوا شعرةً في جسد الأنظمة الجائرة.
وقد سمعتُ من بعضِ الشبابِ المتديِّنين السائرين في هذا الطريقِ، ما يوجب الاستتابةَ شرعاً! فإن حاججتَ أحدهم رأيته يردِّد كالببغاء: (أنتم تحفظون ولا تفهمون). فإذا كشفتَ عن حاله رأيته أضاع الحفظ، ولم يصب الفهمَ. وغايتهُ أن يسرد عليك كلاماً متعالياً تلقَّاه عمن سبقه في هذا الطريقِ، غير أنه يريد إفهامك أنه توصل إليه بعد نظرٍ و تفتيش ودراسةٍ معمَّقةٍ لنصوص الشريعة.
الحرية وسلم الأولويات
فليتَ أبا عمروٍ يستفيدُ من تجاربِ غيره، ويعيد قراءة ما يكتبه الآن، وليتفكر في سلم الأولويات عنده. ولينظر في أي درجةٍ تقع أحكام الشريعة و قضايا التوحيد و أصول السنة في ذلك السلم مقارنةً بالدرجة التي تحتلها “الحرية”.
الذي أراه أمامي في مقالاتِ أبي عمروٍ أن “الحرية” باتت عنده هي الشريعة، وهي التوحيد، وهي السنة، وهي الإسلام، وهي الإيمان، فلا شيءَ عنده يستحق المفاصلة سواها. لأجل هذا ليس من الغريب أن يشنَّ حملاته ويوجه مدافعه ضد إخوانه من ناقدي الديمقراطية، في حين يدعو لاجتناب “التهييج العقدي” مع الشيعة الذين ينتهكون التوحيد و الشريعةَ ليلَ نهارٍ.
وأنا على يقينٍ أن ترتيب الأولويات لو صحَّ عند أبي عمروٍ، لما استحقَّت عنده الديمقراطيةُ وصف “المثال الأعلى للحكم”، ولأعاد النظرَ في قولهِ إن المجتمعَ الإنسانيَّ ما كان له أن يتطوَّرَ لولا الديمقراطية! فمن عظُمتْ في قلبه مفاهيم الإيمان، واستقامت عنده الأولويات، فلن يشك أن الإنسانية في ظل الديمقراطية، تطورت من جهةٍ، وبلغت الغاية في الانحطاط من جهةٍ أخرى.
والجانبُ الذي انحطت فيه، أهم بكثيرٍ من الجانب الذي طورته. وقد يسألُ سائلٌ عما إذا كانَ كاتبُ هذه الأحرف مع الحرية أو ضدها، فجوابي أني مع الشريعة. فما قيدته الشريعة أقيده، وما أطلقته أطلقه. وليس لديَّ قيمةٌ مقدسة عليا لا تمس اسمها “الحرية”. فمن الحريات ما يجب حفظه، ومن الحريات ما يجب انتهاكه. والذي يقولُ غير هذا، فما عرفَ شرعةَ الإسلامِ، ولا درى عن أحكامها شيئاً.