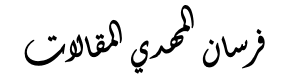من محاذير التفسير : سوء التأويل
من المقرر لدى أهل العلم: أن الأصل هو إبقاء النصوص على ظواهرها، دلالة على معانيها الأصلية، كما وضعت في اللغة.
ولكن تأويل النصوص، بصرفها عن معناها الحقيقي إلى معناها المجازي، أو الكنائي، لا يخالف فيه عالم له دراية بالقرآن والسنة.
وقد لا يسمي بعضهم ذلك مجازاً، ويطلق عليه اسماً آخر، كما يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية (توفي: 728ﻫ/1328م)، ومن سبقه من علماء اللغة، ثم من تبعه من تلاميذه.
ولكن تأويل النصوص، بصرفها عن معناها الحقيقي إلى معناها المجازي، أو الكنائي، لا يخالف فيه عالم له دراية بالقرآن والسنة.
وقد لا يسمي بعضهم ذلك مجازاً، ويطلق عليه اسماً آخر، كما يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية (توفي: 728ﻫ/1328م)، ومن سبقه من علماء اللغة، ثم من تبعه من تلاميذه.
ونحن لا تهمنا الأسماء والعناوين إذا صحّت المسمّيات والمضامين، فهم متفقون على صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر غير المتبادر منه.
* لا تأويل إلا بدليل:
المهم ألا يحدث إلا بدليل أو بقرينة توجب صرفه عن المعنى الأصلي، وإلا بطلت الثقة باللغة ومهمتها. فإذا وجدنا الدليل أو القرينة صرفنا اللفظ من الصريح إلى الكناية، ومن الحقيقة إلى المجاز.
في القرآن الكريم نجد ذلك التعبير بالكناية في مثل قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ (المائدة: 6)، فالغائط هو: المكان المطمئن من الأرض، كُني بالمجيء منه عن التغوط، وهو الحدث الأصغر.
وأما قوله: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ فقد كنى به عن الحدث الأكبر، كما قال ترجمان القرآن ابن عباس (توفي: 68ﻫ/688م): هو الجماع، وقال الفقيه التابعي الجليل سعيد بن جبير: ذكروا اللمس فقال ناس من الموالي: ليس بالجماع؛ وقال ناس من العرب: اللمس الجماع؛ قال: فأتيت ابن عباس فقلت له: إن أناساً من الموالي والعرب اختلفوا في (اللمس) فقالت الموالي: ليس بالجماع، وقالت العرب: الجماع. قال ابن عباس: فمن أي الفريقين كنت؟ قال: كنت من الموالي، قال: “غُلب فريق الموالي! إن اللّمس والمسَّ والمباشرة: الجماع، ولكن الله يُكنّي ما شاء بما شاء.”1
ومن الصحابة والتابعين من أدخل مقدِّمات الجماع في معنى اللّمس والمسّ، مثل القُبلة والجس باليد ونحوها.2
وقد رجح ابن تيمية ما ذهب إليه ابن عباس من أن اللمس كناية عن الجماع3 ولكنه لم يسم ذلك مجازاً، ولم يعتبره تأويلاً، والنتيجة واحدة.
التأويل إذن مقبول إذا دلَّ عليه دليل صحيح من اللغة أو من الشرع أو من العقل، وإلا كان مردوداً مهما يكن قائله.
* اهتمام العلماء بضوابط التأويل:
لهذا كان من اشد ما تتعرض له النصوص خطراً: سوء التأويل لها، بمعنى أن تُفسر تفسيراً يخرجها عما أراد الله تعالى ورسوله بها، إلى معان آُخر، يريدها المؤوِّلون لها. وقد تكون هذه المعاني صحيحة في نفسها، ولكن هذه النصوص لا تدل عليها، وقد تكون المعاني فاسدة في ذاته، وأيضاً لا تدل النصوص عليها. فيكون الفساد في الدليل والمدلول معاً.
وقضية (التأويل) قضية كبيرة تعرَّض لها علماء الأصول، وأشبعوها بحثاً، على اختلاف مشاربهم ومدارسهم، وشاكرهم في هذا علماء الكلام والتفسير.
والمراد بالتأويل4 -هنا- معناه الاصطلاحي، وهو: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح يحتمله، لدليل يُصيِّره راجحاً.5
وهذا هو التأويل الصحيح المقبول.
فلا بد أن يكون الصرف إلى معنى يحتمله اللفظ، ولو كان احتمالاً مرجوحاً. وإلا لم يكن تأويلاً، وإنما هو جهل وضلال، أو عبث وباطل.
ولا بد أن يقوم دليل راجح على هذا الصرف، وإن كان اللفظ يحتمله؛ لأن ترك الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لا يجوز إلى بدليل. وإلا لقال كل من شاء ما شاء، وأبطل كل زائغ أدلة الشرع الواضحة بلا برهان، متذرعاً بعنوان التأويل.
ولا بد أن يكون الدليل الذي صرف عن الظاهر راجحاً فأما دليل مرجوح أو مساوٍ فهو مردود.
ومعنى هذا أن التأويل لا يجوز لكل من هبَّ ودبَّ، ولا يجوز بلا قيد ولا شرط، كما يتوهَّم الجاهلون والمتلاعبون.
قال ابن برهان: وهذا الباب أنفع كتب الأصول وأجلُّها، ولم يَزِلَّ الزَّالُّ إلا بالتأويل الفاسد.6
قال ابن برهان: وهذا الباب أنفع كتب الأصول وأجلُّها، ولم يَزِلَّ الزَّالُّ إلا بالتأويل الفاسد.6
وقد تحدَّث الأصوليون عن معنى التأويل ومجاله وشروطه، وأنواعه، وأفاضوا. ولا مجال في هذا المقام للخوض في هذا الميدان الرحب7، إنما نكتفي ببعض الإشارات والتنبيهات والأمثلة النافعة في بحثنا هذا.
وللظاهرية هنا موقف من موضوع التأويل، فهم يرفضون التأويل إذا لم يدلَّ عليه نص من كتاب، أو سُنَّة أو إجماع، تأسيساً على مذهبهم في الأخذ بظواهر النصوص، فهي عندهم وافية بكل شيء، كما قال مؤسس المذهب داود بن علي (توفي: 270ﻫ/884م)، وأكده أبو محمد ابن حزم (توفي: 456ﻫ/1073م) الذي أحيا المذهب بعد موات.
وفي مقابل الظاهرية الذين يمثلون جانب التفريط -بل الجمود- في التأويل، نجد طوائف أخرى تمثل جانب الإفراط، بل التسيُّب في التأويل.
ومما لا شك فيه أن الأصل هو حمل الكلام على معناه الظاهر، إذ هو ما تدل عليه اللغة بأصل وضعها، وما يُفهم من اللفظ لأول وهلة. فلا يجوز العدول عن هذا الظاهر إلى غيره إلا لدليل يصرف عن ذلك. وهذا ما أشير إليه في تعريف التأويل.
فالأصل في الكلام الحقيقة، ولا يُعدَل عنها إلى المجاز إلا لقرينة ودليل.
والأصل بقاء العام على عمومه، حتى يظهر ما يخصصه. وبقاء المطلق على إطلاقه، حتى يرد ما يقيده.
والأصل بقاء الأخبار -فيما يتعلق بالعقائد والغيبيات- على ظاهر معناها حتى يأتي ما ينقلها عنه.
وكذلك الأوامر والنواهي في الأحكام والعمليات، هي على ظواهرها حتى يجيء ما يصرفها عنها.
* مجال التأويل:
ومن ثمَّ نجد أن التأويل يمكن أن يدخل في الفقه والفروع، ولا خلاف في ذلك، كما قال الشوكاني.
ويمكن أن يدخل في العقائد وأصول الدين وصفات الباري عزَّ وجل، وفي ذلك اتجاهات أو مذاهب ثلاثة، ذكر الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول خلاصة وافية لها، نشير إليها هنا:
الأول: أن لا يدخل التأويل فيها: بل تجري على ظاهرها ولا يؤول شيء منها، وهذا قول المشبهة.
الثاني: أن لها تأويلاً، ولكنا نمسك عنه، مع تنـزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل، لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (آل عمران: 7)؛ قال ابن برهان: وهذا قول السلف، قال الشوكاني: وكفى بالسلف الصالح قدوة لمن أراد الاقتداء، وأسوة لمن أحب التأسي.
الثالث: أنها مؤوَّلة.
قال ابن برهان: والأول من هذه المذاهب باطل، والآخران منقولان عن الصحابة، ونقل المذهب الثالث عن علي وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة.
ونقل الشوكاني عن إمام الحرمين (توفي: 478ﻫ/1085م)، والغزالي (توفي: 505ﻫ/1112م)، والرَّازي (توفي: 606ﻫ/1209م)، ما يفيد عودتهم إلى مذهب السلف ثم قال: “وهؤلاء الثلاثة هم الذين وسَّعوا دائرة التأويل، وطوَّلوا ذيوله، قد رجعوا آخراً إلى مذهب السلف كما عرفت، فلله الحمد كما هو أهل له”.
وحكى الزركشي (توفي: 794ﻫ/1392م) عن ابن دقيق العيد (توفي: 702ﻫ/1303م) أنه قال: “وتقول في الألفاظ المشكلة: إنها صحة وصدق، وعلى الوجه الذي أراده الله، ومن أوَّل شيئاً منها فإن كان تأويله قريباً على ما يقتضيه لسان العرب، وتفهمه في مخاطباتها، لم ننكر عليه ولم نبدِّعه. وإن كان تأويله بعيداً توقفنا عنه واستبعدناه، ورجعنا إلى القاعدة في الإيمان بمعناه مع التنـزيه”.
وقد تقدمه إلى مثل هذا ابن عبد السلام (توفي: 660ﻫ/1262م).
قال الشوكاني: والكلام في هذا يطول، لما فيه من كثرة النقول، عن الأئمة الفحول.8
* لجوء علماء المسلمين كافة إلى التأويل:
ولا توجد مدرسة من المدارس الإسلامية -في الكلام أو الفقه أو الأثر أو التصوف- إلا لجأت إلى التأويل، وإن تفاوتت في ذلك تفاوتاً كثيراً، منها من وسَّع، ومنها من ضيق، ومنها من قرَّب في تأويله، ومنها من بعَّد، حتى خرج عن العقل والشرع.
والمهمّ أن التأويل لا بد منه، فقد يوجبه العقل، وقد يوجبه الشرع، وقد توجبه اللغة، ومن رفض ذلك شرد عن الصواب، سقط في هوة الخطأ، كما فعل الظاهرية.
وأكثر ما يلجأ العلماء للتأويل، لتنسجم النصوص بعضها مع بعض، لا يضرب بعضها بعضاً، ومن هنا أوَّلوا قوله عليه الصلاة والسلام: “لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض”،9 وقلوه: “سباب المسلم فسوق وقتاله كفر”،10 بأن المراد بالكفر هنا: الكفر الأصغر، كفر النعمة، أو كفر المعصية، لا الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإنما سمِّيَ كفراً، لما فيه من التشبه بكفار الجاهلية الذين كانوا يقاتل بعضهم بعضاً، ويضرب بعضهم وجوه بعض.
وسبب هذا التأويل: أنَّ القرآن أثبت الإيمان للمقتتلين من المسلمين، وأبقى عليهم وصف الأخوة الإيمانية وأوجب الصلح بينهم فقال: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا…﴾ (الحجرات: 9)… إلى أن قال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ (الحجرات:10).
ومثل ذلك قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُون…َ﴾ (الأنفال:2-4)، وقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ (المؤمنون:1-3).
وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ (الحجرات:15).
: “لا يزني الزَّاني حين يزني وهو مؤمن، ولاrونحو ذلك قوله يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن”.11
وقوله: “والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن… من لا يأمَنُ جاره بوائقه”،13 فقد أوَّلها العلماء بأن الإيمان المنفي هنا: هو الإيمان الكامل، لا أصل الإيمان. كما يقال: لا مال إلا ما نَفَع، ولا علم إلا ما أدَّى إلى العمل، والمراد نفي الكمال.
وإنما أوَّل العلماء ذلك، لأن نمت نصوصاً أخرى وافرة، دلت على إيمان أهل المعصية، وأن مرتكب المعصية -ولو كانت كبيرة- لم يخرج من دائرة الإيمان.
وذلك مثل النصوص التي بيَّنت أن مَنْ مات على “لا إله إلا الله”14 دخل الجنة.
لمن لعن الذي شرب الخمر من الصحابة وضُرب أكثرrوقوله من مرة: “لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله”،15 أو”لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم”،16 فدلَّ على أن أخوته باقية رغم معصيته، وأن حب الله ورسوله مستقر في قلبه، وإن زلَّت قدمه إلى الوقوع في أم الخبائث.
وكذلك لو كان بالزنى والشرب والسرقة يكفر ويخرج من الإيمان، لكانت عقوبته عقوبة الردَّة، وهي عقوبة واحدة، فلا معنى لأن يُعاقب الزاني والشارب بالجَلْدِ، والسارق بالقطع.
* حتى ابن حزم لجأ إلى التأويل:
والإمام أبو محمد ابن حزم أشد الناس تمسكاً بالظواهر، وأبعدهم عن التأويل، تبعاً للمدرسة التي آمن بها، وعاش حياته محامياً عنها، وهي المدرسة الظاهرية، ومع هذا وجدناه يلوذ بالتأويل في بعض الأحيان، حين لا يجد منه بُداً.
فقد ذكر في المحلَّى حديث” “سيحان وجيحان، والنيل والفرات، كل من أنهار الجنة”، وحديث: “ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة”، وهما صحيحان ثابتان.
ثم قال ابن حزم: “هذان الحديثان ليس على ما يظنه أهل الجهل من أن الروضة مقتطعة من الجنة! وأن هذه الأنهار مهبطة من الجنة! هذا باطل وكذب”، ثم ذكر أن معنى كون الروضة من الجنة إنما هو لفضلها، وأن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة، وأن تلك الأنهار لبركتها أضيفت إلى الجنة، كما تقول في اليوم الطيب: هذا من أيام الجنة، وكن قيل في الضأن: “إنها من دواب الجنة”. وكما قال عليه السلام: “الجنة تحت ظلال السيوف”. ومثل ذلك حديث: “الحجر الأسود من الجنة”.
ثم حمل ابن حزم بشدة على مَن حملوا هذه الأخبار على ظاهرها، قائلاً: قد صحَّ البرهان من القرآن، ومن ضرورة الحس، على أنها ليست على ظاهرها.17
وهكذا وصل التأويل إلى المدرسة الظاهرية، التي تتمسك بظواهر النصوص إلى حد الجمود في بعض الأحيان. ولكنها أوّلت حين لم تجد من التأويل بُدّاً.
* المدرسة الحنبلية والتأويل:
والمدرسة الحنبلية من أشد المدارس -أو لعلها أشدها- حرباً عل التأويل، وخصوصاً في جانب العقيدة، إلى حد جعل ابن تيمية وتلاميذه ينكرون وجود المجاز في القرآن والسنة واللغة عموماً، ويرون فتح ذلك الباب ذريعة إلى الضلال والفساد، ودخول الزنادقة والباطنية وكل عدو للإسلام من خلاله.
ومع هذا اضطروا أن يطرقوا باب التأويل في بعض النصوص.
وقد حكى الإمام الغزالي في فيصل التفرقة: أن الإمام أحمد بن حنبل، وهو أبعد الناس عن التأويل، لجأ إليه في بعض الأحاديث، كما نقل إليه ذلك بعض الحنابلة المعاصرين له في بغداد.
وهذه الأحاديث هي:
“الحجر الأسود يمين الله في الأرض”،18 “القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن”،19 إني لأجد نَفَس الرحمن من جهة اليمين.”20
وقد علّق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المقولة، فرمى هذه الرواية بالبطلان، وقال: إنها كذب على الإمام أحمد، ولا يُعرف ذلك عنه، وناقل ذلك للغزالي مجهول، لا يُعرف علمه بما قال، ولا صدقه فيما قال.
ومع هذا سُئل ابن تيمية عن الحديثين الأول والثالث فقال:
بإسناد لا يثبت. والمشهور إنماr”أما الحديث الأول، فقد روى عن النبي هو عن ابن عباس، قال: “الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمَن صافحه وقبَّله، فكأنما صافح الله وقبَّل يمينه.
“ومن تدبَّر اللفظ المنقول تبيَّن له أنه لا إشكال فيه إلا على من لم يتدبره. فإنه قال: “يمين الله في الأرض” فقيده بقوله: “في الأرض”، ولم يُطلق فيقول: “يمين الله”. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق.
ثم قال: “فمَن صافحه وقبَّله فكأنما صافح الله وقبَّل يمينه”. ومعلوم أن المشبَّه غير المشبَّه به. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلاً؛ ولكن شُبِّه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبَيِّن أن الله تعالى كما جعل للناس بيتاً يطوفون به، جعل لهم ما يستلمونه؛ ليكون ذلك بمنـزلة تقبيل يد العظماء، فإن ذلك تقريب للمقبِّل، وتكريم له، كما جرت العادة.
وأما الحديث الثاني: “إني أجد نَفَس الرحمن من جهة اليمن”، فقوله: “من اليمن” يبيِّن مقصود الحديث، فإنه ليس لليمن اختصاص بصفات الله تعالى، حتى يُظن ذلك، ولكن منها جاء الذين “يحبهم ويحبونه” الذين قال فيهم: ﴿مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ (المائدة:54).
وقد روى أنه لما نـزلت هذه الآية سُئل عن هؤلاء، فذكر أنهم قوم أبي موسى الأشعري. وجاءت الأحاديث الصحيحة: “أتاكم أهل اليمن، أرق قولباً، وألين أفئدة. الإيمان يمان، والحكمة يمانية”، وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردَّة، وفتحوا الأمصار، فبهم نفّس الرحمن عن المؤمنين الكربات… .” 21
ومن تأمل كلام شيخ الإسلام، وكان منصفاً، وجد في توجيهه للحديثين قدراً من التأويل، وضرباً من التجوز، وما ذكره من لفظة “في الأرض” في الحديث الأول، أو لفظة “من اليمن” في الحديث الثاني، هو ما يسميه علماء البلاغة “القرينة” في المجاز، التي تدل على أن اللفظ أريد به غير ما وُضع له في الأصل.
ونحو ذلك حديثه عن معية الله تعالى لعباده، العامة والخاصة، ون قُرب الرب من عبده، وقُرب العبد من ربه، فيه شيء مما ذكرنا من التأويل،22 وإن لم يسمه كذلك. ولكنه تأويل قريب وصحيح ومقبول بلا ريب، وهو ما يحتاج إليه كل عالم في بعض الأحيان. ولكن المحظور هو التوسع، الذي سقط فيه من سقط من الأفراد والفرق.
وقد نقل العلامة جمال الدين القاسمي في تفسيره محاسن التأويل عن ابن تيمية في بعض فتاواه قوله: “نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله، وبالتأويل الجاري على نهج السبيل، ولم يوجد في شيء من كلامنا وكلام أحد منا، أنّأ لا نقول بالمجاز والتأويل. والله عند كل لسان. ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصواب، وما فُتِح به الباب إلى هدم السُّنة والكتاب، واللحاق بمحرِّفة أهل الكتاب”.23
وهذا هو اللائق بإمام مثل ابن تيمية الذي جمع بين النقل والعقل، ووسع علمه تراث السَلف ومعارف الخَلف، وتهيأ له من أدوات المعرفة ما لم يتهيأ لغيره إلا مَنْ مَنَّ الله عليه بفضله، وقليل ما هم.
على أن هناك من أعلام الحنابلة أنفسهم مَن خرج عن خط الحنابلة المتشددين، وخاض في لجج التأويل، وأنكر على من عزا إلى الإمام أحمد أنه يرفض التأويل بإطلاق.
ومن هؤلاء الأعلام: العلامة الموسوعي الغمام أبو الوفاء ابن عقيل (توفي: 513ﻫ/1119م)، صاحب كتاب “الفنون” وغيره، ذكروا أن كتابه الفنون يزيد على أربعمائة مجلد.
ومنهم: الغمام أبو الحسن بن الزاغوني (توفي: 527ﻫ/1133م)، وصفوه بأنه كان متفنناً في الأصول والفروع والحديث والوعظ.
ومنهم: الإمام الموسوعي أبو الفرج ابن الجوي (توفي: 597ﻫ/1201م)، صاحب التصانيف الممتعة المتنوعة، ومنها كتاب دفع شُبه التشبيه.
وكل هؤلاء، قبل ابن تيمية وتلاميذه.
وأنا أُرجِّح رأي السَّلف -وهو ترك الخوض في لجج التأويل، مع تأكيد التنـزيه- فيما يتعلق بشؤون الألوهية وعوالم الغيب والآخرة، فهو المنهج الأسلم. إلا ما أوجبته ضرورة الشرع أو العقل أو الحس، في إطار ما تحتمله الألفاظ.
وفيما عدا ذلك، فلا مانع من التأويل بشروطه وضوابطه، إذا كان هناك موجب للتأويل.
* تأويل النصوص البيِّنات مذهب الباطنية:
أما تأويل النصوص البيّنات المحْكمات، بحملها على معان باطنة غير ما يُفهم من ظاهرها، فهذا هو الإلحاد في آيات الله تعالى، الذي توعَّد الله عليه، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾ (فصلت:40).
والمراد بالإلحاد هنا: الميل بها عن المقصود منها.
وهذا مدخل واسع للهدًّامين الذين أرادوا الكيد للإسلام وأمته بدعوى أن لكل ظاهر باطناً هو المقصود. والظاهر هو القشر، والباطن هو اللُّب. هو ما زعمته “المدرسة الباطنية” بكل فئاتها، وبمختلف أسمائها، من قرمطية وإسماعيلية ونصيرية ودرزية.
ولو صدق هؤلاء لأعلنوا أن لهم ديناً مغايراً تماماً لدين الإسلام، لا صلة له بقرآن ولا حديث، بل مغايراً للأديان السماوية كلها، بل الواقع أنهم لا دين لهم، فحاصل مذهبهم وزبدته -كما قال الإمام الغزالي- طي بساط التكليف، وحط أعباء الشرع عن المتعبدين، وتسليط الناس على اتباع اللَّذات، وطلب الشهوات، وقضاء الوطر من المباحات والمحرَّمات!24 فهم امتداد للمزدكية المجوسية الفارسية الإباحية، إنما تمسحوا بالدين ليهدموه باسم الدين، وتعلقوا بالإسلام، ليضربوه من داخله.
ولما كان القرآن محفوظاً من كل تغيير وتبديل في ألفاظه، فلا يمكنهم الزيادة فيه أو النقص منه، لم يجدوا حيلة أمامهن إلا هذا التأويل المفترى، وهذا الادعاء ببواطن خفية، يقولون فيها ما يشاءون، دون ضابط من لغة أو عقل أو شرع.
* من تأويلات الباطنية والزنادقة:
وقد عقد الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه فضائح الباطنية فصلاً في تأويلاتهم للظواهر، ذكر فيه نماذج عجيبة، تُعَد أغرب من الخيال. قال: “والقول الوجيز فيه أنهم لما عجزوا عن صرف الخلق عن القرآن والسنّة صرفوهم عن المراد بهما إلى مخاريق زخرفوها، واستفادوا -بما انتزعوه من نفوسهم من مقتضى الألفاظ- إبطال معاني الشرع، وبما زخرفوه من التأويلات تنفيذ انقيادهم للمبايعة والموالاة، وأنهم لو صرَّحوا بالنفي المحض والتكذيب المجرَّد لم يحظوا بموالاة الموالين، وكانوا أول المقصودين المقتولين.
ونحن نحكي من تأويلاتهم نبذة لنستدل بها على مخازيهم، فقد قالوا: كل ما ورد من الظواهر في التكاليف والحشر والنشر والأمور الإلهية، فكلها أمثلة ورموز إلى بواطن: أما الشرعيات: فمعنى الجنابة عندهم مبادرة المستجيب بإفشاء سرّ إليه قبل أن ينال رتبة استحقاقه؛ ومعنى الغُسل تجديد العهد على مَن فعل ذلك.
والزنا هو إلقاء نطفة العلم الباطن فينفس من لم يسبق معه عقد العهد. والاحتلام هو أن يسبق لسانه إلى إفشاء السر في غير محلّه، فعليه الغُسل أي تجديد المعاهدة.
الطهور هو التبري والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى مبايعة الإمام.
الصيام هو الإمساك عن كشف السرّ.
الكعبة هي النبيّ، والباب عليّ.
الصفا هو النبيّ، والمرْوة عليّ، والميقات هو الأساس؛ والتلبية إجابة الداعي. وكذلك زعموا أن المحرّمات عبارة عن ذوي الشرّ من الرجال وقد تُعُبّدْنا باجتنابهم، كما أن العبادات عبارة عن الأخيار الأبرار الذين أمِرنا باتباعهم.
فأما المعاد فزعم بعضهم أن النار والأغلال: عبارة عن الأوامر التي هي التكاليف فإنها موظفة على الجُّهّال بعلم الباطن، فما داموا مستمرِّين عليها فهم معذّبون؛ فإذا نالوا علم الباطن وُضِعت عنهم أغلال التكاليف وسعدوا بالخلاص منها.
أما المعجزات فقد أوّلوا جميعها وقالوا: الطوفان معناه طوفان العلم، أُغرق به المتمسكون بالسنَّة؛ والسفينة: حِرزُه الذي تحصَّن به من استجاب لدعوته؛ ونار إبراهيم: عبارة عن غضب نمرود، لا عن النار الحقيقية.
عصا موسى: حُجَّته التي تلقفت ما كانوا يأفكون من الشُبه، لا الخشب. انفلاق البحر: افتراق علم موسى فيهم على أقسام؛ والبحر: هو العالم.
والغمام الذي أظلّهم: معناه الإمام الذي نصبه موسى لإرشادهم وإفاضة العلم عليهم.
الجراد والقمّل والضفادع: هي سؤالات موسى وإلزاماته التي سُلّطت عليهم. والمنّ والسلوى: علم نـزل من السماء لداعٍ من الدعاة هو المراد بالسلوى.
تسبيح الجبال: معناه تسبيح رجال شدادٍ في الدين راسخين في اليقين.
الجنّ الذين ملكهم سليمان بن داود: باطنية ذلك الزمان والشيطان هم الظاهرية الذين كُلّفوا بالأعمال الشَّاقة.
إحياء الموتى من عيسى: معناه الإحياء بحياة العلم عن موت الجهل بالباطن. وإبراؤه الأعمى: معناه عن عمي الضلال وبرص الكفر ببصيرة الحق المبين. إبليس وآدم: عبارة عن أبي بكر وعليّ! إذ أُمر أبو بكر بالسجود لعليّ، والطاعة له، فأبى واستكبر.
الدجّال زعموا أنه أبو بكر، وكان أعور؛ إذ لم يبصر إلى بعين الظاهر دون عين الباطن.
الدجّال زعموا أنه أبو بكر، وكان أعور؛ إذ لم يبصر إلى بعين الظاهر دون عين الباطن.
ويأجوج ومأجوج: هم أهل الظاهر!
هذا من هذيانهم في التأويلات حكيناها ليُضحَك منها؛ ونعوذ بالله من صرعة الغافل وكبوة الجاهل”.25
وقد سلك الإمام الغزالي مسالك ثلاثة في الرد عليهم: مسلك الإبطال لدعاويهم، ومسلك المعارضة بالمثل، ومسلك التحقيق.
ولستُ في حاجة إلى نقل ما ذكره هنا، لوضوح بطلان ما قاله هؤلاء الزنادقة، فإنَّ اللغة أساس التفاهم بني الناس، فإذا لم تكن لألفاظها وتراكيبها دلالات معيَّنة، يفهم بها الناس بعضهم عن بعض في أمور دينهم ودنياهم، أصبح من حق كل امرئ أن يفسر ما شاء بما شاء. وهذا خارج عن حدود العقل.
والغريب أن هؤلاء يستدلون أحياناً لباطن مذهبهم -أو باطل مذهبهم- بظاهر بعض النصوص، مثل: “إن لكل لفظ ظهراً وبطناً ونحوه. ولو صحَّ هذا سنداً -وما هو بصحيح- كيف أبقوا هذا النص وحده على ظاهره، وما يدرينا أن اللفظ والظهر والبطن لها معان آُخر غير المعاني المفهومة منها عند الناس؟
إن بحسبنا أن نذكر أقوال هؤلاء، ليُعرف بطلانها، بل ليُضحَك عليها كما قال الغزالي. فهي تحمل دليل فسادها فيها. إنما أردنا أن يُعرف من أقوالهم مصادر الباطنية اللاَّحقين والمحدثين.
* تأويلات بعض فرق الشيعة:
ومن فِرق الشيعة من غلا في دينه ومنهجه، ونحا نحو أولئك الباطنية المارقين في التحريف وسوء التأويل، حتى فسّروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه! كقول بعضهم في تفسير: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ (المسد:1)، هما أبو بكر وعمر.
وفي قوله: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (الزمر: 65)، أي: أشركت بين أبي بكر وعمر، وعلي، في الخلافة!
وفي قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ (البقرة: 67)، والخطاب من موسى لقومه)، هي عائشة! ﴿فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ﴾ (التوبة: 12)، طلحة والزبير.
﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾ (الرحمن:19)، هما عليُّ وفاطمة!26
﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ (الرحمن:22)، الحسن والحسين.27
﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ (يّـس: 12)، في علي بن أبي طالب.
﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ . عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ﴾ (النبأ:1-2)، عليّ بن أبي طالب.28
والمعتدلون من الشيعة يرفضون هذه التحريفات أو التخريفات!
* تأويلات غلاة الصوفية:
تأويلات في القرآن الكريم والحديث الشريف، تنـزع إلى تجاوز الظواهر، للوصول إلى معان باطنة، فمنهم من يعدها من باب “الإشارات” الرَّامزة لتلك المعاني بالمجاز أو التمثل أو الإلحاق، ومنهم من يعدّها هي المقصودة من النص.
والنـزعة الأخيرة ليست إلا ضرباً من تفسير الباطنية الذين خرجوا عن الشريعة، بل هم لم يدخلوا فيها أصلاً، حتى يخرجوا منها؛ فمن نسج على منوالهم فهو منهم، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ (المائدة: 51).
أما النـزعة الأولى فللعلماء فيها مواقف.
منهم من يقرِّها ويعدها رموزاً وإشارات، وليست تفسيراً. بل ربما يراها بعضهم من كمال الإيمان، وتمام العرفان. ومنهم من يرى أن الشريعة في غِنى عنها، وأن السَّلف من الصحابة والتابعين لم يصح عنهم شيء من هذا، وكل خير في ابتاع مَن سَلَف، وكل شر في ابتداع مَن خَلَف.قال الإمام تقي الدين ابن الصلاح (توفي: 643ﻫ/1245م) في “فتاويه”:
وجدتُ عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسِّر (توفي: 468ﻫ/1076م) أنّه قال: صنف أبو عبد الرحمن السُّلمِِي (توفي: 412ﻫ/1021م) حقائق التفسير،29 فإن كان قد اعتقد ذلك تفسيراً فقد كفر”.
قال ابن الصلاح: “وأنا أقول: الظنّ بمن يوثَق به منهم، إذا قال شيئاً من ذلك أنّه لم يذكره تفسيراً، ولا ذهب به مذهبَ الشرح للكلمة، فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية، وإنما ذلك منهم لنظير ما ورد به القرآن: فإنَّ النظير يُذكر بالنظير؛ ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإبهام والإلباس”!
وقال النسفيّ (توفي:710ﻫ/1310م) في عقائده: النّصوص على ظاهرها، والعدول عنها إلى معان يدّعيها أهلُ الباطن إلحاد.
قال التفتازانيّ في شرحه: سُمِّيت الملاحدة باطنيّة لادّعائهم أن النصوص ليست على ظاهرها، بل لها معانٍ باطنية لا يعرفها إلى المعلم؛ وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكليّة.
قال: وأمّا ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرها، ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك، يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة، فهو من كمال الإيمان، ومحض العرفان”.30
ولكن بعض الصوفية بالغوا، حتى قال بعضهم: لكل آية ستون ألف فهم! واعتمدوا على بعض الأحاديث والآثار الواردة في ذلك، مثل ما ورد مرفوعاً: “إن للقرآن ظهراً وبطناً، وحداً ومطلعاً”.
وقال ابن عباس: “إن القرآن ذو شجون وفنون، وظهور وبطون، لا تنقضي عجائبه، ولا تبلغ غايته”.
ولكن هذا -إن صح- لا يدل على ما ادعاه أولئك الغلاة، فقد قال ابن عباس في الأثر نفسه: “فظهره التلاوة، وبطنه التأويل”.
وهذا يعني الغوص وتعميق النظر لاستخراج جواهر القرآن، فهو لا تنقضي عجائبه حقاً. كما لمسنا ذلك في عصرنا، حيث يجد كل متخصص إذا تعمق فيه ما لا يجد في غيره من الكنوز.
ولذا تحفَّظ الإمام أبو بكر بن العربي (توفي: 638ﻫ/1241م) في كتابه العواصم من القواصم على تلك التأويلات الصوفية التي سماها “قدحات الخواطر، ولمحات النواظر”. فقد تحدَّث في إحدى “القواصم” عن طائفة من هؤلاء الذين سماهم أصحاب الإشارات جاؤوا بألفاظ الشريعة من بابها، وأقروها على نصابها، لكنهم زعموا أن وراءها معاني غامضة خفية، وقعت الإشارة إليها من هذه الألفاظ. وبيَّن خطأهم في إحدى “العواصم”.
فقد ذكر تأويلهم لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا﴾ (البقرة: 114)، وقولهم: “إن الله نبَّه بذلك على أنه لا أظلم ممن خرَّب أركان الإيمان بالشبهات. وهي قلوب المؤمنين، وعمَرها بالأماني، وشحنها بمحبة الدنيا، وفرّغها من محبة الله تعالى.”
ورد ابن العربي ذلك بأن المراد بالمساجد في الآية: ذوات المساحات المتخذة للصلوات، وقلوب المؤمنين معروف حالها، مبيِّنة بأكثر من هذا البيان في مواضعها، ولا يُحتاج إلى ذلك فيها، ولا يدل اللفظ عليها.
وكذلك قولهم في الآية: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾ (طـه: 12)، إشارة إلى خلع الدنيا والآخرة من قلبه.
وفي الآية: ﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ﴾ (النمل:10)، أي: لا يكون لك معتمد ومستند غيري.
قال ابن العربي: “وهذه إشارة بعيدة، أو قُل معدومة، فإنها إلى غير مُشار. وما أمِرَ موسى بطرح النعل إلا لأحد وجهين: إما لأنهما كانا من جلد غير مذكّى، أو لئلا يطأ الأرض المقدسة بنعل تكرمة لها، كما لا يدخل الكعبة بها…
وأما إلقاء العصا، فقد بيّن الله تعالى الفائدة فيه. ومن يعتمد على العصا من طول القيام، أيقال له: إنه على غير الله يعتمد؟ هذه خرافة! فدع عنك نهباً صيح في حجراته، وعوِّل على كتاب الله ومعلوماته”.
ومثل ذلك قولهم في حديث: “لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب” بأن فيه إشارة إلى تطهير القلوب من الحسد والحقد والغضب والبخل والخديعة والمكر وسائر الصفات الذميمة. فإن منـزلتها في القلب منـزلة الكلاب من البيت. قالوا: ونحن نقرأ الحديث على ظاهره، ولكنّا نلحق به المعنى الآخر على سبيل الإشارة.”
وبيَّن ابن العربي أن هذا معنى فاسد من وجهين:
أحدهما: أنه يكاد يقطع بأن هذا لم يكن مقصوداً للنبي .r
والثاني: “أنّا وجدنا التصريح بتطهير القلوب من هذه الصفات الذميمة كلها منصوصاً عليه. فما الذي محوجنا إلى أن نأخذه على بُعد من لفظ آخر؟ هذا من الفن الذي لا يُحتاج إليه. وإنما هو احتكاك بتلك الأغراض الفلسفية، وهي عن منهج الشريعة قصية.”31
قال السيوطي:
“والذي حرره هنا هذا الإمام: أن الصريح عام في الدين، به جاء البرهان، وعليه درا البيان، فلا يجوز أن يعدل بلفظ عن صريح معناه إلى سواه، فإن ذلك تعطيل للبيان، وقلب له إلى إشكال.”
ونقل السيوطي: عن ابن عطاء الله السكندري (توفي: 709ﻫ/1309م) في كتابه لطائف المنن أنه قال: “اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسوله بالمعاني الغريبة، ليس إحالة للظاهر عن ظاهره، ولكن ظاهر الآية مفهوم منه، ودلت عليه في عرف اللسان، وثمّ’ أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لم فتح الله قلبه، وقد جاء في الحديث: “لكل آية ظهر وبطن” فلا يصدَّنك عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة: هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله، فليس ذلك بإحالة، وإنما يكون إحالة لو قالوا: لا معنى للآية إلا هذا، وهم لم يقولوا ذلك، بل يقرون الظواهر على ظواهرها مراداً بها موضوعاتها، ويفهمون عن الله تعالى ما أفهمهم.”32
ورأيي أن يقبل من هذه الإشارات ما كان قريباً غير بعيد، مقبولاً غير متكلف، وكان في دائرة الشريعة وأحكامها، ولم يكن في الظاهر ما يغني عنه مما هو أنصع بياناً، وأوضح برهاناً.
ومنه ما يكون من باب التعليق على النص بإشارة دامغة، أو حكمة بالغة. مثل قول التستري (توفي: 283ﻫ/896م) تعليقاً على آية: ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ﴾ (الأعراف: 148): عجل كل إنسان: ما أقبل عليه فأعرض به عن الله من أهل وولد.33
أما تكلفات بعض المفسرين في أن يكون لجميع آيات القرآن إشارات باطنية -كما نرى ذلك في (روح المعاني) للألوسي وغيره- فلا أراها مجدية ولا مقبولة.
* إسراف المدارس العقلية في التأويل:
وإذا كانت (المدرسة الروحية) أو (الصوفية) قد سقطت أو سقط غلاتها في سوء التأويل للقرآن، فمثلها مثل المدرسة أو (المدارس العقلية)، ومن نظر إلى (المدرسة العقلية) في تاريخ الفكر الإسلامي، يجد أن أصحابها ذهبوا بعيداً في تأويلاتهم الجائرة للنصوص أو -على الأقل- المتكلفة لها، فقد انتهى بهم هذا الشطح إلى أودية بعيدة، بل إلى مفاوز مهلكة، انطمس فيها السبيل، وعًدِمَ الدليل.
– المدرسة الفلسفية:
أبرز المدارس العقلية، مدرسة الفلاسفة، وخصوصاً المشَّائين منهم. لقد كان أكبر همهم التوفيق بين الفلسفة التي أعجبوا بها، والدين الذي ورثوه ودانوا به، ولكنهم جعلوا الفلسفة هي الأصل، والدين هو الفرع واعتبروا قول أرسطو هو الذي يُحتكم إليه، ويُعوَّل عليه، وقل الله تعالى، وقول رسوله الكريم، تابعين له، إن وافقاه فبها ونعمت، وإلا وجب تأويلهما، قَرُبَ هذا التأويل أم بعُد.
لقد أسرفوا في التأويل، فأدخلوه في كل مجالات العقيدة: الإلهيات والنبوات والسمعيات.
فالله عندهم ليس هو الإله المعروف عند المسلمين بأسمائه وصفاته المذكورة في القرآن، ليس هو الخالق لكل شيء، العليم بكل شيء، القدير على كل شيء.
والنبيُّ ليس هو الذي يكلّمه الله تعالى وحياً، أو من وراء حجاب، أو يُرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء، كما هو ثابت معلوم عند جميع المسلمين.
والمعاد ليس كما يؤمن به المسلمون: بعثاً للأجساد، وخروجاً من الأجداث، في يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتُنصب الموازين، وتُنشر الدواوين، ويُسأل الناس عما كانوا يعملون، يُجزى قوم بدخول الجنة بما فيها من نعيم روحي ومادي، وآخرون بالنار، وما فيها من عذاب حسي ومعنوي.
الله عند الفلاسفة لم يخلق العالم، وهو لا يعلم بما يجري فيه من جزئيات وتفاصيل، فلا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينـزل من السماء وما يَعرج فيها.
والنبي ليس بشراً يوُحَى إليه من الله بوساطة مَلَك ينـزل عليه.
والبعث ليس مادياً ولا جسماً، وليس هناك جنة ولا نار بالمعنى الذي عرفناه من القرآن والحديث.
هذه عقيدة القوم كوَّنوها لأنفسهم من خارج الإسلام، ثم أرادوا أن يحملوا الإسلام عليها حملاً، وأن يجرُّوا القرآن جراً ليبرر لهم هذا الضلال المبين.
ولا ريب أن القرآن من أوله إلى آخره يُبطل ما قالوه في العقائد، ويُضادُّه مضادَّة صريحة، وخم يعلمون هذا ويقولون: “إنَّ الشرائع واردة لخطاب الجمهور بما بفهمون، مقرِّبة ما لا يفهمون إلى أفهامهم بالتشبيه والتمثيل، ولو كان غير ذلك ما أغنت الشرائع البتّة”.34
ومعنى هذا: أن الأنبياء يكذبون على النسا، ويقولون لهم غير الحق، ولكن لمصلحتهم؛ لأنهم -لغلظ طباعهم، وتعلق أوهامهم بالمحسوسات الصرفة- لا يقدرون على إدراك الحقيقة الموحدة، والغاية -في نظر هؤلاء- تبرر الوسيلة.
وقد ردَّ الإمام أبو حامد الغزالي على الفلاسفة، بعد أن درس فلسفتهم وهضمها وألّف في ذلك كتابه مقاصد الفلاسفة الذي لخّص فيه مقولات الفلسفة تلخيصاًَ ربما لا يقدر عليه الفلاسفة أنفسهم. ثم كرَّ عليها بالنقض والإبطال، في كتابه الشهير تهافت الفلاسفة وخطأهم في سبع عشرة مسألة، وكفّرهم ي ثلاث مسائل شهيرة: قولهم بقدم العالم، وأن الله لم يخلقه من عدم، وقولهم بأن الله لا يعلم الجزئيات والحوادث الواقعة في هذا الكون، وقولهم بأن البعث روحاني، لا جسماني، فالأجسام بعد أن تفنى لا تحيا ولا تبعث مرة أخرى لتنعم أو تعذب.35
وقد حاول الفيلسوف ابن رشد (توفي: 590ﻫ/1194م) أن يدافع عن الفلاسفة، ويردَّ على الغزالي في كتابه تهافت التهافت.36 ولكن الحقيقة المرَّة أنَّ الفلاسفة استقوا عقيدتهم هذه من خارج المصادر الإسلامية. ولهذا لم يسلم لابن رشد كثير من دفاعاته، على الرغم من مهارته وخبرته بالشرعيات والعقليات.
– تأويلات الفرق الكلامية:
وما سقط فيه الفلاسفة وقعت فيه الفرق الكلامية بأقدار متفاوتة.
من ذلك تأولات الفرقة المعروفة باسم (المرجئة) من الإرجاء، وهو التأخير، لأنهم يؤخرون العمل والسلوك عن الاعتقاد والإيمان ويعتبرون مجرد الاعتقاد كافياً لنجاة الإنسان.
قالت المرجئة: من أقرَّ بالشهادتين، وأتى بكل المعاصي فهو ناج، ولا يدخل النار أصلاً بناء على مذهبهم: أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وخالفوا في ذلك الآيات التي توعَّدت أهل المعاصي بالنار: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً﴾ (النساء:30)، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾ (النساء:10)، ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (البقرة: 275)، ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾ (النساء:93).
وخالفوا أيضاً الأحاديث الصِّحاح التي جاءت في وعيد العصاة، وهي كثيرة غزيرة.
وكذلك الأحاديث التي وردت في إخراج الموحِّدين -ممن في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان- من النار، وهي كثيرة…
قال العلامة أبو الوفاء بن عقيل:
“ما أشبه أن يكون واضع الإرجاء زنديقاً فإن صلاح العالم بإثبات الوعيد، واعتقاد الجزاء، فالمرجئة لمّا لم يمكنهم جحد الصانع (سبحانه وتعالى) لما فيه من نفور الناس، ومخالفة العقل، أسقطوا فائدة الإثبات، وهي الخشية والمراقبة، وهدموا سياسة الشرع، فهم شرُّ طائفة على الإسلام”،37 والمراد بهؤلاء: غلاة المرجئة الذين اعتبروا الإنسان مؤمناً، وإن لم يعمل عملاً واحداً من أعمال الإسلام. فإن هناك نوعاً من الأرجاء قال به بعض أكابر المسلمين. وليس هو المقصود هنا.
“ما أشبه أن يكون واضع الإرجاء زنديقاً فإن صلاح العالم بإثبات الوعيد، واعتقاد الجزاء، فالمرجئة لمّا لم يمكنهم جحد الصانع (سبحانه وتعالى) لما فيه من نفور الناس، ومخالفة العقل، أسقطوا فائدة الإثبات، وهي الخشية والمراقبة، وهدموا سياسة الشرع، فهم شرُّ طائفة على الإسلام”،37 والمراد بهؤلاء: غلاة المرجئة الذين اعتبروا الإنسان مؤمناً، وإن لم يعمل عملاً واحداً من أعمال الإسلام. فإن هناك نوعاً من الأرجاء قال به بعض أكابر المسلمين. وليس هو المقصود هنا.
– تأويلات الجبرية:
ومثل تأويلات (المرجئة) تأويلات (الجبرية) الذين اعتبروا الإنسان مسيَّراً لا مخيَّراً، وأنه لا إرادة له ولا اختيار، وأنه كريشة في مهم الريح تحركها الأقدار كيف تشاء، ومنهم من انتهى إلى جبرية صريحة مكشوفة. ومن انتهى إلى جبرية مقنَّعة، لم يغنِ قناعُها عنها شيئاً.
اعتمد هؤلاء على آيات من كتاب الله متشابها، مثل قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (الأنعام: 102)، ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الصافات:96)، ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ﴾ (النحل: 17)، ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (الإنسان:30)، ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ (المدثر: 31).
وتأولوا الآيات الصريحة التي تنسب إلى الإنسان عمله، وتحمٍّله مسؤوليته، وتُجزيه عليه في الدنيا والآخرة، ثواباً وعقاباً، وتحرّضه على الإيمان والعمل.
اقرأ قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (النحل:97)؛ ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (الأعراف:96) ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (آل عمران:182)؛ ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (الزخرف:72)؛ ﴿فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (السجدة:17)؛ ﴿وَقَالَتْ أُولاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ (الأعراف:39).
والقرآن كله تحريض على الإيمان والعمل الصالح بأساليب شتى، كلها تنبئ عن مسؤولية الإنسان عن إيمانه وعمله، وعن اختياره لأحد النجدين.
اقرأ قوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُون .وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ﴾ (الانشقاق:20-21)؛ ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ﴾ (النساء: 39)؛ ﴿وَالْعَصْرِ . إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) (العصر:1-3)؛ ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . َأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا . قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ (الشمس:7-10).
والقرآن كله، مكيه ومدنيه، حافل بما ينقض مذهب الجبر، ويقتلعه من جذوره.
والحق أن هذا المذهب يناقض نصوص القرآن المحكمات، ويناقض أساس الدين الذي قام على التكليف والمسؤولية، وبه أنـزل الله الكتب، وبعث الرسل وقامت سوق الجنة والنار.
وقد ردَّ عليه علماء المسلمين، ولكن شاعت أفكاره بين جماهير الأمة، فأقعدتها عن العمل، وأفقدتها حرارة الإحساس لعمارة الأرض، وإقامة الحق، ومقاومة الباطل، وأصبح المثل السائد: دع الخلق للخالق أقام العباد، فيما أراد.
– مدرسة المعتزلة والتأويل:
قرأ المعتزلة القرآن، وفسره من فسره منهم بعقلية المعتزلي، وروح المعتزلي، الذي يؤمن بأفكار فرقته الأساسية: أن الإنسان خالق أفعال نفسه، وأن الله لا يريد المعصية، وأن ليس لله صفات ثبوتية كالعلم والقدرة والإرادة والحياة إلخ… وأن القرآن مخلوق، وأن الله لا يرى في الآخرة، وأن مرتكب الكبيرة في منـزلة بين المنـزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ولكنه مخلد في النار، وأن الأنبياء والملائكة والمؤمنين لا يشفعون لمذنب ف الآخرة… إلخ
ومن قرآن تفسيراً مثل (الكشاف) للزمخشري، وحده على علمه وفضله -الذي اعترف به الجميع- يتكلف تكلفاً لا يليق بعلاّمة مثله، لحمل الآيات على مذهبه كما تراه جلياً في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ وقد كررت مرتين في سورة النساء (الآية 48 والآية 116)، فقد فرق الله تعالى بين الشرك وما دونه من الذنوب، ولكنه -أي الزمخشري- سوَّى بينهما في أنهما لا يغفران إلا بالتوبة!
ومثل ذلك موقفه من قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (البقرة: 255)؛ وقوله: ﴿وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ (الأنبياء: 28)، وغير ذلك من الآيات المثبتة للشفاعة بشرطها، وهي أن تكون بإذن الله تعالى لأهل التوحيد، ولكن الزمخشري -مثل كل المعتزلة- يغلبون العدل على الرحمة، والوعيد على الوعد، والعقل على النقل، ولو أنصفوا وتأملوا حق التأمل لعلموا أن العقل المجرد عن الهوى يقضي بإثبات الشفاعة، لأنه الأليق بكمال الله تعالى، وسابغ فضله، وواسع رحمته، وعظيم إحسانه.
ونحو ذلك موقفه من قوله تعالى عن يوم القيامة: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ . إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ (القيامة: 22-23).
وهي صريحة في موضوعها، ولا سيما إذا أضيف إليها صحاح الأحاديث.
وموقفه من مثل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ﴾ (المائدة: 41)، وقوله: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ (الأنعام: 125)، وتمثله رحمة الله في تفسير هذه وتلك وما كان في معناهما لتوافق مذهبه في أن المعاصي واقعة بغير إرادة الله تعالى حتى قال العلامة ابن المنير في (انتصافه): كم يتلجلج هذا الفاضل والحق أبلج.
وقال معقِّباً على قول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: ﴿مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (الأنعام:111) أي مشيئة إكراه واضطرار: (بل المراد: إلا أن يشاء منهم اختيار الإيمان، فإنّه لو شاء منهم اختيارهم للإيمان لاختاروه وآمنوا حتماً ما شاء الله كان. والزمخشري بنى على القاعدة الفاسدة في اعتقاده: أنَّ الله تعالى شاء منهم الإيمان اختياراً، فلم يؤمنوا بل يقول هو وطائفته: إن أكثر ما شاء الله لم يقع… فإذا صدمتهم مثل هذه الآي بالرد تحيّلوا في المدافعة بحمل المشيئة المنفية على مشيئة القسر والاضطرار، وإنما يتم لهم ذلك لو كان القرآن يتبع الآراء، أما وهو القدوة والمتبوع، فما خالفه حينئذٍ وتزحزح عنه فإلى النار، وماذا بعد الحق إلا الضلال.38
– المدرسة الأشعرية والتأويل:
والأشاعرة والماتريدية الذين كانوا يعبّرون عن أهل السنة طوال القرون الماضية، لم يسلموا من التأويل الذي أنكره عليهم غيرهم.
وأبرز أشعري خاض هذا الميدان هو الإمام أبو حامد الغزالي، الذي بسط القول في هذا المجال في كتابه فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة، ووضع للتأويل قانوناً واسعاً فضفاضاً يسع معظم المؤوِّلين للنصوص، وإن أسرفوا وتكلّفوا.
وعذر الإمام أبي حامد في هذا التوسع الزائد عن الحد الوسط: أنه كان يتحدث عن الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، أو بين الإسلام والزندقة، فهو يبحث فيما يخرج المسلم من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، والحكم بكفر المسلم أو بردته أمر خطير، تترتب عليه أحكام جمة كبيرة، وحسبك منها: جلُّ دمه وماله عند جمهور الفقهاء، والتفرقة بينه وبين زوجه وولده. وبالجملة: الحكم عليه بالإعدام من المجتمع المسلم، أدبياً ومادياً.
فإذا كان ثمة مندوحة عن الحكم بـ (التكفير) فلا مفر من التثبث بها، وإن كانت واهية. فقد قواها الاحتياط لحقن دم المسلم، وإبقائه على أصل الإسلام، تحسيناً للظن به، وحملاً لحاله على الصلاح.
فليس كل ما ذكره الغزالي من أقسام الوجود: الحسي والخيالي، والشبهي والعقلي، التي يتحملها النص، وتدخل في التأويل، تأويلاً صحيحاً راجحاً في رأيه، بل يعتبره تأويلاً يمسك من قال به على أصل الإيمان، ولا يخرج به إلى الكفر المخرج من الملة، وإن كان يراه بدعة وضلالاً، كما هو رأيه في المعتزلة والخوارج والشيعة وغيرهم. فينبغي التنبه لهذه الدقيقة، فبعض الذين يكتبون عن الغزالي ورأيه في التأويل، ومراتب الوجود التي تحدث عنها، يوهمون أنه يصحح كل هذه التأويلات، وإن كانت بعيدة، وليس الأمر كذلك، إنما يراها تعفي صاحبها فقط من الحكم بكفره وردته.
* تأويلات الطوائف المنحرفة والمارقة في عصرنا:
وفي عصرنا وجدنا الفئات المارقة والمنحرفة -على تفاوت بينها- تلوذ بمخبأ الإسراف في (التأويل) تحتمي به، وتستند إليه، وتعتمد عليه، عوضاً عن رفضها صراحة للنصوص الثابتة المحكمة، فترفضها الأمة، وتفصلها عن جسمها الحي، فتموت حتماً.
– تأويلات القاديانية:
رأينا ذلك في طائفة (القاديانية) الذين ، وهو ما نطق بهrجحدوا ما عُلِم من دين الإسلام بالضرورة، وهو ختم النبوة بمحمد القرآن، واستفاضت به السنَّة. وأجمعت عليه كل طوائف الأمة، فقالوا في قوله تعالى: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ (الأحزاب:40)، أي زينة النبيين! كما أن (الخاتم) زينة الإصبع!ولو كانوا طلاباً للحقيقة لرجعوا إلى القراءة الأخرى الثابتة: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ بكسر التاء، وكذلك إلى الأحاديث الصحيحة الغزيرة الصريحة مثل “لا نبي بعدي”.
ومثل ذلك تأويلهم للآيات التي تناقض مذهبهم الذي يوجب طاعة أولي الأمر من الكفار المستعمرين (وقد كانوا هم الإنجليز الحاكمين للهند في عصرهم) فقالوا في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (النساء: 59)، فالآية صريحة في أن أولي الأمر الواجبة طاعتهم هنا -بعد طاعة الله ورسوله- يجب أن يكونوا من المؤمنين المخاطبين بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ، أما الكفار فليسوا منهم، ولا سيما إذا كانوا غزاة مستعمرين. ولكن هؤلاء يؤوِّلون كلمة “منكم” التي تفيد البضعية بدلالة “من” ليجعلوا معناها “فيكم”! وهذا هو التبديل لكلمات الله تعالى.
وكذلك أوَّلوا ما استفاض في القرآن من آيات الأنبياء، من الخوارق والمعجزات التي أيَّد الله بها رسله مثل عصا موسى، وانقلابها حيّة تسعى، وضربه بها البحر حتى النفق، فكان كل فِرق كالطود العظيم، وضربه بها الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً، إلى آخر الآيات البيِّنات التسع. ومثل إحياء عيسى الموتى، وإبرائه الأكمة والأبرص بإذن الله، ونفخه في الطين المصور فيكون طيراً بإذن الله، إلى غير ذلك من معجزات الأنبياء.
وكذلك إلغاؤهم فريضة الجهاد، ليتم تعبيد الأمة للكفار المستعمرين.
– تأويلات البهائية:
وأسوأ من هؤلاء: طائفة “البهائية” الذين جاؤوا بدين جديد، له نبوَّة جديدة، وكتاب جديد، وشريعة جديدة، غيَّروا فيه كل شيء، حتى السنة والشهور والأيام، وأبطلوا فيه الفرائض، واستباحوا المحرّمات. ومع هذا أبَوْا إلا أن يتمسحوا بالقرآن العزيز، ويستدلوا على باطلهم بحقه، ويحرِّفوه عن مواضعه باسم “التأويل” ليفتروا على الله الكذب: ﴿قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ﴾ (يونس:69).
فقد ذكروا في قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ . عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ . الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ .كَلَّا سَيَعْلَمُونَ . ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ (النبأ: 1-5): أن النبأ العظيم هو ظهور “البهاء” ودعوته التي سيختلف فيها الناس!39
وهل كان مشركو قريش والعرب الذين نـزل القرآن يخاطبهم مختلفين في أمر البهاء أم في أمر البعث والجزاء، كما دلَّت على ذلك الآيات التالية من السورة؟
وذكروا في قوله تعالى: ﴿وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ . يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾ (قّ:41-42): أن المراد بالخروج خروج البهاء.40 والخروج كما جاء في أوائل السورة يعني: خروج الموتى من قبورهم للبعث والحساب، كما قال تعالى: ﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ (قّ:11)؛ ولذلك قال بعد الآية السابقة: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ . يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ (قّ:43-44)، فيوم الخروج هو يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً، ليخرجوا من الأجداث كأنهم جراد منتشر.وهؤلاء ليسوا إلا امتداداً للباطنية القدامى، الذين لا يؤمنون بقرآن ولا سُنَّة ولا دين، وإنما يتخذون النصوص معاول لهدم الإسلام، كل الإسلام.
* من سوء التأويل حول الشريعة:
على أن أكثر ما نعاني من سوء التأويل في عصرنا، أصبح فيما يتعلق بأحكام الشريعة، أكثر منه في دائرة العقيدة. وخصوصاً بعد أن نجح الاستعمار الغربي في تعطيل الشريعة نحو قرن من الزمان أو يزيد، وإحلال قوانينه الوضعية محلها، وإنشاء تقاليد جديدة مخالفة لأوامرها، وتكوين عقليات مؤمنة بفلسفتها، جاهلة بتراثها، غريبة عن أمتها، واهية الثقة والصلة بربها وشرعها.
– سوء التأويل لآيات الحدود:
– سوء التأويل لآيات الحدود:
ومن نماذج هذا اللون من سوء التأويل ما ذكره المرحوم الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون41 لكاتب ممن سماهم أصحاب الاتجاه الإلحادي في التفسير،42 قال هذا الكاتب تحت عنوان “التشريع المصري وصلته بالفقه الإسلامي”:
“قرأت في السياسة الأسبوعية الغراء مقالاً بهذا العنوان.43 حوى أفكاراً أثارت في نفسي من الرأي ما كنت أريد أن أرجئه إلى حين، فإن النفوس لم تتهيأ بعد لفتح باب الاجتهاد، حتى إذا ظهر المجتهد في هذا العصر برأي جديد، كتلك الآراء التي كان يذهب إليها الأئمة المجتهدون في عصور الاجتهاد، قابلها الناس بمثل ما كانت تقابل به تلك الآراء من الهدوء والسكون، وإن بدا عليها ما بدا من الغرابة والشذوذ، لأن الناس في تلك العصور كانوا يألفون الاجتهاد، وكانوا يألفون شذوذه وخطأه، إلفهم لصوابه وتوفيقه، أما في هذا العصر، فإنَّ الناس قد بَعُدَ بهم العهد بالاجتهاد، حتى صار كل جديد يظهر فيه شاذاً في نظرهم، وإن كان في الواقع صواباً”.
ثم أشاد بما كتبه صاحب المقال المشار إليه، ثم قال: “ولكن يبقى بعد هذا في تلك الحدود ذلك الأمر الذي سنثيره فيها، ليُبحث في هدوء وسكون، فقد نصل فيه إلى تذليل تلك العقبة التي تقوم في سبيل الأخذ بالتشريع الإسلامي من ناحية تلك الحدود بوجه آخر جديد… وسيكون هذا بإعادة النظر في النصوص التي وردت فيها تلك الحدود، لبحثها من جديد بعد هذه الأحداث الطارئة، وسأقتصر في ذلك -الآن- على ذكر ما ورد في تلك الحدود من النصوص القرآنية، وذلك قوله تعالى في حد السرقة: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (المائدة:38-39)، وقوله تعالى في حد الزنى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور:2)، فهل لنا أن نجتهد في الأمر الوارد في حد السرقة وهو قوله تعالى: ﴿فاقْطعوا﴾ والأمر الوارد في حد الزنى وهو قوله تعالى: ﴿فاجْلِدوا﴾ فنجعل كلا منهما للإباحة لا للوجوب، ويكون الأمر فيهما مثل الأمر في قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف:31)، فلا يكون قطع يد السارق حداً مفروضاً، لا يجوز العدول عنه في جميع حالات السرقة، بل يكون القطع في السرقة هو أقصى عقوبة فيها، ويجوز العدول عنه في بعض الحالات إلى عقوبات أخرى رادعة، ويكون شأنه في ذلك شأن كل المباحات التي تخضع لتصرفات ولي الأمر، وتقبل التأثر بظروف كل زمان ومكان.
ثم أشاد بما كتبه صاحب المقال المشار إليه، ثم قال: “ولكن يبقى بعد هذا في تلك الحدود ذلك الأمر الذي سنثيره فيها، ليُبحث في هدوء وسكون، فقد نصل فيه إلى تذليل تلك العقبة التي تقوم في سبيل الأخذ بالتشريع الإسلامي من ناحية تلك الحدود بوجه آخر جديد… وسيكون هذا بإعادة النظر في النصوص التي وردت فيها تلك الحدود، لبحثها من جديد بعد هذه الأحداث الطارئة، وسأقتصر في ذلك -الآن- على ذكر ما ورد في تلك الحدود من النصوص القرآنية، وذلك قوله تعالى في حد السرقة: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (المائدة:38-39)، وقوله تعالى في حد الزنى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور:2)، فهل لنا أن نجتهد في الأمر الوارد في حد السرقة وهو قوله تعالى: ﴿فاقْطعوا﴾ والأمر الوارد في حد الزنى وهو قوله تعالى: ﴿فاجْلِدوا﴾ فنجعل كلا منهما للإباحة لا للوجوب، ويكون الأمر فيهما مثل الأمر في قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف:31)، فلا يكون قطع يد السارق حداً مفروضاً، لا يجوز العدول عنه في جميع حالات السرقة، بل يكون القطع في السرقة هو أقصى عقوبة فيها، ويجوز العدول عنه في بعض الحالات إلى عقوبات أخرى رادعة، ويكون شأنه في ذلك شأن كل المباحات التي تخضع لتصرفات ولي الأمر، وتقبل التأثر بظروف كل زمان ومكان.
وهل لنا أن نذلل بهذا عقبة من العقبات التي تقوم في سبيل الأخذ بالتشريع الإسلامي؟ مع أننا في هذا الحالة لا نكون قد أبطلنا نصاً، ولا ألفينا حداً وإنما وسَّعنا الأمر توسيعاً يليق بما امتازت به الشريعة الإسلامية من المرونة والصلاحية لكل زمان ومكان، وبما عُرِفَ عنها من إيثار التيسير على التعسير، والتخفيف على التشديد. أ.ﻫ. “44
وهذا الاجتهاد المزعوم -وفق هذا التأويل الرديء- مردود على صاحبه لأنه اجتهاد فيما لا مجال للاجتهاد فيه، لأنه أمر قطعي ثابت بالكتاب والسنَّة وإجماع الأمة، ومعلوم من الدين بالضرورة.
والأمر في هذا المقام لا يمكن أن يفهم منه الإباحة بحال، إذ الأصل في الأمر الوجوب أو -على الأقل- الاستحباب، ولا يخرج عنهما إلا بقرينة، ولا قرينة هنا.والأمر في الآية التي استدل بها على أنه للإباحة -وهي: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف:31) ليس كما توَّهم، فقد بيَّن الإمام الشاطبي في موافقاته: أن الأكل والشرب وأخذ الزينة هنا واجب بالكل، مباح بالجزء، فإن بني آدم لا يجوز لهم أن يمتنعوا عن الطعام والشراب والتزين، وخصوصاً الحد الأدنى منه هو ستر العورة- بدعوى التنسك أو التزهد، أو مقاومة الجسد أو ترقية الروح أو نحو ذلك، وإن أبيح لهم ذلك في وقت معيَّن، أو لسبب معيَّن، وهذا معنى أنه مباح بالجزء. وينبغي مراجعة تحقيق الشاطبي هنا فهو في غاية النافسة.
ولو نظرنا إلى القرائن المحيطة بالنص، لوجدناها كلها تنادي بالوجوب، بل تؤكده.
وكيف يكون الأمر هنا للإباحة، وهو يقول: ﴿جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (المائدة: 38)، وكيف رفض أي شفاعة في حدود الله من أحب الناس إليه، وهو أسامة بن زيد، وقال لهrالنبي منكراً: “أتشفع في حدٍ من حدود الله يا أسامة”؟ وكيف قال قولته المعروفة: “وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها”!
وكي يكون الأمر في جَلْد الزانية والزاني للإباحة، وهو يقول عقبه: ﴿وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور:2)، فَلِمَ كل هذا التحريض والإلهاب؟
إن هذا التأويل -لو صحَّ- لجاز أن يقول قائل في آيات أُخر، أو أمر آخر، القول نفسه، ويؤوِّلها التأويل نفسه، مثل قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (البقرة:238)، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (البقرة: 267)، ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (البقرة:110، المزمل: 20).
﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ﴾ (الصافات: ة9) أي وأولئك لهم عذاب دائم، لتقصيرهم عن البحث في سر عظمة هذا الكون، والوصول بذلك إلى عظمة خالقه، وبديع قدرته.
ثم بين من وفقهم الله وأنعم عليهم ممن ظفروا بالمعرفة فقال:
﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ (الصافات:10)، أي إلا من لاحت له بارقة من ذلك الجمال، وعنّت له سانحة منه، فتخطف بصيرته كالشهاب الثاقب، فحنّ إلى مثلها، وصبت نفسه إلى أختها، وهام بذلك الملكوت العظيم باحثاً عن سر عظمته، ومعرفة كنه جماله، وهم من اصطفاهم الله من عباده، وآتاهم الحكمة من لدنه، وأيدهم بروح من عنده، وهم أنبياؤه وأولياءه الذين أنعم عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين.
والخلاصة -أن الدنيا بيت فرشه الأرض، وسقفه السماء، وسراجه الكواكب، والبيوتُ الرفيعة العماد، العظيمة البناء، كما تزين بالأنوار تزين بالنقوش التي تكسبها لألاء وبهجة في عيون الناظرين، ولكن لن يصل إلى إدراك تلك المحاسن إلا الملائكة الصافّون، والأنبياء والعلماء المخلصون، أما الجهال والشياطين المتمرِّدون من الجن والإنس فأولئك عن معرفة محاسنها غافلون، فلقد يعيش المرء منهم ويموت وهو لاهٍ عن درك هذا الجمال، فتخطف بصائرهم كالشهاب الثاقب، فيخطفون منها خطفة يتبعها قَبَس من ذلك النور يضيء، وينير ألبابهم، فيكونون ممن كتب الله لهم السعادة، وقيّض لهم التوفيق والهداية، وممن اصطفاهم ربهم برضوانه، والفوز بنعيمه.هذا ما قاله الشيخ أحمد مصطفى المراغي في تفسير هذه الآيات، ثم عقب في الحاشية فقال:
وقد نحونا بهذا نحواً آخر يخالف ما في كثير من التفاسير، إذ أنهم قالوا: إن خطف الخطفة كان من الشيطان حين أراد أن يسترق السمع، ويأخذ أخبار السماء، فأتبعه شهاب ثاقب فأحرقه، ولم يستطع أخذ شيء منها، وعصم الله وحيه وكتابه. أ.ﻫ.45
ورحم الله الشيخ، فقد أبعد النجعة، وشطح شطحا بعيداً، بعد به عن المنهج القويم، وقد قال تعالى على لسان الجن: ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً . وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً﴾ (الجـن:8-9). والمعنى واضح كالشمس.
فالأمر -وفقاً لهذا التأويل- في هذا الآيات كلها للإباحة لا للوجوب، فمن شاء فليُصل، ومن شاء فليُزك وليُنفق، ومن لم يشأ فلا جُناح عليه، فلم يترك إلا أمراً مباحاً، من فعله أُثيب عليه، ومن تركه فلا إثم علي!
وكذلك يقال في كل الأوامر القرآنية: إذ لا فرق بين أمر وأمر. وهذا هو العبث بعينه، أو هو تبديل لدين الإسلام بدين جديد.
– من تكلفات بعض المفسرين المعاصرين:
ومما نأسف له: ما وقع من تكلف واعتساف في التأويل، لبعض المفسرين المعاصرين، مثل صاحب (تفسير المراغي). فقد ذكر في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ . وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ . لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ . إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ (الصافات:6-10) كلاماً متكلفاً، بعيداً عن المتبادر، ولا دليل عليه من شرع ولا عقل، ولا عرف. يقول عفا الله عنا وعنه:
﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ﴾ أي جعلنا الكواكب زينة في السماء القريبة منكم بما لها من البهجة والجمال، وتناسب الأشكال وحسن الأوضاع، ولا سيما لدى الدارسين لنظامها، المفكرين في حسابها، إذ يرون أن السيارات منها متناسبة المسافات، بحيث يكون كل سيار بعيداً من الشمس ضِعف بُعد الكوكب الذي قبله.
﴿وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ﴾، أي وحفظنا السماء أن يتطاول لدرك جمالها، وفهم محاسن نظامها، الجهّالَ والشياطين المتمردون من الجن والإنس، لأنهم غافلون عن آياتنا، معرضون عن التفكير في عظمتها؛ فالعيون مفتحة، ولكن لا تبصر الجمال ولا تفكر فيه، حتى تعتبر بما فيه.
﴿لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى﴾ أي إن كثيراً من أولئك الجهال والشياطين محبوسون في هذه الأرض، غائبة أبصارهم عن الملأ الأعلى، لا يفهمون رموز هذه الحياة وعجائبها، ولا ترقى نفوسهم إلى التطلع إلى تلك العوالم العليا، والتأمل في إدراك أسرارها، والبحث في سر عظمتها.
﴿َيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُوراً﴾ أي وقد قذفتهم شواتههم وطردتهم من كل جانب، فهم تائهون في سكراتهم، تتخطفهم الأهواء والمطامع والعداوات والإحن، فلا يبصرون ذلك الجمال الذي يشرق للحكماء، ويبهر أنظار العلماء، ويتجلى للنفوس الصافية ويسحرها بعظمته، وهم ما زالوا يدأبون على معرفة هذا السر حتى ذاقوا حلاوته، فخروا ركعاً سجداً مذهولين من ذلك الجمال والجلال.
المصدر: مجلة إسلامية المعرفة، العدد 8
2010