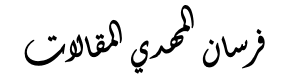من طرائف العلمانية العربية
 |
| من طرائف العلمانية العربية |
قدم الأستاذ العظمة محاضرة بعنوان “تاريخ الله” في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة تونس الأولى…….ولست أنوي مناقشة أفكار الأستاذ العظمة لذاتها ولا خاصة مناقشة ما جاء في محاضرته-ليس لأني لم أحضر المحاضرة فحسب لأن ذلك أمر تداركه ممكن بعد أن صارت المحاضرة متداولة وقد نقل منها الأستاذ الخويلدي مقتطفات مهمة- إنما أريد استخراج الأسانيد النظرية التي يعتمدها المتكلمون في المسألة الدينية على نحو يصح عليه قول ماركس في العلاقة بين إعادة التاريخ لنفسه والتاريخ المضاهية للعلاقة بين الكوميدي مع التراجيدي من الأحداث ومن التعبير الفني عنها.
فما كان في نقد النصوص التوراتية محاولات لتأسيس علم مستند إلى فقه اللغة لتحديد طبقات نص يعلم الجميع أنه متوالي التحرير على قرون صار في تكراره بنفس الأسلوب على القرآن مضغا لكليشيهات ليس لها معنى خاصة وهو لا يعتمد إلا تعميم بعض البسائط من مناهج فقه اللغة والتحليل الانثروبولوجي للذهنيات وللأسطوري يقدمها على أنها مستحدثة وهي مما أكل الدهر عليه وشرب[1]. لذلك فسأعتبر محاضرة تاريخ الله عينة من هذه الممضوغات التي لم يراجع أصحابها أسانيد فكرهم الفلسفية بحسب ما أعلم من الخاصيات التي طغت على كتابات العلمانيين العرب. ولعل ما يتميز به الأستاذ العظمة عن غيره منهم من الاتزان والمعرفة بالتراث والتمكن من اللغة العربية وفنيات البحث أمور يمكن أن تجعل فكره أفضل مثال يضرب على ما يصح من باب أولى في فكر البقية التي هي دونه دراية بالفكرين الغربي والإسلامي رغم كثره كلامهم عليهما وعلى ما ينبغي أن تكون عليه الدراسات الدينية[2].
لعل مناقشة هذه الأسانيد بأكثر ما يمكن من الهدوء لعلها تمكن من تحديد جسور للحوار بين صفي النزاع في المسألة الدينية بمقتضيات سياقها الإسلامي الذي يساء فهمه بمجرد إسقاط خصائص الدين المسيحي عليه ومحاولة فرضها لفهم الديني عامة دون أن أنكر أن هذه المسألة وعلاجها المفروض من منطلق هذا المنظور باتت اليوم بيت القصيد في مشروع النهوض العربي الإسلامي خاصة بعد أن تجاوزت المسألة طابعها الخاص بالمسلمين لتصبح مسألة كونية. فقصارى ما في فكرهم يمكن رده إلى ما يبدو أحكاما مسبقة وعامة سندها الوحيد هو:
انطلاقهم من صورة للحداثة شوهوها جهلا حينا وتجاهلا آخر.
للرد على صورة للإسلام بالغوا في تشويهها غفلة حينا واستغفالا آخر.
فالمعلوم أنه لا علاقة لصورتهم عن الإسلام به بل هي ثمرة ناتجة عن محاكمة للإسلام بمعيار المسيحية بعدما سلموا بكلية تمثيلها للديني في الأديان. فصورتهم عن الفكر الإسلامي كما تعين عند كبار علمائه (الغزالي وابن رشد وابن تيمية وابن خلدون مثلا) لا علاقة لها به فضلا عن عدم العلاقة بنص القرآن والسنة حتى في شكلهما المدون الذي يتهمونه. والمعلوم كذلك أن صورتهم عن الحداثة لا علاقة لها بها بل هي ثمرة ناتجة عن محاكمة لتاريخ التمدن الإنساني بمعيار مزيج بين يعقوبية الثورة الفرنسية والمادية التاريخية الماركسية كما نبين إن شاء الله. فصورتهم عن الفكر الحديث لا علاقة لها به إذا أخذناه كما تعين عند كبار فلاسفته (كنط وهيجل وبيرس وهيدجر مثلا) وحتى الماركسية إذا حررناها من القراءة الاختزالية التي بقيت سجينة شكلها الجنيني أعني ما تقدم على التعديلات التي مكنت كبار مفكريها من تجاوز ما مرت به من أزمات وما اقتضته من إصلاحات ألغت هذه الصورة البدائية.
فجل كلامهم لا يمكن أن يفهم إن لم يكن كله إلا برد وجهه الإسلامي إلى صورة فقه الانحطاط المشوهة عن الإسلام[3] وبرد وجهه الغربي إلى هذه الصورة الماركسية المشوهة عن الحداثة الغربية. لذلك فالمحاضرة لن تكون موضوع كلامي بل هي مجرد مناسبة ومثال لأحلل مسلمات العلمانيين العرب بصورة عامة بعد تحديدها تحديدا نسقيا.
ورغم قناعتي بأن فكرهم لا يستأهل المناقشة الفلسفية الجذرية جملة ولا تفصيلا بعد ما قرأت للبعض وحاورت البعض وجها لوجه لمجرد غلبة هاتين الصفتين عليه غلبة لا ينكرها إلا معاند فإني سأقدم على ذلك هنا مكتفيا بمناقشة ما يؤسسها من مسلمات دون التوقف عند عرضياتها الثانوية التي لا تتجاوز كونها مجرد فتح لأبواب لم تبق أبوابا بعد أن خلعت فصارت مبدلات طريق سيارة وحيدة منذ أكثر من قرن في الغرب وهي من المبتذلات في الثقافة العربية قبل الانحطاط منذ نزول القرآن أي منذ ما يقرب من ألفية ونصف[4].
إن ما أريد الكلام عليه يقبل الرد إلى موضوعة واحدة رئيسية يلخصها بصورة ضمنية عنوان هذه المحاضرة[5] عنوانها الذي يظنه صاحبها اكتشافا رغم أن ما فيه استفزاز مجاني لخصمائه المفروضين يغلب عليه دور العلامة حاسمة الدلالة على قصور الفكر العلماني العربي بصورة عامة. فهذا العنوان يوجز كل فكره في الإسلام الذي لخصه هو نفسه في بحثه “الخطاب الملتهم للزمان Chronophagous Discourse“ والذي بنت عليه السيدة أنجيليكا نويفرت-وعلى تصور مثيل يكثر الكلام عليه الصحفي والمؤرخ سمير قصير-في مقال لها بعنوان:”أن ندرس القرآن في أوروبا كنص أوروبي Den Koran in Europa lehren – als europäischen Text” الكثير من النتائج العرية عن التعليل المقنع: إنها مسألة الصلة بين التاريخ والمدونة الدينية في بنيتها العقدية.
كل ما أسعي إليه لا يهدف إلى مناقشة آراء الأستاذ العظمة ولا مواقفه بأعيانها كما تجلت في كلامه على تاريخ الله أو آراء غيره من العلمانيين العرب ومواقفهم من مسائل فرعية بأعيانها بل تحديد المسلمات التي تجعل آراءهم ومواقفهم الأساسية ممكنة لفحصها فبيان ما تتصف به من وهاء خاصة وهم يعتبرونها فوق المساءلة والفحص النقدي:فهم يشكون في كل شيء عدا شكهم كما قال هيجل أعني أن نقدهم لا ينعكس على ذاته ومن ثم فهو عديم التفكر. وبإيجاز فإن ما أسعى إليه هو الجواب عن الأسئلة التالية التي يغفلها المجادلون في المسألة الدينية بسبب عدم التفكر جوابا ستكون حصيلته إثبات أنهم لا يتكلمون على الحداثة والإسلام بل على صورتين مشوهتين منهما ينفيها التاريخ الذي يزعمون الكلام باسمه والمنهج العقلاني الذي يزعمون انتهاجه:
السؤال الأول: ما طبيعة الإشكالية وكيف نحررها من خلال فهم المناخ الفكري الذي يجري فيه النقاش بين العلمانيين العرب وكل من يريد أن يعالج المسائل علاجا فلسفيا لا يسلم بمنطلقاتهم التي صارت دوغما يعتبرونها فوق النقاش ؟
السؤال الثاني: ما دلالة عنوان من جنس “تاريخ الله” –إذا تجاوزنا مجرد الاستفزاز-بخصوص فكر العلمانيين العرب خلال كلامهم على الظاهرات الدينية ؟
السؤال الثالث: هل طابع الحدث العرضي Kontingent في التاريخي هو المحدد لدلالة الأمور في الشؤون البشرية دينية كانت أو علمية ؟
السؤال الرابع: هل صحيح أن البناء العقدي –الذي هو أكسيومية تعليمية في باب المعتقدات-يلغي البعد التاريخي من الحدث الديني؟
السؤال الخامس: هل اعتبار القرآن بداية جديدة يعني أنه ينفي التاريخ المتقدم في ما ليس هو فيه بداية جديدة بمعنى التحول في مجاله ؟
ونختم بكلام يعيدنا إلى السؤال الأول من حيث هو أساس كل الأسئلة وليس بوصفه أحدها فحسب. والهدف هو أن نفهم لِمَ كان المنطلق الأساسي في كل أحكام العلمانيين العرب المسبقة التسليم المجاني بالإلحاد المؤسس للمادية التاريخية كما يدل على ذلك رد الظاهرات الدينية إلى ما في الوعي الإنساني عنها من تصورات لا تتعداه إلى حقيقة واحدة ذات قيام ذاتي خارج تصوراتنا مهما تعددت الأسماء في غالب الأديان والفلسفات ؟
المسألة الأولى: تحرير الإشكالية وتحديد مناخ النقاش
ولأبدأ فأقدم بعض الملاحظات العامة ولنعتبرها محددة للإشكالية وتحريرا لها ينطلق من فهم مناخ النقاش مع العلمانيين العرب عامة. فقد لا يصدقني من يظن اختلاف العناوين كافيا لإفادة تعدد المضامين لو قلت إن زبدة الكتابات التي تمثل أدبيات العلمانيين العرب لم تتجاوز فكرة واحدة[6] لا يكاد يخلو منها مصنف من مصنفاتهم أعني ما لخصته السيدة أنجيليكا نوفرت الباحثة في الدراسات القرآنية بهذه الجملة الوجيزة استنادا إلى الأستاذ العظمة: “إذا اتبعنا (=أخذنا برأي) عزيز العظمة المؤرخ والناقد الثقافي فإن النص الرسمي[7] (=المصحف العثماني والسنة) لا يدعي الصحة الأبدية فحسب بل هو ينتظم انتظاما غير تاريخي”[8]. فكل الأمر عندهم يدور حول النقد الذي اقتصر على المجادلة في دلالة دعويين واحدة ينسبونها إلى الصف المقابل والأخرى يتبنونها. وكلتا الدعويين ليس لهم عليهما دليل:
1-ما ينسبونه دون دليل إلى النص بصورته الرسمية أو حتى إلى الفكر الفقهي والكلامي من دعوى التعالي على التاريخ تعاليا يستثنيه.
2-وما يدعونه ويتبنونه دون تأسيس من أن بنية النص في صوغه الرسمي تفرض ذهنية إسلامية لاتاريخية فتنفي التاريخية مطلقا.
وهو نقد ليس له الطابع الماركسي إلا في الظاهر لأنه يبقى في كل الأحوال دون دلالة النقد الماركسي العميقة. فالتعالي على التاريخية لا يعني نفي التاريخية بل هو يعني أنها ليست أحداث فوضوية لا يحكمها قانون ولا منطق. ولولا ذلك لما كان لصيرورة المراحل في المادية التاريخية نحو تحقيق القيم الكلية معنى ولولاه لما كان فعل الثورة مساعدا ومسرعا لهذا التوجه بحيث تكون عنفا خالصا ولا أساس لها في رؤية العالم الاشتراكية. فكون الصيرورة التاريخية صاعدة نحو كلية القيم المحققة لكرامة الإنسان يعني أن التاريخ ذو منطق متعال عليه حتى وإن كان لا يظهر إلى في تعيناته المتوالية.
لذلك كان النقد الماركسي الحقيقي يعترف بالطابع المتعالي لمطالب الدين حتى وإن حصر أثرها في مستوى الخيال بحيث صار فعل الماركسية الثوري في الغاية تحقيقا لما يحلم به هذا الخيال الديني ولا يكون الفرق بين النظرتين إلا في عدم تأجيل الماركسية تحقيق القيم إلى يوم الدين وعدم لجوء الدين المسيحي المبدئي إلى العنف الثوري لتحقيقها. وكلتا الخاصيتين المميزتين لا تنطبق على الدين الإسلامي:
فهو لا يؤجل تحقيق القيم إلى مملكة السماء بل إن وجود الإنسان في الأرض أصبح وجودا ذا رسالة وليس بالأمر الذي ينبغي الرغبة عنه أو التأفف منه. ذلك أن استعمار الأرض صار مهمة الإنسان بشرط أن يكون فيها خليفة بمعنى كونه ساهرا على تحقيق شريعة الله بحيث لا تكون الرغبة في الحياة الكريمة أمرا منهيا عنه وهو معنى وعد الصالحين بإرث الأرض.
وهو من ثم لا ينفصل فيه العقد عن الفعل التاريخي الثوري لملازمته الجهاد السياسي من أجل تحقيق قيمه ولو بالحرب لكونه لا يستثني استعمال القوة الشرعي عند اللزوم (وهو ما يميزه عن المسيحية في معناها المثالي المخالف لحقيقتها التاريخية لأن مبشريها كانوا دائما في ركاب جبارة السلطان الزماني) ما يجعل الروحي في خدمة الزماني بعكس الفهم الإسلامي[9].
لكن أصحاب هذا النقد غير الموضوعي-بسبب الجمع المتناقض بين العلموية والتاريخية – لا يهمهم ما للجميع من علم بأن الهم التاريخي والتغيير الفعلي هو جوهر الفكر الديني في جميع الأديان بأساليب مختلفة سواء رغبة في الدنيا أو رغبة عنها-ومن بينها العنف الثوري الشرعي- وهذا الهم هو في الإسلام أكثرها بروزا لأن المسلم المخلص لرسالة القرآن لا يستحي من الحق ولا يقبل بالنفاق الذي يتكلم عن مد الخد الثاني ويؤلب الحملات الصليبية ويبارك إفناء الهنود الحمر فضلا عن ركوب الدبابة الأمريكية في جل أقطار دار الإسلام. فجوهر المضمون القرآني هو السعي الفعلي لتحقيق القيم بوسائل التحقيق التاريخية التي جهز بها الإنسان ليستعمر الأرض ويستخلف فيها من حيث هو عالم (اجتهاد) وعامل (جهاد) فضلا أن المصنفات الإسلامية أي كان مجال بحثها لا يكاد أي منها يخلو من البعد التاريخي بوجهه العملي (أي السياسة من حيث هي نظام حكم ونظام توزيع للثروة والمنزلة في السلم الاجتماعي) شرطا في علمه وعمله.
كما لا يعنيهم أن يكون التفكير في ما بعد التاريخ المؤسس لعلم التاريخ لم يكد التفكير فيه يبلغ ذروته حتى تلازم مع أرخنة الفلسفة (الفلسفة عند ابن خلدون هي التراكم المعرفي بمقتضى العقل بخلاف النقل الذي هو سنن وتقاليد سواء كانت منزلة أو طبيعية) وفلسفة التاريخ (باطن التاريخ أي حقيقته أنه بحث عن علل الأحداث والظاهرات العمرانية وتفسيرها) إلا عند المسلمين وما كان في بداية الثورة القرآنية موضوع هم ديني وجودي دون أن يكون مقصورا عليه -بدليل القصص القرآني من حيث هو مراجعة نقدية لكل تاريخ البشرية غير مقصور على ما في المنزل من الأديان وبدليل تأسيس بداية جديدة للتحديد التاريخي رمزها تغيير القبلة-صار في مرحلة نضوجها هما إبستمولوجيا رغم استثناء الفكر الفلسفي اليوناني إياه من المعرفة العلمية لتعلقه بالعرضي من أعراض الوجود[10].
ومن ثم فالمشكل مع هؤلاء النقاد- الذين لا ينقدون النقد لأنهم لم يسمعوا بما بعده الهردري وبقوا سجناء أدنى درجات فلسفة الوعي الغفل-ليس في وجود التاريخية في الفكر العربي الإسلامي أو عدم وجودها -إذ يمكن ألا يجد البعض منهم بد أو حتى حرجا من التسليم بهذه الحقيقة ولعل في أهم مقاصد كلام الأستاذ العظمة في ما كتبه عن أحد أهم أعلام الفكر الإسلامي وعن علاقة السياسي بالديني في كل الأديان دليلا على ذلك[11]-بل هو يكمن في ظنهم-خلافا لأي مفكر علماني غربي جدي- المسألة التي تخص طبيعة العلاقة بين التاريخي والمتعالي عليه[12] مسألة محسومة بمستويي قيام الموضوعات التي يدور حولها الخطاب عامة والخطاب الديني خاصة.
ذلك أننا سنرى أن المسألة غير محسومة بل هي لا تقبل الحسم أصلا-وفي ذلك يكمن جوهر الإنساني المتعالي على دائما على التعين الكياني-وأن مستويي القيام اللذين سنحدد طبيعتهما لا يتقوم بهما الخطاب الديني وحده بل هما يقومان كل خطاب بما في ذلك الخطاب الإبداعي الشعري والروائي فضلا عن الخطاب العلمي حتى وإن جهل العلمانيون ذلك أو تجاهلوه. وبمقتضى هذا المعيار يمكن تصنيف أجناس الخطاب الأصلية. فهي لا تتعدى الخمسة التالية كما بينا في الكثير من بحوثنا السابقة. وهي الخطاب الأصلي الذي يمكن القول إنه عبارة الفطرة أو المادة الخام من حيث هي نظام رموز عام مشترك بين البشر والشارطة لكل الرموز الأخرى بما في ذلك الرمز اللساني.
وهذه الرموز الأساس هي خام كل خطاب عائد عليها وهي من ثم ذات وجود في الأعيان حتما لأنها عين دلالاتها ولا يتميز فيها الدال عن المدلول لذلك فهي لا تكتفي بالقيام في الأذهان لأنها عين الأفعال والانفعالات “الرامزة-المرموزة” والغنية عن الكلام والشارطة لكل أصناف الرموز الفرعية الأخرى بما فيها الرمز اللساني. وعلى أساسها تتكون أصناف الخطاب الصناعي التي يمكن أن تكون ذات مرموزات مقصورة على الأذهان دون أن يستثني ذلك تحققها في الأعيان. إنها الخطابات الفرعية التي هي بعدتها مع واحد والتي هي متنوعة بتنوع التجارب التاريخية بمعنى التاريخ الطبيعي لا التاريخ الثقافي فحسب. وطبعا فهذه الخطابات الصناعية تعود على الخام فتؤثر فيه وقد تفسده بحصره في التجربة التي صيغت صناعيا بأثر من الخطاب الصناعي.
فأما الخطابات الأصلية أو لغات التواصل الأصلية المتقدمة على التواصل اللساني والشارطة له فهي:
1-خطاب الذوق فعلا وانفعالا (التجربة العاطفية المعيشة وهي مادة الحوادس الأساسية بل هي عين التواصل الفعلي والرمزي فعلا وانفعالا ليس بين البشر فحسب بل وكذلك بينهم وبين المحيطين الطبيعي والثقافي)
2-وخطاب سلطانه فعلا وانفعالا (أثر التجربة العاطفية المعيشة في علاقة البشر بعضهم بالبعض: نفس ما ذكر في عنصر الذوق ولكن يكون الذوق منظورا إليه من حيث أثره في الغير بصرف النظر عن فائدته الذوقية بحيث يصبح الذوق نفسه ماثلا في ما له به صلة قابلة للرد إلى ما نفسر به الأشكال البلاغية من صلات كالاستعارة والكناية)
3-وخطاب الرزق فعلا وانفعالا (التجربة الغذائية المعيشة وهي مادة الحواس الأساسية بل هي عين التواصل الفعلي الرمزي فعلا وانفعالا ليس بين البشر فحسب بل بينهم وبين المحيطين الطبيعي والثقافي).
4-وخطاب سلطانه فعلا وانفعالا (أثر التجربة الغذائية المعيشة في علاقة البشر بعضهم بالبعض: نفس ما ذكر في عنصر الرزق ولكن يكون الرزق منظورا إليه من حيث أثره في الغير بصرف النظر عن فائدته الرزقية بحيث يصبح الرزوق نفسه ماثلا في ما له به صلة قابلة للرد إلى ما نفسر به الأشكال البلاغية من صلات كالاستعارة والكناية)
5-وخطاب السلطان المطلق أعني القوة المجهولة التي تشخص وينسب إليها حيازة كل ما تقدم ذكره وذلك هو جوهر الدين فعلا وانفعالا كما يحدده القرآن عند كلامه عن الدين الكوني المتعين في الأديان المختلفة طبيعية كانت أو منزلة ويسميه الفطرة (معنى الخطابات السابقة ووعي الإنسان الغامض ومحاولات فهمها من حيث ما يحدد معنى تقويمها لكيانه وهي مادة جامعة للحدس والحس ومتعالية عليهما لكونها هي عين الحضور الواعي بذاته كحضور لذاته ولغيره سواء كان الغير من جنسه أو من غيره).
وأما الخطابات المتفرعة عن الخطابات الأصلية-وكلها لغات وأحدها هو اللغة اللسانية ويغلب عليها جميعا التحديد الثقافي من حيث تعينها شكلا ومضمونا رغم كونها كلية الوجود أي لا يخلو منها عمران بأشكال ومضامين مختلفة التعين وهي في نسبة الدال إلى الخطابات الأصلية التي هي المدلول الكوني من حيث كون الإنسان إنسانا-فهي:
6-فمن خطاب الذوق وخطاب سلطانه يأتي الخطاب النظري بمعنييه المادي والصوري أي فعالية الإنتاج الرمزي والتربوي لحفظه ونقله وتوزيعه وتنظيمه (فلا معرفة نظرية من دون صلة ذوقية بالسؤال المعرفي من حيث هو سؤال معرفي)
7-ومن خطاب الرزق وسلطانه يأتي الخطاب العملي بمعنييه المادي والصوري أي فعالية الإنتاج المادي والسياسي لحفظه ونقله وتوزيعه وتنظيمه (ولا عمل من دون صلة بالرزق مهما كانت غير مباشرة)
8-وتوظيف الفعالية النظرية من أجل حاجة العمل ببعديها المادي والصوري يعطينا الفنون العميلة (التقنية) (الفنون التقنية هي نظر موظف عمليا)
9-وتوظيف الفعالية العملية من أجل حاجة النظر ببعديها يعطينا الفنون الجميلة (الفن) (الفنون الجميلة عمل موظف نظريا)
10-ومن توظيف خطاب السلطان المطلق يـأتي الخطاب الإيديولوجي (الخطاب الإيديولوجي هو توظيف خطاب السلطان المطلق الذي هو ديني حتما لغايات في خدمة الخطابات الفرعية الأربعة المتقدمة على خطاب السلطان المطلق).
11-ويجمع بين الخطابات الخمسة الأصلية والثلاثة الفرعية خطاب واحد ذو وجهين متلازمين هما وجها المعرفة التاريخية الموظفة والمعرفة التاريخية لذاتها أعني الخطاب الأسطوري (وهو كل صوغ بأدوات العصر لخطاب السلطان المطلق) والخطاب التاريخي النقدي (هو كل صوغ يرد الممكن بمنظور الخطاب الديني إلى الحاصل بمنظور الخطاب الإيديولوجي). والخطاب التاريخي هو دائما خطاب نقدي للخطاب الأسطوري للعصر إذا كان حقا تاريخا علميا: التاريخ ليس شيئا آخر غير نقد أسطرة الأحداث ودلالاتها وهو ما أراد ابن خلدون تأسيسه مشترطا بناءه على علم قبلي هو علم العمران البشري والاجتماع الإنساني.
فتكون الخطابات التي لا يخلو منها عمران عشرة خمسة أصلية لا يختلف فيها إنسان عن إنسان إلا بما يأتيها من ترجمة في الخمسة الفرعية التي يختلف فيها إنسان عن إنسان بحسب اختلاف الثقافات بوصفها حلولا لمسائل التعبير عن الخطابات الأصلية.
أما الخطاب النقدي الفلسفي الذي يمثل عودة للخطاب في العمران البشري على نفسه ليجعها مادة خطاب من قوة ثانية فهو الوجه السلبي منها ومن الخطاب ذي والوجهين الاسطوري والتاريخي خاصة (لكونه يرد إليهما كل ما تقدم عليهما من الخطابات في تحديدنا هذا) إذ هما يجمعان ما تقدم عليهما من الخطابات: وهذا الموقف النقدي من الخطابات العشرة دين نقدي حتى لو اقتصر على هذا الوجه السلبي الذي يجعله في نسبة القفا من نفس العملة التي وجهها الدين وهو في الحقيقة جوهر الماركسية إذا حررناها من سورة البداية التي جعلتها إيديولوجيا ثورية في حين أنها في الحقيقة دين دنيوي ربه الإنسان.
فكل ما فيها متناظر مع كل ما في الدين والفرق هو وضع الدنيا بديلا من الآخرة ووضع الإنسان بديلا من الرب ووضع ما يسميه الفعل التاريخي بديلا مما يسميه الوهم الأسطوري. ولعل الماركسية -قبل أن يفسدها الموقف العلموي الوضعي-هي أفضل صورة من هذا المعنى. تلك هي الخطابات الأحد عشر التي يمكن للعقل الإنساني تصورها مع قابلية وجود نسخ منحطة منها لا تتناهي لأن الانحطاط ليس له قاع.
ولما كان المعلوم من التاريخ الإنساني القديم إلى اليوم مداره المراوحة وتنازع السلطة بين هذين الضربين رئاسة الأقوال الرئاسة الدينية والرئاسة الفلسفية في الخطابات فإنه منطلقنا في محاولة فض الخلاف مع علمانيينا هو تنبيههم إلى الحقيقة التالية: فهل يمكنهم أن يواصلوا الوقوف هذا الموقف الذي لا بد له من زعم الاستناد إلى الرئاسة الفلسفية الواحدة للرد على الزعم المقابل والقائل بالرئاسة الدينية الواحدة لكل الخطابات فيتجاهوا أن الرئاستين متلازمتان فيكونوا من جنس من يردوا عليهم قائلين بحقائق لا تاريخية حول التاريخية لكأن كلتا الرئاستين لم تتآكل؟ ألا يرون أن الفلسفة التي افتكت الرئاسة من الدين فصار لها دور القول الرئيس منذ بداية التنوير فقدته هي بدورها منذ بدايات القرن العشرين وخاصة بفضل تجاوز فلسفة الوعي وبفضل النقد النيتشوي والهيدجري؟
إن العلم بهذه الأجناس وبطبيعة دورها دون أن يلغي القراءة الماركسية للتاريخ الإنساني يجعل هذه القراءة إحدى العلاجات الممكنة للعلاقة بين التاريخي وما يتعالى عليه وتبين أن الحسم في مسألة هذه العلاقة مستحيل ومن ثم فكل زعم بأن أحد الحلول يلغي الحسوم الأخرى: فجميعها من حيث هي حسوم دعاوى ليس عليها دليل كاف بل هي تحكم ووهم. لكننا سنكتفي بعلاج أوجه المسألة في الخطابين الديني والعلمي-إذ سبق فعالجناها في الخطاب الإبداعي في كتابنا الشعر المطلق والإعجاز القرآني من حيث علاقته بالخطابات الأصلية العلاقة التي تجعلها مبدعة بقدر تحررها من الأثر الثقافي الذي للخطابات الاصطناعية المتفرعة عنها لإعادة التعبير البكر عن الخطابات الأصلية كتجارب حية لا يحيط بها أي تعبير إحاطة مستوفية-لكون موقف هؤلاء المتعالمين يجعل الخطاب العلمي معين حججهم ضد الخطاب الديني فيفسدون كلا الخطابين رفعا للأول إلى مقام الثاني (إطلاق العلم مثل الدين) وحطا للثاني إلى مقام الأول (تنسيب الدين مثل العلم)ومن ثم بقلب خصائصهما[13]:
1-مستوى القيام الأول هو ضرب الوجود في المتن التعليمي سواء تعلق بالعقائد الدينية (الأديان) أو بالنظريات العلمية (العلوم): فلا يمكن المفاضلة بين الضربين المعهودين والمتلازمين ضرب القيام التاريخي وضرب القيام الأكسيومي مع ما بينهما من تفاعل في الاتجاهين ينتج ضربين مزيجين أحدهما يغلب عليه التاريخي وينحو إلى الأكسيومي طلبا لنظام الصيرورة والثاني عكسه طلبا لصيرورة النظام وأصل ذلك كله هو السعي اللامتناهي للمطابقة بين الترتيب الوجودي الذي لا ندري ما طبيعة معقوليته والترتيب المنطقي الذي تبدو لنا معقوليته عين نظام عقلنا الذي نسقطه على الوجود فنعتبره عين عقلانية الموضوعات التي يدركها العقل الإنساني مع العلم بتعذر المطابقة وإلا لكان مجرد التأمل العقلي في الشيء هو عين الشيء: بحيث إن العلم ببعد التاريخية الذي له يبقى خارج ذاته لمجرد كونه لا يقتصر على بنائه الأكسيومي.
2-ومستوى القيام الثاني هو ضرب الوجود في قيام الحقائق الذاتي سواء كان قياما في الذهن أو قياما في العين بصرف النظر عن كونها موضوع عقائد أو موضوع علوم: ولا يمكن المفاضلة بين الضربين الممكنين عقلا والحاصلين فعلا أعني الوجود الذهني والوجود العيني وما بينهما من تفاعل في الاتجاهين تقابل ينتج ضربين مزيجين بنفس المعنى المشار إليه في المستوى الأول وأصل ذلك كله هو السعي اللامتناهي للتحرر من فضالة تعالي العيني على الذهني مع العلم باستحالته ما يجعل غاية التعالي هو العينية المطلقة أو موضوعية الغيرية المطلقة (وذلك هو المقصود بشخص الله أو بالذات المطلقة في الأديان) والتحايث هو التجريد المطلق ذاتية الأنائية المطلقة (وهو القصدية المبدعة لموضوعها أو الوهم).
ورغم ما سيبدو عليه كلامي في هذه المحاولة من طابع المفارقة فإن الموقف التاريخاني المطلق يمتنع القول به على غير المؤمنين بنظرية الخلق المستمر وعرضية الأحداث المطلقة ومن ثم دون الإيمان الحضور الدائم والمساوق للخالق وهو قول يحررهم من تواليه تسليم القائل به الأمر لصاحب الأمر وذلك هو معنى الإسلام. ذلك أن افتراض كل لحظة من لحظات التاريخ فريدة نوعها من دون سلسلة رابطة بين اللحظات يجعلها خالية من قانون ذاتي فتكون على الحال التي هي عليها اعتباطية ومن ثم فهي لا تعدو أن تكون نتيجة لفعل خارجي هو المحدد لمجرى تواليها: وهذا هو معنى الجزء الذي لا يتجزأ الكلامي كما فهمه الكندي بمعنى اللحظة الزمانية المكانية التي لا تنقسم بوصفها نبضة خلق أو ومضة وجود. وعندئذ فلا من الخيار بين أحد حلين في وصف من أو ما بيده الأمر:
فإما القول بأن الأمر يرجع إلى الإرادة الإلهية الخيرة وذلك هو موقف المؤمنين.
أو القول بأنه يرجع إلى محض الضرورة والصدفة وذلك هو موقف الملحدين.
والمفروض أن تكون الأمور في مجراها خلال الحالتين خالية من كل منطق داخلي ذاتي فيكون المؤمن أكثر منطقية من الملحد: فالأول يمكن أن يتصور للإرادة الخيرة مشروعا وهدفا يضفي على المجرى بعض النظام أما الثاني فلست أدري من أين له التسليم بقابلية الصدفة والضرورة العمياء للعلم: لن أفهم إمكان التوفيق بين الصدفة والقانون مهما حاول المتعالمون التسفسط لأن قصارى ما يؤول إليه أمرهم هو القول بغائية ما كامنة في توالي الصدف بحسب انتظام هو معنى القانونية فيكونون مؤمنين بالخطة القصدية وإن بغير وعي.
إن التاريخية عند إطلاقها تقتضي حتما الإيمان بمؤثر مفارق أو بنفي الانتظام في توالي الأحداث فتتنافي في الحالتين مع القول بقانون محايث لمجراها: لا يمكن الجمع بين التاريخانية والمعرفة العلمية عند أخذهما بالصارم من معناهما. لكن التاريخانيين من علمانيينا العرب لا يفهمون ذلك أو من يستطيع منهم لا يريد. ومن ثم فلا عجب إذا غاب عنهم قصد هيدجر من الكلام عن الحدث المطلق أو الآرآيجنس Ereignis والمصير والقضاء والحاجة إلى المنقذ الربوبي ليكون في قوله بالتاريخية المطلقة ذا تناسق يقبله العقل.
ولعلي أزعم في الاتجاه المقابل ما هو أكثر من ذلك. فالتفريط مثله مثل الإفراط في التاريخية ممتنع. إن نفي التاريخية المزعوم مستحيل التصور فضلا عن الحصول في أي حضارة مهما بردت إلا إذا ماتت فلا يحق لنا حينها القول بأي من المعنيين نفيا للتاريخية أو إثباتا. ولعل الأمر كله مرده إلى اختلاف الإيقاعات الذي أفسد على الجماعة فهم القضية. فالكثير من الظاهرات تنتسب إلى المديد من الإيقاع فتبدو للعيون غير اللطيفة غير تاريخية. لذلك ميز ابن خلدون بين ضربين من التـأريخ للتاريخ أصبحا من المعاني الجوهرية في علم التاريخ منذ مدرسة الحوليات رغم أنهما سابقي الدور في فكر المؤرخين العرب لأن ابن خلدون لا ينسب التمييز إلى نفسه بل إلى أسلافه في الفن:التأريخ المؤطِّر والتاريخ المؤطَّر والأول مديد وهو يحدد الصفات العامة للحقب والثاني يعالج الأحداث الجارية في نفس الحقبة لاتصافها بصفات متماثلة أي إن التغير فيها ما يزال كميا ولمن ينقلب إلى التغير الكيفي.
المسألة الثانية
ما كنا لنتكلم على مناسبة العنوان “تاريخ الله” -بتجاوز مجرد الاستفزاز- للمقصود من محاولة صاحبه. ما يعنينا هو ما يفيده من تحديد للمنزلة الوجودية التي يضفيها متكلمونا الجدد على المسألة الدينية. فتصوروا يرعاكم الله أن أحدا تلكم في تاريخ الطبيعة وحصر قصده بـ“التاريخ” في “تاريخ” ما دار حولها من تصورات بالاعتماد على فقه اللغة مستثنيا تاريخها هي من حيث هي ظاهرة ذات صيرورة فعلية وراء صيرورة تمثلات الإنسان لها: فينحصر التاريخ الذي هو موضوع التأريخ في التأريخ الذي هو علم هذا الموضوع. ألا يكون بذلك قد خلط بين أمرين لكأن الإنسان لم يصبح قادرا على التأريخ لتاريخ الطبيعة ذاتها وراء التأريخ لنظرياتها منذ أن اكتشف التقنيات العلمية لقيس أعمار المواد والتحولات الطبيعية والكسمولوجية؟
بهذا المعنى الاختزالي للعنوان الذي يرد تاريخ الله إلى تاريخ تصوراته يكون ما يفيده مضمون محاضرة الأستاذ العظم دالا على أنه يتصور: المعاني الدينية مقصورا وجودها على ما للإنسان عليها من تمثلات ولا شيء وراء تلك التمثلات التي ترسبت في فقه اللغة والمخيال العامي وحتى في المنحوتات والمسكوكات. فيكون تاريخ الله لا يقتضي تاريخ أمر حقيقي هو الله وراء ما للإنسان من تصورات عليه: الله مجرد فكرة لم يصك الإنسان تصورها فسحب بل هو خلقها من خياله بمحض قواه النفسية التي أبدعت وهما لعلاج أوهام الخوف والأمل البدائيين مثلا كما يتصور كل من يرجع الأفكار إلى بعدها النفسي فلا يميز بين النفسي والمنطقي فضلا عن التمييز بين المنطقي والوجودي.
وليس من شك في أن المقارنة مع الطبيعة التي أوردناها تمثيلا للموقف وليس للمماثلة بين الطبيعة والله فيها شيء من عدم الدقة: وتلك هي الحجة الجوهرية التي يعترض بها كل كلام مادي النزعة صاحبه محتجا بإمكان التمييزه بين ما في العين وما في الذهن في حالة الطبيعة وامتناعه في حالة الله. فهو يعتبر التمييز الأول ممكنا بحيث تختلف الطبيعة عن تصوراتها لأنها مدرك بأدوات علمية تبين تاريخيتها المختلفة عن تاريخية تصوراتها. لكن الله فكرة وإدعاء أنه أكثر من فكرة في الأذهان وأن له وجودا في الأعيان فكرة أو عقيدة وليس حقيقة فعلية. ولا توجد طريقة من طرق المعرفة المعلومة يمكن في هذه الحالة أن نتجاوز بها ما في الأذهان إلى ما في الأعيان. ومن يحصر المعلومية في الحصول الفعلي بالأدوات المادية لا يمكن أن يسلم بأن يصبح ذلك ممكنا في أي مستقبل ممكن.
وبين أنه إذا صح هذا الرأي فينبغي أن نستنتج من القول بأنه لا قيام في العين إلا للمادي وأن الأمر الحقيقي الوحيد الذي له قيام وراء التصورات لا يكون إلا من جنس ما يقبل الإدراك الحسي. وذلك هو جوهر النظرة المادية. ولكن كيف للمادي أن يقول بوجود القوانين الطبيعية: فينبغي ألا يكون القانون الطبيعي مثلا ذا وجود حقيقي خارج الذهن لأنه ليس قابلا لأن يكون محسوسا وينبغي ألا يكون متحكما في مجريات العالم الطبيعي لأن ما هو مقصور على الوجود الذهني هو صيغنا للقوانين وهي صيغ لا حول لها ولا قوة في تحريك السماوات والأفلاك بقانون الجاذبية. وإذا قال المادي بهذا اصطدم بما ينقض كل تصوراته لو تأمل تواليه جيد التأمل.
والمسألة التي أريد أن أناقش الجماعة فيها هي: هل كون الله ليس معلوما وكونه قد لا يصبح معلوما بطرق العلم الوضعي يعنيان أنه لا يقبل أن يكون موضوع فكر متعال على مجرد التمثلات المتعلقة به كالحال في ما نفترضه وراء الظاهرات الطبيعية من نظام القوانين المحدد لمجاريها فيقتصر وجوده على القيام في الأذهان؟ فكل من درس كنط مهما قل فهمه يعلم أن مجال الفكر يتجاوز مجال العلم وهو تمييز سبق إليه ديكارت تمييزا بين التفكير والفهم فضلا عما يقرب منه في المعرفة الدينية أو ما يسمى بطور ما وراءه من طور كمفهوم حدي.
تاريخ الله في تصور المحاضر يدور حول تصورات الإنسان لله كما تجلت في فقه اللغة والممارسة العامية للشعائر فحسب ولا يقتضي التفكير في المفهوم الذي حصر في تاريخ تعيناته التمثلية فيكون خاليا من البعد المفهومي العقلي. يتكلم العلماني العربي في تطور تصورات الإله وتمثلاته Vorstellungen ويظنها بديلا مغنيا عن الكلام على مفهوم الإله ذاته Begriff لأنه يتصور الأعيان مقصورة على التعين المادي وما عداها كله من الأذهان. وإذن فـالمفهوم يرد عندهم بالاختزال الساذج إلى تمثلاته المتوالية في التاريخ ولا شيء سواها فتكون الطبيعة كذلك مثلا هي دكسوغرافيا تمثلاتها العامية ولا وجود لمفهومها فضلا عن تعينها الفعلي وراء هذه التمثلات حتى وإن سلمنا بأن هذا الوجود ليس مما يدرك بالتمثل. والنزعة الانطوائية أو السوليبسيسموس ظاهرة فكرية معلومة في الفلسفة والتصوف:
ففي الفلسفة يوجد ما يسمى بـالفينومينوسموس أعني ما يتراءى من الوجود للوعي الإنساني بحيث يكون العلم هو نظام هذه المترائيات الإدراكية رفعا للحكم في عدا ذلك لكونه غير قابل للعلم.
وفي التصوف يوجد ما يسمى بـالوحدة المطلقة أعني نفس الأمر الذي تتكلم عليه تلك الفلسفة مع فارق يضع واء هذا الترائي الادراكي مفهوم التوحد بين الذاتين الآلهة والمألوهة.
لكن المعلوم أن هاتين النزعتين تقتضيان أصلا يفترض دحضهما من الأساس. فإذا كان الوجود مقصورا على مدارك الإنسان وكانت هذه المدارك مقصورة على ما في الأذهان أصبح السؤال الواجب هو ما حقيقة الذهن الذي تحل فيه هذه المدارك هل هو في الذهن أيضا أم لا؟ ألا ينبغي أن يقول العلماني: ما في الجبة غير الله ؟ وإذا سلم المجادل بأن للذهن وجودا غير ذهني فهل الوجود غير الذهني مقصور على وجود الذهن فنكون قد ألهنا الذهن الإنساني بمعنى وحدة وجود إنسوية ؟ لذلك فإنه ينبغي أن نفهم الـسوليبسيسموس بمعنيين:
بالمعنى العلمي حيث يكون إطلاقا لنظرية الظواهر الكنطية في مقابل البواطن عنده. وهو من ثم عكس الوحدة المطلقة الصوفية لأنه ينم عن تواضع المعرفة العلمية التي لا تدعي تجاوز الظاهرات.
بالمعنى الصوفي حيث يكون إطلاقا لنظرية الفناء الصوفية في مقابل البقاء عندهم. وهو من ثم عكس التواضع الكنطي لأنه يعني أن القطب الصوفي هو الله الذي ليس كل ماعداه إلا من مفاعيل إدراكه.
لكن العلماني العربي لا هو من هؤلاء ولا هو من أولئك لأنه ماركسي النزعة بالأساس: فالواقع المادي عنده حقيقة لا ريب فيها وهو قائم خارج الذهن بدليل ردود إنجلز على فيلسوف المثالية الإنجليزي. فيكون ما لا وجود له إلا في الذهن هو عكس الموقفين السابقين أعني المفاهيم والتصورات العقلية التي هي مجرد انعكاس لذلك الواقع المادي الواقع الخارج عن كل شك وتشكيك لأنه عين الواقعية الغفل لهؤلاء المتكلمين باسم العقل دون عقل.
ولما كان هذا الواقع الغفل والعامي لكونه خاليا من الفحص النقدي خاليا كذلك مما يناظر الأفكار والتصورات التي يقول بها الدين فإن القائلين به يعتبرونها مجرد توهمات إيديولوجية تاريخيتها هي تاريخية المواقف المصلحية في الصراع المادي على تقاسم الثروة والسلطة اللتين هما الحقيقة الوحيدة في الجدلية المزعومة علمية. وبعبارة وجيزة: إنهم يمثلون السلفية المادية المناظرة للسلفية الروحية ولا معنى لما تدعيه الأولى من زعم النقد والتفلسف. إنها مثل أختها تزمت عقدي مقيت.
المسألة الثالثة
إذا كان التاريخي متقدما على المفهومي في العلاج الفلسفي فينبغي أن تكون دلالة الحدث العرضي Kontingent من التاريخي متقدمة على دلالة القانون الذي يمثلهمنطق الأحداث أو نظامها فتكون هي المحددة لدلالة الأمور في الشؤون البشرية دينية كانت أو علمية. وليس من شك في أن الطابع العرضي واللامحدد لمجرى الأحداث في حياة الأفراد والجماعات (على الأقل بسبب محدودية العلم بها) من السمات الأساسية للمسائل التي تجعل الموقف الديني ذا معنى. كما أنه ليس من شك في أن ما حصل من تقدم في الفكر الفلسفي كان في ما توصل إليه أخيرا من فهم لهذا الأمر بالذات فهما حرره من مركزية اللوغوس وقربه من فهم دلالة الوصل بين الجوهري والعرضي وصلا لا يكون ممكنا إلا بقدر معين من الإيمان بالغائية سواء كانت مجرد إسقاط إنساني على مجاري الأحداث أو أصيلة فيها. لكن أن ينقلب الأمر ليصبح العرضي هو الجوهري أو حتى لينتفي الجوهري أصلا فذلك هو المحير خاصة إذا جاء من منطلق موقف علموي قائل بالمتافيزيقا الماركسية.
لكننا من هذا المنطلق يمكن أن نفهم غياب الفرق بين الترتيب التاريخي العرضي والبنية المفهومية للشيء الذي يعالجه الفكر ولا نفهم التدرق وراء السؤال العلمي في المسائل الدينية. فهي ما كانت لتوجد لو كان العلاج العلمي كافيا لفهم “ما ليس بمضمون ولا بمعقول” من الوجود عامة ومن المصير الإنساني خاصة: لو كان كل شيء شفافا ومعقولا لما كان للإيمان حاجة ولا معنى فضلا عن كون مجرد الاستدلال العقلي المجرد يكون كافيا لعلاج الأمور فنكون في غنى عن التجريب الممكن من المفاضلة بين السيناريوهات العقلية المتعددة الممكنة لأن الحاصل من الممكن هو أحد السيناريوهات العقلية الممكنة. وذلك هو معنى استناد المعرفة العلمية إلى الضرورة الشرطية.
ومع ذلك فلنقبل ولنناقش الجماعة من منطلقاتهم المزعومة علمية لنحدد بدقة موطن الخلاف أو لنحرر موطن الإشكال مكتفين بمستوى الإشكال الإبستمولوجي (شروط المعلومية الممكنة) لئلا نتهم بالإغراق في الأنطولوجيا والميتافيزيقا (شروط الموجودية الممكنة). فلنفرض أحدا أراد أن يتكلم في علم الفيزياء وقصر كلامه على الحصول التاريخي الخارجي لاكتشاف النظريات الفيزيائية (بحسب السياقات التاريخية لشروط البحث العلمي وعرضيات توزيع العباقرة المبدعين من العلماء في المكان والزمان) فهل يكون كلامه علما فيزيائيا أم هو مجرد تاريخ لأحداث الاكتشافات النظرية في الفيزياء (جزء من علم اجتماع العلم أي من تاريخ البحث العلمي في المجتمع) ؟ هل يميز الجماعة بين الأمرين أم هم لا يفعلون ؟ هل يجهلون الفرق بين الترتيبين الممكنين للمتن العلمي أعني: الترتيب التاريخي لتوالي الاكتشافات والترتيب الدغمائي لبنائها النسقي (بالمعنى الكنطي الإيجابي) أو النسقي (بالمعنى الكونتي) أو الأكسيومي (بالمعنى المنطقي الرياضي) ؟
ما الذي يجعلهم يتصورون الترتيب التاريخي أكثر دلالة من الترتيب الأكسيومي للعقائد وكلاهما لا ينفيه الترتيب الرسمي لنص القرآن في المصحف العثمانيلكون الأول سابقا عليه والثاني لاحقا وكلاهما يبقى حصولا ومعرفة تاريخيا إلى غير غاية ؟ لا يمكن أن يكون الداعي نفي التاريخية المزعوم في الثاني فضلا عنه في المصحف الذي هو ترتيب محايد بالنسبة إلى هذين الترتيبين: لأنه يذكر بترتيب النزول وإن بصورة جملية ولا يفتح الباب لتعدد القراءات ومن ثم لتعدد الأنساق الدغمائية.ذلك أن الترتيب الأكسيومي هو بدوره ذو تاريخ حتى وإن اختلفت تاريخيته عن تاريخية النزول.
فإذا افترضنا هذا الترتيب في تعليم العقائد ليس هو شيئا آخر غير موضوع علم الكلام أو علم اللاهوت فهل ينفي الجماعة أن النظريات الكلامية رغم كونها أنساقا أكسيومية للمضمون العقدي ذات تاريخ هي بدورها ؟ ما الذي يجعلهم يتصورون العودة إلى التاريخي المحض المتقدم على التاريخي المدون أكثر دلالة على الحقيقة التي يريدون بيانها؟ وبين أن الجواب مضاعف:
فسلبا لأن تاريخ الأنساق الكلامية أقل قابلية للربط المباشر مع ما يسمونه واقعا: فمن الصعب مهما تعسفنا أن نفسر بنفس التحديد المنسوب إلى تأثير البنية التحتية في البنية الفوقية إذا تعددت هذه البنية الفوقية بصورة لا تكاد تصدق فيصعب ردها إلى التعبير عن نفس المصلحة الطبقية: مدارس الكلام المتساوقة والمتوالية لا تكاد تتناهي والخيارات بالتفسير الطبقي محدودة جدا وهو علة الهروب من الكلام الدقيق في التناظر بين الأمرين.
وإيجابا لأن تاريخ الأحداث المزعومة حاصلة قبل التدوين أيسر ربطا الربط المباشر مع ما يسمونه واقعا: يكفي أن يجعلوا الناس صفين: البرجوازية واللابرجوازية أو ما ناظر ذلك من الثنائيات قبل اللحظة البرجوازية كالإقطاع والقنانة أو ربما بعدها مما لا أدري كيف يسمونها. وهذا أمر يلحظه كل من يلامس القراءات الماركسية الساذجة التي يحاول أصحابها رد ما في الثورة القرآنية إلى ما كان يعتمل في المرحلة العربية المتقدمة بالتفسير الماركسي البدائي.
لكني لن أطيل الكلام في ذلك بل يكفيني أن أسأل عن العلة في عدم وعي الجماعة بأن ما يدعون إليه فضلا عن استحالته هو عين ما يستند إليه الموقف الأصولي في أشد جماعاته تطرفا: العودة إلى الأصل بتجاوز مستحيل لما حصل بينه وبيننا عودة إلى أحداث بكر لم يؤثر في معانيها ودلالاتها كل ما للتاريخ من وقع ليس عليها هي وحدها بل علينا نحن كناظرين إليها ؟ أما قرأوا جدامر أم إن حداثتهم توقفت عند شعارات القرن التاسع عشر ؟ كيف لنا أن نقفز على وقع التاريخ باسم التاريخانية ذلك هو ما يحيرني ولم أفهمه في موقف هذه الجماعة التي شوهت كل شيء بما لها من عجلة تتنافي مع معنى الفكر الفلسفي مطلق التنافي لفرط ما استطابوا من لوك الشعارات والتنعم بما لذ وطاب من البهارات في الفنادق والبارات.
المسألة الرابعة
هل صحيح أن البناء العقدي -الذي هو أكسيومية تعليمية في باب المعتقدات-يلغي البعد التاريخي من الحدث الديني فيفسد عليه معناه أم هو محرر منه دون إلغاء له كما يحصل الأمر في المعرفة العلمية التي تقدم الأكسمة في نسيج متن العلوم على الأرخنة في أحداث الاكتشافات المتوالية بلا ترتيب بحسب صدف الحدوس الفردية ؟ فسواء أحذنا نص القرآن نفسه في شكله الذي له خلال تلقيه أم كما صار بعد التدوين المتهم-تسليما جدليا بالفرق بين الحالين- والصوغ العقدي المتهم بكل التهم هل يوجد ما يفيد نفي الترتيب العقدي للترتيب التاريخي ؟
ألسنا نجد القرآن نفسه متضمنا لكلا الترتيبين الترتيب التاريخي والترتيب التعليمي حتى في المصحف نفسه الذي يتصوره البعض مخالفا بمضمونه لما نزل من القرآن ؟ ثم ألم يحاول علماؤنا البحث عن نظام وراء التاريخ وعن تاريخ للنظام بنظرية صريحة هي نظرية المجدد على رأس كل قرن؟ فيكون علاج مسألة الترتيب التاريخي وعلاقتها بالترتيب التعليمي في الصيغ العقدية علاجا شديد التعقيد لكونه قد تفرع إلى الفروع التالية:
1-الترتيب التاريخي الذي يمثله ولو بصورة جملية التمييز بين القرآن المكي والقرآن المدني مع ما تسمح به دقة المعرفة التاريخية في بحوث علماء القرآن المسلمين وهي دقة لم يتجاوزها البحث الحديث بأمر يستحق الذكر.
2-ترتيب المصحف الذي يتهم بكل ما لذ وطاب من التهم تتردد بين حدين مذهبي يشكك في أمانة الخلفاء الثلاثة الأول ومزعوم علمي ذهب إلى حد ادعاء أن القرآن نفسه مثله مثل السنة لم يدون إلا في القرن الثالث.
3-محاولة فهم تأثير النظر إلى الترتيب الثاني بمنظور الترتيب الأول: فلا يمكن لمؤصل الفقه مثلا أن ينسى الترتيب التاريخي للقرآن والسنة لأن معرفة ذلك من شروط العلم بالناسخ والمنسوخ ومن ثم فهو يمثل بعدا ضروريا في بناء الانساق المؤصلة للفقه والعقائد.
4-محاولة فهم تأثير النظر إلى الترتيب الأول بمنظور الترتيب الثاني: لا يمكن للمفسر أيا كان مذهبه أن يكتفي بالترتيب الزماني لأسباب النزول وللنزول إذا كان يريد أن يصل النجوم القرآنية بوحدة موضوعية أو مقصدية في تفسيره فيصبح بناء الوحدات الموضوعية والمقصدية شرطا في فهم دلالة توالي النجوم ويصبح التاريخ خاضعا لترتيب نسقي يكون الخالف من النجوم غاية والسالف منها بداية كلتاهما تفهم بمتضايفتها.
5-وأخير فإن نظام القرآن من الداخل تحدده نظرته للتاريخية الإنسانية كما يمثلها القصص القرآني: فلا يمكن أن تفهم الرسالة القرآنية إلا بوصفها الاستعراض النقدي للمحاولات السابقة التي هي بمقتضى نظرة القرآن محاولات لتحقيق نفس الرسالة حتى وإن اختلفت أشكالها إما بسبب الظرف الخارجي أو بسبب التدرج في تحقيق الرسالة نفسها. فيكون الإسلام كمثال أعلى في البداية غاية للتحقيق ثم يصبح كحركة تاريخية سعيا متدرجا لتحقيق تلك الغاية وهو من ثم إستراتيجية عمل سياسي تربوي وليس مجرد منظومة عقائد أو أحداث تاريخ لا تحكمها خطة وإستراتيجية نظرية وعملية.
المسألة الأخيرة
هل اعتبار القرآن بداية جديدة يعني أنه ينفي التاريخ المتقدم في ما ليس هو فيه بداية جديدة بمعنى التحول النوعي في مجاله ؟ ولنقس الأمر على المنعرجات النموذجيه في علم من العلوم (وهنا يمكن الإشارة إلى قصير الذي كان أكثر صراحة في سوء الفهم هذا) أو ما يسمى بتغير البارادايم. فلست أدري لأي العلل يزعم الكثير من المشنعين على المسلمين من مسيحيي الشرق الذين يريدون أن يبيضوا ساحة الاستعمار الروماني والبيزنطي قبل الثورة القرآنية فيتهمونهم بالتنكر للحضارة السابقة ويزعمون أنهم -نتيجة لنفي التاريخ- يدعون أن الحضارة بدأت مع الإسلام وأن ما تقدم عليه ليس إلا جاهلية جهلاء.
ولعل أفضل ممثل لهذه الوجهة وعبر عن الإشكالية بكامل الوضوح هو الأستاذ سمير قصير الذي يحاول الكثير تحميل الحركة الإسلامية دمه وهي منه براء لأنه كان ضحية المعركة بين شقي العلمانية الليبرالية والعلمانية الشمولية التي كان من دعاة التحرر منها ومن طغيانها على مقدرات لبنان.
“ولا يبقى من العصور المتقدمة-يقول قصير-إلا صورة فوضوية تصاغ بمفهوم الجاهلية الذي يفهم كزمن للجهل مختزل”[14] (…)
فصورة الجاهلية الفوضوية التي تفهم هذا الفهم “لا يمكنها أن تقوم عندما ينظر المرء إلى ما تم توثيقه من حصائل البحث في التاريخ الهلنستي والروماني الحصائل المستمدة من وثائق الحفريات وما يوجد على العمارة من تواريخ تشييدها وعلى العملات من تاريخ صكها. فقد كانت المدن العربية في شمال الحجاز تامة الرومنة إلى حد جعل قيصر الروم يمكن أن يكون من أبنائها. وهكذا فالبداوة الحربية التي طبعت عالم التصورات العربية لاحقا سيتم تنسيبها بصورة دائمة ويمكن لنا أن نتصور المنعرج الكوبرنيكي التي يمكن أن يقدمه الاعتراف بعصر ذهبي يكون متقدما على العصر الذهبي الإسلامي المزعوم”[15].
تصوروا أحدا يريد أن يؤرخ لحركات التحرير في سعيها لاستعادة سيادة شعوبها لتكون رب خياراتها الوجودية والخلقية والقيمية بأن ينفي عنها حق الزعم أنها بداية جديدة لأن ما قبلها من فترات الاستعمار كان قد حقق ما يشبه ما تسعى إليه من منطلق ما تريده وليس من منطلق ما فرض عليها. ترى هل يعتبر كلامه هذا ذا معنى وهل يلزم عنه صدقه في إدعاء أن هذا الميل للبداية الجدية فيه نفي لما تقدم من الفعل الحضاري الذي لا يمكن أن يزعموه لأنفسهم لأنهم لم يكونوا فيه ذوات فاعلة بل موضوعات منفعلة. لا أحد ينفي أن أحد العرب من الشام أصبح قيصرا في عهد ازدهار الفلسفة الأفلوطينية بل وكان من حماة أفلوطين. لكن ذلك لا يعني أن العرب قبل الإسلام كانت لهم حضارة هم أربابها وصناعها ومحددو خياراتها الوجودية والخلقية القيمية. ذلك هو مدار الكلام وليس الكلام على تقدم الحضارة على الإسلام:
1-كيف يعقل أن يزعم الزاعم أن المسلمين ينفون ذلك والقرآن مليئ ببيان ما يؤول إليه التاريخ الحضاري الإنساني عندما يكون حضارة مادية خالية من مراعاة القيم الروحية والخلقية التي يدعو إليها ولا يزعم الاستفراد بالدعوة إليها لكونه يقدم نفسه على أنه حلقة في سلسلة اكتملت لكونه يمثل غايتها؟
2-وهل يمكن لنص يقدم نفسه على أنه غاية التطور الخلقي والمدني والروحي أن يقول أهله إن ما تقدم عليه جاهلية بمعنى آخر غير خلو الحضارة من مراعاة القيم التي تدعو إليها الأديان وليس خلو التاريخ من الرقي الحضاري بصورة مطلقة ؟ ألا يكون عندئذ قد جعل نفسه غاية لأمر لا وجود له فيكون صفرا؟
الخاتمة
وفي الختام فإنه يؤسفني أن نظام وقتي لم يسمح لي بحضور المحاضرة التي قدمها الأستاذ العظم لأني لم أعلم بالمحاضرة إلا صبيحة اليوم الذي قدمت فيه. ورغم أن كلامي لم يتعلق بهذه المحاضرة لعدم حضوري إياها فقد تصفحت ما انتخبه منها الأستاذ النابه زهير الخويلدي -وهو من طلبتي السابقين ولست أشك في أمانة نقله للشواهد لذلك اعتمدتها في حدود ما احتجت إليه من عينات منها- عينات بنصها أعلل بها انتخابي عنوانها عينة عن الفكر العلماني العربي في المسألة اليدينية فضلا عما يتوفر لدي من سابق الاطلاع على بعض ما للرجل من أفكار وكتابات حول الإسلام.
والحصيلة أني كلما ازددت اطلاعا على ما يسمى بفكر العلمانيين العرب وجدتهم جميعا من حيث مضمون فكرهم وخياراته الأساسية نسخة مطابقة لأصل باهت من الفكر الماركسي في صورته البدائية بحيث لم يبق للمرء من معيار للمفاضلة بينهم إلا تمكنهم من العربية أو من شكليات البحث الخارجية. والمعلوم أننا في تونس من المحظوظين لوجود عينة منهم لا تكتفي بما تتحفنا به من فكر مبدع في مضغ الميت من الشعارات التحديثية والتنويرية لكنها تمكننا من الاطلاع على مبدعات أبناء عمومتنا من الشرق ومعلميهم من الغرب. ولا يهم أن كانت عينتنا التونسية أكثر العينات العربية فقدانا للصفات اللغوية والعلمية. فيكفيها فخرا أنها أبلغها تجسيدا للصفتين الغالبتين على من يمكن وصفه بالداعية رغم تصوره نفسه مفكرا لأن هاتين الصفتين تنفيان كل صلة بالفكر العلمي أو الفلسفي:
فأما الصفة الأولى فهي ما يمكن وصفه تجملا بالموقف النضالي أو الحزبي تبشيرا بما يعتقدونه حقيقة نهائية خلال نفيهم أن يكون ما يقوله غيرهم حقيقة نهائية: فينطبق النهي عن خلق ويأتون مثله.
وأما الصفة الثانية فهي مضغ الشعارت الموميائية التي كان لها معنى في نشأتها الأولى باتت بعد ما شبعت به من مخض كليشهات لا لصة لها المعرفة أصلا: فيستبدلون السلفية الأهلية بالسلفية الأجنبية.
إنهم يكتفون بالالتزام الغفل مثلهم مثل الدعاة الدينيين الذين يردون عليهم ويمضغون مثلهم شعارات أكل عليها الدهر وشرب للوكهم أمورا تجاوزها من يحاكون منذ أكثر من قرن فضلا عن كونهم يهملون لبها وينشغلون بقشورها: يفتحون الأبواب المخلوعة ويتصورون أنفسهم قد أمسكوا بالأسد من أذنه. وقد شاءت الصدف أن حالت دوني التزامات سابقة الاستمتاع بالمحاضرة التي قدمها الأستاذ عزيز العظمة في الكلية التي كنت أستاذا فيها قبل تقاعدي منذ سنتين محاضرته “تاريخ الله” التي قدمه فيها للحضور داعي دعاة الحدَاثة التي صارت “حِدَّاثة=حَدُّوثة” في تونس.
ولعل المنطلق الأساسي في المواقف العلمانية من الدين جميعها علته التسلم المجاني القول الضمني أو الصريح بالمادية التاريخية كما يدل على ذلك رد الظاهرات الدينية إلى ما في الوعي الإنساني عنها من تصورات لا تتعداه إلى حقيقة ذات قيام ذاتي اسمها الله. لكن هذا الفكر متخلف معرفيا وفلسفيا:
فمعرفيا: هو فكر متخلف عما يسمى بالمنعرج اللساني فضلا عن التحرر من التاريخانية الفجة وسوء الفهم لما يسمى بالفهم الأنثروبولوجي للظاهرة الدينية ومثلها الظاهرة العلمية فضلا عن كون القرآن مثلا لا ينفي التعدد الديني حتى يزعم المحاضر أن المسلمين لهم تصور تاريخي خطي ينطلق من الوحدة ويعود إليها ؟ ذلك أن وحدة المفهوم لا تتنافي مع تعدد الأعيان فضلا عن تعدد التعينات حتى لكل عين منها.
وفلسفيا: هو فكر متخلف لأنه لا يقدم الدليل على الفهم المادي الجدلي بل يكفي بظنه بينا بنفسه بل هو مجرد ضمير. فضلا عن كون التفسير المادي العلمي بالصدفة والضرورة ليس أولى بالقبول عقلا من التفسير المثالي بالقصد والحرية. وهما في كل الأحوال يمثلان غاية النظرة الصعودية للتاريخ عند الماركسيين حتى لو كانوا غير قائلين بالخطة الإلهية بالمعنى الهيجلي. فكيف يكون القانون العلمي أولى بالخروج من فوضى الصدفة والضرورة منه من نظام القصد والحرية ؟
[1] ورد هذا الشاهد في مقال للأستاذ الخويلدي في عرضه لمحاضرة الأستاذ العظمة:”علينا إذكاء ملكة التمييز بالاعتماد على تقنيات مستحدثة وبالاستناد على طبائع معلومة في الأنثربولوجيا. فهل هناك إسلام معياري يؤثر في تصور فكرة الله الذي له منابت ميثولوجية؟ الإسلام المعياري هي تخريجات إيديولوجية رغم وجود إسلامات معيارية عند السنة والشيعة والثقافة الشعبية.” وطبعا فالضمير بعد الذي يعود إلى الله وليس إلى تصور الله. فيكون الله وليس تصوره ذا منابت ميثولوجية. وهو ما يعني عدم التمييز بين منابت التصور ومنابت الأمر المتصور. وهذا هو بيت القصيد من الإشكال.
[2] وهذا الضرب من التمثيل يستعمل دليل الأولى بمعنى مقلوب لكونه ينزل من الأعلى إلى الأدنى بخلاف استعماله العادي الذي يصعد من الأدنى إلى الأعلى. فبدلا من أن نثبت به للأعلى ما يتصف به الأدنى من الصفات الموجبة نعكس فنثبت للأدنى من الصفات السلبية ما أثبتناه للأعلى. ومعنى ذلك أن كل ما نثبته من سلبيات في مفروضات العلاج الذي يقدمه أكثر العلمانيين العرب دراية بالفكرين الغربي والإسلامي يكون من باب أولى ثابتا لأقلهم دراية بهما. وطبعا فمثل هذا الاستدلال يسلم بأن طرد هذا القياس وعكسه صحيحان في الحالتين لكونه مبنيا على اتساق الطبائع دون أن يستثني الفكر البشري من هذا الانتظام. وقد يرفضه المؤمن لكن القائل بالعقل والعلم لا يمكنه أن يتفصى من هذا اللزوم الناتج عن اتساق الطبيعة.
[3] لعل أفضل مثال على ذلك محاكمة الأستاذ العظم الإصلاح الوهابي بالمقايسة مع الثورة الفرنسية حتى جعلني أظن أنه يتصور الحداثة مقصورة على صورتها في الثورة الفرنسية (مغفلا الصورة الإنجليزية من دون إرهاب سياسي وعلمانية والألمانية بفلسفة مؤسسة على الإصلاح الديني والأمريكية مؤسسة على فكرة الأرض الموعودة) ويتصور الإصلاح الوهابي مقصورا على عامل مؤثر وحيد هو ظروفه الاجتماعية الثقافية دون أن يكون لما يدعو إليه من تحرر من الاستسلام للخرافة والمحرر من تراث الانحطاط المتراكم بالعودة إلى البناة الأوائل وما لهم من فاعلية تاريخية تحقق استعمار الأرض والاستخلاف فيها بتحقيق قيم القرآن لم يعتبر ذلك كله مؤشرا موجبا واقتصر على البعد السلوكي المقلد للأوائل. وإني لأعجب من مؤرخ يتصور التوجه إلى المستقبل في الثورة الفرنسية ملغيا للتوجه إلى الماضي والعكس بالعكس في حالة عبد الوهاب: وكل من له علم بالثورة الفرنسية يعلم أن توجهها إلى المستقبل كان مستندا إلى قراءة للماضي اليوناني فلسفيا والروماني حقوقيا وكل من له علم بالثورة الوهابية يعلم أن توجهها إلى الماضي كان مستندا إلى قراءة للمستقبل العربي الإسلامي تاريخيا وخلقيا: كيف يستعيد المسلمون والعرب فاعليتهم التاريخية أو يكف يخرجون من الاستسلام للخرافة والقضاء والقدر. المشكل هو إذن ظن الزمن التاريخي قابلا للتوحيد مثله مثل الزمن الفلكي. الماضي والمستقبل والحاضر بمعناها في الزمن التاريخي إضافية إلى أفق حضاري معين وهي ليست من جنس الزمن الفلكي. وفي هذا يكمن سر التأويل السيء لفكر ابن عبد الوهاب وابن تيمية الذي حوكم بالقياس إلى فكر الثورة الفرنسية: فهما يثوران على التصوف لكونه ينفي فاعلية الإنسان التاريخية وليس لأنهما ينفيان فاعليته. نفيهما لفاعلية السحر والتنجيم والأولياء والخرافة هو من أجل تحقيق شروط التكليف أعني المسؤولية ومن ثم فهو مطلب أعمق ألف مرة من مطلب الثورة الفرنسية إذا صح لنا القيس. فالثورة الفرنسية اتصفت بما اتصفت به من إرهاب لكونها تصورت الإصلاح السياسي ممكنا من دون أن يتقدم عليه الإصلاح الديني فكانت لذلك ثورة عرجاء هدفها تحقيق الفصام. أما ثورة ابن تيمية حتى وإن كان عبد الوهاب لم يفهم أبعادها فإنها كانت إصلاحا دينيا أو بصورة أدق إحياء للإسلام من حيث هو إصلاح ديني متقدم على الإصلاح المسيحي ومغنيا عنه مع خلوه مما طغى عليه من إفراط قلب العلاقة بين الدنيوي والأخروي ولم يعتمد التوالج السوي بينهما كما في الإسلام.
[4] ولنضرب مثالين مما لا يمكن طرحه من المشاكل في الكلام على الإسلام بتعميم ما يطرح عند الكلام على المسيحية مثلا متصورين باستدلال غير واع ضميره المضاعف أن الدين المسيحي يتصف بصفات الكلي الديني ومن ثم فصفاته تعم كل الأديان وأن نفي هذه الخصائص يعني نفي الدين كلية. ثم يعاملون الإسلام بهذا المنطق. ومن ثم فهم لا يرون أن جل ما يعيبوه على الدين الإسلامي لا يصح عليه لأنه في الكثير من الأحيان هو عين ما يرفضه الإسلام من الدين المسيحي بل ويعتبره ما نتج فيه عن التحريف ولذلك فهو لا ينتهي إلى نفي الديني بل إلى نفي تحريف الدين: إذ هو رفض الدين المسيحي لشرطي التعامل السوي مع الدنيا أي العلم والعمل المحايثين للتاريخ. ذلك جوهر النقد القرآني لما يسميه تحريفا ولولا وقوفهم عند ويل للمصلين لكانوا أكثر الناس قربا من النظرة الإسلامية وهم بسبب هذا الوقوف يعودون إلى الفصل الفصامي بين المملكتين السماوية والأرضية:
الأول هو المقابلة التقليدية عند العلمانيين بين العلم بمعنى المعرفة الوضعية والدين بمعنى الوحي المنزل المتعلق بأعيان ما تتوصل إليه المعرفة الوضعية في مجال عالم الشهادة. فليس في القرآن مثل التوراة تكوينية للعالم ولا تحديد لمدده ولا إشارة لقوانين علمية معينة هي التي تعبر دون سواها عن السنن الإلهية. والمعلوم أن الإناجيل لا تلغي ما في التوراة بل هي تبني عليه وخاصة بعد الإصلاح.
والثاني هو المقابلة التقليدية عندهم منها بين النظام السياسي غير الثيوقراطي والنظام السياسي الثيوقراطي. ذلك أن الفكر الإسلامي –إذا ما استثنينا الطائفة الشيعية-يعتبر كل دعوى ثيوقراطية للحكم تحريفا صريحا للنص الديني لأن الحكم ليس حقا إلهيا للحاكم حتى وإن كان خاضعا لواجبات إلهية. والمعلوم أن نظرية الحق الإلهي مبنية على التوراة وما فكرة المقابلة بين الله والقيصر المسيحية إلا من جنس التقية في العهد الروماني لكنها سرعان ما عادت إلى الحق الإلهي بمعنيين: بمجرد أن تمسحت الدولة وحكمت الكنيسة.
وكل من يعرف تاريخ الفكر الإسلامي يعلم أنه لم يحدث أن ادعى أحد من علماء الإسلام الكبار قبل عصر الانحطاط أن القرآن يقدم حقائق علمية يقول بها النص (كما يزعم الأول دجالو الإعجاز العلمي) وينبغي أن يقاس بها العلم الإنساني في مجال ما يقبل العلم الإنساني (علم الشاهد). ويكفي قراءة ما يقول الغزالي في تهافت الفلاسفة في مسألة علم الفلك حيث يجعل قوانين الفلك خارج البحث الديني لكونه يقتصر على معرفة المخلوقية أيا كان قانونها.
وكل من يعرف تاريخ الفكر الإسلامي يعلم كذلك أنه لم يسبق لأحد من غير المذهب الشيعي والتصوف أن اعتقد قبل عصر الانحطاط أن الحكم حق إلهي للحاكم حتى وإن سلم الجميع بأنه خاضع لمرجعية شرعية هي علة شرعية الأحكام كخضوع القانون الوضعي للأخلاق من حيث استمداد شرعيته. لكن الحكام ليسوا رجال دين أو مقدسين أو معصومين أو ذوي حق إلهي في الحكم أو نواب الله في الأرض إلا عند المتصوفة والشيعة (نص ابن خلدون والغزالي) فضلا عن كون الدولة الإسلامية بنص القرآن مطالبة بتطبيق عدة شرائع على الأقل شرائع الأديان الخمسة التي يعترف بها: الإسلام واليهودية والنصرانية الصابئية والمجوسية. لذلك فالكلام عن العلمانية في الإسلام كلام ممجوج لا معنى له إلا عند من يتصور أنه يمكن للحكم ألا يكون ذا مرجعية مقدسة سواء كانت القدسية فيها تسمى حقوقا طبيعية أو حقوقا شرعية: لأن الإسلام يعتبرهما من طبيعة واحدة إذ الفطرة هي التطابق بين الخلقة والخلق. ولعل من أهم مميزات النظرة الإسلامية في المجالين النظري (العلم) والعملي (السياسة) مبدئين من ينكرهما لا يمكن أن يكون أمينا في عرض مضمون النص:
فأما المبدأ الأول فهو حصر الوحدة في الله دون سواه وكل ما عداه متعدد المقومات والوجوه حتى إن الإسلام يقر بتعدد الأديان والشرائع ويعترف بها بل هو يذهب حتى إلى الإرجاء بخصوص المشركين ما يعني أن المعرفة لا تكون إلا اجتهادية ومن ثم فهي ثمرة تعاون (التواصي بالحق).
وأما المبدأ الثاني فهو حصر عبودية الإنسان في خضوعه لله دون سواه ما يجعل السلطان بين الناس ثمرة التعاون كذلك (التواصي بالصبر). فيكون المبدأ الأول نافيا للعلم المطلق والمبدأ الثاني للسلطان المطلق لحصرهما في علم الله وسلطانه. أما ما حصل في التاريخ الفعلي فلا يناقش أحد في كونه كان مخالفا لهذه المبادئ: ولكن فليقل هؤلاء المناقشون بأنهم لا يناقشون النظريات والنصوص بل الممارسات. وهذا يصح على كل الفلسفات: فيكفي مقارنة مبادئ حقوق الإنسان في النصوص وممارسات المتكلمين باسمها في العالم. فنحن قبل أي كان من الساعين لجعل الممارسة تقرب ما أمكن من النظرية وهو معنى حركة الصحوة عندما لا تكون مقصورة على فقهاء الانحطاط أو الحركات التي من جنس حركة طالبان.
[5] ليس من شك في أني بعدم حضوري المحاضرة قد أضعت فرصة ثمينة لأني كما أسلفت اعتبر الأستاذ العظم من المفكرين العرب ذوي المكنة في التراثين الغربي والإسلامي والاختلاف في الخيارات الفكرية لا يفسد للود قضية. لكن ضياعها ليس بذي ضرر كبير على ما أنا بصدده.
[6] شاهد ثان من عرض الأستاذ الخويلدي للمحاضرة: “كل ما أسعى إليه هو تزكية ملكة التمييز في تاريخ الله، هدفي هو التحري والتحقق من صدقية البديهيات، إن الانصباب على تاريخ الله مبني على اللاتاريخ في الفكر العربي الإسلامي. رفض فكرة التاريخ الخطي الذي يبدأ بالتوحيد وينتهي به. ما أقترحه هو إعادة تركيب لحركة دينية في الحجاز أطلق عليها الإسلام. (…)
لدينا رواية توحيدية في التوحيد ترى أن التوحيد شيء من الفطرة عند الناس وتحارب الوثنية التي تراجعت عن هذه الفكرة والحنيفية هي تصحيح نحو التوحيد. الدين الأصلي هو التوحيد في هذه الرواية. الإسلام على استمرار معين مع اليهودية والمسيحية.(…)
لدينا رواية في تاريخ الأديان ترى أن الديانات التوحيدية هي الديانة الأصلية وأن الأديان الوثنية هي تراجع عنه. ما قدمه الوحي حول الله هو لاتاريخ وأسطورة وهناك إيمان بتعدد الآلهة. الحجاز كان عبارة عن محمية للإيمان بتعدد الآلهة. هنا ينبغي مقايسة بين نشوء التوحيد الإسلامي والمسيحي واليهودي.(….)
إن نقطة العبور بين الوثنية والتوحيدية، توحيد الربوبية هو عمل طقسي وتوحيد ألوهية هو عمل اعتقادي والتفريق بين الاثنين رأيناها في الإسلام المبكر. أقترح عبارة إسلام قبل الإسلام أي الإسلام قبل التشكل أي الإسلام الأول قبل أن يتحول إلى تاريخ وتراث ومؤسسات. ويتمثل في النقوش واللغات الشرقية القديمة الصفوية…
لدينا الروايات الإسلامية عند الواقدي وابن الزبير والأصفهاني وابن الكلبي والأزرقي وابن حبيب وكتب الجاحظ. المهم ليس إعادة كتابة التوحيد انطلاقا من تراث التوحيد بل بالانطلاق من الفترة التي سبقته وساهمت في تشكله أي كتابة تاريخ يتطابق مع طبائع الأحوال في العمران في الفترة التي جاءت قبل الإسلام.
[7] وفي الحقيقة فإن أطروحة العظمة تتعلق بالخطاب الفقهي الكلامي أكثر من تعلقها بنص القرآن لئلا نتابع رأي الباحثة التي عممت فنقلت هذا الحكم من الحكم على الفقه إلى الحكم على النص الرسمي أعني القرآن والسنة.
[8] Wenn wir dem Historiker und Kulturkritiker Aziz al-Azmeh folgen, so erhebt der kanonische Text nicht nur Anspruch auf ewige Gültigkeit, sondern ist auch ahistorisch strukturiert
Al-Azmeh, Chronophagous Discourse. A Study of the Clerico-Legal Appropriation of the World in Islamic Tradition, in: Frank E. Reynolds/David Tracy (Hg.), Religion and Practical Reason. New Essays in the Comparative Philosophy of Religions, Albany, N.Y., 1994, 163ff.
عزيز العظمة الخطاب الملتهم للزمان. دراسة تملك الفقهاء ورجال الدين العالم في التقاليد الإسلامية ورد ضمن: الدين والعقل العملي محاولات جديدة في فلسفة الدين المقارنة. : نشر فرنك أ. راينولدس وداود تراسية, ألباني نيويورك 1994 ص. 163 والمواليات.
[9] التلازم بين السياسي والديني في الإسلام لا يعني إخضاع الدين للواقع السياسي بل هو يعني جعل السياسي أداة من أجل تحقيق القيم التي يبشر بها القرآن لأنها ليست أمرا ينتظر اليوم الآخر ليتحقق بل هي ما كلف الإنسان بتحقيقة وهو معنى استعمار الأرض والاستخلاف فيها ومعنى تأسيسه في القول إن الأرض يرثها العباد الصالحون. أما الزعم بأن الديني غير معني بالسياسي ثم القبول بدور الإيديولوجيا التبريرية للغزو من أجل أهداف سياسية فهذا هو التحريف الفعلي وقلب سلم الشرف بين الروحي والزماني.
[10] أرسطو كتاب الشعر الفصل التاسع وبيان أن التاريخ دون الشعر صلة بالكلي الذي ينحصر فيه العلم. وابن خلدون: المقابلة بين ظاهر التاريخ وباطنه بين من خطبة كتاب الفلسفة. لكن التلازم بين مراجعة التاريخ النقدية في بداية الكتاب تأسيسا لعلم التاريخ على علم العمران ومراجعة الفلسفة النقدية في غايته لم يعرها الكثير من الباحثين في ثورته لكأنه كان يمكن أن يصبح التاريخ فلسفيا بمعنى علما يطلب البناء على النظرية العقلية من دون أن تصبح الفلسفة تاريخية تطلب الممارسة التاريخية: ذلك أن ما كان يحول دون التاريخ والارتقاء إلى مرتبة النظر العلمي هو ماكان يحول دون الفلسفة والنزول إلى مرتبة الممارسة المعرفية التاريخية: فكان الوسيط المحقق لهاتين الغاتين هو الكلي المتعين (صيرورة الكلي الفلسفي تاريخيا من خلال تحققه التاريخي في الممارسة والتراكم المعرفيين) في الفلسفة والعين المتكللة في التاريخ (صيرورة العيني التاريخي كليا من خلال تبعيته لكليات العمران).
[11] عزيز العظمة كتاب ابن تيمية وكتاب السياسي والديني وجل كتاباته حول الأعلام بهذا المنظور المركز على المقارنة بالحداثة بحيث يغيب التمييز بين السياقات لكون ضمير التحاليل كلها هو الإيمان بوحدانية التاريخ الإنساني ومن ثم بخطيته بمنظور المراحل الماركسية حتى وإن ينزل مثل غيره إلى التبسيط المستند إلى التفسير بالمقابلات الطبقية السريعة لما يوليه من أهمية للمناخ الثقافي ولتكون الأشخاص الذين يؤرخ لهم.
[12] وذلك هو قصدي بكون فكرهم نسخة باهتة من الماركسية البدائية: فالظن أن التاريخي الحضاري هو المحدد الأول للتاريخ الإنساني وأن المحدد فيه هو المادي هو الحسم الذي أنسبه إليهم. لم يدر في خلدهم أن التاريخي الطبيعي له دور مهم في هذا التحديد وأن المحدد فيه هو ما للإنسان من خصائص وقدرات ترميزية تجعل الأسطوري شرطا في التاريخ الحضاري والمادي مثلا: وعلم العلاقة بين التاريخين الطبيعي والحضاري هو أهم موضوعات الانثروبولوجيا التي يكثرون الكلام عليها ولا يعملون بأهم مباديها. وقد ناقشت هذا الأمر في مستوى نظرية القيمة (ردا على سمير أمين) وأريد أن أناقشها هنا بعد التذكير بالحجج ضد نظرية القيمة في مستوى نظرية الفاعلية التاريخية المحددة لصيرورة الإنسان الحضارية.
[13] فبمجرد أن ينسِّب العلماني الدين بحصره في الأرخنة يطلق العلم بجعله فوق التاريخ. وهذا هو علة القصور الفكري المميز للعلموية: فأصحابها لايدركون أنها لا يمكنها أن تطلق الأرخنة من دون إخراجها عن حكمها. ومعنى ذلك أن المقابلة بين المطلق والنسبي من حيث تلازم بين حدين لا يمكن نفي أحدهما من دون جعل الثاني إياه: إذا نسبت المطلق أطلقت النسبي. ومثل هذين الحدين مثل القطبين في المغناطيس: لا يمكن تصور أحدهما قائما من دون الثاني. والموقف الديني لا يكون نسبيا والموقف العلمي لا يكون إلا نسبيا بل إن كون العلم نسبيا هو علة كون الإنسان متدينا بالطبع. وكون الإنسان متدينا بالطبع هو علة كون العلم نسبيا: فلو لم يكن الإنسان بالمعنى الديكارتي للكلمة إرادته أوسع شمولا من عقله لما كان بوسعه أن يتصور ما يتجاوز إدراكه العقلي ولكان العلم المحدود غير مدرك لحدوده فلا يكون للإنسان طموح لتجاوز المحدود. وهذا الطموح هو أصل الدين وهو عينه جوهر العلم بحدود العلم الذي يضفي على العلم ما فيه من فاعلية.
[14] سمير قصير الشقاء العربي في العظم التاريخي فقدان الذات والإحياء الثقافي ورد في الرسالة الدولية 71 شتاء 2005 ص.62-69 وبالتحديد ص.63. وكذلك في: قصير الشقاء العربي برلين 2006 ص.38 والموالية.
Samir Kassir, Das arabische Unglück. Von historischer Größe, Selbstverlust und kultureller Wiedergeburt, in: Lettre Internationale 71, Winter 2005, 62–69, 63; ebenfalls in: Kassir, Das arabische Unglück, Berlin 2006, 38f.
[15] نفس المرجع. Kassir – „nur ein chaotisches Bild zurück, das sich in dem Begriff jāhiliyya, verstanden als ‚Zeit der Unwissenheit‘, verdichtet.“ (….). (Das chaotische Bild der so verstandenen jāhiliyya – so betont Kassir zu Recht –)„lässt sich aber nicht aufrechterhalten, wenn man Forschungsergebnisse über die hellenistische und römische Geschichte berücksichtigt, die von Archäologie, Epigraphik und Numismatik dokumentiert werden. So waren arabische Städte im Nordhijaz vollständig romanisiert, was dermaßen weit ging, dass aus ihnen römische Kaiser hervorgehen konnten. Das kriegerische Nomadentum, das die arabische Vorstellungswelt später geprägt hat, wird so nachdrücklich relativiert, und man kann sich ausmalen, welche kopernikanische Wende die Anerkennung eines Goldenen Zeitalters einleiten würde, das dem vermeintlich islamischen Goldenen Zeitalter vorangegangen wäre.
24/5/2009
> من موقع الفلسفة