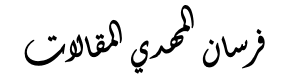ما معنى أن يكون المرء سلفيا ؟
تكرمت الأخت الفاضلة منال الزهراني فصاغت الحاجة إلى علاج إشكالية الفكر في الصراع الدائر بين السلفية والليبرالية بالحاجة إلى الهندرة الفكرية (نحتا لمفردتي هندسة وإدارة) فأبدعت في تحليلها وبيان مطابقتها للوضع الفكري في جل بلاد العرب حتى وإن حصرت كلامها تواضعا فقصرته على الساحة السعودية. وليسمح لي الأخوة في السعودية بأن أعلن أن الأمر لو كان مقصورا على السعودية أو حتى على تونس لما كتبت فيه حرفا: فما يعنيني ليس عين الحيز الذي تتعين في الإشكالية بل طابعها الكلي من حيث هي رامزة لظرفية إنسانية كونية هي جوهر المنزلة التي يمثلها وضع المسلمين في التاريخ الإنساني. فما يحصل على سطح الأحداث ليس محض صدفة بل هو معبر عن العميق من معاني الوجود. والدلالة هي أن مصير الإنسانية مرة أخرى سيتحدد من منطلق قيم القرآن وفي أرض الإسلام عامة وفي الوطن العربي على وجه الخصوص وفي جزيرة العرب بصورة أخص.
وقد أيد بحثها العميق اطمئناني إلى ما استبشرت به من إقبال الشباب المسلم –تمثيلا له بالأخوين الساكر والعامر وغيرهما وفير ولله الحمد-على التفكير الفلسفي والعلمي الجديين العائدين على الذات فحصا وتمحيصا للتحرر من الإخلاد إلى التقليد والاطمئنان الزائف لوهم اليقين بالحقائق النهائية والمعلوم بالضرورة وهلم جرا من الكسل الفكري. فإذا كان البلد الذي يظن ظلما أن منظره الأساسي قد حرم الفلسفة (رغم كونه من أكبر فلاسفة الإسلام لكونه مؤسس النقد الفلسفي والكلامي تأسيسا فلسفيا لاقتصار قرائه السطحيين على دوافعه العقدية) من بؤر الفكر الفلسفي الأساسية في الوطن العربي فمعنى ذلك أن مستقبل الفكر بخير هذا فضلا عن كون المعبرة عن ذلك أخت كريمة في بلد يظن فيه أن المرأة مبعدة عن الحياة الفكرية بل وعن الحياة عامة. لذلك فإني أرى من واجبي تكريم الأخت الفاضلة منال بالتعليق على بحثها سعيا إلى تحديد مفهوم السلفية من حيث صلتها الحداثة لفهم ما بينهما من صلات متينة بخلاف ما يتبادر إلى ذهن القانعين بسطحي الشؤون.
ألأج فالمعلوم أن الوصف بالسلفي انتسابا إلى الذات قد بات أقرب إلى المنبزة منه إلى المحمدة. والغريب أن مصدر التنابز هو أصحاب الموقف الذي لا يقل سلفية محرفة من السلفية التي صارت منبزة. إنهم القائلون بسلفية الانتساب إلى الحداثة كما تعينت في التجربة الغربية التي لا تقبل التكرار إلا بمعنى المحاكاة الببغاوية: وقد سبق فوصفنا المعركة التي تنتج عن التقاء هاتين السلفيتين المحرفتين بمعركة الكاريكاتورين كاريكاتور الأصالة وكاريكاتور الحداثة. أما السلفية والتقدمية بمعناهما السوي فهما متطابقتان لغة واصطلاحا كما نبين. لكن المعركة بين الأصوليتين التقليدية باسم ماضينا والليبرالية باسم ماضي الغرب (إذ الحداثة ماض تجاوزه الغرب) جوهرهما هو التطابق بين موقفين أصوليين من الدين والدنيا إذ يتبادلان التنافي بمقتضى توثين أصحابهما للحاصل من الوجود توثينا يلغي منه كل ممكن فيحولون دون فاعلية الأفق المحرر من العبودية لغير الله ومن الإخلاد إلى الأرض.
والفرق الوحيد بين السلفيتين هو أن أصحاب السلفية المستوردة المباهين بما يظنونه تقدمية غير مدركين لسلفيتهم ظنا منهم أنهم يمثلون المستقبل وهم في الحقيقة يقلدون ما يتصورونه مستقبلا رغم كونه قد صار ماضيا عند أصحابه لأن الحي من كل فعل تاريخي لا يقبل التقليد بل لا بد من إبداع ما هو من نوعه مع امتناع أن يكون مطابقا له بالعدد إلا في أفعال القردة. وعلة الغلط الحداثوي هي أن ما يتكلم عليه مقلدو المنتج المستورد يبدو أكثر حداثة مما يتكلم عليه مستعيدو المنتج المحلي: لكن الفريقين كلاهما يحاكي الميت من نموذجه لأنه أبعد ما يكون عن الإبداع بل هو في الدرك الأسفل من المحاكاة.
في طبيعة الموقف المبدع وعلاقته الزمانية التاريخية
وقبل المضي في تحليل معنى السلفية السوية وبيان طبيعتها ما هي فلنحدد طبيعة الموقف المبدع وصلته بأبعاد الزمانية التاريخية التي تمكن من فهم الفرق بين المثال وتعينات تحققه المتدرج من خلال المزاوجة بين البعدين المادي والرمزي في كل فاعلية مبدعة وحية متحررة من المفعولات الميتة التي يكون تواليها في مسار الحياة من جنس توالي الخلايا التي لا تعيش إلا زمانا قصيرا لتترك مكانها للخلية الموالية وذلك ما ظل الكائن حيا (دون أن ندعي التطابق التام بين الظاهرة التاريخية والظاهرة العضوية من حيث مسار صيرورتهما الحيوي).
فالزمان التاريخي مخمس الأبعاد بخلاف الزمان الفلكي. لكن الزمانين لا يتمايزان إلا إذا كانت الأمة حيا فكرها ووعيها بظرفياتها التاريخية. ذلك أن الزمان التاريخي من حيث هو تكون وجودي ذاتي الفاعلية مؤلف من سلسلتين متوازيتين:
إحداهما هي سلسلة الأحداث التي لا تتكرر أبدا.
والثانية هي سلسلة الحديث المترجم عنها في مستوى الرمز.
ولما كان الحدث متقدم الوجود على الحديث في بعد الماضي من الزمان الفلكي وكان الحديث متقدم الوجود على الحدث في بعد المستقبل منه وكان الحديث والحديث متساوقين في الحاضر إلى حد التوحد باتت أبعاد الزمان التاريخي مستقلة عن أبعاد الزمان الفلكي لكونها أصبحت مخمسة فسمت بالبعدين الحديثيين عن البعدين الحدثيين فصار حدوثها متحررا من الزمان الفلكي وذاتي الزمانية هي عين الزمان التاريخي. فالماضي أصبح ذا حضورين في الحاضر حضور بأثر حدثه وحضور بأثر حديثه وهما حضوران متلازمان ولكن دون تساوق ولا تطابق: وهذه المسافة بين الحضورين هي عين الوعي التاريخي الذي تقاس بها حياة الأمم ونحن المسلمين بات لنا وعي بالحضور التاريخي بمجرد أن حدد الفاروق بداية التاريخ بحدث مؤسس لكل قيم وجودنا الذي لا يمكن حتى لمن يكفر بالإسلام أن يتحرر منه مهما حاول لأنه يتحدد بالقياس إليه وإن بسلبه.
والحدث رغم كونه من جنس الكائنات ذات الوجود المادي المباشر إذ هو واقعة في المتى والأين المحددين يتفجر بفاعليته في الخارج ويهجم على الوجود الذهني هجوما لا مرد له يبقى مع ذلك ذا حضورين:
أحدهما حضور مادي صرف يتعين عضويا بما يفعله في كياننا العضوي بالوراثة العضوية أعني بتوسط التكاثر والتغذية المادية (الإرث العضوي وهو مدين للديموغرافيا والاقتصاد أو الانتاج الرمزي)
والثاني حضور مادي لكن قصده الأول هو أثره الروحي لكونه يتعين نفسيا بما يفعله في كياننا النفسي بالتراث الرمزي الذي يبدعه الإنسان بتراكم تجربته التراكم الذي يتحقق بتوسط التربية والتغذية الروحية (التراث الروحي وهو مدين للرمزغرافيا والثقافة أو الانتاج الرمزي).
ومجموع التأثيرين هو موضوع علم الأناسة أو الانثروبولوجيا. لكن ذلك كله يتضاعف بالعودة على نفسه ليكون موضوع حديث عنه حديثا ليس له من دونه معنى لكونه انعكاسا لدلالاته في الوعي الإنساني وترجمة لهذا الانعكاس في التراث الرمزي للأمة وهو الحيز الذي من دونه لا يمكن تصور ما أشارت إليه الأخت الفاضلة نوال من هندرة ممكنة بكون هذه العودة تمثل المرحلة الأولى من كل تنظير فلسفي وعقلي ينظم به الإنسان شتات كيانه التاريخي عضويه وثقافيه أعني إرثا وتراثا.
وما يحصل من تفاوت بين وجهي الحدث وترجمتهما في الحديث هو المسافة الواصلة والفاصلة بين بعدي الوجود الإنساني اللذين لا يمكن أن يتطابقا أبدا بل هما من جنس الفصام الدائم الشارط لقابلية الحدث الماضي للتأويل اللامتناهي بفضل الحركة الدائمة لدلالات الحديث المتعلق به. وحركة هذه الدلالات تحكمها إشكالات الحاضر من حيث هو استعداد للمستقبل استعدادا تنعكس فيه العلاقة بين الحدث والحديث فيصبح الحديث متقدما على الحدث باعتباره محددا لاستراتيجية الفعل الذي سيكون حدثا. وبذلك يكون الحاضر بؤرة صراع ومنبع فاعلية ذات قبلتين:
أولاهما قبلة متجهة إلى الماضي تؤول حديثه عن حدثه لمحاكمتهما أحدهما بالآخر في الاتجاهين محاكمة نقدية علما وأن الحدث الماضي لم يعد موجودا بذاته بل بأثره في كياننا أثرا لا ندرك معناه إلا بما بقي من حديثه عن حدثه ترجمانا عن كيفيات حدوثه وتلك هي دلالته في تراثنا.
والثانية قبلة متجهة إلى المستقبل تحقق حدثه بمقتضى استراتيجية حديثه لمحاكمتهما أحدهما بالآخر في الاتجاهين محاكمة نقدية علما وأن الحدث المقبل ليس هو بعد موجودا بذاته بل بأثره السلبي في امتحان الحديث في وعينا امتحانا لا ندرك معناه إلا بما يحركنا من دوافع الحديث عن كيفيات الحدوث في المستقبل وتلك هي دلالة مشروعنا.
وكل الصراع بين الصفين إذ يتحولان إلى كاريكاتورين من هذه الحركية المتعلقة بزمانية التاريخ الحي علته تجاهل الدلالة الحقيقية للقبلتين في تاريخ الإسلام من حيث هما محددتان لمنطق التاريخ الإنساني كما يعرضه القرآن الكريم عرضا يجعله منطق التاريخ ذاته ومن ثم فهو الحاضر الدائم:
فالقبلة الأولى ترمز إلى توجه القرآن في قصصه الخبري إلى الماضي نقدا للأحداث والأحاديث بمنطق واجب الحدوث الذي يخضع لسنن قابلة للعلم ومن ثم ممكنة من امتحان التحريفات الممكنة التي يطبق عليها القرآن الكريم منهج التصديق والهيمنة.
والقبلة الثانية ترمز إلى توجه القرآن في إنشائه الأمثولي إلى المستقبل نقدا للأحاديث والأحداث بمنطق ممكن الحدوث الذي يخضع لسنن قابلة للإنجاز ومن ثم ممكنه من تأسيس الاجتهاد والجهاد من أجل تحقيق القيم السامية في التاريخ الفعلي.
والجمع بين القبلتين في نفس اللحظة كما حدث يوم تم تغيير القبلة خلال نفس الصلاة هو المعنى العميق للسلفية من حيث هي السن الحي والدائم والجامع بين هذه الأبعاد الأربعة في الحاضر الذي هو أصلها جميعا (بعدي الماضي حدثا وحديثا وبعدي المستقبل حديثا وحدثا). تلك هي السلفية السوية من حيث هي إبداع دائم بشرطي الاستثناء من الخسر أعني بالاجتهاد (نظرا وهو الإيمان والتواصي بالحق) والجهاد (عملا وهو العمل الصالح والتواصي بالصبر) لشروط تحقيق القيم بأصنافها الخمسة التي حددها القرآن الكريم في سورة يوسف عليه السلام: 1-قيم الذوق 2-وقيم سلطانه (له وعليه: الجمال والحب وسلطانهما) 3-وقيم الرزق 4-وقيم سلطانه (له وعليه: المال وأسباب الحياة الغذاء والاقتصاد وسلطانهما) 5-وقيم السلطان المطلق أو برهان الرب الذي يعدل من سلطاني الذوق والرزق ويسطر عليهما لئلا يتحول الإنسان إلى عابد لهواه.
وليس الحاضر الحي في كل أمة تبدع وجودها التاريخي إلا مساوقة فكرها لوجودها ما أمكنت المساوقة وما هو إلا الوعي بهذه العلاقات ما استطاعت إليه سبيلا ومحاولة تحقيق التطابق بين بعدي الحدث والحديث قدر الاستطاعة. لكن هذه الأبعاد تنعدم عند الأمم الميتة فلا يكون لها حاضر أصلا لأن الماضي والمستقبل يصبحان مقابر رتيبة تقلب فيها جثث الماضي الأهلي والأجنبي باسم الأصالة والحداثة اللتين لا تختلفان إلا عندما تكونان معبرتين عن حاضر ميت لكونهما في ذاتهم أمرا واحدا هو هذا المخاض الذي وصفنا.
في السلفية السوية التي جوهر الفاعلية التاريخية
وانطلاقا من هذا التمهيد المتعلق بالزمانية التاريخية الحية وصلا بين أبعاد الزمان الحضاري والروحي للأمة يمكننا أن نحدد طبيعة السلفية غير المحرفة ما هي وكيف هي واحدة بالحقيقة سواء نظرنا إليها من حيث هي حداثة دائمة لأنها بهذا المعنى تحديث للحدث والحديث بمنطق الحدوث كما وصفنا. فالأصيل في القديم هو ما يخرج الحي من الميت فيه والحديث في الجديد هو التجدد أعني جوهر الحياة. وذلك هو المقصود بالموقف السلفي عندما يصبح اسم علم على السنة فيطابق حقيقة ما تحدد به دور الجيل المؤسس للحضارة الإسلامية. فهذا هو الموقف السلفي الذي يقه بناة الحضارة في كل حضارة قبل أن ينحرف معناه فينتقل من دلالة العمل كما يعمل الجيل المؤسس والمبدع تأسيسا وإبداعا للحي من الوجود المحقق للقيم القرآنية إلى نقيضه تماما فيصبح مجرد محاكاة المبدعات التي ماتت بدل حكاية فعل الإبداع نفسه. وبذلك يتحول الموقف السلفي المحرف إلى قتل كل محاولة للتجريب الحي فيناقض ما لأجله كان الجيل المؤسس نموذجا يحتذى: فأعيان الأفعال التي تعينت فيها قدرات الإبداع الذي صنع به السلف تاريخ الإسلام ليست هي جوهر السلفية بل جوهرها هي فعل التعيين الذي يحقق القيم من الممكن المطلق ما يقدر عليه في المغامرة الوجودية التي هي دائمة التجدد ولا تتكر أعيانها أبدا.
وانطلاقا من هذا التمهيد المتعلق بالزمانية التاريخية الحية وصلا بين أبعاد الزمان الحضاري والروحي للأمة يمكننا أن نحدد طبيعة السلفية غير المحرفة ما هي وكيف هي واحدة بالحقيقة سواء نظرنا إليها من حيث هي حداثة دائمة لأنها بهذا المعنى تحديث للحدث والحديث بمنطق الحدوث كما وصفنا. فالأصيل في القديم هو ما يخرج الحي من الميت فيه والحديث في الجديد هو التجدد أعني جوهر الحياة. وذلك هو المقصود بالموقف السلفي عندما يصبح اسم علم على السنة فيطابق حقيقة ما تحدد به دور الجيل المؤسس للحضارة الإسلامية. فهذا هو الموقف السلفي الذي يقه بناة الحضارة في كل حضارة قبل أن ينحرف معناه فينتقل من دلالة العمل كما يعمل الجيل المؤسس والمبدع تأسيسا وإبداعا للحي من الوجود المحقق للقيم القرآنية إلى نقيضه تماما فيصبح مجرد محاكاة المبدعات التي ماتت بدل حكاية فعل الإبداع نفسه. وبذلك يتحول الموقف السلفي المحرف إلى قتل كل محاولة للتجريب الحي فيناقض ما لأجله كان الجيل المؤسس نموذجا يحتذى: فأعيان الأفعال التي تعينت فيها قدرات الإبداع الذي صنع به السلف تاريخ الإسلام ليست هي جوهر السلفية بل جوهرها هي فعل التعيين الذي يحقق القيم من الممكن المطلق ما يقدر عليه في المغامرة الوجودية التي هي دائمة التجدد ولا تتكر أعيانها أبدا.
إن جيل الصدر ليس نموذجا بـ”ما سن” بل هو نموذج بـ”فعل السن والجمع” المبدعين إنه نموذج بقدرته على السن أي بما بذله من جهد لتحقيق ما يستطيع من قيم القرآن من منطلق الأفق الكوني الذي تمثله ثورته التي تخاطب الإنسانية قاطبة بخلاف ما حوله من وثنوا أعيان الأحداث فحولوا الإسلام إلى دين من بين الأديان بدل من حقيقته التي هو بمقتضاه الديني في كل الأديان بداية وغاية.
فلا يمكن لجيل أن يكون نموذجا بأعيان ما سنه أو ما أبدعه بل هو نموذج ببداره السان بدارا لا يتوقف مثله مثل كل من يؤمن بأن الحركة التاريخية الخلقية هي هذا الجهد الدائم سعيا إلى التحرر من الإخلاد إلى الأرض والاستسلام لقوانين التاريخ الطبيعي. إنما هو يكون نموذجا بقدرته على السن والجمع أعني بالمبادرة إلى فتح آفاق التاريخ على مستقبله بتجاوز ما يشد حاضره إلى الميت من ماضيه تحررا من موقف يكثر القرآن الكريم من ذمه موقف “هذا ما وجدنا عليه آباءنا”. وإذن فلن نكون سلفيين حقا إلا إذا كنا مثل الجيل المؤسس مبدعين سنا وجمعا لكي تبقى الحضارة الإسلامية دائمة الحياة المتجددة وممثلة للريادة في فتح آفاق القيم والحياة الفضلى. ولست أدري ما الذي حدث فصار معنى السلف عكس معناه اللغوي والقيمي:
فلا يمكن لجيل أن يكون نموذجا بأعيان ما سنه أو ما أبدعه بل هو نموذج ببداره السان بدارا لا يتوقف مثله مثل كل من يؤمن بأن الحركة التاريخية الخلقية هي هذا الجهد الدائم سعيا إلى التحرر من الإخلاد إلى الأرض والاستسلام لقوانين التاريخ الطبيعي. إنما هو يكون نموذجا بقدرته على السن والجمع أعني بالمبادرة إلى فتح آفاق التاريخ على مستقبله بتجاوز ما يشد حاضره إلى الميت من ماضيه تحررا من موقف يكثر القرآن الكريم من ذمه موقف “هذا ما وجدنا عليه آباءنا”. وإذن فلن نكون سلفيين حقا إلا إذا كنا مثل الجيل المؤسس مبدعين سنا وجمعا لكي تبقى الحضارة الإسلامية دائمة الحياة المتجددة وممثلة للريادة في فتح آفاق القيم والحياة الفضلى. ولست أدري ما الذي حدث فصار معنى السلف عكس معناه اللغوي والقيمي:
ففي اللغة السلف هو الطليعة المتقدمة دائما وليس الأجيال السالفة بمعنى ما تقدم في الزمان.
وحتى في معناه الاقتصادي فهو تقديم المال في التجارة قبل تحقق البضاعة بصفة الرهان على مستقبل إنتاجها. فالسلف رهان على المستقبل بسبب كون المال المقدم مسبقا هو شرط الفعل ومحركه فيكون بذلك رمزا لدور الرمز من حيث هو القيم المحركة.
والسلف في مدلوله القيمي الجامع بين المدلولين السابقين هو كل من لا يقبل أن يكون مسبوقا بغيره في مجاله كما يقال عن الناقة التي تشرب قبل غيرها مثلا بحيث يعبر السلف عن شغل منزلة الصدارة في الأفعال فعلا فعلا بسبب ما لهذه المنزلة من دلالة قيمية أولا ومن تعبير عن حرية المبادأة والسن.
وهو أخيرا -وبالتعيين الذي يلامس التسمية العلمية- الجماعة التي أسست دولة الإسلام وحققت النموذج الأول من الاجتهاد والجهاد: فليست هي سلفا إلا لكونها قطعت مع ما في الماضي من مكبلات لتحقق شروط الاستخلاف التي حددها القرآن الكريم قيما للبشرية جمعها ومن ثم بوصفها إشرئبابا دائما لتحقيق شروط تحقق القيم في بعدها الكلي. أما عين القيم فهي ما لا يمكن أن يتكرر وإلا لصارت القيم أوثانا تعبد بديلا من المطلق.
وهو أخيرا -وبالتعيين الذي يلامس التسمية العلمية- الجماعة التي أسست دولة الإسلام وحققت النموذج الأول من الاجتهاد والجهاد: فليست هي سلفا إلا لكونها قطعت مع ما في الماضي من مكبلات لتحقق شروط الاستخلاف التي حددها القرآن الكريم قيما للبشرية جمعها ومن ثم بوصفها إشرئبابا دائما لتحقيق شروط تحقق القيم في بعدها الكلي. أما عين القيم فهي ما لا يمكن أن يتكرر وإلا لصارت القيم أوثانا تعبد بديلا من المطلق.
فكيف أصبح هذا المفهوم تقليد الماضي –سواء كان ماضينا الأهلي أو الماضي المستورد-في ما فعل وليس في كونه يفعل بإقدام دون تقليد بمقتضى قاعدة تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت؟ المفروض أن يكون السلفي من يفعل اجتهادا في النظر (الإيمان والتواصي بالحق) وجهادا في العمل (العمل الصالح والتواصي بالصبر) ليكون الطليعة المتجهة نحو المستقبل وليس من يقلد الماضي في مضمونات أفعاله بل في قدرته على الفعل لا غير.
وبصورة عامة فـكلمة “السلف” مفردة عربية معناها مطابق تمام المطابقة لمعنى مفردة التقدم والسبق ليس بمعنى الترتيب الزماني كما يسيء البعض الفهم بل بمعنى ترتيب الشرف بمعنى السعي للكون في الصدارة. ومن يفهمه بمعنى ما سبق ملتفا إلى الماضي لا يراه إلا بالنظرة المدبرة للزمان فيجعل السابق متقدما على اللاحق ليس بالزمان الفلكي فحسب بل بالقيمة وهو ما يعني أن البشرية ليست ساعية إلا الكمال والرفعة بل إلى الانحطاط والذلة: وذلك أمر ينافي تمام المنافاة مضمون القرآن الكريم كله.
والمعلوم أن المعنى الأصلي للتقدم ليس معنى الترتيب بمقتضى المجرى الفلكي للزمان بل هو السبق في المنزلة والشرف ومن ثم فهو الإبداع الذي يسن سنا يجمع جمعا وليس تقليد السنن السابقة القاتلة للإبداع: السلف هو فعل السن وليس حصيلته التي هي أعيان لا تتكرر أبدا بل ما يتكرر هو التعيين الذي يحقق الكلي القيمي في أشكال دائمة التجدد هو عين الحياة الروحية.
إنه النظرة المقبلة لأن التقدم يعني السبق سواء التفت المرء إلى الوراء أو إلى الأمام عند حصر الكلام على الترتيب الزماني الفلكي. لكن الأمر لا يتعلق بالترتيب الزماني بل هو يتعلق بمنزلة الصدارة في الفعل القيمي ومن ثم في صنع التاريخ بما هو سعي لجعل الواقع أقرب ما يكون من المثال. لذلك فهو دائما ما يوجد على رأس المسيرة ومن ثم فهو الاستقبال الدائم بمعنى تحديد القبلة كالحال في منزلة الإمام: فاستقبال القبلة ليس تكرارا إلا من حيث كونه في الصدر لكن التصدر متجدد دائما بمضمون عيني مبدع غير مسبوق.
فيكون المعنى المقصود بالسلفي في الحالتين مؤسس السنن بإبداعها وليس متبع السنن بتقليدها. لذلك استبدلتُ في جل كتاباتي عبارة أهل السنة والجماعة بعبارة أهل السن والجمع. فمؤسسو دولة الإسلام مثلوا قطيعة مع التاريخ الماضي بتأسيس سنن جديدة أهم سنة فيه هي التحرر من موقف التقليد لأنه أكثر شيئا ذما في القرآن أعني سنة “هذا ما وجدنا عليه آباءنا”.
السلفية ليست تقليد سنن فاتت لقوم خلوا لهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا بل هي بقاء الأمة طليعة الإنسانية لتكون من ثم سلف العصور المقبلة أعني صدرها بما تسنه سنا يجمع ولا يفرق ومن ثم فالقصد هو الريادة في السن لا تقليد مبدعي السنن إلا في القدرة على الإبداع الدائم للسنن الملائمة للغاية من الوجود الإنسان من حيث هو مستعمر في الأرض استعمال استخلاف يرعاها وليس استعمار إتلاف يقضي عليها. فيكون لنا ما نكون به كاسبين مثلهم لا أن نكسب ما كسبوا. نتعلم منهم مناهج الكسب وشجاعة السن لأن ما يراد تحقيقه ليس السنن المكتسبة التي هي مجرد مدارج نحو الغاية والغاية هي قيم القرآن.
فكيف نحقق ما نستطيع تحقيقه منها بسنن دائمة التجدد؟ إن الكسب طريق لامتناهية لتحقيق قيم القرآن التي لا يمكن أن يدعي جيل أنه قد حققها بحيث صار واقعه مثالا بديلا منها بما في ذلك جيل الرسول نفسه: ذلك أن اعتباره قد حقق المثال فضلا عن عدم صحته يخلق من المثل العليا أوثانا بديلة منها فيموت جوهر التدين الذي هو هذا التوق بالذات إلى المثال الأعلى بوصفه في المعرفة اجتهادا وفي العمل جهادا إلى يوم الدين.
قيم القرآن قد لا يكفي تحقيق الممكن منها كل المستقبل إلى يوم الدين فكيف ندعي أنها تحققت ويكفي أن نقلد من سبق من محاولات تحقيق السنن المثالية التي يصفها القرآن فنتوقف عن السعي إليها من حيث هو إبداع لنجعله مجرد اتباع ؟ سنن الرسول نماذج في السعي لتحقيق بعض الممكن من السنن القرآنية ومن حيث هو سعي فإنها ليست نماذج بما حصل منها مضمونيا بل بصورة تحصيلها وإلا لكان ذلك يعني أن المستقبل ليس إبداعا لطرق تحقيق الاستخلاف بل اتباعا لما تبين أنه لم يعد كافيا لتحقيق أدنى شروطه: خلق السن وأساليبه وطرقه تلك هي الأمانة التي حملها الإنسان وأبتها الجبال. ذلك هو ما ينبغي أن نتعلمه من عصر الرسول وليس الحلول التي حقق بها الأوائل ما تيسر لهم تحقيقه من قيم القرآن فكان في عصره ثورة بشكله ومضمونه وهو اليوم تربة كل ثورة بشكله حتى وإن بات مضمونه غير كاف لتحقيق ما يمكن أن يجعلنا قادرين على استعمار الأرض مستخلفين وأسيادا.
والله أعلم.
2010