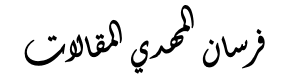خيرة العقول المسلمة في القرن العشرين
ـ ملاحظة من الكاتب:
اخترت هؤلاء الخمسة من بين علماء الإسلام ومفكريه في القرن العشرين بناء على معايير ثلاثة، هي: الجمع بين ثقافتيْ الشرق والغرب، وبين الفهم الشرعي والموقف الشرعي، وبين عمق الفكرة وإشراق الروح. وأرجو أن تعين هذه المقالات القارئ الكريم على الإلمام السريع بحياة هؤلاء الأكابر، ثم ببعض الأفكار الكبرى التي صاغوها، لعل ذلك يستحثه على البحث بنفسه عن المزيد من نفائس الأفكار التي خلفوها لنا في كتبهم، والعبرة التي تنبض بها سير حياتهم.
أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهؤلاء الأعلام في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هو الموفق لكل خير، لا شريك له.
محمد بن المختار الشنقيطي
الدوحة 29 رمضان 1431 هـ 8 سبتمبر 2010 م
(1)
ـ محمد إقبال.. أعجميٌّ ذو لحْنٍ حجازيٍّ
* أسألك اللهمَّ عمرا عريضا:
كان الفيلسوف ابن سينا يقول: “اللهم إني أسألك عمرا عريضا”.. أي عمرا حافلا بالإنجاز. ويمكن القول إن حياة الفيلسوف الشاعر محمد إقبال قد تحقق فيها هذا الدعاء. ولد إقبال في مدينة “سيالكوت” بمقاطعة البنجاب الهندية عام 1877، لأسرة من البراهمة النبلاء اعتنقت الإسلام في عصور متأخرة.
وكان والده متصوفا عميق التدين. درس إقبال في مدرسة انكليزية ثم في كلية حكومية بلاهور عاصمة البنجاب، وتميز في اللغتين العربية والانكليزية، وحصل على شهادتيْ الباكالوريوس والماجستير في الفلسفة. فعمل مدرسا للتاريخ والفلسفة السياسية في الكلية الشرقية بلاهور، وبدأ ينشر بواكير شعره الذي هز الحياة الأدبية والفكرية في الهند. رحل إلى أوربا عام 195، فتابع تحصيله العلمي في جامعتي كامبريدج البريطانية وميونيخ الألمانية حيث حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة وشهادة المحاماة في القانون، وعاد إلى الهند عام 198 بحصاد علمي وافر في برهة زمنية وجيزة.
عمل إقبال بعد عودته إلى الهند محاميا، لكن اهتمامه بالفلسفة والشعر والسياسة شغله عن ذلك. فانضم إلى عدد من الجمعيات والمنظمات الساعية إلى حماية الوجود الإسلامي في الهند بعد أن بدأت بواكير تقرير المصير الهندي ورحيل المستعمر البريطاني تلوح في الأفق. وكان إقبال أول من اقترح فكرة تأسيس دولة خاصة بالمسلمين في القارة الهندية، تحفظ وجودهم وهُويتهم، وتمنع تراثهم وحضارتهم الإسلامية من الاندثار، وهو الذي أقنع السياسي البارز محمد علي جناح بهذه الفكرة عبر المراسلات بينهما، فحولها جناح إلى برنامج عملي. وبعد عمر عريض من العلم والعمل رحل إقبال عن هذه الدنيا فجر يوم 19 ابريل 1938. وتجسدت فكرته عن الدولة المسلمة في القارة الهندية يوم ميلاد باكستان، بعد وفاته بعقد من الزمان.
* بحر من الأفكار والأشعار:
خلَّف إقبال بحرا من الأفكار والخواطر البديعة التي ضمنها دواوينه الشعرية وكتبه النثرية. فقد ألف تسعة دواوين شعرية، ضمت حوالي اثني عشر ألف بيت من الشعر، منها حوالي سبعة آلاف بيت بالفارسية، وخمسة آلاف بيت بالأوردية. ومن دواوينه: “جناح جبريل” و”رسالة المشرق” و”ضرب الكليم” و”هدية الحجاز” و”الأسرار والرموز”. كما ألف بضعة كتب نثرية تبرهن على أنه كان متمرسا بفلسفة الشرق والغرب. وأهم هذه الكتب: “تجديد الفكر الديني في الإسلام”، و”تطور الفكر الميتافيزيقي في بلاد فارس”The Development of Metaphysics in Persia. وقد ترجمت إلى العربية كل دواوينه وواحد ـ على الأقل ـ من كتبه النثرية، هو “تجديد الفكر الديني في الإسلام”. ولعل أحسن الترجمات العربية لشعر إقبال هي ترجمة سفير مصر بباكستان في الخمسينات، الأديب عبد الوهاب عزام، والشيخ الأزهري الضرير الصاوي شعلان، ثم الصياغات الشعرية البديعة التي صاغ فيها الأديب السوري زهير ظاظا الترجمة النثرية لديوان (جناح جبريل)، ومنها نقتبس جُلَّ الأبيات الشعرية الواردة في هذا المقال.
* هندي الهوية حجازي الهوى:
كتب أحد المؤلفين الهندوس ساخرا من إقبال، فقال: إن إقبال “رجل ظمآن على ضفاف نهر (الغانغ) يبحث عن الماء في صحراء العرب”. ونسي الكاتب المغرور أن صحراء العرب عند إقبال هي النبع الذي استقت منه كل الإنسانية، فارتوت بماء الإسلام الزلال. كما نسي أن الصحراء عند إقبال هي رمز الرجولة والشجاعة والشهامة، وهذه هي الفضائل التي تعبر عن فلسفة “إثبات الذات” التي نادى بها إقبال. واسمع قول إقبال في قصيدته “الشاهين”، وهو يفتخر بصحرائه، ويزهو بكبريائه:
أنا نجل الصحراء والزهد ديني *** وهما في سجيَّـتي ودمائي
أجهلُ الزهرَ والنسيمَ وما في *** لوعة العندليب عند المساءِ
وجمال البستان يُغري، ولكن *** ليس يغري مُنَشَّأً في العراءِ
أين مجدي إذا شَقِيتُ لجـوع *** وأذلَّـتْ حمامة كبريـائي؟
نشأ إقبال في أجواء الثقافة الهندوسية، ثم اغترف الثقافة الغربية من منبعها، وارتضع لبانها، في وقت قلَّ فيه وجود المسلم الملمِّ بثقافة الغرب بعمق… فما زاده كل ذلك إلا ولَهًا بجمال الإسلام، وإيمانا بأن رسالة الإسلام لا تطاولها رسالة أخرى، وأن اللحن الإسلامي لا يضاهيه لحن آخر. وفي ذلك يقول:
ليس في ضوضاء هذي الأممِ *** نغمةٌ إلا أذان المسـلمٍ
وسواء كان طالبا في بريطانيا، أو باحثا في ألمانيا، أو سائحا في إيطاليا، كان قلب إقبال دائما معلقا بصحراء الحجاز وجباله، ولم يجد في بلاد الشرق والغرب ما يسحر قلبه أو يسبي لبَّه مثل ما فعلتْ به أرض الحجاز. كان إقبال رجل المحبة بحق، أحب الإسلام وكل ما يمت له بصلة، وأحب العرب لارتباطهم بتاريخ الإسلام وثقافته. لكن حبه تجلَّى أعمق ما تجلَّي في تعلقه بالحجاز، أرض النبوة ومهبط الوحي. كان هنديَّ الهوية حجازيَّ الهوى، وفي ذلك كتب:
أنا أعجمي الحـب إلا أنني *** أطلقت في الحرم الشريف لساني
كم ثوبَ إحرام على متضرِّع *** مزَّقْـتُه باللـحن من ألحـاني
وكتب:
صوت قيثارتي التي سمعوها *** أعجميٌّ لكنَّ لحْني حجـازي
وكانت أمنية إقبال في هذه الحياة أن يكون جذوة من جذوات الحرم الشريف. وفي ذلك يقول:
تمعَّن بقلـبك واستفـته *** ولا تسأل الشيخ عن شانهِ
خلا حرم الله مـن أهـله *** فكن أنت جـذوة أركـــانـهِ
وحينما رحل إقبال عن عالم الفناء إلى عالم البقاء يوم 21 ابريل 1938 حمل معه الوله المزمن بالحجاز، فكان من آخر ما نطق به وهو يحتضر بيتيْ شعر يقول فيهما:
نغماتٌ مضيْنَ لي هل تعـــودُ؟ *** أنسيمٌ من الحجــاز يعـــودُ؟
آذنَتْ عيشتي بوشْك رحيل *** هل لعلم الأسرار قلب جديدُ؟
* عز العبوديَّة لله:
يمكن تلخيص فلسفة إقبال ونظرته للحياة في ثلاث كلمات هي “عز العبودية لله”. ويعبر إقبال عن هذه الفكرة أحيانا بمصطلح “زهد الملوك” و”زهد المقتدر”. وتتألف فلسفة عز العبودية من شقين: أحدهما يدعوه إقبال “نفي الذات”، والثاني يدعوه “إثبات الذات”. والمقصود بنفي الذات: التواضع والخضوع المطلق في العلاقة بالخالق، وبإثبات الذات: العزة والثقة بالنفس في العلاقة بالمخلوق. فالعزة عند إقبال ليست فكرة ساذجة من الاستعلاء على الغير، أو الانكفاء على الذات، بل هي مفهوم مركَّب من العلاقة بالخالق وبالمخلوق. وقد كان إقبال في مسار حياته مثالا للمسلم المعتز بدينه، في وقت قلَّ فيه وجود الأعزة بين المسلمين. وما ذلك إلا لأن إقبالا كان يرى كل ما سوى العبودية لله ذلا وتسولا ومهانة. وفي ذلك يقول:
أنت عبد الله فالزمْ *** ليس للحُرِّ تحوُّلْ
ما سوى عز العبــــــــوديــة لله تســوُّلْ
على درب القلب والحب
كان إقبال مثالا للعالم المتبحر ذي العقل الكبير، فقد تعلم سبع لغات، وأتقن عدة تخصصات. على أن روح إقبال ومرآة فكره الصافية تتجلى في شعره أكثر من نثره، فقد آثر لغة القلب على لغة العقل ـ رغم تمرُّسه بالصنعتين ـ فاختار الشعر مطية لأفكاره، لأن الشعر دفقات من الوجدان وومضات من العبقرية تقتحم القلوب دون استئذان، بينما يدخل الفكر إلى العقول ببرودة، وعبر مسار متعرج من المقدمات المنطقية الجافة. وقد قال إقبال بحق: “إن جفاف المنطق لا يقَْوى على مقارعة نضرة الشعر”.
آمن إقبال بأن أساس الالتزام الإسلامي هو المحبة القلبية الوالهة، لا المعرفة الذهنية الباردة. فالحب أعمق أثرا من العلم، والقلب أقوى سلطانا من العقل، وما يحتاجه المسلم للوصول إلى مقام “عز العبودية لله” أكثر بكثير من مجرد المعرفة الذهنية بالإسلام، أو الإلمام التاريخي بأيام المسلمين. إنه يحتاج إلى تمثل تعاليم الإسلام بقلبه، حقائق من لحم ودم، لا قوالب ذهنية مجردة. لم يكن إقبال في يوم من الأيام حياديا بين العقل والقلب، بل مال إلى جانب القلب دائما. وقد عبر عن ذلك واصفا تجربته الشخصية في الحياة، فقال:
مضى إقبال هَوْنًـا في *** دروب الفكر واجتازا
فلما جاء درب الحـبِّ *** مال القلـب وانحــازا
وفي مقارنة بديعة بين القلب باعتباره مستودع الأسرار والحقائق، والعقل باعتباره الدليل إلى سطحها الخارجي، يقول إقبال إن ما يحتاجه المسلم اليوم هو “دواء البصيرة” الذي يحرر من “داء البصر”، وأن القلب المؤمن المفعم بحب الله ورسوله هو مصدر الهداية ومنبع الرشد:
دواء البصيرة هـذا الـدواءْ *** رجاؤك في كشف داء البصرْ
وما العقل إلا جدال العلـومْ *** وحرب الظنون ورجم النظرْ
مصيرك أعظم من وقـفـة *** وأول معنـاه ذوق الســــفــرْ
وسر اللآلئ خُلْد البـريـقْ *** وإلا فمعدنــها من حجــــــرْ
وما هي جدوى دم في العروقْ *** إذا كان يطفـئ نار الفكرْ؟
على أن لغة القلب والحب عند إقبال لا شأن بخضوع الإنسان لأهوائه الأرضية. بل الحب عنده قرين للكرامة ومرادف للعز، ذلك العز الذي يجسِّده الخليل عليه السلام وهو يحطم الأصنام:
وجائزة الحـرِّ غيرُ الخمـــــــورْ *** وغير الغواني وغير الخيـــامْ
على الطُّعْم يسقط من لا يطيرْ *** ومن لا يحلِّق فوق الغمامْ
*****
هو الحب ينسيك وقع الجراحْ *** وتفضـح سـرَّك آثــــارُهُ
وما الحب إن لم تمتْ عـزةً؟ *** وما العيش جلَّـلَـه عارُهُ؟
رحم الله العلامة محمد إقبال.. الشاعر الأعجمي ذو اللحن الحجازي.
(2)
ـ محمد عبد الله دراز.. عاشق القرآن الكريم:
* سيرة حياة:
ولد العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز عام 1894، بمحافظة (كفر الشيخ) المصرية. ونشأ في أسرة ذات علم وورع. فوالده الشيخ عبد الله دراز من علماء الأزهر المبرَّزين، وهو شارح كتاب “الموافقات” للإمام الشاطبي. أكمل دراز حفظ القرآن الكريم وهو فتى يافع لما يكمل العقد الأول من سنيه بعد، وحصل على شهادة العالمية عام 1916. عمل مدرسا بجامعة الأزهر عام 1928، وسافر إلى الحج عام 1936. وفي العام ذاته حصل على منحة دراسية للدراسة بجامعة السوربون الفرنسية. فأقام في فرنسا اثنتي عشرة سنة مضت كلها جدا وانكبابا على استيعاب الثقافة الغربية من منابعها الأصلية، وتأملا مقارِنا لتلك الحصيلة بمبادئ علم الأخلاق في القرآن الكريم.
حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون، ونالت أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان “أخلاق القرآن” La Morale Du Koranإعجاب كبار المستشرقين الفرنسيين، ومنهم ليوي ماسينيون وليفي بروفنسال. وكانت مناقشتها يوم 15/12/1947. وبعد عودته من رحلته العلمية المديدة، أصبح دراز عضوا في هيئة كبار العلماء عام 1949. كما عمل محاضرا بعدد من الجامعات المصرية في تاريخ الأديان والتفسير وفلسفة الأخلاق. انتقل العلامة دراز إلى ربه في مدينة لاهور الباكستانية عام 1958 وهو مشارك في مؤتمر الثقافة الإسلامية هناك، فنعاه الأكابر في مصر والعالم الإسلامي.
* عِرْق مغاربي:
ويبدو أن أسرة دراز نزع بها عرق وقرابة عقلية خاصة مع المغرب العربي، ربما لانتساب الأسرة تقليديا إلى المذهب المالكي. فقد شرح الشيخ عبد الله دراز ـ والد الدكتور محمد عبد دراز ـ كتاب (الموافقات) لفقيه الأندلس أبي إسحاق الشاطبي، وحقق دراز الابن الكتاب، ثم كتب دراسة عن كتاب (الاعتصام) للشاطبي أيضا، وحاول توليد أفكار الاعتصام وتجديدها في كتابه (الميزان بين السنة والبدعة) الذي توفي قبل إكماله، رحمه الله.
وحينما كان دراز يتابع دراسته في فرنسا منتصفَ القرن العشرين ارتبط برباط وثيق مع الفيلسوف الجزائري مالك بن نبي، وظهر بين الرجلين شبََه كبير في الاهتمام الفكري، وفي النتائج التي توصلا إليها، خصوصا في مجال تجديد الدراسات القرآنية. وقد صرح دراز بذلك في تقديمه لكتاب بن نبي: “الظاهرة القرآنية”، ولا تخطئ عين المقارِن لكتاب بن نبي هذا مع كتابيْ دراز: “النبأ العظيم” و”مدخل إلى القرآن الكريم”، القرابة الفكرية بين هذين العلَمين من خيرة العقول المسلمة في القرن العشرين.
على أن الأمر تجاوز الرباط الفكري والقرابة العقلية إلى التضامن الأخوي والنضال المشترك، فقد دراز وقف بشجاعة مع المطالبين باستقلال دول المغرب العربي عن فرنسا، وخاطر بوضعه طالبا ومهاجرا مقيما في فرنسا في سبيل ذلك. وأرجو أن تكون هذه الأسطر ردا لشيء من الجميل العلمي والعملي الذي ندين به في المغرب العربي، وتدين به كل الأمة، لهذه الأسرة العلمية اللامعة.
* نفس أبيَّة:
كان دراز يحمل بين جنبيه نفسا أبيَّة، وكان يتصف بشمائل نادرة، أجملها شيخ أهل قَطَر عبد الله الأنصاري، فعدَّ منها: “الفطنة، والذكاء، والحِلْم، والأناة، والتواضع، والوداعة، والوفاء، والجرأة، والإقدام، والشهامة، والصلابة في الحق، ولباقة الحديث، ولين العريكة، والحدب على المرافقين”. كان يدرك قيمة الرسالة القرآنية التي يحملها، كما كان يحمل همَّ الأمة أينما حل وارتحل، حتى كتب عنه تلميذه العلامة يوسف القرضاوي: “ما حدثنا وجلسنا إليه إلا وجدناه مشغولا بأمر الإسلام وهموم المسلمين.” ومن مظاهر عزة نفسه دعمه العلني ـ وهو مقيم بفرنسا ـ لحركات التحرر في المغرب العربي الذي كانت فرنسا تحتله آنذاك. وحينما عرض عليه رجال الثورة المصرية أن يكون شيخا للأزهر اشترط أن يتمتع الأزهر باستقلالية أكاديمية عن السلطة. ولما رفض رجال الثورة ذلك اعتذر دراز عن قبول المنصب، وأصرَّ على رفضه له رغم المحاولات والعروض المتكررة.
* فكر تركيبي:
كان دراز “ابن الأزهر، وابن السوربون” كما وسمه العلامة القرضاوي. وقد أتاحت له الدراسة المعمَّقة لكلٍّ من الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية من منابعهما الأصلية بناء رؤية تركيبية تحليلية فريدة، بعيدا عن السطحية التبسيطية، وعن “سوء الهضم العقلي” الذي أصاب الكثيرين ممن وقفوا عند حدود الثقافة الموروثة الراكدة أو الغريبة الوافدة. كان متعمقا في روحانيات الغزالي والحكيم الترمذي وأبي طالب المكي، متضلعا بفلسفة “ديكارت” و”كانت” و”برجسون”. وقد امتاز دراز بفضل هذا الفكر التركيبي برحابة الأفق، وعمق التحليل، ودقة الاستدلال، مع حجاج مقنع، وبلاغة ساحرة استمدَّها من بلاغة القرآن الكريم.
* عاشق القرآن:
كانت أهم سمة من سمات شخصية دراز، والمنبع الذي فاضت منه كل مآثره العلمية والعملية هي الوَلَه بالقرآن الكريم. كان رجل القرآن بحق، فقد ملكت عليه محبة القرآن لبه، وشغفت قلبه، فكان شغله الشاغل، لا يكاد يُرى إلا وهو منكب على قراءته وتدبُّره، أو قائم يصلي به. وقد انصب اهتمامه العلمي على القرآن حصرًا، فلا يكاد يوجد له عمل علمي إلا والقرآن محوره ولبابه. ولا يستطيع دراز كفكفة عشقه لكتاب الله وتعلقه القلبي به، فهو يتتبَّع ألفاظ القرآن تتبع الوالِهِ، ويصفها بحق بأنها “حبات درية”.
ثابر دراز على قراءة ستة أجزاء من القرآن كل يوم دون كلل أو ملل. وكان معظِّمًا للقرآن، يسجد سجود التلاوة أثناء محاضراته في التفسير، ويطلب من طلابه التوضأ قبل بداية المحاضرة استعدادًا لذلك. وقد كتب عنه رفيق رحلته إلى المؤتمر الإسلامي بلاهور، الشيخ محمد أبو زهرة: “كان يؤمُّنا في صلاة العشاء، ثم يأوي كل منا إلى فراشه، ويأوي هو إلى صلاته وقرآنه. وكنت لا تراه إلا قارئا للقرآن أو مصليا”.
* منهج وسطي:
كان الشيخ دراز إماما من أئمة الوسطية الإسلامية السمحة. وقد تجلت وسطيته في تناوله لعدد من الثنائيات الكبرى التي حيرت الفكر الإسلامي واستنزفته. وهي: العقل والنقل، السنة والبدعة، الجبر والاختيار، السلم والحرب، العلم والدين، الخلق والقانون…الخ. وقد تتبعتُ تناول دراز لهذه الثنائيات الكبرى بتفصيل في دراسة عنه ستصدر قريبا إن شاء الله عن (مركز القرضاوي للوسطية الإسلامية والتجديد) بالدوحة. ولا يسمح المقام بأي بسط هنا، وإنما أنوه الآن ببعض إشاراته في مسألة العقل والنقل. فهو يرى أن “التمييز بين الخير والشر… إلهام داخلي مركوز في النفس الإنسانية قبل أن يكون شِرْعة سماوية”. بيد أن الشرع الإلهي “يكمل الشرع الأخلاقي الفطري”، وهي تكلمة ضرورية للفطرة الإنسانية التي تشوبها شوائبُ صادَّةٌ عن الحق والخير، أو ظلمات قائدة إلى الحيرة والاضطراب.
ومن دون نور الوحي، فإن البشر يظلون في صراع دائب حول تعريف الخير والشر “ولسوف تُقاوَم عقول بعقول، كما تُقاوَم عواطف بعواطف”. وقد أفادنا تاريخ البشرية بضروب من هذا التخبط لا حدود لها، من تقشف (النرفانا) البوذية، إلى إباحية الرواقية اليونانية. وهي كلها شهود على أن نور الوحي ونور الفطرة يجب أن يظلا فرسيْ رهان، كما أراد لهما خالق الشريعة الفطرية، منزل الشريعة السماوية.
* ريادة وتجديد:
لا يكاد عمل من أعمال دراز الفكرية يخلو من نظرات تجديدية ثاقبة. لكن تجديده تجلَّى أكثر ما تجلى في الدراسات القرآنية. ففي هذا المضمار يمكن القول دون مجازفة إن دراز أسس علمين جديدين، هما علم “أخلاق القرآن” وعلم “مصدر القرآن”. ففي الأول كتب كتابه (دستور الأخلاق في القرآن) وفي الثاني ألف كتابيه: (النبأ العظيم) و(مدخل إلى القرآن الكريم). وقد أدرك دراز أنه يسلك دروبا غير مطروقة، وأن عليه أن يبدأ عملا تأسيسيا في هاذين العلمين. ومن هنا كانت إضافته في هذا المضمار ثمينة حقا، وهي حصيلة جهد ومعاناة فكرية عميقة لا يقدرها إلا من تمرَّس بكتبه واكتشف ما فيها من أصالة وعمق وصدق.
ويتجلى تجديد دراز في علوم القرآن من خلال المنهج الذي اتبعه. فقد اعتاد علماء الإسلام أن يبرهنوا على أصالة القرآن الكريم من خلال المدخل اللغوي البياني بالأساس. أما دراز فانطلق من الدراسة التحليلية للرسالة القرآنية منطقيا وتاريخيا. وهذه منهجية تجديدية مفارِقة للمنهج المتوارث. ومن ثمراتها نقل القرآن من السياق الثقافي العربي، ووضعه في سياق العالمية.
رحم الله الدكتور محمد عبد الله دراز.. فيلسوف القرآن الكريم.
(3)
ـ مالك بن نبي.. فيلسوف الحضارة الإسلامية:
* في غسق الاستعمار:
ولد المفكر الإسلامي مالك بن نبي في مدينة قسنطينة الجزائرية عام 1950 لأسرة متواضعة الحال، حيث كان أبوه عمر موظفا بسيطا في إدارة مدينة تبسَّة، وأمه زهيرة ربة بيت تعمل في الحياكة. لكن الأسرة كانت عميقة التدين، عزيزة الأنفس. وقد تحدث مالك في مذكراته (شاهد القرن) عن هجرة أجداده لأمه إلى تونس والجزائر بداية الغزو الفرنسي، خوفا من انتهاك أعراض بناتهم على أيدي الجند الفرنسيين المتغطرسين. كانت أحاديث جدته هي النافذة التي فهم منها مالك جرائم الاستعمار الفرنسي، وأهمية الاعتزاز بالعقيدة الإسلامية واللغة العربية، ثم كانت صلة أسرته بالحركات الإصلاحية وبالطرق الصوفية، خصوصا (الزاوية العيسوية)، دافعا له إلى الاهتمام بقضايا الإصلاح والنهضة والتجديد.
ثم كان حرص والدته على تعليمه القرآن ـ حتى إنها رهنت سريرها مرة لدفع أجرة المعلم ـ دافعا آخر عمق في نفسه حب القرآن وحمْلَ راية الدفاع عنه ضد المستشرقين في كتابه القيم “الظاهرة القرآنية”. جمع مالك بين الدراسة في الكتَّاب وفي المدارس الفرنسية بالجزائر، ثم تخرج من معهد إسلامي بالجزائر (مدرسة سيدي الجليس) وواصل دراسته العليا في فرنسا فتخرج مهندسا عام 1935. والحق أن مالكا كان معلم نفسه، فولعه بالقراءة شديد، وجلده في التعلم الذاتي لا يضاهى، وذلك أكبر مصدر من مصادر المعرفة لديه.
* بين المشرق والمغرب:
بعد ثلاثين عاما من العيش في فرنسا، رحل فيلسوفنا إلى مصر عام 1956. وفي القاهرة عمَّق مالك معرفته باللغة العربية، وقد كانت الفرنسية غالبة على لسانه وقلمه من قبل، وهناك ترجم له د. عبد الصبور شاهين عددا من أهم كتبه ترجمة بديعة، فاشتهر ذكر مالك وتعرَّف عليه الأكابر بمصر والشام. كما بنى مالك صلة بالرئيس عبد الناصر، وخصصت له القيادة المصرية راتبا شهريا مكنه من التفرغ للكتابة والمحاضرات خلال سبع سنين.. وفي مرحلته القاهرية اندلعت الثورة الجزائرية المجيدة، فجرد مالك قلمه لها، وكتب الكثير عنها. عاد مالك إلى الجزائر عام 1963 وفيها تقلد عدة مناصب أكاديمية، منها منصب مستشار للتعليم العالي، ثم مدير جامعة الجزائر، ثم مدير التعليم العالي، لكنه استقال عام 1967 مؤثرا التفرغ للعمل الفكري إلى أن وافاه الأجل يوم 31 أكتوبر 1973. وخلف مالك ثروة فكرية رائعة من حوالي ثلاثين كتابا، نشر منها حتى الآن حوالي العشرين، ولا تزال بعض أعماله مخطوطة لم تنشر. ويمكن اعتبار أهم أعماله هي: “الظاهرة القرآنية”، و”وجهة العالم الإسلامي” و”شروط النهضة” و”مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي”.
* ثائر موطَّأ الأكناف!
يقول علامة فاس ومؤرخها الدكتور عبد السلام الهراس ـ وهو ممن عايشوا مالك بن نبي في نفس المنزل بمصر ـ إن مالكا كان متواضعا بسيطا في حياته وعلاقاته الشخصية: “مالك بن نبي كان يعيش معنا بسيطا جدا، البساطة التامة، كان عندما بدأ يتلقى النقود على كتبه، ويدفع حظه في البيت، فنحاسبه كما نحاسب بعضنا، فيخضع لنا ولا يرى في ذلك غضاضة. يقول: هل أساعدكم؟ فنقول: لا، ثم يثق فينا ثقة كبيرة…”، لكن مالك كان عزيز النفس أبيًّا يعرف قيمة الفكر والعلم الذي يحمله. وكان فيه شدة وفورة غضب أحيانا، تجعل رفقاءه يتجنبونه حتى يهدأ غضبه. لكنه إذا لم يكن غاضبا فهو موطأ الأكناف، رقيق القلب، شديد الوفاء لرفقائه. يقول الهراس: “ما أعتز به هو أن مالك بن نبي أبى أن يودِّعني في الدار بالقاهرة، عندما أتممت دراستي (ليسانس) وعزمت على العودة إلى المغرب. فأبى إلا أن يودعني في بورسعيد على باب الباخرة”.
* حامل همِّ النهضة:
يمكن إجمال الجهد التجديدي لمالك بن نبي في مجالين: مجال الدراسات القرآنية ومجال فكر النهضة. ففي الدراسات القرآنية ابتكر مالك ـ بالتوازي مع الدكتور محمد عبد الله دراز الذي قدم له كتابه “الظاهرة القرآنية” ـ منهجا جديدا للبرهنة على أصالة الرسالة القرآنية، يعتمد التحليل المنطقي والتاريخي أكثر من التحليل البياني اللغوي. وفي مجال النهضة كتب مالك جل كتبه، وهو ما نركز عليه هنا.
لقد قدم مالك بن نبي إسهامات جليلة في تجديد الفكر الإسلامي المعاصر، وتنقية المنبع الفكري الذي استمدت منه حركة النهضة منذ ختام القرن التاسع عشر. وأصبحت بعض المصطلحات التي نحتها مالك على كل لسان. ومن ذا الذي لم يسمع بمقولاته حول العلاقة بين “الاستعمار” و”القابلية للاستعمار”؟ والصلة بين “الأفكار الميتة” و”الأفكار المميتة”؟ ومراحل تطور الحضارة الإسلامية من “طور الروح/الصعود”، إلى “طور العقل/الامتداد”، إلى “طور الغريزة/الانحطاط”؟
وقد توصل مالك بن نبي إلى أن أزمة المجتمع المسلم هي أزمة منهجية عملية في الأساس، وأن التحدي الرئيس الذي يواجه المسلمين هو تحدي النهضة. وصاغ نظريته في التغيير الاجتماعي على أساس مبدإ الفاعلية. وقد أخذ مالك على بعض حركات الإصلاح التي ظهرت في العالم الإسلامي مطلع القرن العشرين إغراقها في الحديث عن العقائد المجردة على طريقة علم الكلام القديم، وتفريطها فيما دعاه “الفكر الفني الذي يعجل بحركة التاريخ”. ففقدت هذه الحركات رسالتها ودورها التاريخي، كما يقول مالك، لأن “المسلم لم يتخل مطلقا عن عقيدته، فلقد ظل مؤمنا .. ولكن عقيدته تجردت من فاعليتها، لأنها فقدت إشعاعها الاجتماعي … وعليه فليست المشكلة أن نعلِّم المسلم عقيدة هو يملكها، وإنما المهم أن نرد إلى هذه العقيدة فاعليتها، وقوتها الإيجابية، وتأثيرها الاجتماعي. وفي كلمة واحدة: إن مشكلتنا ليست في أن نبرهن للمسلم على وجود الله ، بقدر ما هي في أن نشعره بوجوده”.
* تغيير جوهر الإنسان:
وحين قارن مالك بين منهج محمد عبده ومنهج محمد إقبال اكتشف الفرق بين المدرستين: مدرسة كلامية تتعامل مع المشكلة الإسلامية في الإطار الذهني المجرد، ومدرسة عملية تهدف إلى تغيير جوهر الإنسان ومحيطه الاجتماعي. وقد كتب مالك عن ذلك يقول: “إن المدرسة الإصلاحية [بقيادة الشيخ محمد عبده] صاغتها بلغة علم الكلام، بينما صاغها إقبال في مصطلحات أخرى، حين نبَّه على أن المطلوب ليس العلم بالله، ولكنه ـ في أوسع وأدق معانيه ـ الاتصال بالله. ليس المطلوب مفهوما كلاميا، ولكنه انكشاف للحقيقة الخالدة، وبحسب تعبيره هو: (تجلي هذه الذات العلوية)”. ولذلك لا عجب أن المدرسة الإصلاحية بقيادة عبده “ظلت تعاليم تهدف إلى تخريج متخصصين بارعين، أكثر مما تتجه إلى تكوين دعاة مخلصين” حسب تعبيره. والمتخصص البارع الذي لا يحمل هما ولا رسالة، إنما يغذي وقود الجدل على حساب العمل.
وقد ذهب مالك بنْ نبي إلى أن المدرسة الإصلاحية كان في وسعها أن تؤثِّر في مسار المجتمعات الإسلامية تأثيرا أكثر إيجابية “لو أنها استطاعت أن تقوم بتركيب أفكارها، وتجميع عناصرها، لتوحد ما بين الأفكار الأصول التي ذهب إليها الشيخ محمد عبده، وبين الآراء السياسية والاجتماعية التي نادى بها جمال الدين، الأمر الذي كان سيؤدي حتما إلى طريق أفضل من مجرد إصلاح مبادئ العقيدة”.
وكان إقبال قد سبق مالكا في التشديد على أن النفوس المؤمنة إذا لم يشفها تدبر القرآن واستنطاقه بمنهجية عملية، فلا الذوق الصوفي (الكشف) بمغن عنها، ولا الجدل الكلامي (الكشاف) بنافعها. يقول إقبال في ديوانه: “جناح جبريل”:
نفسٌ إذا القرآن ما انتفعت به *** لا الكشف ينفعها ولا الكشَّافُ
والسر في هذا التشخيص الذي اتفق عليه إقبال ومالك وغيرهما من خيرة العقول المسلمة، هو أن علم الكلام ـ الذي رمز إليه إقبال بكتاب “الكشاف” للزمخشري ـ يزيِّف المشكلة الإسلامية من أساسها، كما دلت عليه التجربة التاريخية للمسلمين “حيث لم يكن المتجادلون يبحثون عن حقائق وإنما عن براهين”، كما يقول مالك. ذلك أن “علم الكلام لا يواجه مشكلة الوظيفة الاجتماعية للدين”، وهي جوهر أزمة المجتمع المسلم الآن، ومن أجل استرجاعها ظهرت الحركات الإصلاحية المعاصرة، بل يشغل الناس بالجدل حول أمور غيبية لا مجال لحسمها من الناحية العلمية، ولا تترتب عليها ثمرة عملية.
رحم الله مالك بن نبي.. منظر النهضة الإسلامية.
(4)
ـ إسماعيل الفاروقي.. حامل همِّ الشرق في الغرب:
* سيرة حياته:
ولد الدكتور إسماعيل راجي الفاروقي في مدينة يافا الفلسطينية عام 1921، وبدأ دراسته الإسلامية بالمسجد وفي البيت على يد والده الذي كان قاضيا شرعيا. وتابع دراسته الابتدائية والثانوية في مدارس الدومينيكان الفرنسية، ثم حصل على الباكالوريوس في الفلسفة من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1941. عمل في ظل الانتداب البريطاني محافظا لمنطقة الجليل إلى حين ميلاد الدولة الصهيونية، فالتحق بالمقاومة برهة، ثم هاجر إلى أميركا حيث حصل على شهادتيْ الماجستير في فلسفة الأديان: الأولى من جامعة إنديانا عام 1949، والثانية من جامعة هارفارد عام 1951. وفي عام 1952 حصل على الدكتوراه من جامعة إنديانا، وكانت أطروحته بعنوان: “نظرية الخير: الجوانب الميتافيزيقية والإبستومولوجية للقيم”.
بعد تضلعه بالفلسفة الغربية وبتاريخ وتعاليم الديانتين اليهودية والمسيحية في دراسته بأميركا، أحس الفاروقي بالحاجة إلى تعميق معرفته بدينه الإسلامي، فرحل إلى مصر، ودرس في الأزهر أربع سنوات (1954-1958) بنى فيها ثقافة إسلامية رصينة، ثم عاد إلى الغرب وبدأ التدريس بجامعة ماكجيل الكندية، وباحثا في كلية اللاهوت بالجامعة ذاتها، حيث أسفرت أبحاثه هناك عن كتابه القيم: (الأخلاق المسيحية: تحليل تاريخي ومنهجي لأفكارها المهيمنة). انتقل الفاروقي إلى باكستان عام 1961، ليساهم في تأسيس (معهد البحوث الإسلامية) في كراتشي، ثم عاد إلى أميركا أستاذا بجامعة شيكاغو 1963-1964، وفي جامعة سيراكيوز 1964-1968. ثم استقر قراره بجامعة تمبل التي مكث فيها حوالي ثمانية عشر عاما من العام 1968 إلى عام استشهاده 1986.
* السفير المغدور:
من عادة الملوك الأقدمين أن لا يقتلوا السفراء الذين يحملون الرسائل بينهم، وهم يعتبرون هذا العرف السياسي من أمارات المروءة والشهامة. لكن سفير الشرق الإسلامي إلى الغرب المسيحي إسماعيل الفاروقي قتل غدرا وغيلة. جاء الفاروقي إلى الغرب حاملا معه مظلمته من الشرق، فوجد الظلم في انتظاره في غرب أحلَّ عبادة إسرائيل محل ديانته المسيحية. ففي ليلة 18 رمضان 146 هـ، 27 مايو 1986 م، قُتل إسماعيل الفاروقي طعنا بالسكاكين هو وزوجته الدكتورة لمياء الفاروقي ـ وهي عالمة متمرسة بالفن والعمارة الإسلامية ـ بسبب مواقفه الصلبة في الدفاع عن قضيته وقضية شعبه الفلسطيني، وتعريته الأديولوجية الصهوينية وجذورها العنصرية، وبسبب عمله الدعوي الدؤوب لنشر الإسلام وثقافته في المجتمع الأميركي. بيد أن فكر الفاروقي لم يمت، بل شكل زادا على الطريق الشائك الذي اختطه، طريق كلمة الحق في وجه الجبروت.
* العالم الموسوعي:
كان الفاروقي مثالا للعالم المسلم الموسوعي، فهو متضلع في الفلسفة، والأديان، والتاريخ، وفي مختلف العلوم الإنسانية الأخرى، وهو يتقن العربية والفرنسية والإنكليزية ويكتب باللغات الثلاث وكأن كلا منها لغته الأم. يحكي الدكتور جمال البرزنجي أنه استدعى الفاروقي لعشاء في بيته عام 1972، وتحدث الضيف أمام جمع من أتباع ديانات شتى لمدة ساعة.
وفي ختام الحديث، رفع قسيس يده طالبا التعقيب، فقال: “لقد تعلمتُ عن المسيحية هذه الليلة وحدها أكثر مما تعلمته في دراستي لها خلال الثلاثين سنة الماضية”. خلف الفاروقي ثروة فكرية متميزة، منها خمسة وعشرون كتابا، وأكثر من مائة بحث ومقال أكاديمي. ولا تزال جل كتبه في أصلها الإنكليزي، وهي بحق مساهمة نوعية في تحرير العقل المسلم وتجديد الفكر الإسلامي. وقد ترجمت له بضعة كتب إلى العربية، منها “أطلس الحضارة الإسلامية”. كما تخرج على يديه عدد وافر من العلماء المتخصصين في الأديان. ويمكن إجمال المساهمة التجديدية التي قدمها الفاروقي في أربعة محاور: الحضارة الإسلامية، ومقارنة الأديان، وأسلمة المعرفة، والظاهرة الصهيونية.
* الحضارة الإسلامية:
ففي مجال الحضارة الإسلامية ألف الفاروقي وزوجته لمياء سفرا ضخما وقيما جدا، هو “أطلس الحضارة الإسلامية”، الكتاب الذي “ولد يتيم الأبوين” كما كتب مقدمُه الدكتور هشام الطالب، لأن الدكتور إسماعيل وزوجته استشهدا والكتاب لا يزال في المطبعة. فكان من نعم الله أن خرج الكتاب شاهدا لهما، وحافظا لجهدهما وجهادهما. وهو عصارة فكرهما في مرحلة النضج والتمكن. ولعل بقاء هذا الكتاب دليل على ما ذهب إليه برويز منصور إذ كتب في نعي الفاروقي: “إن حبر العالِم أقوى من سكين الغادر”. ويمتاز هذا الكتاب برحابة النظرة وامتدادها في الزمان والمكان، فالمعرفة الواسعة التي بناها الفاروقي في تاريخ الأديان، خصوصا اليهودية والمسيحية، والخبرة العميقة التي اكتسبتها لمياء في الفن والعمارة الإسلامية، جعلتهما يضعان الحضارة الإسلامية في إطار رحب لا مثيل له في الكتابات الشائعة في هذا المضمار، وقد تبنى المؤلفان منهجا مبتكرا، بيَّنا فيه “السياق” الذي ولدت فيه هذه الحضارة، و”الجوهر” التوحيدي الذي تمحورت حوله، و”الشكل” الذي عبرت به عن نفسها، و”التجليات” التي ظهرت بها (وهذه هي المحاور الأربعة للكتاب).
* مقارنة الأديان:
وفي مجال الدراسة المقارنة للأديان حرر الفاروقي “الأطلس التاريخي لأديان العالم” وكتب الفصل الخاص بالإسلام في ذلك الأطلس، كما قدم له بمدخل ضافٍ بين فيه جلال الرسالة الإسلامية وتفوقها على كل الأديان، واحتواءها جميع الفضائل التي جاءت بها الرسالات السماوية السابقة، واعتمادها على العقل والمنطق. كما ألف كتاب “الأخلاق المسيحية” الذي نقض فيه الأساس النظري والتاريخي لهذه الديانة من خلال مصادرها الأولى. وقد حاول عدد من القسس في جامعة ماكجيل التي كتب الفاروقي الكتاب في رحابها أن يمنعوا نشره، قائلين إنه يزلزل الإيمان المسيحي في قلوب قرائه. وللفاروقي كتب أخرى في الأديان، منها “الإسلام والديانات الأخرى” و”ثلاثية الحوار اليهودي-المسيحي-الإسلامي”، كما اشترك في تأليف كتاب “الديانات الآسيوية الكبرى”، هذا إلى جانب كتبه الخاصة بالإسلام، ومنها كتاب “التوحيد ومقتضياته في الفكر والحياة”.
* أسلمة المعرفة:
وفي مجال أسلمة المعرفة وضع الفاروقي الأسس النظرية لإعادة صياغة العلوم الإنسانية والاجتماعية المعاصرة صياغة إسلامية، بحيث تصبح هذه العلوم رافدا إيجابيا لثقافة المسلمين، لا سيلا جارفا يسلبهم هويتهم ودينهم وثقتهم في الذات. وقد شخص الفاروقي داء المسلمين المعاصرين في نظامهم الفكري والتعليمي السائد، وانعدام الدافع القوي والفكرة المحركة في ثقافتهم. وندد بازدواجية التعليم بين ديني تقليدي ومدني معاصر، مما أنتج ذاتا منشطرة مهزوزة، لا تحسن غير التقليد: تقليد الأجداد الذين رحلوا، أو الغربيين المختلفين دينيا وثقافيا. بينما المطلوب هو تعليم واحد تسري فيه الروح الإسلامية من خلال تدريس مادة الحضارة الإسلامية في كل الجامعات والأقسام بغض النظر عن التخصص. أما المتخصصون في الدراسات الإسلامية فلا بد أن يتضلعوا بالعلوم الإنسانية الحديثة لإثراء ذواتهم وبناء قدراتهم النظرية لتكون على مستوى الثقافة العقلية المعاصرة. وقد أسس الفاروقي مع الدكتور عبد الحميد أبو سليمان المعهد العالمي للفكر الإسلامي ليكون مركز تنظير وتخطيط للثقافة التركيبية التي يحتاجها المسلمون اليوم.
* الظاهرة الصهيونية:
وفي مجال التعريف بالظاهرة الصهيونية، كتب الفاروقي ثلاثة كتب هي: “الإسلام ومشكلة إسرائيل”، و”أصول الصهيونية في الدين اليهودي”، و”الملل المعاصرة في الدين اليهودي”. وكان طرحه متميزا بالعمق والرحابة، وإن لم تخل نبرته من مرارة الظلم. كان الفاروقي متضلعا بتاريخ الديانة اليهودية وبتطور الحضارة الغربية، وقد وضع الصهيونية في ذلك السياق التاريخي، وتوصل إلى أن المسلمين يسيئون فهم أهم عدو لهم اليوم وهو إسرائيل، بالنظر إليها على أنها مجرد ظاهرة استعمارية غربية أو مجرد تكرار للحروب الصليبية، وهي كل ذلك وأكثر بكثير. ثم وضع ميلاد إسرائيل في سياق ثلاثة أفكار مهمة هي: عقيدة “الانتقال الوجودي للخطيئة” ontological passage of guiltفي المسيحية، وتراجع وعود عصر الأنوار الأوربية عن تحقيق المساواة لليهود، ثم المركزية العرقية في الديانة اليهودية. وهكذا اقتلع اليهودي جذوره من أوربا وزرعها في فلسطين وهو محمَّل بكل هذه الأثقال. لكن الحقيقة أنه فعل ذلك متأخرا جدا، وأن عمله هذا مجرد حل مؤقت ويائس لن يكون هو الحل النهائي للمعضلة اليهودية. فتلك معضلة مسيحية غربية لا يمكن حلها على حساب أمة عظيمة تتقدم اليوم إلى مسرح التاريخ من جديد.
رحم الله الشهيد إسماعيل الفاروقي.. حامل همِّ الشرق في الغرب.
(5)
ـ علي عزت بيغوفيتش.. إسلامي بأفق إنساني:
* بواكير حياة واعدة:
ولد السياسي والمفكر المخضرم علي عزت بيغوفيتش عام 1925 في بلدة (بوسانا كروبا) في شمال غرب البوسنة، لأسرة عريقة في تاريخ الإسلام بالبلقان. وكانت أمه على قدر من الورع والتقوى، فغرست في قلبه حب الإسلام. فعشق القرآن، وخصوصا سورة الرحمن، وهو صبي يافع. ثم أسس مع زملاء له في الثانوية نادي “الشبان المسلمين” وهو طالب، وتوسع النادي فيما بعد ليصبح جمعية ثقافية وخيرية، ويجتذب العديد من طلاب جامعة سراييفو التي درس فيها علي عزت القانون، وأدت الجمعية خدمات اجتماعية جليلة خلال الحرب العالمية الثانية. وحينما احتلت النازية الألمانية مملكة يوغوسلافيا وأحالتها جمهورية فاشية، قاطعت جمعية الشبان المسلمين النظام الفاشي، وضايقها هذا النظام فحرمها من الشرعية القانونية. تخرج علي عزت محاميا، وجهد في إتقان اللغات الأوربية الأساسية، ومنها الألمانية والفرنسية والإنكليزية، كما بنى بجهده الخاص ثقافة رصينة في العلوم الاجتماعية والفكر الإسلامي والأدب حتى أصبح ضليعا بهذه العلوم، كما تشهد به كتبه، خصوصا “الإسلام بين الشرق والغرب” و”هروبي إلى الحرية”.
* متحدِّي الزحف الأحمر:
بدأت محنة المسلمين في يوغوسلافيا تتعمق أكثر بعد الحرب العالمية الثانية، حينما استولى الحزب الشيوعي بقيادة جوزيف تيتو على السلطة، وفرض نظاما قمعيا مناهضا للإسلام، واعتقل عددا وافرا من قادة المسلمين وأعدم العديد منهم، أما جمعية الشبان المسلمين، ذات المنهج الثوري واللغة السياسية الصريحة، فكانت الوطأة عليها أقوى، فاعتقل منها النظام الشيوعي حوالي الألفين منهم علي عزت، الذي مكث في السجون الشيوعية خمسة أعوام (1949-1954). وبعد خروجه من السجن بدأ علي عزت العمل محاميا عام 1962، وواصل عمله الفكري الإسلامي، من خلال الكتابة المنتظمة في مجلة “تاكفين” التي كانت تصدرها جمعية العلماء المسلمين في يوغوسلافيا.
وقد صدرت مجموعة من مقالاته في كتاب بعنوان “البيان الإسلامي” عام 1981، فأثار الكتاب ثائرة السلطة الشيوعية التي رأت فيه نوعا من المناهضة للشيوعية، خصوصا بعنوانه المثير الذي يشبه المناقضة لعنوان “البيان الشيوعي” الذي أصدره كارل ماركس وفريديريك أنغلز عام 1848، وأصبح إنجيل الحركة الشيوعية. حوكم علي عزت محاكمة صورية وحكم عليه عام 1983 بالسجن لمدة أربعة عشر عاما، فمكث خمس سنوات كالحة في السجون الشيوعية للمرة الثانية. ومع انهيار الشيوعية عام 1989 خرج من السجن بعد إعادة محاكمته وتبرئته، وبدأ العمل السياسي في أجواء الانفتاح الجديد. فأسس حزبا سياسيا، وفاز برئاسة جمهورية البوسنة طيلة عقد من الزمان (1990 ـ 2000). ثم رحل عن عالمنا عام 2003م، مخلِّفا ذكرى عطرة وأثرا لا يندثر.
* قاهر بربرية الحضارة:
تفاءل مسلمو البوسنة بسقوط الشيوعية خيرا، وحسبوا أنهم دخلوا عالم الحرية الموعودة التي طالما انتظروا إسفار فجرها على بلدانهم. بيد أن عدوا جديدا أطل برأسه القبيح، فكان أبشع من الشيوعية وأكثر دموية، وهو الفاشية الصربية، التي سعت إلى استئصال الإسلام من يوغوسلافيا، مدفوعة بأحقاد دفينة ترجع إلى ميراث العصور الخوالي من الصراع بين المسلمين الأتراك والمسيحيين السلافيين في البلقان. وقد تواطأت أوربا مع الصرب بحصار المسلمين وحرمانهم من أي سلاح يمكنهم من الدفاع عن وطنهم المستباح. وبينما كان المسلمون يبادون كان بعض القادة الأوربيين يتحدثون عن خطر وجود “دولة إسلامية” في أوربا!! وكان على علي عزت أن يقود شعبه في معركة موت أو حياة، انتهت باستقلال البوسنة، لكن بعد تضحيات جسام، وبحور من الدماء في سبرنيستا وغيرها.
كان علي عزت أبياًّ في تواضع، صلبًا في حكمة. صمد في السجن أمام الإغراء والإغواء، وصبر خارج السجن في البأساء والضراء. جمع بين العلم والعمل، بين الفكر والالتزام بالقضية. كان شديد الذكاء، عظيم الشجاعة، لكنه كان يقدر الشجاعة أكثر من الذكاء، وقد كتب يقول: “لم يغنِّ الشعب للذكاء، وإنما غنَّى للشجاعة… لأنها الأكثر ندرة”. وفي أحلك المحن التي واجهها ظل علي عزت ذلك الرجل ذا القلب الكبير الذي لا يحمل حقدا حتى ضد أعدى أعاديه. وقد كتب عن نفسه بحق: “لا كراهية لدي، وإنما لديَّ مرارة”، “لا أتذكر بأني احتقرت أحدا”. ولم يكن يرى العدالة انتقاما، بل إرجاعا للأمور إلى نصابها، مع العفو والصفح حالما يرتفع الظلم عن المظلومين. وفي ذلك يقول: “الطريقة الوحيدة للانتصار على الظلم هي التسامح… أليست كل عدالة ظلما جديدا؟”. وبهذا العقل الواسع والقلب الكبير قهَر علي عزت بربرية الحضارة التي أرادت استئصال شعبه تحت سمع وبصر العالم.
* عاشق الحرية السجين:
كان علي عزت عاشقا للحرية التي يراها جوهر إنسانية الإنسان، كما كان يرى الدكتاتورية أعدى أعادي الإنسان. وكان يعتبر ملكة التفكير مصدرَ قوة الكائن البشري ومنبعَ حريته التي لا تستطيع قوة القهر المادي سلبها. ولذلك كتب متحدثا عن نفسه في السجون الشيوعية: “لم أستطع الكلام، لكني استطعت التفكير. وقررت استغلال هذه الإمكانية حتى النهاية.” وقد حاولت السلطة الشيوعية استدراجه إلى نوع من المساومة على مبادئ الإسلام والحرية فلم تجد منه سوى الصدود والإباء. كتب في دفتره المخفي بالسجن: “اليوم هو 27 شباط 1987م: وهو يوم قليل الإثارة. طلبوني في الصباح لإدارة السجن واضطربتُ، لأنه لم يكن وقت زيارة. وفي غرفة اللقاءات وجدت ليلى وسابينا [ابنتيْه] بوجوه مرحة. أرادتا فورا وربما على المدخل أن تقولا بأن لا شيء مكروها قد حصل. ثم تحدثتا لي كيف أن (نيقولا ستويانوفيتش) رئيس لجنة الاسترحام في رئاسة جمهورية البوسنة اقترح استدعاء للاسترحام، وسيتم الإفراج عني. وكان الوسيط (زدرافكو جوريتشش) سكرتير اللجنة آنذاك هو زميل ليلى في الدراسة، الذي كتب الاستدعاء. وقرأت النص، ولم أوقع، واستمر السجن”. لقد طلبوا منه التوقيع على استرحام من سجانيه، وعلى التزام باعتزال السياسة والشأن العام، فرفض بإباء، ومكث في السجن عامين آخرين جراء ذلك.
وقد علَّمتْه محنة السجن الكثير. وكان يكتب بعض الخواطر وهو سجين، ويخفيها عن أعين سجانيه. ونشرتْ هذه الخواطر فيما بعد ضمن كتابه (هروبي إلى الحرية). وهي تدل على إيمان راسخ، وعقل ثاقب، وفهم عميق للحياة وابتلاءاتها. وفي اثنتين من هذه الخواطر كتب: “السجن يقدم معرفة يمكن أن يقال عنها إنها مؤلمة للغاية”، “يعاني الإنسان في السجن من نقص في المكان وفائض في الزمان”.
* حامل الرسالة الإنسانية:
كان علي عزت بيغوفيتش إسلاميا في العمق، لكن بأفق إنساني رحب. ويحتار المطالع لتراثه من سعة اطلاعه على الثقافة الإنسانية. فهو ضليع في الفلسفة، والأديان، والقانون، والتاريخ، والأدب، والرسم. وتدل هوامش كتبه وثراء استشهاداته وملاحظاته على إطلاع مذهل على ثمرات الفكر الإنساني في الشرق والغرب، وعقل منهجي ناقد لما قرأ، متمثل له في ذاته. وكان يرى أن ركام المعلومات من غير هضم عبء على حامله، وليس من المناسب تسميته معرفة أصلا. وقد كتب في ذلك: “المعرفة المفرطة تخنق أحيانا الفكرة الإبداعية… يمكن للإنسان أن يمتلك المعرفة في عدة مجالات، لكن من غير تنظيم وبدون رؤيا… الكثير من المتعلمين عاشوا وماتوا بدون معرفة حقة… كومة من المواد الجيدة من دون مخطط، تبقى كومة فقط”.
أسهم علي عزت إسهاما جليلا في الفكر الإسلامي والإنساني من خلال كتبه. وأهم هذه الكتب هي (الإسلام بين الشرق والغرب) و(هروبي نحو الحرية)، ثم (البيان الإسلامي). آمن إيمانا عميقا بالإسلام رسالة إنسانية، تحتاجها البشرية اليوم حاجة مُمضَّة. وقد قدم الإسلام بصفته طريق الوسطية بين المادية العمياء التي تغلِّف الأفق الإنساني وتحجب رؤيته، والروحانية العرجاء التي تؤصِّل الانهزامية والانسحاب من معركة الحياة. فالإسلام هو “الطريق الثالث” كما يدعوه علي عزت.. الطريق الذي لا يشطر الذات الإنسانية شطرين، بل يصوغها صياغة متزنة، تجعلها قادرة على التوفيق بين واقعها المتناهي وأفقها اللامتناهي. فالروحانية الواقعية هي أهم سمات الإسلام، والإنسان الكامل في الإسلام ـ كما يراه علي عزت ـ ليس القديس، بل المؤمن الواقعي القوي، الملتزم برسالته الاجتماعية ودوره في الحياة. ولو فهمنا الإسلام حق الفهم ـ يقول علي عزت ـ فسنجد أن الإنسان الواقعي الملتزم أعظم من القديس، وأن ذلك هو السر وراء أمر الملائكة المعصومين بالسجود لآدم الخطَّاء.
رحم الله علي عزت بيغوفيتش.. قاهر بربرية الحضارة بإيمانه الإسلامي وأفقه الإنساني.
ـ تمت ـ
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات..
2010